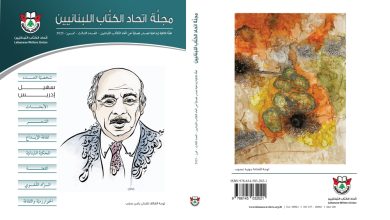الرّيحاني ورحلة البحث عن لغة ثانية – د. باسل بديع الزّين
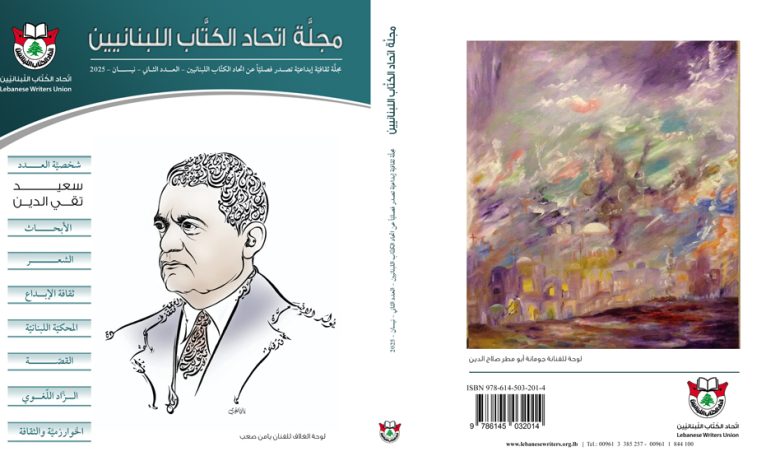
– القراءة الأولى –
الرّيحاني ورحلة البحث عن لغة ثانية
(قصيدة “مفردات الأغاني الحائرة” نموذجاً)
د. باسل بديع الزّين
لا يَفضُّ الالتباسَ سوى الالتباس. ومن معاني الالتباس، لغويّاً، الاشتباه. وغنيّ عن البيان أنّ الاشتباه يُحيلنا على الفِسارة بوصفها جهداً تأويليّاً يبذلِه الـمُفسِّرُ أو المؤوِّلُ بُغية الغوصِ على رموز النّصّ، ومحاولة تفكيكه، وتبيّن مقاصده. وغنيّ عن البيان أيضاً أنّ الاشتباه يُحيلنا على النّصّ بوصفه خطاباً غنيّاً يحتمل التّأويل.
لا مِراء في أنّ النّظريّات التّأويليّة، وبخاصّة الغربيّة منها (شلايرماخر، غادامِر، ريكور، هايدغر، إلخ.) رصدت شروطاً صارمة لعمليّات التّفسير والتّأويل، بدءاً من التّفسيرين النّفسيّ والنّحويّ (شلايرماخر)، مروراً بالقطيعة بين الحقيقة والمنهج (غادامِر) وليس انتهاءً بِعَدّ اللّغة موطن الكينونة (هايدغر)؛ بيد أنّ القاسم المشترَك في هذا كلّه انعقاد إمكان التّأويل على توفُّر نصٍّ أصيل يُتيح لإمكانات القراءة أن تتفتَّح، ومن ثمّ، يُتيح لتفيكيكيّة دريدا أن تقوم لها قائمة، ولموت الكاتب بارتيّاً (نِسبة إلى رولان بارت الّذي نادى بموت المؤلِّف) أن يتحقّق، كيما يُصبِح النّصّ ملك القارئ يُؤوِّله ويُفسِّره انطلاقاً من جملة معطيات موضوعيّة وذاتيّة في آنٍ معاً.
والحقّ أنّ نصوص ديوان الشّاعر أمين ألبرت الرّيحانيّ “صهيل الأغاني الحائرة” لا يُعْوِزها الإبداع الرّصين، والرّمز المكين، والخيال الخصب، والثّراء المهيب. ذلك بأنّها تحفَلُ بالقلق الوجوديّ، والانهمام التخيّليّ، والتّوق الإبداعيّ الأصيل. لكن بالنَّظر إلى ضيق مجال القراءة، سنكتفي باختيار قصيدة “مفردات الأغاني الحائرة” نموذجاً، وسنجهد في أن نتبيَّن أبعادها استناداً إلى ثيمة (موضوع) محوريّة ارتأينا تأويليّاً أنّ النّصّ برمّته يدور حولها، عنينا ثيمة المأزق اللّغويّ، أو رحلة البحث عن لغة ثانية.
تجدر الإشارة، بادئ ذي بدء، إلى أنّ القصيدة تحفَل بِحَقْلَيْنِ مُعْجَمِيَّيْنِ مُتبايِنَيْنِ: حقل “اليباب” وحقل “اليقين”، ويُماثلهما شعريّاً حقلا “الحيرة” أو “الضّياع” وحقل “القبض على” أو “الظّفر بـ”. والحقلان كلاهما يرسمان معالَم جليّة لرحلة الشّاعر الوجوديّة بحثاً عن معنًى جديد أو لغة جديدة.
1 – حقل اليباب أو الضّياع
لِنُنْعِم النّظر في المفردات والتّعابير الّتي تُكَوِّن حقلَ الحيرةِ الدّلاليَّ: “الأغاني الحائرة (تكرّرت أربع مرّات)، المدينة الغاربة، المتاه، تفلتُ منّي بكلّ اتّجاه، طيوراً شريدة، إلخ.”، والكلمات والتّعابير الّتي تُكوِّن حقلَ اليبابِ الّذي يُماثِل حقلَ الضّياع: “فَسُدّ اللّقاح، كُسِرَ الصَّهْرُ، صقيع الرّماد الشّديد، إلخ.”.
واقع الأمر أنّ الحيرة تتولَّد هنا من ضياع المعنى. بيد أنّ هذا الضّياع لا يتأتّى من جرّاء انعدام المعنى، بل من انعدام القدرة على إيجاد المعنى. ثمّة لغة كان الشّاعر يتّكأ عليها إبّان رصده المعاني المحتجبة، شأنه في ذلك شأن أيّ شاعر حقيقيّ آخر. لكنّ الأزمة الّتي تُطالعه تكمن في انعدام الوسيلة لا في انعدام الغاية. وعليه، لا مِراء في أنّ الشّاعر مُوقِن يقيناً تامّاً بأنّ الظّفر بالمعنى غاية قائمة في ذاتها، ومن ثمّ، لم تدفعه تجربته الوجوديّة إلى اختبار العبث اختباراً مُطلقاً. وخير دليل على ذلك أنّه ما عتّم أن رام لغة تُنجده في ارتباكه اللّغويّ، وعجز مفرداته عن بلوغ المحتجب. المشكلة، إذاً، تكمن في الوسيلة لا في الغاية.
يستهلّ الشّاعر قصيدته قائلاً:
“قشرةُ الذّات الـمُنكسِرة
تصفعُ وجهي
كلّما بحثتُ عن كلمات المدينة الغاربة”.
لعلّنا لا نُجانب الصّواب إذا قلنا إنّ مآل هذه القصيدة معقود على بدايتها. فلو أنّ الشّاعر استهلّ قصيدته بالحديث عن الذّات المنكسِرة، وعن رحلته في سبيل رَأْبِ صَدْعِها لاختلف قولنا وتفصيلاً؛ لكنّه استهلّ نصَّه الشّعريّ بمفردة “قشرة”، وهذا يعني أنّ الانكسار وًقفٌ على قشرة الذّات من دون لبِّها. وعليه، ثمّة مخزون شعريّ طاقويّ يعتمل في ذاته الحقّة، بيد أنّ الالتباس مُتَحّلِّق حول القشرة الهشّة الّتي تملك – على هشاشتها – أن تفعل ولا تفعل! بعبارة أوضح، صحيح أنّ القشرة لا تحجب اللّب، لكنّها تجعل تمظهره صعباً، أي إنّها تؤدّي دوراً ارتكاسيّاً في عمليّة التّعبير الشّعريّ.
يتابع الشّاعر، فيقول:
“أديم الأرض اليباب
يحاصرني
كلّما وقعت على بقايا المفردات المحطّمة”
يرمز تعبير “الأرض اليباب” هنا إلى انعدام قدرة الشّاعر على إيجاد مفردات جديدة تنضج حيويّة وثراء، ذلك بأنّ مفرداته محطّمة، ولم يجد سبيلاً بعد لكي يُفتِّق لغة جديدة تُخرِج المعاني من حقول القوّة أو الإمكان إلى حقول الفعل أو التحقّق.
والحقّ أنّ الرّيحانيّ يجلد لغته المحطّمة بقوّة، في ما يُشبه الإعلان الصّريح عن تهالك هذه اللّغة وفقدانها وهجها، وتألّقها وبريقها. لذا تراه يقول:
“إذا نشز اللّحن فبماذا يُلَحّن؟
وإذا فسد اللّقاح فبماذا يُلقّح؟
وإذا كُسِر الصّهر فبماذا يُصهَر؟”
يشي التّوازي الاستفهاميّ هذا بإنكارٍ مفهوميّ قوامه الآتي: ضياع الإيقاع – فقدان القدرة على توليد المعاني – فقدان القدرة على المواءمة بين المعنى والمبنى. فاللّحن يوازي الإيقاع، واللّقاح يُماثل توليد المعاني، أمّا الصّهر فهو المواءمة بين المعنى والمبنى. ولا يُعتِّم الشّاعر أن يُفصِح صراحة عن مأزقه المعنويّ -الإيقاعيّ هذا قائلاً:
“مفردات الأغاني الحائرة
تفلت منّي بكلّ اتّجاه”
بيد أنّ الأمل الّذي رسمه الرّيحاني منذ بداية النّصّ (قشرة الذّات لا الذّات)، عاد ليستكمله من خلال تحويل مسار القصيدة تحويلاً تامّاً، عنينا اجتراح حقلٍ دلاليّ يُباين الحقل الأوّل، ولا يلبث أن يحلّ محلّه، ولو موقّتاً.
2 – حقل اليقين أو “الظّفر بـ”
لم يَفُتَّ في عضد الشّاعر يباب المعاني وضياع الإيقاع، فها هو ذا يستجمع طاقته الشّعريّة، ويعقد العزم على الإتيان بمعانٍ طريفة، وتحديداً عند الأصيل، أي في العُرف الزّمنيّ الوقت بين العصر والمغرب؛ ولعمرنا لم يكنِ اختيار الشّاعر هذا الاختيار من باب التّقفية أو التّجميل الإيقاعيّ، بل رام بذلك أن يشهد موت ذاته الشّعريّة القديمة، كيما يشهد ولادة ذاته الشّعريّة الجديدة:
“مفردات الأغاني الحائرة
تستجمع ذاتها قبل الرّحيل،
تسترجع صوتها عند الأصيل”
هنا الموت قيامة، بل ضرورة. وعندما عنونتُ إحدى مجموعاتي الشّعريّة بـ “صلاة لراحة نفسي”، كنتُ أروم قيامة أخرى مُرجأة أو منتظرة. تلكم هي حال الشّاعر الّذي لا يقنع بما يكتب، أو يرضى بما أنتجه، بل يسعى دائماً إلى فضّ ما احتجب، واستنطاق ما سكت. قلنا إنّ الموت هنا قيامة. لكنّ القيامة تتطلّب مُكابدة، ولا يُمكنها أن تتحقّق بطرفة عين. وذلكم ما أدركه الشّاعر، إذ لم يشأ أن تكون رحلته مُبتسرة، أو أن تنفضّ سريعاً عن تحوّل جوهريّ ينقل التّجربة الشّعريّة من حال إلى حال. لا بُدّ، إذاً، من صعوبات جمّة، وتحدّيات عظيمة، وعوائق ضخمة، وإلّا لاستحالت المكابدة ترفاً، والمعاناة تُرَّهة، والكتابة إسفافاً:
“وتعود تفرّ من يدي
طيوراً شريدة،
صقوراً طريدة…
أطرق الجدران والأروقة الحجريّة:
أين طعم الكلام؟
أين وقع الزّمان؟”
يجدر بنا أن نتوقّف هنا عند أمرين اثنين: الأمر الأوّل: نعت الشّاعر المفردات بالصّقور الطّريدة، وفي ذلك دلالة عميقة على صعوبة الظّفر بالمعاني البعيدة، أمّا الأمر الثّاني فيندرج في باب التّأويل المحض. لننعم النّظر في هذا التحوّل من البُعد الـمَدينيّ إلى البعد الرّيفيّ، أي الانتقال من “كلمات المدينة الغاربة” إلى “الأروقة الحجريّة”. إنّها العودة إلى النّقاء الأوّل، ومحاولة استعادة لحظة البراءة الأولى، وتلمّس الفطرة الشّعريّة النقيّة، والدّفق الإبداعيّ، وزخم الصّور، واندفاع الخيال.
مع ذلك، لم يفقد الشّاعر إيمانه بنفسه، بل، على العكس، تبيَّن أنّ المكابدة العتيدة هذه ستفترّ عن نصوص عظيمة. صحيح أنّه سيُكابد طويلاً، ويتألّم كثيراً، لكنّه سيقبض على ناصية المعنى في إشارة صريحة إلى ما كابده الأنبياء إبّان الوحي:
“أوراقي ينتظرها النّهر المقدّس
أوراقي يُبلّلها رذاذ تشرين
تحرقها ألسنة المجامر
تُبدّدها صخور المغاور
تغور بها الأرض في كلّ حين،
ووسط صقيع الرّماد الشّريد،
وفوق قشرة الذّات المنكسرة
أسمع أصداء احتدام وطيد
لمفردات الأماني
وأصداء كلام عصيّ عنيد …”
3 – خلاصة
ثمّة حضور خفيّ أو صريح في هذا النّصّ لرحلة الشّاعر خليل حاوي في قصيدته الأيقونيّة “الجسر”. ونعني بالحضور هنا وحدة التّجربة وجماليّة الإيقاع. صحيح أنّ تجربة خليل حاوي انعقدت على العبور من شرقٍ متحجّر بليد إلى شرق ثائر جديد، لكنّ المكابدة هي نفسها، ونفي الذّات القديمة هو نفسه، وتلمّس الولادة الجديدة هو نفسه، وربط القيامة بالموت هو نفسه. وذلكم ما انعكس بوضوح أيضاً في اختيار القوافي، وتقسيم الأسطر الشّعريّة، واعتماد التّوازيات، واللّجوء إلى صيغ الاستفهام. ونحن لا نورد هذه الإشارة هنا إلّا لِنُدَلِّل على فكرة مفادها أنّ وحدة التّجربة تستتبع وحدة في التّعبير مع تباين في الأسلوب. صحيح أنّ لكلّ شاعر أسلوبه الخاصّ، وصوره المبتكرة، وخياله الخصب، لكنّ وحدة التّجربة لا بُدّ من أن تنعكس على طابع القصيدة الإيقاعيّ، من مثل: اختيار المفردات، والحقول الدّلاليّة، بل حتّى نسج الصّور، وتأطير الخيال، وتجسيد الإيقاع. وإلّا كيف نُفسِّر التّقارب المذهِل بين شعراء المدرسة الواحدة (الرّومنسيّة، البرناسيّة، الرّمزيّة، إلخ.)؟