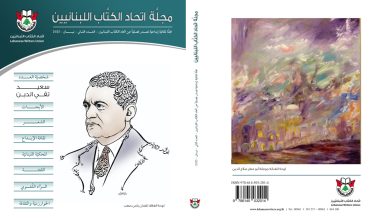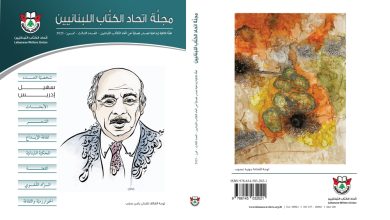سعيد تقي الدين بين ماهية التذكير وكيفية التعبير – أ. سلمان زين الدين
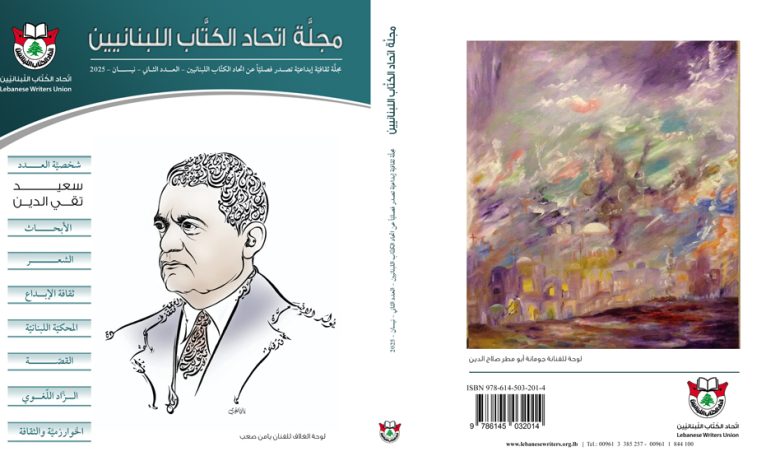
سعيد تقي الدين بين ماهية التذكير وكيفية التعبير
أ. سلمان زين الدين
يصادف العام الجاري ذكرى مرور مئة وعشرين عاماً على ولادة الأديب اللبناني النهضوي سعيد تقي الدين، وهو المولود في بلدة بعقلين اللبنانية من قضاء الشوف في 15 مايو 1904، والراحل في جزيرة سان أندروس الكولومبية في 10 فبراير 1960، إثر إصابته بنوبة قلبية، عن ستة وخمسين عاماً، كانت حافلةً بالنشاط الثقافي والاجتماعي والسياسي، وتمخضت عن مجموعة من المؤلفات المتنوعة والمقالات المختلفة، التي حفرت له موقعاً متقدماً في الذاكرة الثقافية، اللبنانية والعربية.
رغم مرور نيف وستة عقود على رحيله، لا يزال يملأ الدنيا ويشغل الناس. ذلك أن القضايا التي طرح، والخطاب الذي ابتكر، واللغة التي اجترح، هي من لوازم الحاضر والمستقبل، تتخطى الحقبة الزمنية التي أنتجت فيها، خلال النصف الأول من القرن العشرين، وتعلن صلاحيتها للنصف الثاني منه، بل يبقى تاريخ الصلاحية مفتوحاً على المستقبل. وبهذا المعنى، سعيد تقي الدين أديبٌ حداثيٌ حين الحداثة تحررٌ من الزمنية، وانفتاحٌ على الجديد اللامحدود. وهو أديبٌ شاملٌ حين الشمول أولى ميزات أدبه، في رأي جورج مصروعة، فهو قد كتب المقالة والرسالة والمسرحية والمذكرات والقصة القصيرة والومضة، وكانت له بصمته على كل من هذه الأنواع الأدبية، حتى ليمكن تمييز نصه من سواه، دون كبير عناء. وإذا كان المقام لا يتسع لتناولها جميعها، في هذه العجالة، فحسبي أن أضيء واحداً منها، عنيت به المذكرات، من خلال كتابه “رياح في شراعي”، على أن تقي الدين، في سائر الأنواع، هو هو، الثائر، الساخر، المتمرد، الظريف، الصادق، اللماح، المضحك، المبكي… فأدبه مرآةٌ لشخصيته، على اختلاف مقاماتها وتعدد أحوالها.
في ماهية المذكرات التي كتبها بين عامي 1962 و1950، وأصدرها بعنوان “رياح في شراعي”، يقول تقي الدين ملحمة الاغتراب اللبناني بمراراته وعذاباته، وما يكابده المغترب من مشقة وعناء، وما يتعرض له من مخاطر، وما يتقلب فيه من أمل ويأس ومعاناة وحنين. وهو يفعل ذلك من خلال تذكر تجربته الخاصة في الفلبين، تلك التي امتدت على مدى ثلاثة وعشرين عاماً، وهي تجربةٌ حية، غنية، مغمسةٌ بالعرق والدمع والدم، تستحق أن تدون، وأن تتذكر، فالذكرى، في هذا المقام، تنفع. وفيها، نتعرف إلى تقي الدين في حالات شتى، هي فصول تلك التجربة الحية المتنوعة التي يختلط فيها الذاتي بالوطني، والخاص بالعام، والسيرة بالتاريخ، والحزن بالفرح، واليأس بالأمل.
سعيد تقي الدين السياسي:
فهو المناضل الدبلوماسي الذي يتجشم مشاق السفر، ويتصل برئيس الفلبين ليقنعه بالتصويت ضد قرار تقسيم فلسطين، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1947. وما أشبه الأمس باليوم حين يقارن بمرارة بين اجتماع الأعداء على باطلهم وتفرق العرب عن حقهم، فيشير إلى مئات التلغرافات الواردة إلى رئيس الفلبين تدعوه للتصويت مع قرار التقسيم بينما لم يرد تلغرافٌ واحدٌ من عربي يشكره على خطاب مندوب الفلبين رومولو المناهض للتقسيم.
وهو الذي يتعرض ورفاقه للقصف الأمريكي في مانيلا، ويعانون التهجير، ويضطرون إلى بيع الحاجيات والألبسة للحصول على بعض الطعام.
وهو صاحب النفس الأبية الذي يؤثر الموت على الذل، فيزمع على تجرع السم مع زوجته، بعد دخول اليابانيين مانيلا، إذا ما حاولوا التنكيل بهما.
وهو الذي يعلي المبادئ على الربح، فيوبخ أحد مواطنيه على رغبته في شراء القصدير وبيعه من اليابانيين، رغم ما يدره ذلك من مال، لأن في ذلك ضرراً بمصلحة الأمريكيين “ذوي الفضل على بلاده”، آنذاك، وتكون المفارقة أن الصفقة تباع من اليابانيين بواسطة أمريكي، فيتلقى سعيد نصيحةً من مواطنه أن يخفف من مواعظه ويتذكر أنه تاجر.
وسعيد هو الذي يخوض تجربة الاعتقال، فيشهد على الضعف الإنساني واستيقاظ الغرائز السفلى، غير أنه لم يتخل عن السخرية وروح الدعابة والظرف، حتى في أشد اللحظات سواداً، فلا تملك إلا أن تنقلب على قفاك من الضحك حين تسمعه يهنئ صديقه سعد الدين الجارودي بوظيفة “غلام المرحاض”، ويتحدث عن عهده الباهر وإمكانية التجديد له. وإذ يتعلم تقي الدين من السجن أن النفس تنهار قبل الجسد، يشير إلى أن وجود قضية يناضل الإنسان من أجلها يجعل النفس تصبو للمصاعب.
وهو الذي شارف الموت مراراً غرقاً في بحر، أو انتحاراً بفعل أزمة مالية، أو هلاكاً “بقنبلة باضتها طائرةٌ أمريكية”، على حد تعبيره.
التعبير الأدبي:
في كيفية التعبير، يقول سعيد تقي الدين: “معظم السير والأوتوبيوغرافات والمذكرات ليست في غالب الأحيان سيرة ما كان، بل ما وجب أن يكون”. ويقول: “ليس في الدنيا من لا يبالغ في سرد ما يعني أموره وتفخيم شأنه”. فهل كتب هو سيرة ما كان أم ما يكون؟ وهل بالغ في ما يعنيه من أمور؟
في مقاربة هذا السؤال المزدوج، ثمة إجابتان اثنتان، أولاهما يقدمها الكاتب، والثانية يقدمها الكتاب. أما الأولى فتأتي في سياق الحديث عن منهجه في كتابة المذكرات حين يقول: “لا أقول إني طهرت إلى حد أن أصبحت أترفع عن الغلو والتحريف فيما أكتب، فالذي يصور الأشياء كما هي هو فوتوغرافيٌ لا فنان. ولكن بعض الأشياء والحوادث فيها من الجمال أو البشاعة، ما يجعل صورتها الفوتوغرافية فناً”. وهكذا، لا يدعي الترفع عن الغلو والتحريف، بل يربط ذلك باعتبارات فنية، ويدرك أن بعض الحوادث صارخةٌ إلى حد أن تصويرها بصدق وموضوعية هو بحد ذاته فن. ولعل حوادث كتابه هي من هذا النوع.
أما الثانية فتقودنا إلى الحديث عن الأسلوب الذي اعتمده تقي الدين في سرد المذكرات؛ وفي هذا السياق، نشير إلى أنه لم ينح المنحى الكلاسيكي في سردها، ولم يراع التسلسل الزمني، ولم يتبع نظاماً معيناً، فجاءت مذكراته مجموعة فصول مستقلة، لكنها تتقاطع فيما بينها حين ترد الواقعة الواحدة في غير فصل منها.
ينطلق تقي الدين في فصوله غزيراً كنهر، يتدفق على رسله، لا شيء يحد من جريانه، وهو في تدفقه قد يخرج عن مجراه لكنه سرعان ما يعود إليه. ويخيل إلي أنه في سرده يتحدث إلى جليس، أمام الموقد في سهرة جبلية، أكثر مما يكتب، وهو في حديثه كثيراً ما يمارس هذا النوع من الالتفات الجميل فيبقي الجليس مشدوداً إليه، فبينما هو مستغرقٌ في سرد واقعة معينة، يلتفت إلى القارئ/ الجليس بالقول: “ذكرني أن أخبرك بكذا…”. وإذا ما جرفه الاستطراد، يسأله: “أين كنا؟ قبل أن نضيع لنرجع إلى…”، أو يقول: “شطحنا…”، ويعود ليستأنف السرد من حيث شطح. وبذلك، يمنح سرده العفوية والتلقائية، ويكسر الحاجز المصطنع بين الراوي والمروي له.
بالانتقال من الكل إلى الأجزاء، يمتاز تركيب سعيد تقي الدين بالبساطة والسلاسة، ويجانب الصناعة والتعقيد، وينتمي إلى الحياة، ويقطفه أحياناً من أفواه الناس العاديين. وهو، حين يجاور بين المفردات المختلفة في التركيب الواحد، يمنح التركيب والمفردات طاقةً أكبر من طاقتها المعجمية الأصلية، ويشحنها بالقدرة على التصوير والدقة في التعبير عن الحالات النفسية والذهنية. اقرأ معي هذه التراكيب تتحقق من صحة ما أذهب إليه: “تدحرجت راجعاً”. “بطشنا بصينية كبة”. “تفجر صوت محرك”. و”حياة شرفك…”. :وكانت الطائرات تبيض قنابلها”، وغيرها.
أما المفردات، عنده، فبعضها مبتكر، وليد ما يمارسه من اشتقاق أو نحت، من قبيل: “يسردب، تتسلحف، قاولناه، غطواز”. وبعضها تستخدمه العامة، من قبيل: “تدحرجت، بطشنا، شطحنا، كشر”. وربما أخذ بعضها من معجم “لعب الورق” للتعبير عن حالة سياسية معينة… وأياً كان المعجم الذي يختار منه تقي الدين مفرداته، فمما لا شك فيه أنه كان بارعاً في الاختيار والاستعمال، على حد سواء.
الصراحة الأدبية:
وبعد، إذا كنا نفتقر في أدبنا العربي إلى أدب الاعتراف، بحيث نخفي عن الآخرين عيوبنا أو أخطاءنا أو ضعفنا أو تقصيرنا، فإن بعض ما ورد في المذكرات ينتمي إلى هذا الأدب. وهنا، يجيب الكتاب عن السؤال المطروح أعلاه بأن الكاتب كتب ما كان من سيرته لا ما يجب أن يكون، ولم يبالغ في تفخيم شأنه، والأمثلة على هذا الجواب كثيرة؛ فهو يعزو الفضل في الاتصال بالرئيس الفلبيني إلى كامل حماده وزوجته وديعة ولا يدعي هذا الشرف، وهو يعترف بالخوف في محطات معينة ولا يجترح البطولات، ويقر بضعفه في اللغة الفرنسية، ولا يتورع عن ذكر سقوط “كلسونه” وإثارة ضحك الآخرين منه، وعن الإشارة إلى أكله لحم الكلاب إثر مقلب دبره رفيق، كما يعترف بتعويله على الانتحار مرة وبإفلاسه مرتين. وكثيراً ما يمارس النقد الذاتي أو يسخر من نفسه. وهكذا، لا يسعى الكاتب، في مذكراته، إلى تقديم بطل نموذجي بل قدم شخصيته كما هي، دون زيادة أو نقصان.
ولا يمكن توفية الموضوع حقه ما لم نشر إلى ميزة لازمت سعيد تقي الدين في سائر أدبه، وهي السخرية. يسلطها على واقع معين فيبدد سواده، وينطلق من واقعة قاتمة فيجعلها مثاراً للضحك. ومن ذلك وصفه الجنرال الياباني، غداة احتلال اليابانيين مانيلا، بأنه “لا يملك من اللغة الفرنسية أكثر مما يملك سعيد فريحة من شركة الكوكاكولا” (ص 53)، ووصفه الجو القاتم بالقول: “هوذا الجو أغبر من بعد وكشر ونفخ كأنه كبيرٌ في السراي قابل طالب وظيفة”، فيعرض ببعض العقليات التي كانت تتحكم ببعض المسؤولين، ولا تزال.
بناءً على ما تقدم، لا يسعنا سوى أن نشاطر جان داية، ناشر المذكرات، رأيه في مدخلها أن مذكرات سعيد تقي الدين “تعج باللمعات الإبداعية…، وأنها من أجمل ما كتب في أدب المذكرات، في العالمين العربي والغربي”.
* هذه المقالة منشورة في مجلة العربي- العدد 790، 2024.