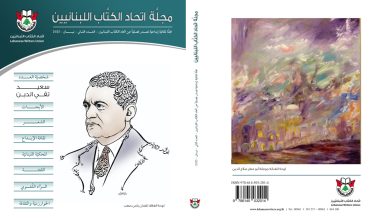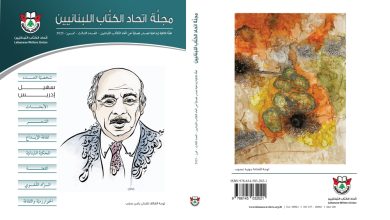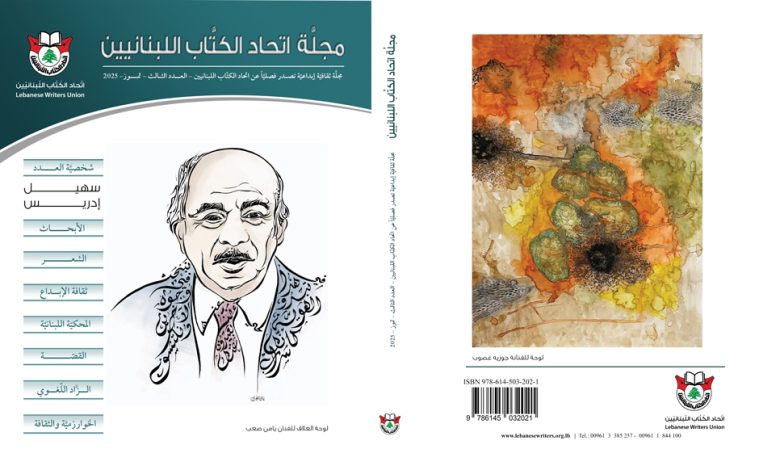
الرؤيا الشّعريّة بين القدماء والمحدثين
The poetic vision between the ancients and the moderns
أ. بتول عبد الله يوسف
Batoul Abdullah Youssef
المستخلص– Abstract
النّاظر في النتاج الأدبيّ العربيّ يجده سِفراً شاملاً تتجلّى بين دفّتيه مسيرة العربيّ، ماضيه وحاضره، وكذلك رؤاه إلى الوجود ومحاولته كشف كلّ مستغلق. والبحث هنا يطرح مفهوم الرؤيا الشّعريّة بين الأقدمين والمحدثين، ويسعى لإبراز التفاوت بين كلا النتاجين على المستوى الفكريّ العقديّ، والإنسانيّ الاجتماعيّ. فالرؤيا في مفهومها الشّعريّ الحديث ليست تبصيراً وشعوذة، ولا هي ادّعاء بتلقّي رسالة إلهيّة، بل أنّ الشّاعر ينطلق من الواقع، يتعمّق فيه، يحلّله، ويصل ببصيرته الثّاقبة إلى النتيجة قبل حصولها. وقد اعتمد البحث المنهج النّفسيّ كون الرؤيا تنشأ من مواقف وتبدّل رؤى تنبثق بمجملها من التّأثيرات النّفسيّة؛ والمنهج الاجتماعيّ لأنّ الأدب ينبثق من المجتمع ويكتب له. وقد بحثنا عن الرؤيا الشّعريّة في جوانب متعدّدة وحاولنا المقارنة بين الرؤيا القديمة والرؤيا الحديثة
Abstract
The observer of the Arab literary production finds it a comprehensive book in which the Arab journey, his past and present, as well as his visions into existence and his attempt to reveal everything hidden, are revealed. The research here presents the concept of poetic vision between the ancients and the moderns, and seeks to highlight the disparity between both products on the ideological, doctrinal, and social human levels. In its modern poetic sense, the vision is not foresight or sorcery, nor is it a claim to receive a divine message. Rather, the poet starts from reality, delves into it, analyzes it, and reaches the result with his keen insight before it happens. The research adopted the psychological approach because visions arise from situations and change visions that emerge entirely from psychological influences, and social approach because literature emerges from society and is written for it. We searched for the poetic vision in various aspects and tried to compare the ancient vision and the modern vision.
(الكلمات المفاتيح: الرؤيا الشّعريّة، الحدس، والإلهام، السّحر، الفلسفة، الإبداع، علم الغيب).
(Keywords: poetic vision, intuition, inspiration, magic, philosophy, creativity, knowledge of the unseen.)
المقدّمة:
للفنون علاقة وثيقة عند الأقدمين بوحي السّماء، وعلى رأس هذه الفنون الشّعر، الّذي عُني بالكلمة، فقد عدّوا هذه القدرة فوق طاقات البشر، ولا تكون إلّا بوحي إلهيّ، ومنهم اليونانيّون الّذين عزَوا الإلهام الشّعريّ إلى ربّات الشّعر، حيث يَهبنَ الشّعراء ما يردّدونه على ألسنتهم. والعرب في الجاهلية، كباقي الأمم الّتي شغلتها مظاهر الوجود الغريبة، أرجعوا الإبداع الشّعريّ إلى عالم غيبيّ، تجلّى عندهم بشياطين الشّعراء الّذين يلقّنون شعراءهم أجود الشّعر، فهم راؤون تنكشف لهم سُبل الغيب. أمّا الشّعر المعاصر، فقد أطلق روّاده مفهوم الرؤيا الشّعريّة، والّتي يصير معها الشّاعر “فناناً من نوع خاصّ، وتصبح الرّؤيا الشّعريّة معه عشقاً أبدياً بين الفنّان وقضايا الإنسانيّة، فيغدو الشّاعر مع هذا العشق رسولاً سبّاقاً رائياً”.([1]) فمتى نشأت الرؤيا الشّعريّة؟ وما علاقتها بالحدس والكلمة والسحر والفلسفة والإبداع؟
الرّؤيا الشّعريّة والنّشأة:
لعلّ أوّل توافق بين الشعر الجاهلي والشعر المعاصر هو اشتراكهما في أسباب نشأة الرّؤيا الشعريّة، ففي الشّعر الجاهلي استمدت حضورها من معتقدات دينيّة كانت سائدة تُرجع “كلّ فنّ وإبداع إلى الآلهة، فالشّمس والقمر والّلات وإيزيس آلهة نسبوا إليها قدرات خارقة كالموت والحياة والرزق والفنّ، وارتبط الأخير، لا سيّما الشّعر، بالرؤيا. فقد كان شائعاً أنّ ” شعر الشّعراء الجاهليّين الرّائين هو أحرف ناريّة تُلقي بها الجنّ على ألسنتهم، وأنّهم إنّما يتناولون من الغيب، فهم فوق أن يُعدّوا من الناس، ودون أن يُحسَبوا من الجنّ”.([2]) ومثلما بقي الجاهليّ على اتصال بالموروث الدّيني، وتبلورت لديه رؤياه، كذلك لم ينقطع الشّاعر المعاصر عن الاتصال بموروثه الدّيني والتّراث بصورة عامة، بل “خلق علاقات مثاقفة واعية ومتجاوزة في الوقت ذاته للتراث، وطالب بضرورة الانتماء، عن قناعة وإرادة، للشّعرية العربيّة، ومراجعة التّراث مراجعة حداثيّة من خلال العمل على تفعيل هذا التّراث بوصفه معطى حضارياً، وشكلاً فنياً في بناء العمليّة الشّعريّة”.([3]) فعلى الرّغم من صدمة الحداثة الشّعريّة المعاصرة الّتي قلبت كثيراً من ضوابط الشّعريّة، فإنّ جذورها تمتدّ عميقاً في جوهر البدايات. لذلك، كانت الرّؤيا المعاصرة تنهل من معين التّصوف الدّينيّ، إلّا أنّها تمايزت عن الرّؤيا الجاهليّة في كون الأخيرة كانت امتداداً عفوياً للمعتقدات السّابقة، رغبة أو رهبة أو تقليداً رتيباً آمن به المجتمع الجاهليّ فمثّله الشّاعر في قصائده مستدعياً ما قد سلف من معتقدات دينيّة وأساطير، ووظّفها في أشعاره. أمّا الرؤيا المعاصرة فحوّلت التّجربة الدّينيّة الصّوفيّة المغرقة في المجهول ضمن دائرة الفرديّة إلى نموذج للالتزام. ذلك، حين يدفع الشّاعر رؤياه للحياة فتضيء مناحي الوجود، وتوسّع طاقات الفكر الإنساني. كما أنّ تبنّي الحداثة للخطاب الصّوفي يعززّ مفهوم الرّؤيا المعاصرة، لأنّ الصّوفيّة تمثّل ” درجة من درجات الكشف الّذي يكون بالاطّلاع على المعاني الغيبيّة القائمة وراء حُجب الحسّ والعقل”،([4]) حتّى قال أدونيس: “إنّ حركته تنتمي إلى امرئ القيس وأبي نواس، وأبي العلاء المعرّي والحلّاج والرّازي”.([5]) إلّا أنّ أدونيس أراد من الصّوفيّة الجانبَ الوظيفيّ لا المعنى الوجوديّ المرتبط بالله. أي: أنّه يحاول عقلنة الصّوفيّة بوصفها تجربة بحثٍ عن المجهول، وليس بوصفها معطًى دينياً ثابتاً. يقول أدونيس:
ورأيت أطفالاً قرأت لهم
رملي، قرأت لهم
سوَرَ الغمام وآية الحِجر
ورأيت كيف يسافرون معي
ورأيت كيف تضيء خلفهم
برك الدّموع وجثّة المطر([6])
هو نموذج جديد في الشّعر يوَلّد من فضاء رؤياويّ حالم، حيث يتلقّى أدونيس رؤياه بعيداً من المألوف وعقلانيّة الواقع، مع غياب للمنطق، وشاعريّة مبنيّة على قوى المعرفة، معتمدة على الحدس الشّاعريّ المعاصر. إذ يرى عزالدين اسماعيل أنّه ” من خلال الرؤيا الشّعريّة والحلم الواعي يرى متصوّف عصرنا الواقع الكائن، والواقع الممكن، وهو بذلك يخترق حجاب الزّمن الآنيّ إلى الزّمن المستقبل، فيؤدّي، بالنسبة إلى عصره، دوره القديم، دور النبّوّة”.([7])
الرّؤيا الشّعرية والحدْس:
عجز المجتمع الجاهليّ عن تعليل ظاهرة الإبداع الشّعريّ، ما دفعه إلى تبنّي فكرة الإلهام، والّتي نادى بها (أفلاطون) Plato من قبلُ… قائلاً: “بهذه الطريقة نفسها تُلهِم ربّة الشّعر نفسُها بعضَ النّاس الّذين يُلهِمون بدورهم غيرَهم. وبذا، تتصل الحلقات. لأنّ شعراء الملاحم الممتازين لا ينطقون بكلّ شعرهم الرّائع عن فنّ، ولكن عن إلهام ووحيٍ إلهيّ”.([8]) كما أنّه رفض أن يستقبل الشّعراء في مدينته الفاضلة، “لأنّ الشّاعر ينظم شعره عن إلهام، وحالته تشبه حالة الجنون، فشعره لا يصدر عن عقله، فهو كاذب”.([9])
كما تأثّر الشّعراء العرب في العصور الإسلامية بالرؤيا نفسها. أمّا في النّقد الحديث، فقد تغيّرت النّظرة إلى مسألة الإلهام. حيث “ارتبطت النّظرة إليها بالمدرسة أو الاتّجاه الّذي يتناولها، فمنهم من يرى أنّ ما يُطلق عليه الإلهام هو إثارة مباغتة، أو شيء كالوحي يُفقِد النّفس سيطرتها، ومنهم من يراه بزوغاً فجائياً للوعي الباطن، يكوّن التّداعي الكامن الّذي ينطلق منه الفنّان، ومنهم من يحسبه قوة تُطلِق عناصرَ الانفعال استجابة لحاجات المجتمع”.([10])
هذا التحوّل البارز تجاه الإلهام في الشّعر بين القديم والحديث يعود غالباً إلى التّطور العلميّ والنّضوج الفكريّ، ما يعزّز موقف الحداثويّين في هذا الإطار، والّذي يرى في الحدوس الشّعريّة طريقاً سامياً أمام الشّاعر المعاصر، للكشف والتّجاوز، كونه ” نحواً من حدّة الذّهن، وسبْق الخاطر إلى تصوّر الدّلالة، كما يحمل شيئاً من معنى الظنّ والتّخمين، لكنّه التّخمين المعتمد على التأمّل. ولهذا، ربّما فرّق (بيتي)Petti بين التّفسير الموضوعيّ والتّفسير التّأملي المعتمد على الحدس. والحدس بهذا الشّعور المتسائل المتأمّل يختلف عن الانطباع الوجدانيّ الرومانسيّ”.([11])من ذلك موقف خليل حاوي في (السّندباد في رحلته الثّامنة) إذ يقوده حدسه التأملي في المقطع الثّامن إلى إشراق قريب البزوغ، فهو ينتظر البشارة بلهفة وقلق لتغنّي في دمه الرّؤيا بالصبّاح الموعود. فيقول:
واليوم، والرّؤيا تغنّي في دمي
برعشة البرق وصحو الصباح
وفطرة الطّير الّتي تشم
ما في نيّة الغابات والرّياح([12])
وعلى الرّغم ممّا ينتاب الأمّة من أزمات وصراعات في واقعها الرّاهن، ليس هناك من سبب يدعوه للتّفاؤل لولا رؤيته من خلال حدسه وتأمّله العميق أبناءَ يُعرب وهم يهرعون للاغتسال بمياه أنهارهم، النيل والفرات، وفي الأردن للتّطهّر من أدران الخطايا:
ما كان لي أن أحتفي
بالشّمس لو لم أرَكم تغتسلون
الصّبح في النيل وفي الأردن والفرات
من دمعة الخطيئة([13])
الرّؤيا الشّعريّة والغرب:
وإذا كانت فكرة الإلهام في الشّعر قد وصلت إلى الشّعر الجاهليّ من طريق الموروث الديني والثّقافي، ومنه اليونانيّ الغربيّ، فإن الشّاعر المعاصر استلهم من الثّقافة الغربيّة خطابه الحداثويّ أيضاً، وقد عبّر أدونيس عن هذا الموقف، بقوله: “أحب هنا أن أعترف بأنّني كنت بين من أخذوا بثقافة الغرب، غير أنّني كنت كذلك بين الّذين ما لبثوا أن تجاوزوا ذلك، وقد تسلّحوا بوعي ومفهومات تمكّنهم من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة، وأن يحقّقوا استقلالهم الثقافيّ الذّاتي”،([14]) لأن الرّؤيا ليست شعوذة، ولا ادّعاءً بتلقّي رسالة إلهيّة، “فالشاعر الرّؤياوي ينطلق من الواقع، يتعمّق فيه، يحلّله… يتمتع ببصيرة ثاقبة تنفذ عبر الواقع المعطى، وتصل إلى النتيجة”.([15]) لأنّ مهمّة الشّاعر المعاصر هي الالتزام بقضايا المجتمع، والنّظر في “قلق الإنسان وخيبته وشكوكه وتناقضات حياته، وأن يكون نبيّ عصره الّذي يقف بين الجموع يحدّث الآلهة ويوحي إلى النّاس بحديثها”.([16]) فهذه الأمّة على موعد مع الانعتاق والنّهوض والانبعاث عبر حلم رؤياويّ مفعم بالخصب والحياة والتّجدّد، رسمه خليل حاوي على غرار الشعراء الغربيين، بقوله:
كيف ظلّت شهوة الأرض
تدوّي تحت أطباق الجليد
شهوة للشّمس للغيث المغنّي
للبذار الحيّ في قبوٍ ودنِّ
للإله البعل تمّوز الحصيد
شهوة خضراء تأبى أن تبيد ([17])
الرّؤيا الشّعريّة والكلمة:
تقلّد الرّائي الجاهليّ مكانة لا تضاهى في مجتمعه، لأنّه مثّل- في ما مثّل- صلة وصل بين عالم الغيب وعالم الشّهادة، حتّى رأى بعض المهتمّين بالنتاج الشّعريّ أنّ “صورة الجنّ الّتي التبست الشّاعر الجاهليّ، يستدعي أمرها ذكر نوبة الاختلال، وعدم الاتّزان الّتي تعتري المبدع في جو من الانفعال الشّديد الّذي يرنو إلى كوّة الاتزان والتّطهير. ذلك، أنّ عالم الانفعال يكون شبيهاً بعالم الحلم أو عوالم الجنون”.([18]) وليس هذا مستغرباً في بيئة بدائيّة ترى ضالّتها أمام مجاهيل الوجود، لدى السّحرة والشّعراء. فثقافة المجتمع تعتمد على الغيبيّات بسبب الموروث المتراكم والمتشابه، من ديانات وأساطير. ولعلّ عالم الانفعال، هذا، يشبه إلى حدٍ ما القصيدة المعاصرة “وهي تشقّ طريقها إلى أعماق النّفس من خلال لغة الرّموز والأساطير والأحلام الّتي وُصِفت بأنّها المنافذ المطلّة على عوالم البداية، فأصبح للكلمة الشّعرية على لسان الشّاعر المعاصر مكانة عالية لا تختلف عن المكانة الّتي كانت لها”،([19]) وذلك، حينما غدت الرّؤيا الشّعريّة المعاصرة ” قفزة خارج المفهومات السائدة”،([20]) “فهي أقرب إلى منطق الحلم والنّبوءة. ونتيجة لذلك، وُصِف الشّعر بأنّه كالسّحر أو الممارسة الميتافيزيقية الّتي تضرب صوب الخّارق والفائق”،([21]) حتّى غدت نظرة الشّاعر المعاصر كنظرة الشّاعر الجاهليّ في محاكاتها للأشياء كأنّها أرواح. يقول أدونيس:
“لو أنّني أعرف أن أكلم الأشياء
وقلت للأشياء والفصول
تواصلي كهذه الأجواء
مدّي ليَ الفرات
خلّيه ماءً دافقاً أخضر كالزيتون”([22])
يرجو أدونيس أن تحاوره الأشياء، كي يتّصل بالوجود الّذي أخذ الشّاعر يلاحظ القطيعة معه، ولعلّ ذلك يعود لضعف الرّوح في الاتصال بالموجودات، على غرار ما كان يفعل الشّعراء الجاهليون. فهذا عبيد بن الأبرص يهجو خصومه مستنداً إلى ضرب من السّحر عبر محاورة الأشياء، فيقول:
صقعتكَ بالغرّ الأوابد صقعة خضعتَ لها فالقلب منها جريضُ
حيث يرتكز هذا البيت على معتقد سحريّ قديم، يعطي الكلمة الصّدارة الأولى بوصفها القوّة الّتي يستطيع بها الإنسان أن يقهر عدوّه، لأنّ الكلمة لا تعني القول فحسب، إنّما الفعل أيضاً. وبعبارة أخرى، فإنّ الكلمات لا تصف الأشياء، بل تحاول إحداث أثر فيها، لأنّها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجوهر المخلوقات الّتي تعبّر عنها. فالشّاعر، هنا، صفع عدوّه بالكلمة، لأنّ الأوابد تعني القصائد، فكانت النتيجة خضوع العدو وتقهقره أمامها”.([23]) والشّاعر الرّائي الجاهليّ، بفعل إدراكه، كان الأكثر شعوراً بالقصور أمام فهم ما غمض من الظواهر الكونيّة، فكان الأشدّ حرصاً من غيره على محاولة المعرفة والتّنبّؤ، متسلّحاً بالكلمة، وإن اعترف بعجزه أحياناً. كقول زهير ابن أبي سلمى:
أعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنّني عن علم ما في غد عمِ([24])
تصدّى الشّاعر الجاهليّ لدور الوسيط بين عالمَيّ الغيب والشّهادة، ولم يتوانَ عن محاولاته من طريق الكلمة، الّتي وجدها قوّة حيّة يواجه بها صعاب الحياة ومغاليقها، فبالكلمة تطمئنّ النّفوس، وبالكلمة تواجَه المِحن، وبالكلمة يُخفّف وقع المأساة، وتُرفع المعاناة. فاستخدم الكلمة قوّة مؤثّرة على غرار ما صنع السّحرة والكهنة عندما ابتدعوا الأساليب الأسطوريّة، والممارسات السّحريّة بهدف استعلام الغيب ومعالجة المشاكل الاجتماعيّة.
والشّاعر المعاصر يدرك بوضوح أنّ مجتمعه يحارب في معركة مصيريّة، وأنّه يملك سلاحاً من أخطر أسلحة هذه المعركة، هو الكلمة. ولَئن كان الفارس القديم يواجِه بالسّيف، فقد كان يكسب نصف المعركة بالكلمة، وبالشعر على وجه التّحديد. ولم يكن غريباً أن تتآزر الكلمة الشاعرة والسّيف، فكلاهما يستمد حرارته من موقف الفارس، من عقيدته الّتي آمن بها، وبكل مبادئها. ونجد في الشّعر المعاصر ما يماثل هذه الظّاهرة، حيث ينشِئ الحداثويّ علاقة بالكلمة ليصبح ساحراً يستقرئ المجهول، ومنهم أدونيس الباحث عن سرّ الكلمة:
ساحرٌ أنا واسمها البخور والجرن
ساحرٌ وهي مجامري وهيكلي في بدايات الجمر
أتطاول في كثافة الدّخان
راسماً شارات السّحر
ساحراً جرحها ([25])
كأن أدونيس ههنا، يحيي علاقة الشّاعر بالسّاحر. وإذا كان من الشّائع، قديماً، أنّ الشّاعر وسيط بين عالمَيّ الغيب والشّهادة، فإنّ الشّاعر المعاصر قد تجاوز هذا المفهوم إلى موقف جديد، يعطيه حقّ الرّيادة والتّفرّد في الخلق والإبداع، بحيث يصبح تأثيره أبلغ. “فتقمُّص أدونيس شخصيّة السّاحر دليل على رغبته الجامحة في امتلاك سرّ الكلمة، لأنّ الاعتقاد السّائد لدى بعض الشّعراء، وهو اعتقاد قديم، أنّه من امتلك الكلمة، فقد امتلك القوة والسّلطة”.([26]) وفي سياق آخر، يغدو أدونيس عرّافاً:
قرأت النّجوم كتبت عناوينها ومحوت
راسماً شهوتي خريطة
ودمي حبرها وأعماقي البسيطة ([27])
“فهو يمتلك ناصية الأشياء الّتي يصبح بها قادراً على التّعبير والتّأثير والتّغيير، واختراق الجاهز والمألوف، ومن ثَمَّ كانت الكلمة عند أدونيس رحِماً لخصب جديد، ومجامرَ تحترق فيها الذّات لتتطاول دخاناً راسماً التحوّل والانبعاث”.([28])
وهكذا، يشترك الشّاعر الجاهليّ والشّاعر المعاصر في تجربة مواجهة الكون بوساطة الكلمة، إذ رأيا فيها سبيل خلاصهما، فوجد الجاهليّ فيها سحراً يبدّد الخوف من العدم، ورأى المعاصر فيها قوّة، إذا أُزيل عنها ما أصابها من صدأ، لأنّها ليست مجرّد وسيلة للتّعبير، إنّما هي وجود وحضور له كيان، وهي قادرة على إحداث الأثر.
الرّؤيا الشّعرية والفلسفة:
كما حاول الرّائي الجاهليّ سدّ الثغرات المعرفيّة تجاه الظّواهر الغيبية والأسئلة الوجوديّة، مثلما تولّى الكهّان استجلاب الحظّ والنّجاح ودرء الشّر والأّذى، في ظلّ عجز الإنسان عن الغوص في إشكالياته الوجوديّة ومشكلاته النّفسيّة، فكان الشّاعر فيلسوف القوم وحكيمه، “أحسّ وهو يعبّر عن ذات كل عربيّ في صحرائه أنّ الموت يطارده في كلّ محطّة، وأنّ الإنسان محض وهمٍ في وجوده، فإذا كان الآن موجوداً، فهو بعد حين وغرّة غير موجود، وأنّه، كما يقول (هيدغر) Heidegger وجودٌ للموت. أي، أنّه من أول وجوده مرهون بالموت، وإليه”.([29]) وأضحى الدّهر في منظور الجاهليّ القوّة المركزيّة الّتي تلتحم بالأحياء جميعها، وتفعل فعلها تبديلاً وتغييراً. يقول امرؤ القيس:
ألا إنّما الدّهر ليال وأعصر وليس على شيء قويم بمستمر([30])
وأمام هذا الواقع، “وفي مثل هذا الإحساس بالموت يتّجه الإنسان عادة إلى واحد من ثلاثة مسالك: الاقتناع بحتميّة الموت، أو الاستسلام له وانعدام الإرادة، أو اتخاذ موقف المواجهة والتحدّي. وهذا ما سلكه الشّاعر الجاهليّ الرّؤياويّ من خلال شعره”.([31]) ذلك، لأنّه شعر أنّ الكلمة تضمن له الخلود والبقاء، وهذا ما يفسّر الماهيّة الفلسفيّة للشّعر الجاهليّ، إذ أودع الشّاعر أحلامه وأحزانه وعالمه وروحه في الشّعر. لذلك، نجد اختلاف هذه الروحيّة الشّعرية بين امرئ القيس وزهير وطرفة، “وهذا ما أكّده الفيلسوف (كانت) Kant من تجسّد الرّوح في الفنّ، ولا سيّما عند عباقرة الفنّ العظماء”.([32]) فمن فلسفة زهير الّتي يخاطب فيها الّذين يرَون الموت يطاردهم، فيتمادَون في الهروب، يقول:
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقَ أسباب السّماء بسلّمِ([33])
ونتيجة تفكّر زهير في خلق السّموات والأرض، وجد نفسه مدفوعاً برؤياه وحكمته إلى القول:
تزوّد إلى يوم الممـات فإنّه ولو كرهتْه النّفسُ آخرُ موعــدِ([34])
ويلخّص طرفة بن العبد فلسفته ورؤيته، فيؤكد حضور الموت بقوة كدالٍّ على معاناة الشّاعر:
“أرى الموت يحتام الكرام ويـصطفي عقيلة مال الفاحش المتـــــشدّدِ
لعمرك إنّ الموت ما أخطأ الفتــى لكا لطول المرخي وثِنياه باليـــدِ” ([35])
وبموازاة هذه المقاربة الجاهليّة تجاه قضايا الوجود والمصير من طريق الرّؤيا الشّعريّة على هيئة إرهاصات فلسفية أولى، فقد نسجت الحداثة الشّعرية المعاصرة بين الشّعر والفلسفة رابطة وثيقة، لأنّ غايتها محاكاة هموم الإنسان المعاصر، وعلى رأس هذه الهموم القلق أمام الوجود والمصير، وانعدام الأمان والثّبات، وازدياد تناقضات العصر. ولأنّ الفلسفة نأت عن السّاحة الفكريّة العربيّة، ولا بوصلة ترشد إلى فهم جديد للوجود في ظلّ حجم المتغيّرات المتسارعة، انبرى الشّعر المعاصر بديلاً معرفيّاً يوجّه الإنسان في لجج القلق العاتية، ” فالفلسفة الغربية أدّت هذه المهمّة الوجوديّة في الغرب، وصار الإنسان العربيّ في وحدته أمام مصيره”.([36]) لذلك، تبنّت الرّؤيا المعاصرة فلسفة صارت جسراً بين الذّات والعالم ” تقود الإنسان إلى عتبات كل ما لم يُخلق”،([37]) فتضيء له عتمات الحياة. “وذهبت إلى أنّ التّجربة الوجوديّة والرّؤيا توأمان شعريّان”،([38]) بهدف الكشف عن كلّ غامض مستغلق، حتّى يغدو “الشّعر في العصر الحاضر وعياً شاملاً لوضع الإنسان في وجوده ومصيره”.([39])
فهذا جوزف حرب يحفّز النّاس على أهميّة أن تكون لأرواحهم أجنحة وظيفتها أن تحلّق بعقولهم وبعفويّة وتلقائيّة عذبة في فضاءات الخلق والحريّة والتّفتح:
كلّ ما يغدو اكتشافاً هو من قبل
تلاميح كأشباح مع الّليل تطوف
أجمل الأرض وأبهى النّاس
إذ تخرج من أعماقهم أجنحة
الرّوح كما يخرج من سنبلة
القمح الرّغيف([40])
ويولّي جوزف حرب قلمه شطر البحث عن الله، حيث الصّراع بين الأنا (الإنسان) والأنت (الله)، وقد تلقّف الفلاسفة صراع الـ(نعم) والـ (لا) الرهيب الّذي سيطر على روح الإنسان المعاصر ومزّقها، وانشغلوا، وتقاتلوا عليه، فيقول في محبرته:
في الشّرق والغرب، وفي أيّ مكان
وزمان، لم يلحْ وجهٌ لِطَيفِ الله إلّا
اختصم الفلاسفة
نعم،
ولا،
ولستَ موجوداً
وموجود
وأنت القدَر الفاطر لهذا الكون
لا شيء سوى ما قد خلقتَه
… لا حياة بعد موتي. قدري داخل روحي
فأنا هاملِت. ولا أوديب بي، ما منقذي
في الأرض إلا العقل([41])
يبدو أنّ السّعي لكشف مظاهر الغيب من خلال الفلسفة هي سمة مشتركة بين الرؤيا الشعرية الجاهلية والرؤيا الشعرية المعاصرة بهدف تحرير الإنسان من الأوهام، وتبديد هواجس الخوف والقلق تجاه الأسئلة الوجوديّة، والخلاص من أزمات الحياة، لأنّ مهمّة الشّعر كمهمّة الفلسفة. وهذا ما أكّده أدونيس حينما حدّد دور الشّاعر بأنّه “رؤيا، والرّؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفاهيم القائمة”.([42])
الرّؤيا الشّعريّة والسّحر:
ابتدع الإنسانُ الفنّ قديماً “بوساطة عبقريته ليضمن العيش والبقاء… وكان فنّه ليدعم عقيدته أو ليؤثّر على القوى الخارجيّة، فيجعلها صالحة له، محقّقة لأمانيّه، موطّدة لأقدامه في البيئة الّتي يعيش فيها. وقلّما نجد فناً من الفنون بعيداً من الأغراض السّحرية”. ([43]) والرؤيا الشّعريّة في العصر الجاهليّ لم تخرج عن هذا الإطار، فجاءت بمجملها متأثرة بالمعتقدات، ويلفّها السّحر. ذلك، لأنّ “الشعر، عموماً، نشأ نشأة دينيّة من خلال الطّقوس التّعبيريّة القديمة”.([44]) ويؤكّد (هيربرت رِد) Herbert read هذه الفكرة، بقوله: إنّ الشّعر” كان ضرباً من السّحر”.([45]) وكانت الممارسات التعبّديّة الكلاميّة ” تستهدف أغراضاً سحريّة اجتماعيّة واقتصاديّة مباشرة”.([46]) وبهذه الصّورة البدائية تغدو “القصيدة شبيهة بتميمة السّاحر وطقوس العابد، يُصدرها بدوافع روحيّة وفكريّة، قاصداً بها إصلاحَ الخلل حمايةً لحياته وحياة عشيرته”.([47]) كمثل الممارسات السّحرية الهادفة إلى معالجة المرضى وإلحاق الأذى بالأعداء. كما ويذكر(بروكلمان) Brockelman حول وظائف الشّعر الأولى ” أنّه كان يُنشَد لأغراض سحريّة تساعد على تحمّل مشاقّ العمل كالجَني والصّيد”.([48]) إضافة إلى ما أُعِدّ من شعر” لطقوس الموت، ما يندرج ضمن الاحتفالات الجنائزيّة… الّتي يُناح بها على القتلى والموتى بهدف طمأنتهم في قبورهم، وإبعاد الأرواح الشّريرة عنهم”.([49]) فمن الأغراض السّحريّة في الشعر قهر الأعداء وإلحاق الهزيمة بهم، كقول عبيد بن الأبرص:
صقعتك بالغرّ الأوابد صقعةً خضعتَ لها، فالقلب منها جريض([50])
وقد مهّدت هذه الطّقوس الطّريق للشّعراء الجاهليّين الرّائين، فاستفادوا منها لمدّ نفوذهم والتّرقي في المراتب الاجتماعيّة،” ذلك، لصلتهم بتلك الأرواح وقدرتهم على ذلك القول السّاحر الّذي يسمّى شعراً. وأمّا فضلهم على قومهم في السّلم والحرب وفي حاضرهم ومستقبلهم فكان عظيماً”.([51])
ولئن تجاوزت الرّؤيا المعاصرة الأغراض السّحريّة التقليديّة للشّعر، على غرار القصيدة القديمة، إلّا أنّها حافظت على سحر الكلمة وقدسيّتها، فاكتست مع الشّاعر المعاصر أبعاداً سحريّة جديدة. ولعلّ هذا ما يشير إليه اسماعيل عزالدين بقوله: ” لم يعرف الإنسان السّحر إلّا يوم أدرك قوة الكلمة، ولم يعرف الشّعر إلّا يوم أدرك قوة السّحر. فاللغة والسّحر والشّعر ظواهر مترادفة في حياة الإنسان ومتساندة”.([52]) وهذا ما يؤكّد الجذور المشتركة للشّعر والسّحر، ويدل على قدرة الكلمة على التّغيير والتأثير وتبديل الوقائع. ” فلم يعد الشّاعر المعاصر يحسّ بالكلمة على أنّها مجرّد لفظ صوتيّ له دلالة أو معنًى، وإنّما صارت الكلمات تجسيماً حيّاً للوجود، ومن ثَمَّ اتّحدت الّلغة والوجود في منظور الشّاعر.”([53]) ” فالكلمة هي وجود وحضور له كيان وجسم…وهي قطعة من الوجود أو وجه من وجوه التّجربة الإنسانيّة، ومن ثَمَّ، فإنّ لكلّ كلمة طعماً ومذاقاً خاصّاً”.([54]) ويستشهد عزّ الدين بمقطع من قصيدة (الزّمان الصّغير) لأدونيس، ليؤكد سحر الكلمة في التّوحيد بين الّلغة والوجود:
أبحث عمّا يعطي للحجر شفاه الأطفال
والتّاريخ قوس قزح
وللأغاني حناجر الشّجر
أبحث عمّا يوحّد نبراتنا
الله وأنا، الشّيطان وأنا
العالم وأنا([55])
“وبذلك، فلم تعد الّلغة في تصوّرات الشّاعر المعاصر وسيلة (ترجمة) للوجود أو للتّجربة، ولم يعد الشّعر، كما كان التصور من قبل، ترجماناً للمشاعر والأفكار، أو ترجماناً للحياة، وإنّما صار الشّعر، بالنسبة إلى الشّاعر ولنا، هو الوجود، وهو التّجربة، وهو الحياة”.([56])
الخاتمة:
البحث في عالم الرؤيا الشّعريّة هو بحث في ما يتأمّله المرء من هذا الوجود بصراً وبصيرةً. حيث تجبهه الألغاز المحيّرة، فيبذل جهده لتقصّي الحقائق، وتخفيف عبء القلق والخوف، وتأخذه الدّهشة إزاء ما يحيط به، فتتملّكه الرّغبة بالكشف والمعرفة. ومن المرجّح أنّ الشّعر تبوّأ المكانة الأبرز بين وسطاء الغيب في ذلك العصر، حيث مثّلت الكلمة مساحة البوح الفضلى، فكان الشّعر مترجماً للهواجس والآمال والآلام معاً. وقد انتقلت الرؤيا الشّعريّة بالتجربة من مرحلة الرؤيا الفكريّة للواقع والفن، إلى مرحلة الرؤيا الحديثة، وقد رأى “حاوي” أن الإنسان هو محور هذه الرؤيا لأنّه يسلّط قلمه شطر مأساة الإنسان العربيّ. إذا، وفي ظلّ التحوّلات المختلفة في العالم العربيّ، شكّل الشّعر انعطافة فكريّة فلسفيّة فنّية بفعل الضغوط الاجتماعيّة والسّياسيّة، فواكب قضايا المجتمع، واحتضن ندوب الواقع وعبر نحو حياة إنسانيّة راقية.
هوامش البحث:
([1]) أبو جهجه، خليل، الحداثة الشعرية العربية بين الابداع والتنظير والنقد، ص196 .
([2]) الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، ص58.
([3]) بوعيشة، بوعمارة، الشاعر العربي المعاصر ومثاقفة التراث، لاط، لات، الجزائر، جامعة زيّان عاشور، ص7.
([4]) أبو سيف، ساندي سالم، قضايا النقد والحداثة، ص51.
([5]) مجلة شعر، هيئة التحرير، أخبار وقضايا، ع16 صيف1960 م. ص132.
([6]) أدونيس، الأعمال الشعرية الكاملة، ج1، دار الساقي، ص 369 .
([7]) اسماعيل، عزالدين، الشعر العربي المعاصر، ص415 .
([8]) سويف، مصطفى، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، ط2، القاهرة، دار المعارف 1959م. ص32.
([9]) جان بران، أفلاطون والأكاديمية، ط1، سوريا، دار الأبجدية، تر. جورج أبو كسم1974م. ص176.
([10]) زكي، أحمد كمال، دراسات في النقد الأدبي، ط2، دار الأندلس، 1980م. ص122.
([11]) عباس، عبدالحليم، تأملات في الخطاب الشعري العربي المعاصر، لاط، عمّان، الأكاديميون للنشر والتوزيع، 2013م. ص148.
([12]) حاوي، خليل، ديوان خليل حاوي، لاط، بيروت، دار العودة ، 1993م. ص286.
([14]) أدونيس، الشعرية العربية، ط2، بيروت، دار الآداب ، 1989 م. ص76.
([15]) مجلة دراسات عربية، مقال من كتاب” جبران خليل جبران ووليم بليك شاعرا الرؤيا” لجورج نقولا الحاج، ترجم المقال ونشره جورج نقولا الحاج، عدد10، سنة 9، 1982م.
([16]) أبو جهجه، خليل، الحداثة الشعرية العربية، ص205.
([17]) حاوي، خليل، ديوان خليل حاوي، 2015، ص84.
([18]) ناصر، اسطنبول، تداعي الوعي في الشعر الجاهلي، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة وهران 1980، ص150.
([19]) بلحاج، كاملي، أثر التراث في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة، لاط، دمشق، اتحاد الكتاب العربي 2004م. ص48.
([20]) أدونيس، زمن الشعر، ط3، بيروت، دار العودة، 1983 م. ص9.
([21]) بلحاج، كاملي، أثر التراث في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة، ص49.
([22]) أدونيس، الآثار الكاملة، ط2، 1971، ج2، ص35 .
([23]) بلحاج كاملي، أثر التراث الشعبي، ص44، الجريض، الهمّ الشّديد.
([24]) زهير بن أبي سلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى، ط3، بيروت، دار صادر، 2002م. ص86.
([25]) أدونيس، الآثار الكاملة، ج2، ص146.
([26]) كاملي، بلحاج، أثر التراث الشعبي، ص129.
([27]) أدونيس، الآثار الكاملة، ج2، ص34.
([28]) كاملي، بلحاج، أثر التراث الشعبي، ص129.
([29]) قاسم، باسم إدريس، الشاعر الجاهلي والوجود، دراسة فلسفية ظاهراتية، لاط، لات، بيروت، مركز دراسات الوحدة الإسلامية ص 62 و63.
([30]) امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، دار صادر، ص99.
([31]) قاسم، باسم ادريس، الشاعر الجاهلي والوجود، ص63.
([32]) قاسم، باسم ادريس، الشاعر الجاهلي والوجود. م..س. ص63.
([33]) زهير بن أبي سلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى،ط3، بيروت، دار صادر، 2012، ص87.
([35]) طرفة بن العبد، ديوان طرفة بن العبد، ط3، بيروت، دار صادر، 2012، ص34.
([36]) مجلة شعر، هيئة التحرير، أخبار وقضايا، ع13، س 4 كانون الثاني 1960م. ص250.
([37]) مجلة شعر، هيئة التحرير، إلى القارئ ع 19، س 5 صيف 1961 م.ص5.
([38]) مجلة شعر، مصطفى خضر، حرية الشعر أن يكون، ع39، شتاء ربيع 1964م. ص92.
([39]) مجلة شعر، هيئة التحرير، أخبار وقضايا، ع19، س 5 صيف 1960م. ص120.
([40]) حرب، جوزف، المحبرة، ص1552.
([41]) حرب، جوزف، المحبرة، 1522 و 1523.
([42]) أدونيس، زمن الشعر، دار العودة، 1972م. ص9.
([43]) بلحاج، كاملي، أثر التراث الشعبي، ص 31 و 32.
([45]) هيربرت رد، الفن والمجتمع، ط1، بيروت، دار القلم، تر. فارس متري ضاهر، 1975، ص19.
([46]) عبدالمنعم، تليمة، مقدمة في نظرية الأدب، ط3، بيروت، دار العودة، 1983م. ص32.
([47]) بلحاج، كاملي، أثر التراث الشعبي، ص46.
([48]) بلحاج، كاملي، أثر التراث الشعبي، م. س.ص41.
([50]) عبيد بن الأبرص، ديوان عبيد بن الأبرص، لاط، بيروت، دار صادر، تح. كرم البستاني، 1964، ص 103.
([51]) حميدة، عبدالرازق، شياطين الشعراء، لاط، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية1956 م. ص85 و86.
([52]) إسماعيل، عزالدين، الشعر العربي المعاصر، ص173.
([53]) إسماعيل، عزالدين، الشعر العربي المعاصر، م. س. ص180.
([54]) إسماعيل، عزالدين، الشعر العربي المعاصر، م..س. ص182.
([55]) أدونيس، أغاني مهيار الدمشقي، ص169.
([56]) إسماعيل، عزالدين، الشعر العربي المعاصر، ص180.
قائمة المصادر والمراجع:
(1) أبو جهجه، خليل، 1995م، الحداثة الشعرية العربية، مجلة دراسات عربية، ط1، بيروت، دار الفكر اللبناني.
(2) أبو سيف، ساندي سالم، 2005، قضايا النقد والحداثة، لا ط. عمان، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر.
(3) أدونيس، الأعمال الشعرية الكاملة، ج1، دار الساقي.
(4) أدونيس، 1989م، الشعرية العربية، ط2، بيروت، دار الآداب.
(5) أدونيس، 1983م، زمن الشعر، ط3، بيروت، دار العودة.
(6) أدونيس، 1971م، الآثار الكاملة، ط2، ج2 بيروت، دار صادر.
(7) اسماعيل، عزالدين، 2007م، الشعر العربي المعاصر، لاط.، بيروت، دار العودة..
(8) الرافعي، مصطفى صادق، 1974م، تاريخ آداب العرب، ط2، ج3، بيروت، دار الكتاب العربي.
(9) امرؤ القيس، 1948م، ديوان امرئ القيس، دار صادر.
(10) بوعيشة، بوعمارة، الشاعر العربي المعاصر ومثاقفة التراث، لاط، لات، الجزائر، جامعة زيّان عاشور.
(11) بلحاج، كاملي، 2004م، أثر التراث في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة، لاط، دمشق، اتحاد الكتاب العربي.
(12) بلحاج كاملي، أثر التراث الشعبي، الجريض، الهمّ الشّديد.
(13) حاوي، خليل، ديوان خليل حاوي، 1993م، لاط، بيروت، دار العودة.
(14) حرب، جوزف، المحبرة، ط1، بيروت، دار رياض الريّس للكتب والنشر.
(15) حميدة، عبد الرازق، 1956م، شياطين الشعراء، لاط، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.
(16) جان بران، 1974م، أفلاطون والأكاديمية، ط1، سوريا، دار الأبجدية، تر. جورج أبو كسم.
(17) زكي، أحمد كمال، 1980م، دراسات في النقد الأدبي، ط2، دار الأندلس.
(18) زهير بن أبي سلمى، 2002م، ديوان زهير بن أبي سلمى، ط3، بيروت، دار صادر.
(19) سويف، مصطفى، 1959م، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، ط2، القاهرة، دار المعارف.
(20) طرفة بن العبد، 2012م، ديوان طرفة بن العبد، ط3، بيروت، دار صادر.
(21) عباس، عبد الحليم، 2013م، تأملات في الخطاب الشعري العربي المعاصر، لاط، عمّان، الأكاديميون للنشر والتوزيع.
(22) عبد المنعم، تليمة، 1983م، مقدمة في نظرية الأدب، ط3، بيروت، دار العودة.
(23) عبيد بن الأبرص، 1964م، ديوان عبيد بن الأبرص، لاط، بيروت، دار صادر، تح. كرم البستاني.
(24) قاسم، باسم إدريس، الشاعر الجاهلي والوجود، دراسة فلسفية ظاهراتية، لاط، لات، بيروت، مركز دراسات الوحدة الإسلامية.
(25) مجلة دراسات عربية، مقال من كتاب” جبران خليل جبران ووليم بليك شاعرا الرؤيا” لجورج نقولا الحاج، ترجم المقال ونشره جورج نقولا الحاج، عدد10، سنة 9، 1982م.
(26) مجلة شعر، هيئة التحرير، أخبار وقضايا، كانون ثان 1960، ع16 صيف1960 م، شتاء 1964م.
(27) ناصر، اسطنبول، 1980م، تداعي الوعي في الشعر الجاهلي، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة وهران.
(28) هيربرت رد، 1975م، الفن والمجتمع، ط1، بيروت، دار القلم، تعريب فارس متري ضاهر.