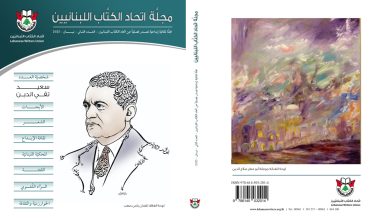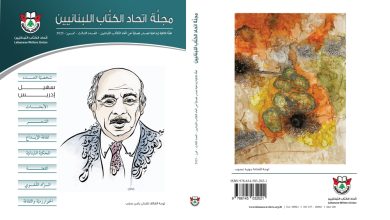نظريّات في أصل اللغة – د. إميل منذر
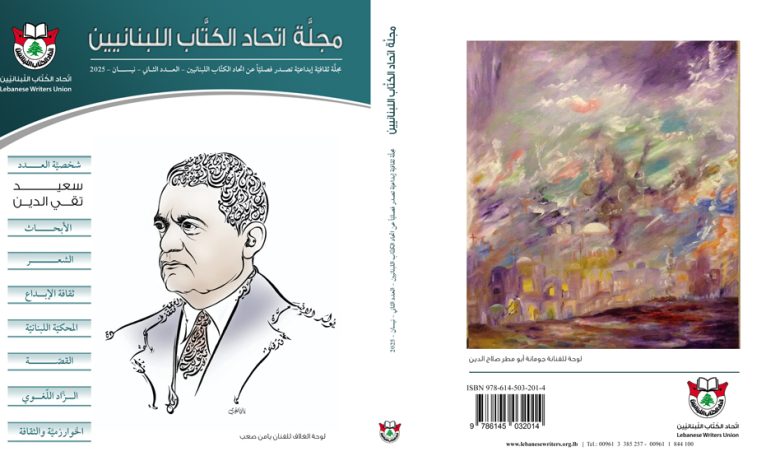
نظريّات في أصل اللغة
د. إميل منذر
ليست العربية أداةَ تواصلنا وحافظة إرثنا التقافيّ والحضاريّ فحسب، لكنّها أيضاً رمز هويّتنا التي نعتزّ بها. لذا نرى لِزاماً علينا أن نعرّف أبناءها بها عن طريق سلسلة مقالات سننشرها تِباعاً على صفحات مجلّتكم هذه.
إذا كانت الكلمة هي العنصر الأساس في اللغة، فإن هذه الكلمة لم تظهر إلى حيّز الوجود إلا في مرحلة متقدّمة من عمر البشرية على الأرض.
في البدء كانت الأصوات الأحديّة المقطع، التي تشبه أصوات الحيوانات، أداة الإنسان في محاولة التعبير عن انفعالاته ورغباته. وهذا اعتقاد سلّم به الأقدمون قبل أن يصبح نظرية ألسنية حديثة. يقول ابن جنّي: “وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلّها إنما هو من الأصوات المسموعات، كدويّ الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء، وشحيج الحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الظبي، ونحو ذلك. ثم وُلدت اللغات عن ذلك في ما بعد. وهذا عندي وجه صالح، ومذهب متقَبَّل”1. وغالباً ما كانت هذه الأصوات تترافق مع إشارات بصرية بمختلف أعضاء الجسد توخّياً للإيضاح. ولما احتاج الإنسان إلى تدوين أفكاره وحفظها، استعان بأشكال رآها حوله في الطبيعة من جماد وطير وحيوان؛ فكانت الكتابة الهيروغليفية.
غير أن الإنسان رأى أنه بهذه الطريقة لا يستطيع التعبير إلا عن مقدار ضئيل من أفكاره باستهلاك وقت طويل وجهد كبير ومساحة واسعة من المادّة المرسوم عليها؛ ففكّر في وسيلة أجدى، إلى أن اهتدى إلى الحرف الذي شكّل بحقّ ثورة عظيمة وفتحاً مبيناً، إذ أصبح لكلّ صوت شكل يرمز إليه. ويكاد الباحثون يُجمعون على أن ذلك “الفاتح” إنما هو قدموس الفينيقيّ ابن هذه الأرض التي كُتب لها أن تكون منارة العالم القديم.
والحرف كان أساس الكلمة. والكلمة كانت اسماً قبل أن تكون فعلاً لأن الفاعل أسبق إلى الوجود من الفعل، ولولا ذاك لما كان لهذا أن يكون.
وهذه النظرية يؤيّدها ستيوارت ضود. يقول: “تعلّم الإنسان بمرور الأجيال أن يُكثر من تسمية الأشياء. وأن يزداد دقّةً في ذلك. وحالما تعوّد أن يسمّي الأشياء بأصواتها، امتدّت هذه العادة إلى تسمية الأعمال وصفات الأشياء، فمن المحتمل إذن، أن تكون الأفعال والصفات قد نشأت بعد الأسماء والضمائر”2.
وإذا كان الباحثون يُجمعون على أن الاسم هو أساس اللغة؛ فإنهم اختلفوا في نشأة هذا الاسم. بعضهم ذهب مذهب ابن جنّي في الكلام على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح. يقول ابن جنّي: “هذا موضع محوِج إلى فضل تأمّل. غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيف. إلا أن أبا عليّ، رحمه الله3، قال لي يوماً: هي من عند الله، واحتجّ بقوله سبحانه: وعلّم آدمَ الأسماءَ كلّها”4.
غير أن ابن جنّي يعتصم بمنطق الباحث فلا يسلّم بنظريّة أستاذه، ويتوسّل الشكّ سبيلاً إلى اليقين؛ فيتساءل: “فإن قيل لي: فاللغة فيها أسماء وأفعال وحروف، وليس يجوز أن يكون المعلَّم من ذلك الأسماء دون غيرها ممّا ليس بأسماء، فكيف خصّ الأسماء وحدها؟”5. عن ذلك يجيب بأن رُبّ قائل يقول إن الاسم هو أقوى من الفعل والحرف، وجاز أن تكتفي الجملة به من دونهما. وهذا الشكّ يتوافق واعتقاد ابن جنّي بنظرية إطلاق الإنسان على مخلوقات الله أسماء مستوحاة من أصواتها. ويتّفق أيضاً مع ما جاء في كتاب العهد القديم: “وجبل الربّ الإله من الأرض كلّ حيوانات البريّة وكلّ طيور السماء. فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكلّ ما دعا به آدمُ ذاتَ نفسٍ حيّة فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البريّة”6.
لكن ابن جنّي يعود ليترك مع أستاذه ابن فارس مجالاً “للصلح” فيتراجع خطوة إلى الوراء، ويقرّر أنّ بعض اللغة توقيف وبعضها اصطلاح. يقول: “وقد تقدّم في أوّل الكتاب القول على اللغة: أتواضُع هي أم إلهام. وحكينا وجوّزنا فيها الأمرين جميعاً. وكيف تصرّفت الحال وعلى أيّ الأمرَين كان ابتداؤها؛ فإنها لا بدّ أن يكون وقع في أوّل الأمر بعضها، ثم احتيج في ما بعد إلى الزيادة عليه، لحضور الداعي إليه، فزيد فيها شيئاً فشيئاً، إلا أنه على قياس ما كان سبق منها في حروفه وتأليفه وإعرابه المبين عن معانيه”7.
واستناداً لما جاء في كتاب العهد القديم، فقد “كانت الأرض كلّها لساناً واحداً ولغة واحدة”8. لكن الربّ بلبل ألسنة الناس في عهد ملكهم المتجبّر “النمرود”، وشتّتهم في الأرض كلّ جماعة منهم بلسان. وكانت “الساميّة” لغةَ قوم سام بن نوح9. وهذه أيضاً لم تصمد أمام قدَر الانقسام؛ فانقسمت بدورها، باعتبار الزمان والمكان، أقساماً ثلاثة، هي:
أ- شرقية، وهي البابلية الآشورية، والأكادية. وموطنها بلاد ما بين النهرين منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد.
ب- غربية، وهي الكنعانية بفروعها الفينيقية، والعبرية، والآرامية/ السريانية التي كانت سائدة في فلسطين وبلاد الشام قبل الميلاد.
ج- جنوبية، وهي قسمان:
– شمالية، وهي الثمودية، واللحيانية، والعربية العدنانية، أي لغة الحجاز قبل الإسلام ببضعة قرون.
– جنوبية، وهي لغات اليمن القديمة كالسبئية، والحِمْيرية، ثم لغات الحبشة وأهمّها الأمهرية، والعربية القحطانية التي تُنسَب إلى يعرُب بن قحطان.
ومن هنا تبدأ الحكاية مع اللغة العربية.
سيادة اللغة الشمالية
كان واضحاً أن لغة اليمن الحِمْيرية مختلفة كثيراً عن لغة الحجاز العدنانية في الصرف والاشتقاق، حتى “قال أبو عمرو بن العلاء: ما لسان حِمْير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيّتهم بعربيّتنا”10. وقيل أيضاً: “لغة اليمنيين كانت تخالف لغة الحجاز وضعاً وتصريفاً، وهي أكثر اتّصالاً باللغة الأكادية والحبشية. أما لغة الحجاز فأكثر اتّصالاً بالعبرية والنبطية”11.
يورد د. طه حسين، نقلاً عن الأستاذ جويدي، عبارة نموذجية من لغة الجنوب تبيّن اختلافها الكبير عن لغة الشمال. وهذه العبارة هي: “وهبم وأخهو بنو كلبت هقنيو إل مقه ذهرن ذن مزندن حجن وقههمو بمسألهو لو فيهمو وسعدهمو نعمتم”.
“قال الأستاذ جويدي في تفسير هذه الكلمات:
(وهبم) أي وهّاب اسم رجل، والألف كثيراً ما تحذَف من وسط الكلمة وآخرها في الكتابة الحِمْيرية، وكذلك الواو والياء. أما الميم الأخيرة فهي بدل التنوين في العربية.
(وأخهو) أي وأخوه، ففيه واو حُذفت قبل الهاء. أما “هو” في آخرها فهي بدل ضمير الغائب وهو “هـ” في العربية.
(بنو) تكتَب بالواو لأنه للقبيلة.
(كلبت) أي كلبة بالتاء المربوطة، وليس في الكتابة الحِمْيرية تاء مربوطة. وكلبة اسم قبيلة.
(هقنيو) أي أقنوا ومعناه أعطوا. والفعل الذي على وزن أفعل في اللغة الحِمْيرية تبدَّل همزته هاءً، والمعتلّ لا يحذَف حرف العلّة منه مع اتّصاله بواو الجماعة.
(إل مقه) اسم إله من آلهتهم كان يُعبَد في هران وفي أوام.
(ذهرن) أي ذوهران، الواو حُذفت من ذو، والألف من هران. وذو بمعنى صاحب، وهران موضع قال ياقوت إنه حصن ذمار باليمن.
(ذن) أي ذان، وهو اسم إشارة زيدت النون في آخره لتأكيد الإشارة، وحُذفت منه الألف كالعادة.
(مزندن) أي لوح، وهو لفظ حِمْيريّ.
(حجن) معناه لأن أو بسبب.
(وقههمو) أي أجابهم، و”همو” هو ضمير المفعول في الجمع.
(بمسألهو) أي عن سؤاله.
(لوفيهمو) هو فعل لم يُحذف منه حرف العلّة كما في هقنيو. ومعنى لوفيهمو أي سلّمهم.
(وسعدهمو) أي وساعدهم.
(نعمتم) أي نعمة، والميم بدل التنوين”12.
لم يكن التباين بين اللغتين مقصوراً على الوضع والتصريف فحسب، بل تعدّاهما إلى المفردات أيضاً. وخير دليل على صحّة هذا الكلام تلك الرواية: “رُوي أن أبا هريرة لما قدم من دوس عام خيبر، لقي النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، وقد وقعت السكّين من يده؛ فقال له: ناولْني السكّين. فالتفت أبو هريرة يمنة ويسرة، ولم يفهم ما المراد باللفظ؛ فكرّر له القول ثانية وثالثة؛ فقال: المدية تريد؟ وأشار إليها؛ فقال له: نعم. فقال: أوتسمّى عندكم السكّين؟”13.
لكن ما استمرّ وساد ودام إلى اليوم من العربيّتين الشمالية والجنوبية، هو الأولى أي العدنانية المسمّاة أيضاً مُضَريّة. ذلك أن أحداثاً اقتصادية معيشية وسياسية حصلت في الجنوب، وأدّت إلى انحسار لغته وتقهقرها. فمن الأحداث الاقتصادية كان تهدُّم سدّ مأرب نحو سنة 115 ق.م، واندفاع السيل العُرْم الذي أغرق البلاد وقضى على الزرع والضرع؛ فنزح عدد من القبائل نحو الشمال، حيث استوطن الغساسنة بلاد الشام، واللخميون المناذرة الحيرةَ جنوب العراق، حتى ضُرب في ذلك المثَل؛ فقيل: “تفرّقوا أيدي سبأ”. ومن الأحداث السياسية كان أفول دولة التتابعة مع ذي نُواس سنة 525م. ومملكة كندة بحلول سنة 540م.
هوامش البحث:
1 ابن جنّي، الخصائص، 1/ 46- 47.
2 ستيوارت ضود، العلاقات الاجتماعية في الشرق العربيّ، ص 292.
3 هو أبو عليّ الفارسيّ أستاذ ابن جنّي، وصاحب كتاب “الصاحبيّ”.
4 ابن جنّي، الخصائص، 1/ 36.
5 المصدر نفسه، ص 41.
6 سِفْر التكوين: 2/ 19- 20.
7 ابن جنّي، الخصائص، 2/ 28.
8 سفر التكوين: 11/ 1.
9 الساميّة اصطلاح استخدمه لأوّل مرّة العالِم الألمانيّ شلوتسر عام 1781م.
10 ابن سلاّم الجُمَحيّ، طبقات الشعراء، ص 45/ جلال الدين السيّوطيّ، المزهر، 1/ 105.
11 مارون عبّود، المجموعة الكاملة، المجلّد1، ص 13.
12 طه حسين، في الأدب الجاهليّ، ص 94- 95- 96.
13 أحمد أمين، فجر الإسلام، ص 52.