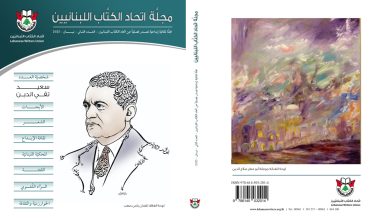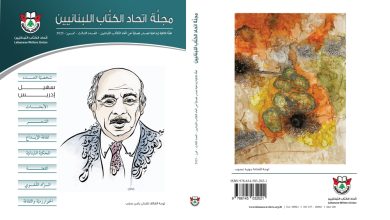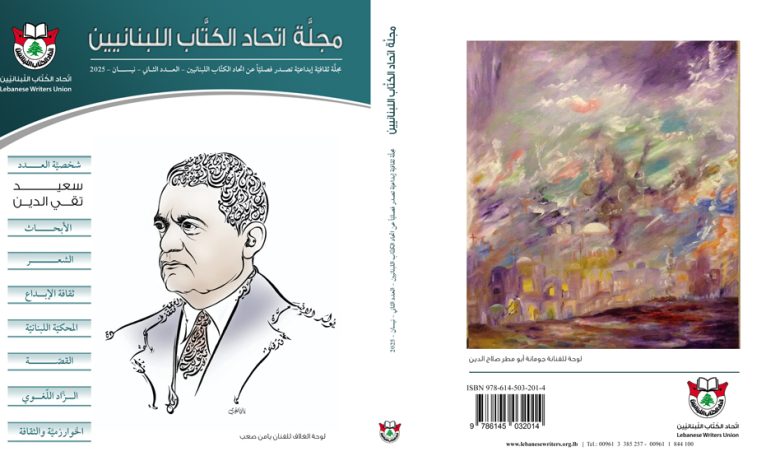
القصة القصيرة جدَّاً تدافع عن نفسها
أ. سعيد أبو نعسه
لم يشهد نوعٌ أدبيٌّ ما شهدته القصة القصيرة جدَّاً من جدل محتدم خلال الندوات، والمؤتمرات التي عقدت حول هويّتها من جهة، وحول أحقيّتها في الحياة من جهة ثانية.
فالأنواع الأدبية الأخرى فرضت نفسها في حيّز الوجود، كأسلوب لا غنى عنه من أساليب التعبير؛ ولم يمانع أحد في تلقّفها ولم يسألها عن بلد المنشأ، طالما أنها تقدّم نفسها مرآة للإبداع والجمال اللذين يتجاوزان حدود الوطن والجنسية.
لماذا تُحارب القصة القصيرة جدَّاً هذه الحرب الشعواء؟ تُقام في وجهها السدود، وتُغلق دونها الحدود، وتكال لها الردود التي تحمل في طياتها التهكّم والسخرية أحياناً.
هذا يسميها ومضة، وذاك يسميها برقية، وآخر يقول: لمحة، وأخرى تقول: طرفة، وخامس يقرِّر: إنها فكرة، وسادس يُشعرنها مطلقاً عليها اسم: خاطرة؛ ما جعلني أنضمّ إلى ركب المتفذلكين، مختاراً لها اسماً جديداً: قَصَجَة؛ اختصاراً لاسمها الطويل، والذي لا يتناسب وجوهرها.
إذا كانت حجّة المحاربين تتمركز حول حجمها الصغير جدَّاً، فالقصة القصيرة أيضاً ثارت على الرواية، وأعلنت الانفصال، محقِّقةً نجاحات لا تُحدّ، وجمالات لا تحصى.
وإذا انتُقِدت لاجتزائها بعض عناصر السرد، كالزمان أو المكان أو كليهما معاً، فهذا التحرُّر يزينها ولا يشينها، ويُنصّبها منارة يخترق نورها أمداء الزمان والمكان، ويُعلّق على صدرها وسام الشمولية.
وإذا تناوشتها سهام النقد لأنها تُكثّف الصور والمشاهد والرؤى إلى درجة تقرّبها من الغموض، فهذا فخر لها، وقد قرّر الإمام النفّري رحمه الله: “كلما ضاقت العبارة اتّسع المعنى”. لأن خيال القارئ يسرح في تصوّر المشهد كما يحلو له، فيغدو مشاركاً في كتابة النص، غير مكتفٍ بتأدية دور المتلقّي السلبي؛ ولا بأس بمثل يدعم هذا الرأي:
لو وصفنا الحديقة بأنها (قِبلة المتنزهين وأمل الراغبين في السعادة، والجمال؛ تتطاول أشجارها معانقةً كبد السماء وتتلاون أزهارها معلنةً أنها السحر بعينه).
ووصفناها بأنها: جنّة.
فأيّ الوصفين أقدر على تحفيز الخيال؟!
وإذا جوبهت بأنها تدور حول حدثٍ واحدٍ، وحبكةٍ واحدةٍ لا غير، فهذا يقدّمها للقارئ على طبق من البساطة، والوضوح بعيداً عن تداخل الأحداث، وتشابك العُقد.
وإذا اتّهمت بأنها أباحت نفسها لكلّ من هبّ ودبّ من حملة الأقلام، فهذا جُرم هي منه براء، والجاني هو من يستسهلها، وينتهك حرمتها.
ولعل الرمح الذي يكاد يصيب منها مقتلاً هو ضبابيتها، التي تقلِّص الرؤية حولها فتجعلها عصيَّةً على التمظهر بقوامٍ فريدٍ، يميّزها عمّا يشبهها من أنواع القصّ الأخرى، كالطرفة والنادرة رغم أنّ الفرق بينها شاسع.
فالطرفة (النكتة والملحة) هي نصٌّ سرديٌّ قصيرٌ يهدف إلى الإضحاك تحديداً؛ يختلقها الراوي، ساخراً من الفكرة التي تختزنها، معتمداً على مبدأ الإدهاش، وعدم التوقُّع؛ ما يجعلها شبيهة بالأحجية. والبعض لا يفرّق بينها وبين النادرة.
بينما القصة القصيرة جدَّاً لا تهدف إلى الإضحاك إطلاقاً، وإن لبست ثوب الطرافة أحياناً راسمةً البسمة على وجه القارئ؛ ولعل ما يميّزها هو سخريّتها السوداء، التي تفضح الواقع المرير، والتي تستمطر الحزن بدل الفرح كقصّتي هذه، والتي أظن أنها أقصر ما كُتب من القصص القصيرة جدَّاً.
(دمارٌ شاملٌ أزعجَتهُ نحلةٌ، فلاحَقها بالرصاص).
كما أنّ القصة القصيرة جدَّاً تتميَّز عن النادرة في كونها تسرح في عالم الفانتازيا الخيالي الرائع؛ بينما النادرة تسجيلٌ حرفيٌّ لحدثٍ اجتماعيٍّ، أو تاريخيٍّ غير مألوف، يتَّصف بالغرابة والإدهاش؛ لذا فالأَولى تصنيفها في خانة القصص التاريخي؛ كما أن النادرة قد تترهَّل على مدى صفحات، وقد تنكمش في سطورٍ قليلةٍ بحسب عدد الشخصيات، والأحداث فيها، على العكس من القصة القصيرة جدَّاً.
أما تشبيهها بالفكرة فخطأ فادح، لأن الفكرة قد لا تروي حدثاً، ولا تتلبس شخصية، ولا تتأطَّر في زمانٍ أو مكانٍ.
والخاطرة أيضاً تختلف عن القصة القصيرة جدَّاً، لأنها أشبه بالمناجاة، والبوح الحكيم؛ وهي بعيدة عن السرد المتضمِّن حكاية كقولنا مثلاً:
(لماذا أيها الحُبّ، كلّما اقتربنا منك ازددت بُعداً، وكلما تودَّدنا إليك ازداد صدّك؟).
وتختلف القصجة أو الققجة -كما يحلو للبعض تسميتها- عن القصة القصيرة التي قد تتعدَّد فيها الشخوص، والأزمنة والأمكنة، والأحداث والحبكات، وقد تتضمَّن أكثر من ألف كلمة؛ بينما القصجة لا تتعدَّى مئة كلمة، بشرط عدم التكرار والشرح والوصف والاستطراد…
إزاء ما تقدَّم، وبعد نفي علاقة القصة القصيرة جدَّاً بالأنواع الأدبية الأخرى، فلا بدّ من تحديد معالمها من خلال العناصر الأساسية التي يجب أن تتوافر فيها، وهي:
1- الحكاية: فعليها أن تحكي حكاية، تماماً كالرواية والقصة القصيرة والمسرحية والمقامة والنادرة و…
2- الشخصية: فلا قصة من دون شخصيات تُنجِز الحدث، وتشكِّل جوهر السرد الأساس، ولا يُشترط في الشخصية أن تكون إنساناً، فالحيوان والنبات والجماد كلها تصلح لتأدية الدور.
3- الوحدة: أي الإضاءة على حدثٍ واحدٍ بعينه، مصوغٍ في حبكةٍ واحدةٍ، تُبدي وضوحها للعيان؛ لأن تنوّع الأحداث يستدعي تشابكها، ويؤدي إلى تعدد الحبكات، وربما العقد التي تقود إلى أكثر من احتمال، وإلى تكرار الأفكار في معظم الأحيان، ما يرمي بالقصة إلى هاوية الترهُّل والذبول.
4- التكثيف المقصود: ولعله الهوية الأبرز التي تحملها القصة القصيرة جدَّاً، وهو يعتمد على ضغط الصور، والرؤى بشكل موجز مختصر، يحافظ على جوهرها بكل مكوّناته، من دون شرح أو تفصيل؛ أي على مقاسها تماماً، من دون تطويلٍ مملٍّ، أو إيجازٍ مُخلٍّ. ولعل هذا الشرط هو الأصعب بين عناصرها؛ لأنه يحتاج إلى الموهبة المبدعة، والثقافة الثرّة، والقدرات اللغوية، والتركيز الذهني الشديد؛ ومثال على ذلك ما ورد أعلاه في وصف الحديقة.
5- المفارقة: وهي عنصرٌ جوهريٌّ لأنها تتمحور حول التضاد، والاختلاف بين الأفكار، وحول تقنية تفريغ الذروة، وصدم القارئ بما لا يتوقَّع؛ وهنا يلمع وجه الشبه بينها وبين الطرفة والنادرة، لأن المفارقة تشكِّل عنصر التشويق اللذيذ، الذي يميِّز القصة الناجحة، ويسكب المتعة والارتياح في نفس القارئ.
6- انتشار الجمل الفعلية بشكلٍ لافتٍ؛ لأنها في إيحاءاتها الدلالية تشير إلى الحركة، والحالة، وهما شرطان لازمان من شروط السرد؛ وهذا لا يعني الاستغناء عن الجمل الاسمية نهائيَّاً، لضرورتها في الوصف أحياناً، من دون أن يطغى على السرد، لأنه يهدم الحدود التي تفصل القصجة عن الخاطرة، وعن المقالة الوصفية.
7- العنوان: وهو رغم أهميته في النصوص على اختلاف أنواعها، فإنه في القصة القصيرة جدَّاً يجب أن يُختار بدقة؛ لأنه يؤدي دوراً حاسماً مضيئاً على المضمون، شاحناً للرؤى والدلالات. وقد يؤدي دور القائد لكشف المضمون، كالقصة المذكورة أعلاه (دمار شامل) والتي تشير إلى الحرب التي شنّتها أمريكا على العراق.
وهذه شروطٌ تبدو تعجيزيَّةً، يجفل منها الكتَّاب فيديرون ظهورهم للقصة القصيرة جدَّاً، منصرفين إلى نوعٍ إبداعيٍّ آخر.
وحين تزدان القصة القصيرة جدَّاً بعناصرها، تأتلق فيها الفكرة ماسةً تتعاكس عليها المرامي البعيدة، والدلالات المبطَّنة، يستوحيها القارئ الفطِن، متَّكئاً على المفردات الدالَّة، والمختارة بدقَّةٍ، ودرايةٍ، فإذا هو في دقائق معدودات يقرأ قصةً ماتعةً، غنيَّةً بالرموز والأبعاد، والمعاني التضمينية، في جوٍّ ساحرٍ، وساخرٍ، يُشكِّله الخيال الخصب، المنطلق من أرضية الواقع المرير، الذي تعبث به قوى الشرّ والظلام، لتجد القصة القصيرة جدَّاً نفسها الأقدر على ملامسة المواضيع الحساسة كالعولمة، وصراع الحضارات، والديمقراطية، والدكتاتورية، وقضايا الإنسان العادلة، والحرب، والإرهاب، في أسلوب يتوخَّى التلميح، مستغنياً به عن التصريح.
والقصة القصيرة جدَّاً إذ تقدِّم نفسها نوعاً أدبيَّاً جديداً له أنصاره ومؤيدوه المدافعون عنه، تضع نفسها تحت المجهر، مهيبةً بالنقاد أن يفسحوا لها في الطريق كي تأخذ مكانها اللائق بها، طالبةً منهم الحذر والدقة في التعاطي معها، لأنها طريَّة العود تتوق إلى من يحتضنها ويرعاها.
تجارب الكتّاب المبدعين ما زالت خجولة في ارتياد هذا الفنّ النثري الجديد، وهي لا تكفي بضآلتها الحالية لتشكيل نظرة نقدية حولها، تكون وافيةً ومحدَّدةً، ومتَّفقاً عليها، ما يجعل التسرُّع في الحكم عليها أقرب إلى النقض منه إلى النقد.
هذا الخجل في التجريب يقابله خللٌ في المشهد النقدي؛ فبين ناقدٍ يُطبِّل، ويُزمِّر لفلان، أو علّان، من معارفه كَتَبة القصة القصيرة جدَّاً؛ وبين ناقدٍ محايدٍ، تهتزُّ المعايير ويختلُّ التوازن، وتفقد (القصجة) عذريّتها، وألقها بعد أن عرَّشت الطحالب على صدرها، حارمةً ساحتنا الأدبية متعة التلذُّذ بنوعٍ أدبيٍّ جديدٍ جميلٍ، توَّاقٍ للظهور، ومناسبٍ لواقع الأمور، اسمه: القصة القصيرة جدَّاً.