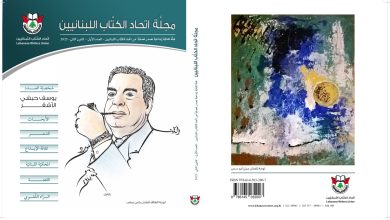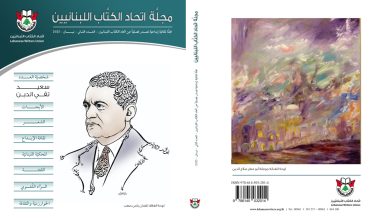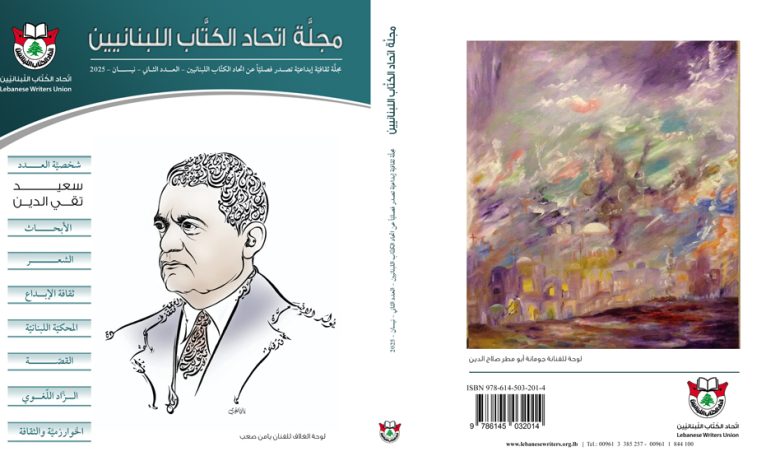
رُقود
أ. نجوى الموسوي
أنزل زجاج نافذة “الرّانج” اللامع المكيّف. شهَرَ جواله، كما لو أنّه يشهر شهادة أحد أطفاله وقد أنهى توّاً “كورسات عزف البيانو”. صوّب “كاميرا” الهاتف نحو الرّصيف أمام جدارٍ عالٍ. التقط ظاهر المشهد الذي رآه. كان الرّجل قد انطلق قبل قليل على “أوتوستراد” المطار الدّوليّ، في طريقه إلى منزله في العاصمة، بين نهاية سهرته، وغياب هموم المترفين، تأفّف متحدّثاً مع نفسه. “أتخمني الكلام وليس الطّعام وحسب. لو كنت أعلم أنّ العشاء سيتخلّله ندوة فكريّة في نادي الصّحافيين لما حضرت”.
كانت مناسبة مُضجرة له منذ ما بعد الغروب، لكنّه أنهاها بلمحةٍ اعترضت ناظريه. التقط “ظاهر المشهد” على قارعة الطّريق، وحرص على تسجيله في “استديو” الخلوي خاصّته، لعلّه كسر الجمود قليلاً أو بدّل ملله. إلا أنّه لم يشاهد ما بعد تلك اللّمحة حتماً، فما بعده كان يحصل في آخر “زقاق” معتم، عند المنعطف بين أوجاع مفاصل الأرملة، وجداول بكاء مسائها الماطر.
هناك في الطّابق الأرضيّ من مبنى متهالك من الزّقاق، وقفت امرأة بباب الدّار تفتحه. تلوي شفتيها باستياء. تلقي بنظرها إلى أقصى تلّ من النّفايات لم تنتشلها شاحنات الحكومة بعد. تضرب على صدر عباءة بدويّة طويلة، ثم تغلق الباب. “أين أنت يا “ولدي”. لم كلّ هذا التّأخير؟ ما هذا “الشّغل”؟ ليتك بقيت تعمل في جمع الأواني البلاستيكيّة، أو حتى في نقل الأحجار والحديد!”.
تهادت خلف المرأة فتاةٌ حافية، على حصيرة منتوفة الأطراف، صغيرةٌ تبدو شبيهة بهيكل من عظام ضامرة. لا تبالي باصطامها بطاولة مكسورة، تشير إلى نفسها ثم تشير إلى خارج الباب، كأنّها تطلب الإذن من أمّها لمغادرة الغرفة، ولكنّها تلفظ بصعوبة حروفاً محدّدة:
– ما .. ما … ما.. سا .. سا
أجابت الأم بصوت لا يكاد يتجاوز حنجرتها.
– اسكتي. لن أكرّر. لن تبيعي أكياس المناديل، بعد الغروب”.
ثم شردت في تفكيرها كأنّها تناجي زوجها الفقيد منذ أكثر من سبع سنوات، وتخبره: “لا داعي للقلق، أليس كذلك؟ سيُكمل “رجُلُنا” بيعَ صناديق الماء المقرّرة لكل يوم. سيرجع كما اشترطتُ عليه بعد الغروب بساعة واحدة، ساعة واحدة”.
كان الصّبي قد رجاها أن يطيل المكوث مع أخته في الشّارع، لما بعد الغروب، فالعائدين أو المسافرين في مثل هذا الوقت أيضاً كثر. وربما يشترون منه، فيما تعود هي للغرفة. وها هو هي تنتظر.
على المقلب الآخر، في أول وقفة عند إشارة حمراء، ضغط الصّحافي على زر “إرسال” فوق صورة الفتى النّائم. صبي مثير للشّفقة، كان مفترشاً الأرض ملتحفاً السّماء. وطارت الصّورة الى مجموعاته وأصدقائه في العالم الأزرق الواسع. عشرات التّفاعلات والتّعليقات، وصلته في دقائق معدودة. بعد أن انتشر سَبْقه “المجتمعيّ” بومضة ضوء.
في سريره الوثير، ابتسم الصّحافيّ من دون أن يتأمّل في الكلمات التي توقعها مسبقاً. شكر المتابعين على مرورهم:
– هذا أقل الواجب.
استسلم للنّوم. لم تصل إليه حتماً تأتأة فتاة هناك تنادي وتنادي:
– ما..ما…. سا ..سا.
استمرت الطّفلة في إشاراتها وتأتأتها. ذات السّبع سنوات ونصف، النّحيلة، ضامرة العضلات ماضية في الإصرار اللّجوج. مسحت المرأة دموعها بكُمّها.
– قلت لك سبعين مرة اسمه “سعيد”.
وما لبثت أن مشت، مشت تتأرجّح مع هواء الشّتاء وبرقه تجرّ ابنتها وتحملها. وصلت إلى أول دكان ضيق. حين مدّت يدها على سماعة “التّلفون” الدّبقة، قال البائع:
– بمن تتّصلين في هذا الوقت يا امرأة؟
– مندوبة مبادرة القضاء على عمالة الأطفال. قالت لي أن أتصل عند الحاجة.
ضحك الرجل قائلاً:
– الكلّ مغلق الآن.
– هذا رقم جوال.
أخيراً ردَّ الطرف الآخر، وردّدت الأم ما يقوله الصوت المتثائب. بلهجة سؤال.
– آه، انتهت مهمتكم؟ نشرتم التّحقيق الصّحفيّ!؟ كان ناجحاً!؟ شكراً لخدماتي!؟
أقفلت السّمّاعة بيد مرتجفة. وهي تلعن وتشتم في سرّها… هرولت، هرولت باتّجاه المكان الذي اتّفقت عليه مع وحيدها منذ أشهر ليبيع فيه الماء والمناديل والبالونات للمارة. كان ذلك القرار نصيحة من “طالب خدمة اجتماعيّة” بأن يترك فتاها عمله في ورشة بناء لأنّه أكبر من حمل جسمه وقتها، وعدها بأن يزور أسرتها وينظر في ما تحتاج ويحتاج ولديها. ذهب ولم يعد. ولم تعد تذكر حتى تقاسيم وجهه.
تقدّمت في سيرها. صعدت درجات جسر المشاة تتلفّت يمنةً ويسرةً، على طريق المطار الذي تقلّ فيه حركة السّير في هذه الفترة.
فجأة لمعت في الأسفل أضواء سيارة توقّفت هنيهة قرب حوض زهور يابس أمام جدار. ساعدتها لتميّز كنزة ولدها الخضراء المخرومة. كانت قد تصدّقت بها إحداهن، حين جدّدت ثياب ولدها.
– يا ويلي. ماذا أصاب الصّبي؟
صرخت. فيما مضت السّيارة في سبيلها. تجعد وجهها في لحظة. أرسلت عيناها دموعاً يخفيها الظّلام. أسرعت الخطى نحوه. نطقت البنت وأجابتها:
– ما..ما.. سا سا .. با.. … با.. بوم .. بوم
– كلا، كلا. لا تخافي. لن يموت سعيد. ربما هو نائم.
خنقت عبرَتها. مسحت رذاذ المطر عن وجهها وعن رأس صغيرتها. راحت تناديه بأعلى صوتها. رددت الفتاة “س سِيد.. س سيد” لاهثة، وقد تبعها صدى الفراغ الأسود.
لحظة وصولهما إليه، هزّت الأمّ فتاها لينهض. رفعت وجهه الأحمر المطبّع من أثر النّوم عن زنده الذي اتّخذه مخدّة. فجأة شيء ما سقط على رأسه. هبّ مذعوراً. إنّها قنينة ماء رماها سائق ماجن. ولولت. حاولت أن تجر الفتى بعد حين. بدأ يتحرك بصعوبة. لم تعرف. غابت مع اليتيمين في دهاليز الأزقة، ثم توارى المشهد في ليل المدينة ونهارها. وسريعاً، غابت صورة ذلك الصّحافيّ من “أرشيف” هاتفه بعد عشرات “التّحديثات” ومئات الرّسائل.