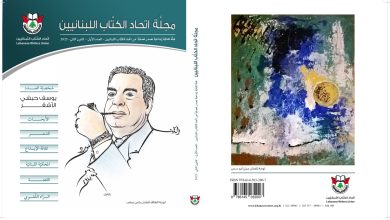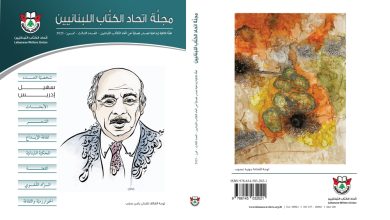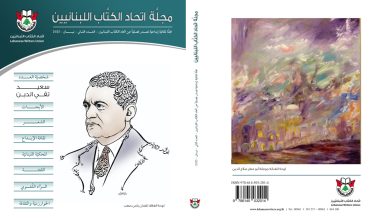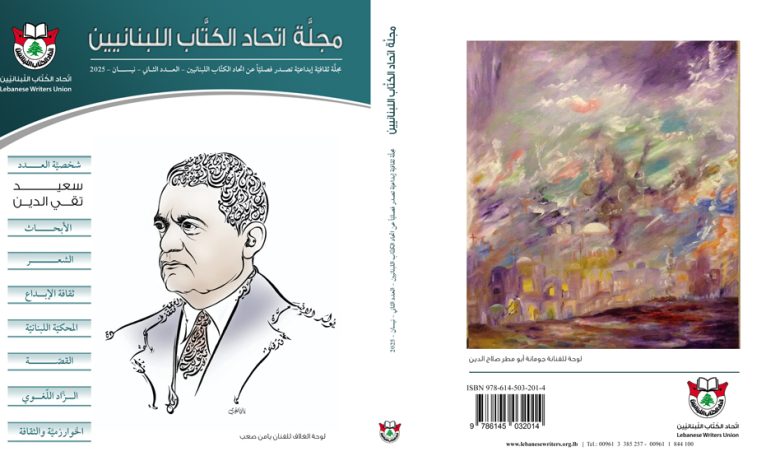
ماسح الأحذيّة
أ. هلا ضاهر
اسمه لاجئ أو ماسح الأحذيّة لا أحد يهتمّ لاسمه الذي اختاره له أبواه. اكتسب سحنته السّمراء من المشي في الشّمس. يخرج يومياً من مخيم شفعاط. يتجوّل من شارع إلى شارع وهو مضّطر للدّوران في الشّوارع.
يحمل على خصره الصّندوق المربوط بحزام من الجلد منادياً: بويا! بويا!
كان يرتدي سترة زرقاء ويعتمر قبّعة بلون أنفه المحمّر من الزّمهرير.
على أحد جانبي الصّندوق زجاجات الصّبغة بألوان الأحذيّة الرّئيسة: أسود، كحلي، بني، أبيض. والجانب الآخر يحتوي على فرشاة وعلب الدّهان وفوط التّلميع.
يجلس عند حافة الرّصيف قرب حانوت الورد يضع أمامه كرسيّاً صغيراً مصنوع من الخشب والخيزران كلّما أتاه زبون يمدّ قدمه فوق الكرسي ويبدأ علاء في طلاء الحذاء حسب اللّون المطلوب.
عمله لا يغطّي نفقات الجامعة، لذا كان يدرس فصلاً ويغيب عن الفصل التالي من أجل تأمين كلفة الأقساط الجامعيّة. تلك الحقيقة لا يعرفها الجميع والوقت عنده ثقيل كسيح، فاستغرق ضعف السّنوات التي يحتاجها أي طالب آخر، ليتمكّن من الوصول إلى التّخرّج من كليّة الإعلام.
مقابل الرّصيف هناك “قهوة بدران” حيث يجتمع جنود الاحتلال الإسرائيليّ كلّ صباح. تتعاقب مجموعة منهم تلو المجموعة على تنفيذ دوريّة استطلاعيّة في المنطقة ويعرجون على المقهى لشرب ما يحلو لهم مما يختارونه من لائحة المشروبات السّاخنة أو الباردة. لا فرق عندهم طالما لا يدفعون ثمنها. تماماً كما يفعلون معه فكلّما مرً أحدهم من أمامه يمدّ حذاءه، ويأمره بمسحه ملوّحاً بسلاحه وما إن ينتهي يتابع سيره من دون أن يدفع الأجرة.
تضاعفت مأساة علاء بفعل هؤلاء الجنود لكنّه لم يعتدّ على الأمر، ولم يستسلم للحرج والضّيق ونفاد الحيلة. ولم يخضع لسلوكهم القمعيّ العدوانيّ. بل بدأ يخطط لمعاقبتهم.
استمرت عملية مراقبتهم مدّة ثلاثة أشهر. حرص خلالها على تدوين الملاحظات في دفتر الحسابات والدّيون. دوّن تحرّكاتهم وعددهم والسّلوك الذي يتفرّد به كلّ عنصر منهم ونقاط ضعفهم ونقاط قوتهم والجهة التي يصلون منها فاختار التّوقيت الذي يصل فيه أوّل جنديّ منفردا وحيداً قبل الجميع. كل حاسّة من حواسه راقبت شيئاً وكل لحظّة من لحظاته استفاد منها حتى بات مستعدّاً للمواجهة صباح ذلك اليوم…
ما إن رأى الجندي الهزيل يتقدّم باتّجاهه من ناحية المقهى رفع طرف بنطاله الجينز، وتحسّس السّكين الذي خبّأه داخل فردة الجوارب في قدمه اليمنى. وضع الجندي قدمه فوق الكرسي الصّغير أمام علاء وراح يتمتم بصوت خفيف بين شفتيه بكلمات أغنية بالعبريّة. تظاهر علاء بتحضير علبة الدّهان والفرشاة وسحب السّكين بخفّة كما تدرّب مرارا. قفز بسرعة دون أن يعطيه فرصة لاستيعاب ما يحصل. ثم طعنه في صدره عدّة طعنات متتالية وفرّ سريعاً عائداً إلى المخيم.
كان يركض وصوت الرّصاص يلعلع خلفه وفوق رأسه.
وصل إلى ممر ضيّق في نهاية الزّقاق الفاصل بينه وبين الجامع وسط المخيّم. توقّف لالتقاط أنفاسه وإذ بصوت يعلو: تعال… من هنا… أدخل بسرعة يا بني.
التفت لناحية الصّوت فوجد إمرأة خمسينيّة أمام باب بيتها تعدّل منديلها المطرّز فوق رأسها بيد وتشير بيدها الأخرى إلى الدّاخل مشجّعة له.
أسند ظهره إلى الباب بعدما أحكم إغلاقه وبعد دقائق كان يسمع صوت أقدام الجنود في الخارج تبتعد لناحية الجامع.
التقط أنفاسه المتقطعة، كان يتساءل بينه وبين نفسه: كيف عرفت تلك المرأة أنّه مطارد ولماذا خبأته؟ تناول من يدها كوباً من الماء. في تلك اللّحظة وجد إجابة عن سؤاله إذ انتبه أنّه لا زال يحمل بيده السّكين الملطّخ بدم الجنديّ الصّهيونيّ.