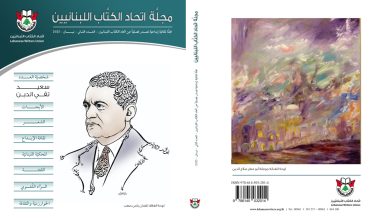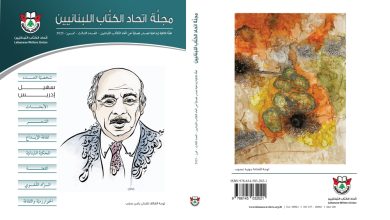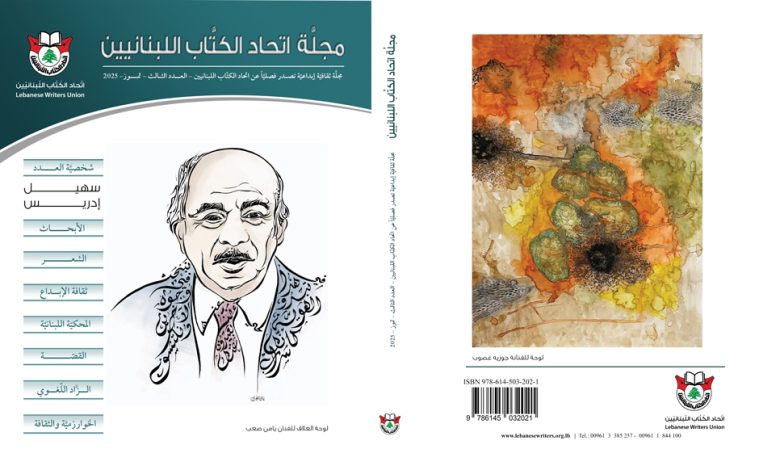
فَاعِلِيَّةُ السِّيَاقِ الشِّعْرِيِّ وَأَثَرُهُ فِي البُعْدِ السِّيْمْيَائِيِّ.. قِرَاءَةٌ فِي تَجْرِبَةِ“يُوْسُف الصَّائِغ”.
أ.د. سعيد حميد كاظم/ جامعة كربلاء- كلية العلوم الإسلاميَّة- قسم اللُّغة العربيَّة.
الملخَّص:
تصطفُّ الكلمات لتُدلي بمضمارها نحو رؤية تلتقي بمدلولاتها نحو سياقٍ كاشفٍ لتلك الدوالّ المخبَّئة؛ ليتّجه حاملًا أبعادهالرمزيَّة ذات الملامح السيميائيَّة العميقة التي تحمل ضمنًا خطاب الشاعر وأسراره التي أفرد لها مساحةً خفيَّةً تتحرَّك بهدوء نحو تكريس الواقع الحياتيِّ والشعريِّ معزِّزًا وجودهما بالقرائن والأدلَّة السياقيَّة؛ لذلك تجد تعدُّدًا في المعنى تختفي فيه الإيحاءات والإشارات فيرفدان النصَّ بالمزيد من الاحتمالات.
لذا ليسمن محدِّداتٍ للسياق مع اتِّساع المفهوم وعلاقته ببناء النصِّ، وتلك -غالبًا- ماتحكم البنية النصِّيَّة لتجعل البحث غير محكوم ببعض الاشتراطات المحدَّدة؛ لذلك تراه منتميًا إلى أصوله ليكشف هو الآخر عن رصانته إلى مزيدٍ من دوالِّه ومعارفه تارةً، وتارةً أخرى ليكون دليل الرصد إلى رؤاه مقارباته الفكريَّة والمعرفيَّة وهو يحمل تعدُّد المعاني في قبالة تعدُّد القراءة من أجل تأسيس بنية تتوالى فيها الرؤى وتشيع فيها الأفكار بانسيابيَّة يترشَّح فيها الاستدلال العقليُّ والمنطق الفكريُّ ليكون مرتكزهما السؤال المعرفيّ، وهذا ما كشف عنه البحث في اقتصار عيِّنته لشاعرٍ عُرِف بخصوبة تجربته الشعريَّة ونماء مدلولاتها.
abstract
Words align to steer their course toward a vision that meets its connotations in a context that reveals those hidden connotations; to move forward carrying its symbolic dimensions with deep semiotic features that implicitly carry the poet’s discourse and secrets, for which he has devoted a hidden space, moving quietly toward consecrating the life and poetic reality, reinforcing their presence with contextual clues and evidence; therefore, you find a multiplicity of meaning in which connotations and allusions disappear, providing the text with more possibilities
Therefore, there are no contextual determinants with the expansion of the concept and its relationship to the construction of the text, and those – often – govern the textual structure to make the research not subject to some specific conditions; therefore, you see it belonging to its origins to reveal its solidity to more of its connotations and knowledge sometimes, and at other times to be a guide to monitoring its visions and intellectual and cognitive approaches, and it carries the multiplicity of meanings in the face of the multiplicity of reading in order to establish a structure in which visions follow one another and ideas spread smoothly in which rational deduction and intellectual logic are filtered to be their basis the cognitive question, and this is what the research revealed in limiting its sample to a poet known for the fertility of his poetic experience and the growth of its connotations..
المحور الأوَّل: متاهات المعنى واللامعنى
لعلَّ من المهمِّ النظر إلى فاعليَّة السياق وأثره في تشكُّل البعد السيمائيِّ للخطاب الشعريِّ؛ إذ بواسطته تتلاقى أواصر العمل الأدبيِّ عند نقطة تُعدُّ غايةً بحدِّ ذاتها فهي الفاعل نحو التلاؤم والدالَّة على نجاح العمل الأدبيِّ، وهذا التواصل كفيل في أن يجعل العمل الشعريَّيمضي وهو يحمل سمات تأثيره، وعلامات دوالِّه، وإشارات مدلوله لينحوَ متِّجهًا نحو المتلقِّي؛ عاقدًا معه أواصر التواصل، وبهذه الغايات المتكرِّرة لا تكون علامات المعنى هي (المدلول)، إنَّما (الأساس)؛فالعلامة ترجع دومًا إلى أساس موضوعها لتفتح مضمونها نحو مداليل متعدِّدة؛ لذا انعكست فكرة النصِّ لتنفتح نحو نمطٍ مخصوص من الفهم الدالِّ على الحقيقة المغيَّبة؛ بل يفتح مجالًا للذات لتكون أمام أفق جديد يطلق عليه الفيلسوف الفرنسي(بول ريكور) عالم النصِّ وهو أفق احتمالات الفعل وإمكاناته لتطوير الفهم وبناء المعرفة الدلاليَّة، وهذا مايضعنا أمام رؤية تكشف أنَّ بين السياق والنصِّ تطابقًا في المفهوم؛ إذ للسياق قيمته في بناء النصِّ وتفسيره فيكون مؤسِّسًا للدلالة وكاشفًا عنها[1].
وفي هدى ذلك كلّه استغرق الشاعر “الصائغ” أوقاتًا في عقد الوئام بين المفارقات الضِّدِّيَّة -الحياتيَّة- التي واجهت واقعه؛ فهو يعاني فَقْدَ زوجته”سيَّدة التفَّاحات الأربع” فكان يعاقر الوجع ويعيش بواقع قهريٍّويمضي بذاكرة سلبت اطمئنانه القادم؛ لذلك كانت تضجُّ بحياةٍ من غير عافية تنحو من الذات إلى الجمعيِّ، وبالعكس حتَّىارتقى معناه الشعريُّ بتلك الرؤية المسكونة بالقلق والمناورة من الواقعيِّ إلى النصِّ فتحوَّلت من مفارقة واقع، إلى مفارقة (واقع -نص) تحمل ثيماتها ومدلولاتها، ولتكون في ضمن (شعريَّة) المكان /داخل شعريَّة النصِّ) معزّزين بجلالةالموقف وعمق الدلالة؛ فضلًا عن ذلك أنَّه يجمع بين التراث والحداثة، والمتأمِّل في منهجه والآليَّات التي يستأنس بها في تفكيك أبنية الخطابات وإظهار وظائفيتها، يدرك عمق الحيرة المعرفيَّة التي كانت هاجسًا دائمًا في حياته، كذلك يدرك ما رافقها من تأويل متحيِّزٍ إلى مرجعيَّات وخلفيَّات وضروب من الوعي أفرزتها ممارسات اجتماعيَّة.
ترجّلْ
فإنَّ القطا نائمٌ
والقوافلُ متعبةٌ
هوَّمَ النازحونَ لطول السرى
سوى فارسٍ، ما ينامُ.
وحيداً ..
يمنِّيه هذا الدجى بسهيلٍ
ترابُ …
(سهيلُ) انطفأ…
واستراحتْ على حلمٍ صهوةٌ،
وخيامٌ،
وساوسها الرملُ بينَ جفونكَ،
تعمى عليكَ عيونُ اليتامى ..
تُشيحُ العواصمُ حين تمرُّ[2].
بتلك المختصرات الدالَّة يكشف عن محطَّات وجوده التي هيمن عليها الانتظار الذي يتسارع فيه الكمد والحزن، وما يُحيط به حتَّى نجمَ القول الشعريُّ عن حداثة رؤى، ورؤية، وإيجاز يكشف علاماته ودلالاته بوعي دال؛ إذ إنَّ((الصورة الذهنيَّة التي يقابلها اللَّفظ أو الرمز أو الإشارة، ومنه دلالة اللَّفظ على المعنى الحقيقيِّ والمجازيِّ، ودلالة القول على فكر المتكلِّم، ودلالات اللافتات الموضوعة في الطريق على اتِّجاه السير، ودلالة السكوت على الإقرار، ودلالة البكاء على الحزن))[3].ولعلَّ هذه الرؤى السيميائيَّة تتماشىوما”انبثقت السيميائيَّة على أنَّه منهج نقديٌّ تتناول النصَّ بالتحليل والدراسة مع منتصف القرن العشرين… وساعد على انبعاث هذا المنهج النقديِّ الجديد انحسار البنيويَّة وانغلاقها على النصِّ”[4] فهي مسار يؤكِّد المعنى ويدعو للتواصل بما قدَّمته حتَّى”ظلَّ تقسيم موريس للسيميائيَّة إلى ثلاثة: البرجماتيَّة، الدلالة، والتراكيب، محتفظًا بمكانته؛ لأنَّه يجمع بين التواصل والمعنى”[5]، وبهذا فقد كشف سياق النصِّ الشعريِّعن إنتاج المعاني من مكوِّناتها؛ فضلًا عن تكريس وجودٍ وإرادة على ما عليهما من تحجيمٍ وأغلال لكنَّهما يتقدَّمان نحو صناعة وجودٍ ثابت يكسر القيود، ويمضي نحو أملٍ تمدُّه الذكريات بالمزيد من التقدُّم متعلّلًا بماضٍ لا يُنسى.
أرأيتِ إلى سنواتِ العشقِ،
وندّمك النسيانُ؟
خذيني الآن إذنْ،
مغترباً،
غربةَ يوسفَ في الجُبِّ،
وفي السجنِ،
وإذ تدعوه امرأةٌ في قصرِ الحاكمِ،
لكنْ …
يا يوسفُ أعرِضْ عن هذا …
صارَالسيفُ رغيفي …[6]
متوالية من الأوجاع ينظمها خيطٌ رفيعٌ من الأفراح والأوجاع في قصائدَ حملت أغانيه وشجونه؛ فكان السبيل لوصف هذا التعاقد في تناصٍ قرآنيٍّ يكشف الشاعر عن اللحظات الموجعة في سورة “يوسف” وما صنعته من غربة واغتراب سيطرا على مشهدٍ جديد بعدما كانا في وئامٍ ووفير عيش حتَّى جاءت البدائل عن غربة متعدِّدة ناجمة عن “الجبِّ” و”السجن” وصنيعة الاختيار بين الطاعة والعصيان؛ فكانت إرادة الطاعة بديلًا عن ذلك فصار “السيف رغيفه”، وبهذه العلائق المتعاقدة بين مآلات النصِّومسبغات الواقع يكون الشاعر قد منح القارئ بعدًا تفاعليًّا للفهم والإحساس، لذا كان هذا الإيجاز يفيض بموحيات تتَّسع فتخرج عن حافَّة الرسم وأسطر النصِّ المكثَّف الوجيز، بحيث تنمو في مخيلة المتلقِّي صور المعنى ودلالاته على الرغم أنَّه (رآها) مرسومةً أمام مقلته، بصريًّا وقرائيًّا. وتتَّسع آفاق النصِّ الشعريِّ لتخبِّئ أسئلتها الوجوديَّة والجماليَّة بما يتيح للقارئ الإمساك بها والظفر بمدلولاتها، ولعلَّ الشاعر على مقربةٍ كبيرة من مقصدياتها حين أضفى المعنى على المعاناة وعمل على الإحاطة بماهيَّتها لتدلوَعن مقاصدَ أخرى أكثر تأثيرًا من سابقاتها، ممَّا جعل المعنى – على وفق رؤية غادامير- يسلك سبيل الكلِّ تبعًا للأجزاء أو تفسير الأجزاء بناءً على الكلِّ؛ إذ أضحى تأويل النصِّ تبعًا لما أسماه “حلقة التأويل” كون الإيجاز يقتضي تكثيف الحالة، وتوسيع أفق العبارة، والدوالّ، إنَّها تكشف عن عناصرَ، علاماتٍ، علاقاتٍ، أوسعَ من مدارها الظاهريِّ، هو كلُّ ما تضمَّنته علامته من الوجهة الدلاليَّة.
تنبضْ في رَحِمِ الأرض خبايانا:
خبأنا الحجلَ تحتَ الرملِ،
قلنا يورقُ الزيتونْ ..
تعالوا أيُّها الأحباب
عندي قمرٌ مدفونْ …
يرافقني في المنافي ..
يباركُ لي قلقي واعترافي،
رهنتُ له فرسي وعقالي،
وساومتُ بينَ الهدى والضلالِ
وقالوا: ترجّلْ
ترجّلتُ …
كان القطا نائماً،
والندى فوق سيفي.
مسحتُ الندى بثيابي،
عبرتُ إلى جسدي…
ورأيتُ منازلكم[7]
لقد حسم (الصائغ) انشغالاته وبحثه في معضلاته وخياراته، وهو أمر قد يبدو خارج النصِّ- تلك الانشغالات التي اتَّخذت (شكل): قصائد غائمة، مليئة بالغربة، سود، متردِّدة، معزولة، قصيرة النفس، لكنَّها فنطازيَّةيتعالق فيها الواقعيُّ بالحلم في صورةٍ يكتمل فيها الإيجاز، وفي رؤيةٍ شعريَّةٍ فيها تضمين حكائيٍّ وجيز، مكثَّف، دال، على ما ساوره من همومٍ، وعلى وجيب قلبه؛ كلُّ ذلك بسبب حزنه على فَقْد حبيبته حتَّى شعر بفراغ فؤاده، وهو إنَّما يستنطق البنية الكلِّيَّة الإجماليَّة لتنمو بصيغٍ محتملة لا تحصى دلاليًّا ويقدِّمها برؤيةٍ ذات بنية ذهنيَّة قابلة للتأويل من داخل النصِّ وخارجه في ضمن احتمالات متعدِّدة لقراءات متعدِّدة تكون بأقلّ ما يمكن من (تفاصيل) وأوسع ما يمكن من آماد تأويليَّة وموحيات، وتلك مبتغيات الرؤية السيميائيَّة وهي تعوِّل على العلامات واستعمالاتها، إذ “درسنا في السيميائيَّة العلامات واستعمالاتها في النصِّ، لتصبح أداة لفهم العمق الدلاليِّ المحتوى والمضمون”[8]، فالشاعر فاقدٌ لقمره الذي هو آخر الأنساغ وأوَّل القادمين في وجوده الحياتيِّ، ولعلَّه يتقلَّب بين أضمار الحزن الخفيِّ وإيقاعات الشجن المستديمة حتَّى خلُص لواقعٍ عرف أسراره وأتقن لعبة الموت التي اختارت رفيقة دربه لتكون- قهرًا وقسرًا- في ضمن هذه اللُّعبة التي جعلته في حيرة الواثق، ووثوق الصابر المتمسِّك برفيقه، فقد ترجَّل مرغمًا ونزل كبريائه، وبدت بوادر الصدأ على سيفه حين علاه الندى؛ وهو ينظر إلى القبور بخطابه (منازلكم).
وممَّا يمنح النصَّ الشعريَّ دلائل حيويَّة أنَّه يهجس بصمته وبوحه بروح غنائيَّة تحمل المعنيين معًا سرورًا بالماضي الذي كان يجمعهما وحزنًا بحاضرٍ شرخ هذه العلاقة على نحوٍ غير مرغوب به، بمعنى أنَّ مفهوم المدلول- هنا- هائل الاتِّساع والإفاضة عن تلك الرؤى، أمَّا النصُّفهو يمتلك التساؤل الدائم، وفي اجتماعهما لن تحيد رؤيته عن منهاج واقعه اليوميِّ الثابت والمتحوِّل،وبهذا تعدَّدت تفاصيل النصِّ الشعريِّ على نحوٍ دالٍّ حتَّى بانت تمظهرات السؤال المعرفيِّ في مضمرات خطابه، وكان الدالُّبالكشف والتحليل لاستنطاق النصِّ اللُّغويِّ والأدبيِّ لبلورة رؤية معرفيَّة دائمة الإيحاء إلى الفكر نحو تأسيس خطاب مختلف يؤمن بروح المغايرة ويشي بالروح التجديديَّة؛ قاصدًا السبيل نحو ثيماته ودلالاته وتشكُّلاته التي تتعدَّد فيها الاحتمالات نحو بنية تتوالى فيها الرؤى .
ومن يتردّدْ، إذا هَمّتِ الريحُ،
يُصلبْ إلى ذلّهِ، وتقطعُ أرجلُه من خِلافٍ،
ويُرمى لسبع الفلا
ومن يَحُنِ الريحَ …
سدّوا المنافذَ
ولتنظروا في الوجوه،
وجسّوا الجلودَ، وجسّوا العيونَ،
وجسّوا الوجيبَ،
وجسّوا …
وجسّوا …
عسيراً ولا تغفروا ..!!
آذن الصبرُ للمنتهى !!![9]
فدلالة الريح الصرصر العاتية التي عُذِّب بها الأقوام الغابرة، والصَّلب من خلاف كان خاصًّا بعذاب فرعون للناس فضلًا عن ساحات الأسود عند الرومان وغير ذلك، فما كان من الشاعر إلَّا أن يذكر العذابات كلِّها في قبالة الدعوات التي دعا بها الأنبياء أقوامهم فكانت لهم النذر من هول العذاب وشدَّة المعصية، وفي هذا كلِّه إنَّما يكرِّس الشاعر أنَّ هذه العذابات كانت سابقة لمن يريد الاهتداء وليست واقعًا مفروضًا أو نتيجةً حتميَّةً سواء أهتدى المنزُّ منها أم لم يهتدِ.
ولعلَّها تأتي نتيجةً أهون بكثير من ورودها سببًا من دون سابق إنذار، ولعلَّه اضطرم بنارها وكانت اختيارًا له من دون أن يكون مخيّرًا.
المحور الثاني: الموجزالشعريُّ الدالُّ نصًّا حكائيًّا
وإذا كان الشاعر يدفع الموقف إلى نهايته”نحو صراع مفروض على واقعه، إذ لا يستطيع أن يحيد عنه، وبهذا جعل مسار النصِّ يتَّجه إلى “المتأمِّل”، وهي ثنائيَّة مزدوجة، تقابليَّة، وإن لم تكن تضادِّيَّة؛ كونه يحفر في عمق المأساة كي تندمج بأسطرة “الشخص” وأسطرة “الحالة” وأسطرة”الزمن”، وأنَّ مفردة “وجسّوا” -وحدها-مفردةً ومسمًّى- تسوِّغ لنا التأويل بصوتها الخفيّفالمفردة، استدعت عمقًا آخر، ففاضت عن حدود النصّ، وجعلت القارئ المساند يستغرق في استذكاراته؛ لأنَّها “مرجعيَّة” النصِّ الشعريِّ يتَّكئ عليها كأنَّها “وثيقة” وهكذا يتحصَّل لنا، من إيجاز عالٍ، متَّسعة من الدوالّ والمعاني، بل متَّسعة من السرد والحكايات، لذلك عمل على تكريس الإحالات والإشارات معزّزةً بالرموز والأساطير وأحسن في إعادة صياغتهما، ولعلَّ المطَّلع على نصوصه الشعريَّة يلمس بوضوحٍ أنَّ الشاعر قد مدَّها بالأفكار والحدوس التي عبَّرت عن وعي كلّي فيما كانت تنمو نحو أفكار جديدة ومواقف مستقبليَّة.
فتح الحارسُ لي …
ها أنذا أدخلُ مملكةَ البحرِ،
وأوغلُ، يتبعني نجمٌ،
يدنو مني،
يتدلّى ..
فيكادُ يمسّ الأرض ..
توسّلتُ به:
– يا نجماً أبيضَ فوق خليجِ البصرةِ،
أقسمتُ عليكَ ثلاثاً:
بالمنفى ..
بحنينِ الموتى ..
وبأمواجِ “بويبْ”
إن كنتَ لخيرٍ جئتَ .. فقُلْ:
بعد قليلٍ، سوف يصيحُ الديكُ
ويُستدعى الأمواتُ إلى المثوى.
أو كنتَ لشرّ …
يا شبحاً فوق خليجِ البصرةِ
عُدْ للبحرِ،
شرورُ مدينتنا تكفي ..
انّا ابتعنا بالخيبةِ خُبّازاً،
ودماً[10]
يثني الشاعر بأمورٍ؛ وكأنَّها أنساق ثقافيَّة موزَّعة يلمحها القارئ ذو البصيرة؛ يستدعي بها المتلقِّي إلى مشاركته همِّه؛ لذا جاءت الأفعال التي استعملها في نصِّه تدلُّ على الفتح والدخول والإيغال والمتابعة والدنوُّ والتدلِّي وأخيرًا انفتاح بصرِهِ على الخليج الكبير (خليج البصرة) الذي ناغمه السياب وهجس بصوته فكان صداه يملأ آفاق هذا الخليج، ولعلَّه يشارك صاحبه على ما عاناه من فقدٍ داعيًا المتلقِّي إلى أن يشعر بما شعر ويلامس موضع الجرح،وأنَّما يعيد للشاعر صبره مواساة الفاقدين وما يخفِّف وجع الحزن عنده التأسِّي بالماضين فلقد تشبَّثوا ببقايا لم تنفع لكنَّها كانت خلًّا لهم في زمنٍ تعسَّر حضور الأقربين، فهذا الفقد ألهب روح الشاعر وجعله في هيام يلاحق بقايا النجوم لاحت لناظره على صفحات البحر لتبدأ تلك المناغمة بين حزنه والنجم الذي اقترب منه متبادلًا معه الحوار الذي وجد فيه الشاعر “الشفيع” لروحه الفاقدة ولحياته التي تعيش الوحدة، وما جاد به المقطع الشعريُّ في أعلاه يكشف عن انفتاح السيمياء على (بويب)السيَّاب، وما كان يعاني من ألم موت أمِّه وهو صغير، فضلًا عن رؤيته عددًا من الذين عرفهم في عالم الدنيا، وهنا يزداد الألم عند الشاعر؛ فيأمر ذلك الشبح بأن يعود إلى البحر لعلَّه يُغرق همومه التي تكاثرت في صدره كأمواج البحر.
ويمضي الشاعر متسائلًا عن هذا القرب بين الحزن والنجم الذي لاح على صفحات البحر –الذي يرجو منه أن يكون مقربة وداد- ومقدِّمًا تساؤله بقسمٍ جمع الثالوث”المنفى” و”حنين الموتى” و” أمواج بويب” متوسِّلًا بمن سبقه بالوجع حتَّى وجَّهه لـ”سيابه” الذي طال انتظار وجعه ولازمه حتَّى الرمق الأخير وربَّما خلد بعده حتَّى وُسِمَ به، وبهذا إنَّما يجمع بين الجمال الفنِّيِّ والعمق الفكريِّ.
وممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّالشاعر يخوض بمسارات لا تبتعد عن دمج الواقع باللاواقع بنفس صوفيٍّ مع كثافة عالية في الحسِّ، بل راح يحدو في إضفاء اللاشعور على فكرة النصِّل تنماز بشعور آخر يجمع بين تصديق الواقع وتكذيب القادم، لذا نحا نصُّه نحو مقصدٍ يُتيح “مسافة تخييل” تجمع بين الواقع والقدر في صناعة واقع جديد بوصفه واقعَ حالٍ، وبهذا أبدع في صناعة صورة شعريَّة تحاكي ذلك ومن يتأمَّل نسج حرفه الشعريّ ينتهي إلى أنَّه الرسَّام الماهر الذي يملك أدواته الفنِّيَّة في الكشف عن واقع شعريٍّ مصداق للوحة تشكيليَّة شاملة لكلِّ التفاصيل.
ولم يكتف الشاعر بذكر لفظة(شبح) بل وصفه بالأبيض؛ ليجعله مقابلًا ضدِّيًّا لِمَا في نفسه من سواد الهموم؛ الذي كان في الليالي الثلاث، وهذا الشبح يراه الشاعر ملفوفًا في كفنٍ، وهنا تتَّضحُ دلالة اللون؛ فاللون الأبيض واللون الأسود يتجاوبان في حركة متناسقة كحركة الشبح، وما بينهما اللون الفضِّيُّ المتكوِّن من امتزاج اللونين الأبيض والأسود، وكلُّ ذلك مع اختلاط الفرح بالحزن وما بينهما يكون هنالك امتزاج واضح للحالة النفسيَّة من حيث الرعب والخوف والغضب، ممَّا يدلُّ على نفس الشاعر التي لا تهدأ حين فَقَدَ ذات التفاحات الأربعة كما في قوله:
شبحٌ أبيضُ عندَ خليجِ البصرةِ،
شاهدهُ الحرّاسُ، ثلاثَ ليالٍ
يخطرُ ملفوفاً في كفنٍ،
فارتعبوا …
قال الأوَّلُ:
إنِّي شاهدتهُ في ساعاتِ الليل الأولى،
وعلى عينيه أسىً كالفضّةِ،
مَسّتْني في القلبِ،
فخفتُ، وأغمضتُ عيوني ..
قال الثاني:
وأنا شاهدتُهُ، في منتصفِ الليلِ
على بُعدِ ذراعٍ مني ..
كان يحدّقُ بي غضباً:
نَدّ لهُ شعري ..
فسقطتُ على وجهي مغشيًّا ..
أمَّا الثالث، قالَ:
أتاني، والفجرُ يكادُ،
رأيتهُ، عند الأفقِ الشرقيِّ
يُشير إليّ: تَقدّمْ ..
فتقدَّمتُ ..
وإذْ قاربْتُهُ،
صاح الديكُ، وغُيِّبتِ الرؤيا ..[11]
وما بين شاهدة المغيَّب وحرارة الفقد يغوص الشاعر في أحلامه قاصدًا سبيل فقيدته التي أشغلت كيانه ومدَّته بشتَّى أسباب الوجع فكان يمارس بين يديها “اعترافات مالك بن الريب” طالبًا منها أن تشاطره هذه المراثي بعدما كانت تشاركه الحياة، وهذاما اعتاده عنهاحتَّى يلاقيَ مصيره بنفسه بعيدًا عن شريكه الحقيقيّ الذي كان يقاسمه نسيم الفرح ورغيف القحط حتَّى مضيا يقارعان الطارئ معًا في مواجهة صامدة، ولعلَّ هذه الرؤية الشعريَّة قد توزَّعت على رؤى مقسَّمة لم تمنحه أيَّ خيار سوى الرعب من الفقد الذي طرأ عليه، ثُمَّ إنَّه تشبَّث بقوله الشعريِّمناغمًا وجوده ومطلقًا العنان لصداه في الآفاق لعلَّه يهمس في آذان المفقود فيعود له لكن ليس ثمَّة جدوى، حتَّى تمسَّك الحلم الثالث الذي أباح له اللقاء به مع بزوغ الفجر ليعقد صورةً مشرقةً لهما لكنّ هذا اللجوء الأخير أوصله على مقربة ممَّا يطمح ويرجو حتَّى استفاق على غير ما يطمح؛ لذا سلَّم إلى واقعٍ ختم مصيره بهذه النهاية.
وبذلك، لم يجعل العتمة تهيمن على مقارباته حتَّى تضيء الأحلام نصَّه، فكانت مكانة الإيجاز، وبلاغته في بساطته، ليس في نيَّاته، بحسب كذلك قدم (قصَّة شعريَّة موجزة)، تحتمل الكثير من “الحكايات” عن نفسه، عن (علاقة) النصِّ بــ “السيَّاب البصريِّ”، وثريَّاه المضيئة المليئة بالصمت والصخب والتساؤل ممَّا يدعو للتأمُّل فهنالك غربة الروح وغربة المكان عند مالك بن الريب الذي ندم على أنَّه التحق بالجيش وترك حياة الصعلكة؛ وبين غربة السيَّاب ومرضه المزمن وحياته التي علاها البؤس والقهر، إنَّها مزيج من الأمل واليأس، من الخوف والرجاء، إنَّه مزيج من الليل والنهار، ومن الغياب والحضور.
بهذا المعنى، يكون عمق (المسمَّى) ودلالتهفي قصائده، مرتبطًا بمقصد النصِّ وتوجُّهاته حتَّى يتجاوز فيه الرؤية الأولى، وإنَّما يكون بالتعاون مع القارئ المساند للحكاية الشعريَّة في النصِّ، وهذا ما يبرِّر لنا الحديث عن فيوض النصِّ/ وإيجازه، ولعلَّ ما يصطلح عليه (جيرار جينيت): بـ “الشعر الخالص” (المحتشم/ والفاعل هو ما ينسجم وتطلُّعات شاعرنا الذي تنفتح رؤيته على فضاءات تحتفي برمزيَّة عالية، وما بين الحسِّيُّ والرمزيُّ والواقعيُّ وغير الواقعيِّ يظلُّ الشاعر عصيًّا على المصالحة والاحتواء؛ وهو الذي له وجهة نظر مختلفة عن كلِّ القناعات السابقة التي صارت آراءً -فيما بعد-قابلة للأخذ والعطاء والقبول والرفض، كما كان له اختياره في صناعة واقع شعريٍّ يُتيح مساحات أخرى للمتلقِّي في كلِّ شيء، إذ يمكنه إعادة صياغته، داخل “واقع -النصِّ” في متواليات لا نهائيَّة من الإعادات، الإضافات، أو الترتيب لواقعيَّة الواقع بفيوضات ذهنيَّة /أو مخيَّلة، بلذَّة قراءة نصٍّ محتمل، جديد، أو بوجدان قراءة، يمكن أن يستشرف الواقع ويعمل على صياغته، وتلك إضافة ساندة إلى المعنى، وإلى النصِّ في آنٍ واحد، ولعلَّه يضفي واقعًا جديدًا لحيوات ممكنة يحييها المعنى بديناميَّة اللُّغة في مستوياتها الرمزيَّة، وبهذا ضمن وجود المؤتلف والمختلف في نصِّه الشعريِّ وسعى إلى إتمام رسالته في الشعر والحياة.
تلك الكلمات رسمت طريقها على ضراوة الواقع فكتبت وأرادت لرماده أن ينبعث عنقاء من تراب ليعانق الوطن الأرض والإنسان، وهكذا تختار لروحها زمنًا خاصًّا كيما تحلِّق فريدةً، وتعرج إلى ملكوت الإنسانيَّة فتخاطبها بهدوء وسلام.
وهكذا تمضي لتخاطب ضمائرنا بروح إنسانيَّة سامية مثلما تخاطب المثكول بفقده فيهجع خاطره لصدق ما تجود به، لتنبجس كلمات قصائدها في مظهرٍ أسمى، وفي رؤيةٍ أخرى تكون صاخبةً ومحتدمةً في جوهرها.
بحسب (شكلهم) و(تشكُّلهم) في النصِّ.. لكنَّهم، جميعًا، كأنَّهم -هم- في الواقع!
التي تتمحور حول تجسيد هموم الحياة ومعاناة عامَّة النّاس برؤىً تسمو إلى توظيف الحبِّ والجمال بدلالاتٍ تشكَّل صورة البحث عن الوطن والحرِّيَّة والكرامة والسلام.
وسرْنا خلفَ جنائزنا.
تتبعنا البصرةْ
حتَّى أوفينا … جيكورَ،
قرأنا اسمك محفوراً في صخرةْ
“قرأتُ اسمي على صخرةْ ..”
“على آجرّةٍ حمراءْ …”
“هنا في وحشة الصحراء ..”
“فكيف يحسُّ إنسان يرى قبرهْ؟”[12]
والسؤال (عكس الحداثة) في مفارقة قراءة النصبمحاورة قالت بها تجربة الشاعر بالاستعانة برؤيته التي أتيح له أن يرى قبره وأن يتأمَّل تلك الخطوات اللاحقة وأن يشهدَ برزخها ليشعر بطعم الحياة وحقيقة الموت، ممّا يجعل (النصّ) خارج قيود الواقع؛ أي :يتيح الانتقال من وقائعيَّته إلى (واقعيَّة -النصّ) وهو يحمل المعنى وضدَّه، وكأنَّه “وثيقة” النصّ، مسندة بـ “تعزيزات معلوماتيَّة” شاملة للوجود وما بعده.
تتشكَّل (الوقائع) و(مشابهاتها) في ذهن الشاعر، بمساعدة تخييل كي تحلَّ في النصِّ؛لذلك ينسج فيه دلائل تنفي (موته) بمعنى: نسيانه، وتؤكِّد (موته) بمعنى: حضوره الآخر (في النصِّ)! إنَّها مفارقة فهم الموت والغياب، بتأكُّد الحضور، وإحياء الحادثة، ولعلَّه في إيراد الحدث وضدِّه والواقعة ونظيرها إنَّما هو الجنوح إلى الذكرياتوالحبِّ والتمسُّك بهما على الرغم من امتداد مساحة الألم، لكنَّ محاولاته تظلُّ دائمًا في تمرُّدٍ واضح حتَّى إنَّه يبزغ ليكون الظلَّ الآخر لمسك ورقة الاحتجاج على كلِّ مايحزن وعلى الحياة نفسها، على أنَّهناك الظلُّ الخفيُّ بين هذين الظلِّين الضاغطين على نفسه المتعبة وروحه الحزينة، وهوالظلُّ المؤمَّل الذي يكون في عالم آخر بعيد عن المآسي والقسوة والظلم، وهو ظلٌّ خارج نطاق هذه الكرة الأرضيَّة تنتفي فيه كلُّ الضغوطات إنَّه عالم النقاء الذي يجمع الأرواح النقيَّة.
ولعلَّ ركيزة خطابه إنَّما تكشفها نفحات قوله الضامر بالحزن عن فقدٍ أفل ضياؤه قبل أوانه، وهو المبعث الذي لن يهدأ مع تقادم الأيَّام، فكيف لقرين الروح أن يغادر بصمت مفجع على حين يجلب التفاحات التي اختارها بمقدار عديد عائلته حتَّى ثُكل بحادثٍ أسقط هذه التفاحات وقطع شوطًا عظيمًا في ميدان الوداع ليكون الأقرب من عالمها المتعاقد معه في حضور يحيي أوَّلهما الآخر؛
فكيف وقد حلَّ القدر بديلًا
قبلَ قليلٍ،
جاءتْ سيّدةٌ،
وابْتاعتْ أربعَ تفّاحاتٍ،
أربع تفّاحاتٍحُمرْ.
ورأيناها، تمضي مسرعةً،
نحو القفرْ[13]
ويرجع بنا الشاعر إلى سيميائيَّة اللون، واللون هنا هو اللون الأحمر، إذ ينبجس في ذهن المتلقِّي دلالة الدم ودلالة العاصفة التي تحمل الغبار الأحمر ليربط بذلك دلالة الدم الذي أفجعه حين سال من زوجته على إثر الحادث حين سُفح على الشارع الأسود مع التفاحات الأربع الحمراء ثمَّ يأتي اللون الأبيض الممزوج بالحشرجة الصّامتة ليكون طريقًا إلى الموت الأسود، وكلُّ هذه الدلائل بانتقالها من لون إلى آخر إنَّما يكشف الحركة الزمنيَّة التي تسلسلت لمنح روحه من وجودها وذكرياتها ثُمَّ لفقدها ثُمَّ لذكرياتها فقط، وهذا المسار أخذ من الشاعر مأخذه وألقى ركامًا من القهر في وجدانه، إذ يكمل قصيدته قائلًا:
كانت تضحكُ ..
تضحكُ،
والتفّاحاتُ الأربعُ،
تكبرُ
تكبرُ …
ثمّ انقطعَ الضحكُ،
وأعقبه صوتٌ أبيضْ
ورأينا التفّاحاتِ الأربعَ تسقطُ،
فوق الأرضْ
أربعُ تفّاحاتحمرٍ
أربعُ ضحكاتٍ
وانقطعَ الصوتُ
وسادَ الصمتْ
….. …..
اصغوا ..
سيّدة التفّاحات الأربع
تضحك بعدَ الموتْ[14]
بهذا التسلسل الشعريِّ الذي شكَّله الشاعر كانت خلاصة الفقد التي تحوَّلت فيه الأماني إلى ضياع، والحياة إلى موت؛ لذا تضمَّن خطابه مفهومي الحياة والموت، وهو في تكريسه هذا إنَّما يمثِّل ردَّة فعل الذات داخل مجالها.. إنَّها أشكال انبثاث الواقع في الوعي، أو لحظات صياغة هذا الواقع داخل أطر التصوُّرات المطروحة بأشكال فنِّيَّة تؤلِّف الأحداث مضمونها بصور متعدِّدة؛ وبهذا تركَّزت رؤيته كاشفةً عن مدى معرفة المضمر في هذه العناصر ومدى قدرته على كشف الخفايا الدالّة.
ولا يخفى أنَّ للمتلقِّي حضورًا كبيرًا في الكشف عن المعاني بل يُعوَّل على وعي القارئ في درجةٍ من الحضور والكثافة التي يمكن أن يصلَ إليها في كشف أيِّ متتالية شعريَّة تحمل معها دلائلها بالمعنيين الظاهريِّ والمخفيِّ على أن تظلَّالصورة الشعريَّة تشكيلًا ملغّزًا يحمل تعقيدًا؛ كونها تتشكَّل من عناصر الواقع، والفكر، والعاطفة، واللاشعور، واللغة التي يصهرها خيال الشاعر، ويُخرجها في حلَّة جديدة مغايرة لملامحها الأساسيَّة، هذه الحلَّة الجديدة هي نتاج جديد لما ذُكِرَ .
ويبقى السؤال مرتكزًا مهمًّا يدور في حلقات التجربة الشعريَّة للشاعر؛ كونه ملمحًا أصيلًا يكشف سمات النصِّ الشعريِّومآلات الشاعر في صوره المتعدِّدة، ولا نعدم أن نجد بعض النصوص الشعريَّة للشاعر ما لا تحتاج إلى عميق تأمُّل، ودقَّة نظر وتأويل؛ لأنَّها واضحة المعنى، مكشوفة الدلالة بسبب لغتها التي لا تحتمل تعدّدًا للقراءات، بل هي ممَّا تستنفده قراءة عابرة، إذْ تساوي ألفاظُها معانيها، ولا تكتسب معنًى جديدًا يتحقّق بالتشكيل الشعريِّ الذي ينأى بها عن معانيها المحدَّدة، وليس ثمة ما يبرِّر القول سوى وصول الشاعر إلى محطَّة مهجورة لا عود فيها ولا ذهاب؛ ولعلَّ هنالك قصديَّة واضحة تدعو المتلقِّي إلى تحسُّس عمق التشتُّت والتلظِّي لنفسٍ أُضرمت في ثناياها نار الفقد، لكنَّنا لا نعدم-أيضًا- أنَّ غالبيَّة تجربته الشعريَّة كانت على مستوى عالٍ في صناعة المفردة الشعريَّةوعمق معناها.
إذ لا يخفى – أيضًا- أنَّ الكتابة الأدبيَّة في مفهومها فعل جسديٌّ ينبني على فاعليَّة الذهن في ممارسة عمليَّة الوعي والإدراك فما يتحقَّق إخضاعه للوعي، والإدراك يثبت لغة حين يتعلَّق بالذاتي في صيغته المحضة بما يمثِّل الخارج في تفاعلات صراعاته ويحدث في سياق عمليَّة الإنتاج الجمعيِّ بين (الذاتيّ/ الداخليّ، والآخر/ الخارجيّ)؛ لذا ظلَّ السؤال مهيمنًا يتخطَّى العبارات الشعريَّة ويندمج في تفاصيلها.
يبتدي الحبُّ .. بالأسئلةْ ..
ينتهي ..
ويظلُّ السؤالُ،
بدون جوابْ ..
ونحنُ،
نفتّش في الكلماتْ ..
وبين الأصابع .. والذكرياتْ ..
فما بين أسئلةٍ في الضميرْ ..
وأخرى تشاركنا في السريرْ ..
نزيد عذاباً ..
ونزداد حبّاً ..
إلى أن
يجيءَ
السؤالُ
الأخير …![15]
ولعلَّه بسؤاله الأخير إنَّما أجهش باكيًا، خالعًا حكمتَه، نازعًا تجلَّده، ولم أره يبكي على هذا النحو في تفاصيل تجربته الشعريَّة! فلقد حلّق في مرايا الذاكرة، وأقتحم أقبية العزلة القاهرة، وأجمع من بقايا الذكريات ما فرّقتْه الأيَّام، ليظلَّ مدينًا لفقيده بتفاصيل ظلَّت تحمل أسرارها العنيدة ولم تمضِ نحو بقاع بعيدة عن مساحة وجوده، ولعلَّها تضطرم في وجدانه بين الآونة والأخرىتقف على تخوم البدايات، وتتذوق فطرتها السليمة؛ممَّا يدفعه إلى التساؤل الدائم ما فتئ محاصرًا بواقع الموت الذي لا مفر منه، ولعلّها صورة أخرى تعكس روح التحدِّي التي تميِّز شعره.
المحور الثالث: تشظِّي الذات وجُرأة التمرُّد الفلسفيِّ
عاشت الروح انقسامات توزَّعت على مدارات متعدِّدة، لكن الروح الشاعرة استطاعت أن تعيش في فضاءاتها وأن تحقِّق التوازن بين الممكن وغير الممكن لصناعة واقع جديد يعمل على تقليص الفجوة الفاصلة بين “المعرفة”و”الحسّ”؛ لذلك فالمتلقِّي على مقرُبة من مضمون النصِّ الشعريِّ لمعرفة ما يحسُّ به الشاعر وإحساس ما يمرُّ به، ولعلَّواحة من ممَّا تحتفي به السيميائيَّات أنَّها تحتفي بالسيرورات التي تقود إلى المعنى وتكشف عنه بما يُخفي وليس بما يُكشف ويوضِّح فحسب؛ لذا فإنَّثمَّة جليسًا آخر يمتلك قدرة التأثير المباشر على الذات وليس بوسعها التخلُّص منها؛ كونها حاملةً لآثار معنويَّة بالغة الخصوصيَّة ألا وهي تعالق تلك الذات بمصدر وجودها مع الآخر(سيِّدة التفاحات الأربعة) الذي غدا هو الآخر يشكِّل هيمنته على الذات لتعود مرةً أخرى إلى الانصهار وهي التي تحول من دون نسيان صانعةً بفقدها مرارةالغيابِ ومشكَّلةً آصرته الكبرى، وهي القرين الذي يصاحب الذكرى من أسًى.
وعلى النحو ذاتهومع شموليَّة النصِّ-بتفاصيله المتعدِّدة- تظلُّ أشعاره وثيقةً لا تُختزلُ في جمالِ ألفاظِها أو إتقانِ صورِها، إذ تتحوَّلُ الكلماتُ إلى ألغازٍ تَستفزُّ العقلَ، ولعلَّ القارئ وهو يطالع هذه التفاصيل ينتهي في تأويل بعضها إلى ما يراه “نيتشه” الذي عدَّالتأويل هو الدالُّ الوحيد على جواهر الأشياء، وذلك في قوله: “لا وجود لحقائق بل لتأويلات فقط” أيْ إنَّ الرؤى الشعريَّة المتنوِّعة في نصوصه الشعريَّة إنَّما ترتبط بالحقائق التي يُريد الشاعر الإفصاح عنها وبفلسفة الشاعر الخاصَّة به لينجم عنهما شخصيَّته الأدبيَّة وعمق تأثيرها في المتلقِّي،أمَّا البديل المفاهيميُّ الّذي وسمت به سوزان التأويل فهو قولها: “التأويل هو ذلك الفعل الذهنيُّ الواعي الذي يجسِّد نظامًا معَّينًا، وقوانين تأويليَّة معيَّنة” وهو بما يبحث عنه “بورديو” بوجود منطقة وسطى لا ينفلت فيها التأويل ليصل إلى درجة متعالية من الفوضى والعبث الذي يهشِّم بنية المعنى وتعبث بقصديَّات الذات، فتأويلات النصِّ وتعدُّداتها متعلِّقةً أساسًا بمؤهِّلات القارئ أوَّلًا، وأنَّ التأويل شرط لازم للقراءة والنقد على السواء، ولكن وفق شرط سيميائيٍّ يسمح بتعدُّد القراءات تحت سقف واحد من دون جنوح أو عبث أو فوضى تضرب مركزيَّة المعنى، هنا يحدث نوع من التماس مع القصديَّة النَّصِّيَّة وتشظِّياتها في بنية النصِّ، وتنفتح حركيَّة التأويل في مسارات ذات صلة وطيدة.
ومن يتابع حركة المسار الشعريِّ في مجموعات الشاعر الشعريَّة يلمحأنَّ(الصائغ) يحترف الإصغاءَ، ويجيد طرح الأسئلة، يتمتَّع بهدوء فنِّيٍّ، بل هوَ مرآةٌ عاكسةٌ لِأزمةِ واقعه في ظِلِّ انهيارِ مشواره القادم الذي تسبَّب به القدر؛ فكان يَحمِلُ دلالةً رمزيَّةً مُتعدِّدةَ الطبقاتِ تكتنزُ بذورَ ثورته الفكريَّةِ، ومعلنةً حالة التمرُّدِ الخفيِّ حتَّى يتحوَّل الحزنُ الفرديُّ إلى تأمُّلاتٍ في قسوةِ الموتِ وعبثيَّةِ الحياةِ، وكأنَّ الفقدَ يُذكِّرُهُ بأسئلةٍ كبرى لن تفارق وجدانه، وهي رؤية تُؤثِرُ العزلةَ التأمليَّةَ، وهذه النزعةُ ستتطوَّرُ لاحقًا إلى فلسفةٍ مُتشائمةٍ رافضة:
أنا لا أنظرُ
من ثُقب الباب
إلى وطني …
لكنْ ..
أنظرُ، من قلبٍ مثقوبْ
وأميّزُ،
بين الوطن الغالبِ،
والوطنالمغلوبْ …[16]
فأيُّ وطنٍ! يفتش عنه الشاعر في ظلِّ ما اشتبكت عليه من أسنَّة الوجع، وكيف له أنْ يكونَ في ظلِّ واقعٍ فرض عليه وجوده، فهل يسلّم لمعطياته أم يبقى في مواجهة تُستعصى على الاستسلام، ولعلَّ من بين ما تناوله الشاعر باستمرارٍ هو أنَّ الفراق والفقدان نتيجة لمرور الزمن يمكن أنْ تؤدِّيَ إلى مشاعر العزلة والوحدة، ومن بين مضمرات السياق يُبرّز “الصائغ” الصراع في حتميَّة الفناء، إذ تُعدُّ موضوعات الزمن والمصير من المحاور الأساسيَّة التي يختبئ فيها المعنى الموضوعيُّ، لكنَّها تختلف عنها في أنَّها تدعو إلى موقفٍ إيجابيٍّ تجاه هذا الغياب، حيث يرى “كامو” أنَّ الإنسان يمكن أنْ يعيشَ بكرامة رغم إدراكه لعبثيَّة الوجود؛ إذ إنَّها تعنى أكثر بالسؤال الوجوديِّ الأخلاقيِّ أكثر من السؤال الفيزيائيِّ، وكلُّ ذلك صبَّه في قالبٍ ينطلق من الضيق إلى السعة من حيث ثقب الباب الصغير إلى الوطن الواسع المغلوب ولكنَّه في الوقت نفسه غالب يتحوَّل إلى مغلوب ليحيل الشاعر فجيعته من الخبر الذي طعنه في قلبه فغدا ثقبًا تفاقم حجمه إلى حجم الوطن الذي أكل أبناءه فغدا في حزنٍ مغلوبٍ عليه.
” إلى أمّ الشهيد في نصب الحرية”
الليلةَ،
قبل طلوع الفجرْ …
نزلتْ من نصبِ الحريّةِ،
خمسُ نساءٍ ، في مقتبل العمرْ ..
يحملنَ شموعًا، موقدةً للشهداءِ ،
وللأبطالِ أكاليل الزهرْ ..
لم يبقَ على النصبِ ،
سوى تلك السيدة الثكلى ،
تمسح بالزيتِ ، وبالطيبِ ،
عيونَ القتلى ..[17]
ولا يُغفلُ الديوانُ الجانبَ الإنسانيَّ، ففي وصفِهِ لِمعاناةِ الفقراءِ والمهمَّشينَ، تظهرُ نزعةٌ تعاطفيَّةٌ نادرةٌ في شعرِ ذلك العصرِ، فكلماتُهُ تُلامسُ الوجع المستديم بِمهارةِ على أن يبقى نصًّا مُحاطًا بِغموضٍ مقصودٍ، فـ”الصائغ”لم يُقدِّمْ أفكارَهُ صريحةً، بل أرسلَها إشاراتٍ تحتاجُ إلى قارئٍ وَاعٍ يَفكُّ شفراتِ اللُّغةِ البلاغيَّةِ المُتداخلةِ التي حوت معرفةً وموقفًا.
وهو سعي يتضامن مع رؤية “فوكو” التي تفرز معرفةً تتيح للقارئ الإفادة منها، لذلك يرى “فوكو”: “لا توجد سلطة بدون إنتاج للمعرفة… ولا معرفة بدون ممارسة للسلطة.” يستخدم الرمزيَّة والاستعارات لتجسيد أفكاره الفلسفيَّة. هذه الرموز تضفي على النصِّ بعدًا فلسفيًّا وتجعله قابلًا للتأويل بطرائق متعدِّدة؛ فكانت رؤيةً نقديَّةً مُتخفِّيةً تَستبطنُ تساؤلاتٍ وجوديَّةً عن مَكانةِ الإنسانِ في عالَمٍ مُلتبسٍ، وتَستشرفُ – بِذكاءٍ – أزمةَ العقلِ العربيّ بينَ سلطةِ النصِّ الدينيِّ وحُرِّيَّةِ التأويلِ الفلسفيِّ.
فقد جعلته هذه التجربة يعيش في عالم داخليٍّ غنيٍّ بالأفكار والتأمُّلات، ممَّا أسهم في تكوين شخصيَّته الشعريَّة. وعندئذٍ، يمكن القول إنَّ السياق التاريخيَّ والثقافيَّ الذي نشأ فيه الشاعر كان له تأثير عميق في إنتاجه الأدبيِّ، حيث يعكس الشاعر بقصائده تأمُّلاته العميقة بشأن الوجود والحياة إذتتداخل هذه التأمُّلات مع فكرة المصير، هذه النظرة تعكس عمق الفلسفة الوجوديَّة التي تتَّسم بها أشعار الصائغ، إذ يُظهر كيف أنَّ الإنسان يعيش في حالة من التوتُّر بين الرغبة في تحقيق الذات والواقع الذي يفرض عليه قيودًا، تعكس موضوعات الزمن والمصير في الديوان رؤية “الصائغ” العميقة والمعقَّدة للحياة، بأسلوبه الشعريِّ المميَّز، يتمكَّن “الصائغ” من تناول هذه القضايا الوجوديَّة بعمق وبلاغة، ممَّا يجعل شعره يحمل معاني متعدِّدة تدعو القارئ إلى التفكير والتأمُّل في تجربته الإنسانيَّة ومكانته في هذا الكون المتغيّر.”يمكن استخدام العلامات لقول الحقيقة”[18]،كما أنَّ المعاني المتعدِّدة للكلمات تُضفي على النصِّ بعدًا إضافيًّا، ممَّا يدعو القارئ إلى تأمُّلٍ أعمق في المعاني والدلالات.
ممَّا يُثري نصوصه ويجعلها أكثر حيويَّةً وتأثيرًا؛إذ تُستخدم هذه الصور لتوضيح الأفكار وتقديم تجارب إنسانيَّة معقَّدة بطريقة بصريَّة ومؤثِّرة، إذ يتمكَّن الصائغ من خلق نصوص شعريَّة تترك أثرًا عميقًا في النفوس وتدعو القارئ إلى التأمُّل بما تطرحه”السيميائيَّة من دراسة لأنظمة الاتصال، سواء لغويَّة أو غير لغويَّة، لأنَّها تتكامل مع اللِّسانيَّات”[19]، تظهر إشارات خفيَّة إلى التساؤل عن القدر والمصير، ولا سيَّما في رثائه لأشخاص أو أحداث، حين يتحوَّل الحزن الفرديُّ إلى تأمُّل وجوديٍّ في قسوة القدر وغياب الحكمة الإلهيَّة.
هذي وجوه الأهل والأقاربْ
ومّاضة…كالأنجم الثواقبْ
أرى وجوهاً بينها، شواحب
تخافُ أن تحبّ..أو تحاربْ[20]
يُقدَّم الشاعر رؤيته بصور شعريَّة تُعارض الظلم الطبقي من دون ذكر صريح،وبهذا إنَّما يُعلن عن صراعه الداخليِّ، حيث يشكو بثّه ولواعجه من الأوهام والأفكار التي تهاجمه في أثناء نومه،وما تعكسه من حالة القلق والتوتُّر النفسيِّ، ممَّا يدلُّ على عمق المعاناة الإنسانيَّة التي يعيشها الشاعر وتشاؤمه تجاه الحياة، إذ يرى أنَّ كلَّ ما قد يحدث له هو إمَّا شرٌّ محتَّم أو مجرَّد أحلام غير واقعيَّة، لذا عاش رحلةَ كفاح، صارع فيها الظروف فما تمكَّنت منه، لكن كان يداوي الوجعَ بالأمل والوجومَ بالصبر والمرحمة، والإحباطَ بمزيدٍ من العزيمة.
والدنيا ممطرة
كان المطر الناعم،
يسقط فوقَ خواطرها،
وعلى سقف البيت،
بايقاعٍ عذبْ[21]
وطبيعي – والأمر كذلك- أن يُعبِّر عن رفضه القاطع لكلِّ ما يبعد المرء عن وجوده والتفكُّر به، وكان التعبير بصور شعريَّة تُجسِّد عبثيَّة الحياة وضرورة التحرُّر من أسر المادَّة، ممّا يعكس بذور فكره الفلسفيِّ الذي بلورَه في كتاباته الشعريَّة حتَّى شكَّل خطابهلمواجهةالسلطة الخطابيَّة المناهضة لسلطة الواقع الاجتماعيِّ المعيش وما يفرضه على الفرد، ثُمَّ ينضوي ذلك الخطاب على وسائل بنائيَّة تعكس مقاصد منتج الخطاب، وخلخلة تصوُّر المستقرّ، وتحفيز المتلقِّي نحو الرفض وعدم الاستسلام، ومثل ذلك ما تُدلي به “السيميائيَّات تضبط العلامات ومعانيها في سياقاتها، وتطبيقها يفضي إلى كشف أعمق للثقافة الكامنة وراء النص”[22]، فضلًا عن تكريس المعالم الجماليَّة في القول إذ إنَّ في بعض أصناف الخطاب يمكن أن تكون مثل هذه التفاصيل مردودة إلى أغراض التواصل الجماليَّة الاستطيقيَّة أو العمليَّة[23]
الخاتمة:
كانت قصائد “الصائغ” تجمع بينالدلائل الواضحة على تميّزه الشعريّ وواقعه الحياتيّ ؛ كونهانافذةً على عالمه الداخليّ الذي انفجر لاحقًا؛ فقد تحرَّر جزئيًّا من قيود التقاليد، وأنَّالقارئ المطَّلع على نتاجه الشعريِّ ينتهي إلى أنَّ هذا النتاج يتطلَّب تفكيك الرموز والانزياحات البلاغيَّة التي تخفي فلسفته، وهي التي تبقى موضوعًا للتأويل الأدبيِّ والفكريِّ، ليظلَّ الفراق هو العنصر الآخر الذي يتداخل مع مشاعر الحبِّ في شعر “الصائغ”بوصفه “مهيمنةً” تبوح بها تلك القصائد؛ إذ يتناول الشاعر الألم الناتج عن الفراق بأسلوبٍ مؤثِّر مُظهرًا كيف يمكن للفقدان أنْ يتحوَّل إلى تجربةٍ مدمِّرةٍ تتقدَّم فيها شيخوخة النفس بسبب مؤثِّرات الواقع؛ ولعلَّ هذا مايجعل الشاعر يعيش حالةً من الاغتراب الداخليِّ الذي يجمع أمري التوتُّر بين الحبِّ والفراق كجزءٍ أساسيٍّ من التجربة الإنسانيَّة، ممَّا يجعل القارئ يشعر بعمق المشاعر التي يعيشها الشاعر متوسِّلًا للمعنى عبر سياقات النصِّ ومضمراته الرمزيَّة والإشارات والاستعارات التي بلور فيهاأفكاره الفلسفيَّة، وأنَّهذه الرموز كانت تضفي على النصِّ بعدًا فلسفيًّا وتجعله قابلًا للتأويل بطرائق متعدِّدة، كانت في أغلبها تتداخل هذه التأمُّلات مع فكرة المصير؛إذ يُظهر الشاعر أنَّ الإنسان ليس سوى كائن ضعيف أمام قُوى الزمن والمصير، ليس أمامه سوى أن يُعبِّر عن قلقه من عدم القدرة على التحكم في مجريات الحياة؛ ممَّا يدفع به إلى التساؤل عن معنى الجهد البشريِّ وأثره في عالم مليء بالمآسي؛ لذا فإنَّ هذه النظرة تعكس عمق الفلسفة الوجوديَّة التي تتَّسم بها أشعار الصائغ، إذ يُظهر كيف للإنسان أنْ يعيش في حالة من التوتُّر بين الرغبة في تحقيق الذات والواقع الذي يفرض عليه قيودًا.
وممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ الشاعر يستخدم الرموز لتجسيد الأفكار المجرَّدة والمشاعر العميقة، ممَّا يضفي على النصِّ بعدًا فلسفيًّا؛ ويجعله قابلًا للتأويل بطرائق متعدِّدة تجعل القارئ يتفاعل مع النص بنحوٍ أعمق ويستكشف معانيه المخفيَّة، وبذلك تمكَّن الصائغ من صناعة نصوص تحمل معانيَ متعدِّدة تدعو القارئ إلى التفكير والتأمُّل في تجربته الإنسانية ومكانته في المجتمع.
المصادر والمراجع:
آريفيه., ميشال. السيميائية: أصولها وقواعدها. ترجمةرشيد بن مالك. ط1. الجزائر: منشورات الاختلاف, 2008.
إيكو., أمبرتو. التأويل بين السيميائية والتفكيكيةترجمةسعيد بنكراد. بيروت: المركز الثقافي العربي, 2000.
الزيادي, تراث حاكم. “الدرس الدلالي عند عبد القاهر الجرجاني.” جامعة القادسية – كلية الآداب, 2004.
الصائغ, يوسف. المعلم. ط1. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة, 1986.
لصائغ, يوسف.قصائد. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة, 1992.
الطلحي, ردّة الله بن ضيف. “دلالة السياق.” جامعة أم القرى, 1424هـ.
بنكراد, سعيد. السيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها. ط3. الاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع, 2012.
تشاندلر., دانيال. أسس السيميائية. ترجمةطلال وهبة. ط1. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 2008.
توسّان., برنار. ما هي السيميولوجيا؟ترجمة محمد نظيف. ط2. المغرب: أفريقيا الشرق, 2000.
دايك., فان. النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداوليترجمة عبد القادر قنيني. المغرب: أفريقيا الشرق, 2000.
كعواش, آمال. “السيميائية منهج ألسني نقدي العدد29. . (2015)
[1] الطلحي ,ردّة الله بن ضيف “دلالة السياق” جامعة أم القرى, (1424هـ), 8_9.
[2]الصائغ, يوسف. قصائد بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة, (1992), 51.
[3] الزيادي, تراث حاكم .“الدرس الدلالي عند عبد القاهر الجرجاني” جامعة القادسية – كلية الآداب, (2004), 15.
[4]كعواش, آمال “السيميائية منهج ألسني نقدي,” العدد29. (2015) .393.
[5]برنار توسّان., ما هي السيميولوجيا؟, ترجمة نظيف, محمد .ط2 المغرب: أفريقيا الشرق, (2000), 354.
[6]الصائغ, قصائد, 53.
[7]الصائغ, 58.
[8]ميشال آريفيه., السيميائية: أصولها وقواعدها, ترجمة. رشيد بن مالك, ط1 الجزائر: منشورات الاختلاف, (2008), 10.
[9]الصائغ, قصائد, 90.
[10]الصائغ, 101_103.
[11]الصائغ, 95_96.
[12]الصائغ, 103_104.
[13]الصائغ, 187_188.
[14]الصائغ, 187_188.
[15]الصائغ, 359_360.
[16]الصائغ, 265.
[17]الصائغ, 279.
[18]أمبرتو إيكو., التأويل بين السيميائية والتفكيكية, ترجمة. بنكراد ,سعيد .بيروت: المركز الثقافي العربي, (2000), 197.
[19]دانيال تشاندلر., أسس السيميائية, ترجمة. وهبة, طلال. ط1 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, (2008), 56.
[20]يوسف الصائغ, المعلم, ط1 بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة, (1986), 96.
[21]الصائغ, 58.
[22]بنكراد, سعيد .السيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها, ط3 اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع, (2012), 25.
[23]فان دايك. النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي, ترجمة. قنيني, عبد القادر المغرب: أفريقيا الشرق, (2000), 157.