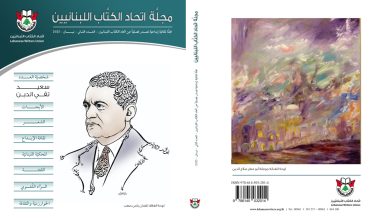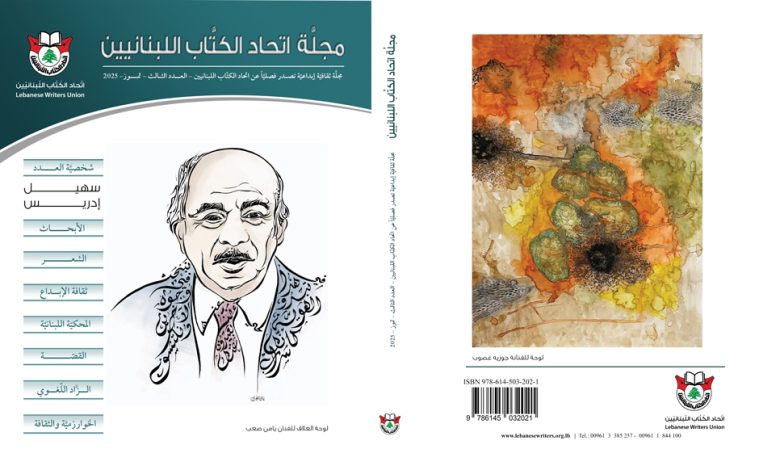
استراتيجيّة البناء النقدي المعماري في شعر محمد علي شمس الدين
د. مصطفى الفـوعانـي
مع محمد علي شمس الدين، لا تعرفُ من أين تبدأ وإلى أين تصل. ثقافته اللغوية الشعرية، تدفعك إلى الحفر في أغوار مفرداته وتراكيبه وصوره الشعرية وفي كلّ محاولة حفرٍ، تعود إلى البداية استعداداً للمحاولة الثانية، وتتوالى المحاولات، من دون أن تصل إلى الكلمة النهائية التي أرادها الشاعر في هذه القصيدة أو تلك.
ما يُميّز البنية اللغويّة في شعر محمد علي شمس الدين هو تعدد الأبنية وتنوعها داخل القصيدة الواحدة، من البناء البسيط إلى البناء المُركب فالمعقَد فالأكثر تعقيداً.
ويأتي هذا التعدد أو التنوع تلبية لمقتضيات تعبيرية، إذ ترتبط درجة “البساطة” و”التعقيد” اللغويين بدرجة البساطة والتعقيد النفسيين.
أمّا الصورة الشعرية في شعر شمس الدين، فهي أداة تشكيليّة لابُدّ منها في بناء القصيدة، لأنها تترابط ترابطاً تفرضُهُ طبيعة التجرية الشعرية، وبفعل العلاقات الناشئة بين الصور، تكتسب كلُّ صورةٍ أبعادَها الدلاليّة ودورها الوظيفي البنائي ، وتأخذ القصيدةُ في النموّ حتّى تصبحَ بناءً متكاملاً.
وتطالعنا في شعر شمس الدين النماذج البنائية الآتية:
- البناء المتدرج:
حيثُ لا يعرضُ الشاعر رؤيته دفعة واحدة، إنما بشكل متلاحق ومتطور.
- البناء الدائري:
تتنوع الصور الشعرية في هذا البناء، ولكنها تدور حول صورة مركزية تشرحها وتؤكدها.
- البناء المتشظي:
أخذُ الصور الشعرية في بعض القصائد شكلاً تجميعياً أو تراكمياً على نحوٍ يكادُ يفتقر إلى الروابط اللفظية أو التركيبية، بحيث تبدو الصورة مستقلّة عن غيرها من الصور، وما يجمعها مع بعضها بعضاً، كونها تنتمي إلى قصيدة واحدة.
- البناء التلاحقي أو المتلاحق:
حيث تتلاحق الصور أو تتدافع تبعاً للحالة الشعرية ومهما يكن من أمر، فالبنى النقدي التفكيكي والتركيبي في شعر محمد علي شمس الدين، يحتاجُ إلى ثقافة لغوية عالية تواكبُ ثقافة هذا الشاعر، بوصفها عابرة للعصور والأزمنة، فتنطلق من السؤال الآتي: مَنْ هو الإنسان المثقف؟ وتصل إلى نقطة: اللاوصول” ليظل الشعر والبنىّ في حركة نقدية، شعرية، لغوية وإنسانية لا تنتهي.
أ. استراتيجيّة بناء الجملة:
تشبهُ البنيةُ اللغوية في شعر “محمد علي شمس الدين” لعبة “الشطرنج” التي تتطلب ذكاءً لغوياً قائماً على دقّة الملاحظة لهذه البنية، ولعناصرها ، كيف تترابط، وتتباعد، وتتقارب. ما العلاقة بين عنصر وآخر؟ وكيف نبني هذه العلاقة، خصوصاً إذا كان العنصران متباعدين، ولا تربطهما أداة لفظية أو إحالية؟ وليس غريباً إذْ رأى “دو سوسير”(Do Saussure) أن اللغة أشبه بقُطع الشطرنج والقطارات.
ويذهب نقّاد آخرون إلى أن “الأسلوب غير المباشر الحر حالة خاصة للتعددية الصوتية، إذ يسمع في صوت السارد أصداء صوت آخر، وحتى إن كان هذان الصوتان منفصلين فالخطاب يبدو، في آن معاً، منقولاً ومستشهداً به.
نحنُ إذاً في قصيدة شمس الدين أمام أصوات لغوية، تتطلب “حساً نقدياً عند الباحث، ليحدد تفاعلاتها، وتقاطعاتها، وتداخلاتها، ودورها في بناءٍ فسيح الرؤية.
البناء اللغوي في هذه القصيدة يُخالفُ أحياناً الأعراف والقوانين اللغوية، من حيث التقديم والتأخير، وعلاقة ما يُحدِثُ الدهشة اللغوية. وقد تحدث “رولان بارت” (Barthes R) عن “متعة النص: متعة النص من أجله ولذاته خارجاً عن القواعد التي تمليها التقاليد.
ب. استراتيجيّة بناء الصورة:
يطالعنا في شعر شمس الدين عددٌ من الأبنية التركيبية التي تشكّل ديناميكية البناء الشعري في القصيدة، وتتفاعل وتتكامل بحيث تصبح أدواتٍ تشكيلية، تفرضها الرؤية الشعرية.
- البناء المتدرج:
تُعرضُ الرؤية في هذا البناء بشكل متلاحق، بحيث تُقدّمُ في كل سطرٍ فكرة أو معنى، وهكذا نصلُ إلى السطر الأخير فتكتمل الرؤية.
ومن نماذج هذا البناء قصيدة “حراسة الليل، حراسةُ الشاهد”
“انظروا
فوق هذا الجدارِ الذي رصّعتهُ الدماءْ
تروا نسباً بيننا
انظروا تحت هذي السماءْ
تروا أنّ أعصابنا
وترٌ واحدٌ للبكاء
أرى أسمعُ الان شيئاً رهيباً
تصيحُ الديوك مولولةً في الجنوب ثم تكسرُ منقارها في الحجر”
يُلاحظُ في هذه القصيدة تدرّجُ الرؤية، ومعها يدرّجُ الأسلوب والقصيدة الشعرية، بحيث يُصبحان متلازمين ومتزامنين: النظر فوق الجدار ــــ هذا الجدار ترصَّع بالدماء ــ النظر تحت السماء ← الأعصاب مُتعبة ← البكاء ← الرؤية ← السمع ← الشيء الرهيب ← ولولة الديوك في الجنوب ← تكسرُ هذه الديوك منقارها في الحجر تدرّجت الرؤية في تسع مراحل، وكلُّ مرحلةٍ أشدُّ عمقاً وخطورةً من سابقتها: فالأولى وهي النظرُ فوق الجدار، أقلُ وطأةً من ترصّع الجدار بالدماء، والتي ترتبطُ بالموت أو بالشهادة، وتنقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي النظرُ تحت السماء، وتوحي بأنها [السماء] شاهدة على هذا المشهد الذي لم تكتمل تفاصيله بعد، فالأعصاب مُتعبة، وهذا التعب يقودُ إلى البكاء، فهل منْ يرى؟ وهل من يسمعُ؟ وتستمرُ هذه المراحل بالتدرج والتنامي، حتى تبلغ ذروتها في المرحلة الأخيرة، مع كسر الديوك منقارها في الحجر، وما يحمله هذا الكسرُ من دلالاتٍ وشيفرات ثقافية، ليس أقلّها خيبة الأمل، والانتفاضة والثورة الشاملة، ما كانت هذه الرؤية الى “ثورة الجنوبيين” (وضمناً المقاومة ضد الظلم والظالمين) لتبرر لنا هذه الدهشة لو لم تُنسجُ تفاصيلُها على هذا النحو المتدرّج.
ومن هنا يذهبُ “رومان جاكوبسون” (Jakobson R) إلى “أن لغة الشعر هي الأكثرُ تلاؤمُا معها [مع الناحية اللسانية في الشعر] لأن القوانين البنيوية والوجه الإبداعي للغة هي في الخطاب الشعري في متناول المراقب أكثر منها في الكلام اليومي”.
وهذا يعني أنّ “المراقب” أي الناقد التفكيكي- التركيبي هو أكثرُ ملاحظة لهذا التطوّر البنائي في القصيدة من الشاعر بنفسة، وهو شريكهُ في عملية البناء الشعر المعماري.
- البناء الدائري:
تبدأ القصيدة –هنا- بما انتهت إليه، الأمر الذي يعني وجودَ رؤية مركزية تستقطبُ التعابير والروابط اللفظية والإحالية.
ومن نماذج هذا البناء قصيدة “أغنية للموت”:
… هذا النباتُ المعرّش فوق الجدار غزائره
وهذي الطيور الأليفةُ: أُنثاهُ والشمسُ دائرةٌ في خلايا يديه وعندَ قران الغزاله في البحر يبسطُ كفيه حتى عروق المياه تسائله نجمةٌ في الفلاة…
تطالعنا في هذه القصيدة صور عدة، فالصورة الأخيرة والأولى هي نفسها، وما بينهما، تتكاثر الصور والرؤى، وتتنوع، وتتداخل، بعد أن أحكمَ الشاعر بناءها الداخلي، وترك الحرية للعناصر البنائية (في الداخل) للتحرك، فالصورة الأولى هي النباتُ المعرّش فوق الجدار غرائزه، والأخيرة هي النجمةُ التي تسائِل الشاعر في الفلاة: فالنبات المعرّش ينتمي إلى عالم اليابسة، والنجمة المسائلة تنتمي إلى عالم الفضاء، واليابسة والفضاء صورتان لوجهٍ واحدٍ، تتكشف معالمه من خلال الصور التي تتحرك بينهما: الطيور الأليفة ← فضاء الشمس ← فضاء، الغزالة في البحر ← ماء ← عروق المياه ← ماء، فوجه الشاعر يحمل طياته معالم الموت، الذي هو واحدٌ يابسة، وفضاءً وبحراُ.
أن تبدأ القصيدة بصورة اليابسة، وتنتهي بصورة النجمة، يحمل البعض على التساؤل: كيف تكون اليابسة والنجمة صورةً واحدة؟ والجواب: أن هذه النجمة لم تبقَ نجمة عادية (في الفضاء) ولكنها (من خلال بعض الروابط اللغوية، وتحديداً الجار والمجرور)، أصبحت تنتمي إلى عالم البر لا الفضاء، (نجمة ٌ في الفلاة) وهكذا، انتقلت “النجمة” من الائتلاف” إلى “الاختلاف”، أو من “التجانس” إلى “التباعد”، ومن هنا يختلف البناء الدائري في شعر شمس الدين عن الأبنية الدائرية في قصائد الشعراء الأخرى، لارتباطه بالاختلاف والائتلاف.
وكأنّ هذا الاسلوب البنائي نابعُ من ذات “محمد علي شمس الدين” تلك الذات التي حدّدت من خلال الرؤيا الشعرية الاستشرافية بدايات العمل الشعري ونهاياته، ولذلك، يذهب “ريفاتير” (M. Riffateire) إلى أن الأسلوبَ هو النصُّ ذاته.
- البناء المتشظي:
تتشظى الروابط البنائي، فتتباعد أحياناً، وتتقارب وتتجاوز أخرى، من دون نظامٍ أو قانونٍ لغويّ محدد، ما يُحتّم على القارئ / الباحث أن يُنتجَ نظاماً لغوياً خاًصّـاً بها، ليتمكن من تحديد مفاصل الرؤية: أين تبدأ، ومتى تنتهي، والى أين تنتهي.
من نماذج هذا البناء، قصيدة “قمر الجنوب”:
“قمرُ الجنوب على التلال
قمرٌ خفيفُ
ثمّ لا يهوى
كعصفورٍ على كتف الجبال
وثيابه البيضاء نشرها
على الأشجار آونةً
ويجلس مثل تمثالٍ
على قدمين حافيتين
من قصب الخيال
وأقول يا قمري الذي صلبوك
هَبْ لي
من أقاصي كفّك البيضاء أغنيةً
ونشربُ قبلَ بارقةَ الزوالْ
وتنامُ
هل
ستنامُ يا ولدَي القرى الحجرية الزرقاء
هل ستنام؟ “
يُلاحَظُ في هذه القصيدة أنَّ الرؤية تتبعُ بشكلٍ تلقائي من التراكيب، ويصعب تحديد العلاقة بين تركيب لغوي وآخر، لأنّ الروابط اللفظية- الإحالية غير منتظمةٍ في قانونٍ لسانيّ واضح.
فقمرُ الجنوب على التلال وإنْ كان قمراً خفيفاً، مع ضبابية هذا الوصف، وإنْ كان لا يهوى، فهو لا تجمع علاقة موضوعية أو منطقية بالعصفور على “كتف الجبال”، بالرغم من استخدام الرابط التشبيهي (الكاف). وثياب هذا العصفور البيضاء مشتظّية الدلالات والاحتمالات، والثياب البيضاء قد ترمز إلى النقاء والصفاء والسلام، ولكنّ هذه الدلالات تتراجع مع الصورة اللاحقة، لأنّ القمر الجالس “مثل تمثالٍ على قدمين حافيتين” تتناقض صورته مع السابقة، حتى ليسأل القارئ: من أين يبدأ؟ وكيف ينسجُ العلاقات بين هذه الصور “الغريبة”؟ وماذا أردا حقاً ـ أن يقول محمد علي شمس الدين؟ وتتصاعد وتتواتر هذه الغرابة مع الصور التالية: القمر المصلوب ذو الكف البيضاء. فالصلبُ لا يتجانسُ مع الأغنية، ولأنه يرتبط بالألم، بينما الأخيرة تدل على الفرح. وتأتي صورة “ولد القرى الحجرية” لتجعل الغرابة تصل إلى ذروتها: مَنْ هو هذا الولد؟ وما هي القرى الحجرية الزرقاء؟ أن هذه الغرابة التي تحكم صور هذه القصيدة، تحملُ على وصف بنائها بـ “المتشظي” أو “المتداعي”
- البناء التلاحقي أو المتلاحق:
تتلاحق أو تتدافع الرؤى والتعابير اللغوية في هذا البناء بشكل تدرجي أو ما نمكن تسميته متموّج، بحيث تتدافع الرؤى والتعابير على شكل “أمواج” تتسارع حيناً، وتتباطأ آخر وكأن هذا البناء محكومُ بنظام (الموج).
ومن قصائد هذا البناء، قصيدة”عودة ديك الجن إلى الأرض”:
“ولكني ظامئ للدم الآدميّ
إلى خمرةً في خوابي الجحيم
فَمَنْ واقفٌ في مدى شهوتي
كالحصان القديم
شهوتي كالحصان
وأنتِ ممهَّدةٌ كالمراعي“
تطالعنا في هذه القصيدة الرؤى والتعابير من خلال “محطات” أو “تموجات” وفي كل محطة، أو موجة فكرةٌ أو نسيج رؤية، وتتماهى هذه الأنسجة مع الأمواج، الأمر الذي يتطلب تقصيها لغوياً في حالة التسارع، وحالة التباطؤ، في وضعية التقدّم، ووضعية التراجع.
فالصورة الأولى/ الموجة الأولى هي الشاعر المتعطش إلى الدم الآدميّ، والموجة الثانية هي التعطش إلى خمرة في خوابي الجحيم، وهذه الصورة تتسارعُ حركتها لتصل بشكل مفاجئ إلى مدى شهوة الشاعر، لأن “المدى” المذكور يتطلب وقتاً ليس قليلاً للوصول إليه، وتحديده، والدخول في مداره، الأمر الذي يعني أن سرعة الموجة/ الصورة الثانية لم تكن بالمقدار نفسه الذي تحركت من خلاله الموجة الأولى.
وهذه السرعة تعودُ وتخفّ وتيرتها مع ربط الشاعر سؤاله عن “الواقف في مدى شهوته” بالحصان القديم، فهذا الأخير أقلُّ سرعةً من الشهوة الجارفة التي لا تُبقي ولا تَذر.
وأمام هذا التسارع والتباطؤ، نصلُ إلى ما يشبه حالة “الانسياب” أو الحركة السلسة، مع كون المرأة ممهّدةً لشهوة الشاعر كالمراعي، لأن “المراعي” تؤمن الحرية، والأمان، والسلام للقطيع، وهذه الصفات ترتبطُ عادةً بالانسياب واختيار المناسب ويمكن توصيف حركة صور هذه القصيدة بالمعادلة الآتية: تسارع اعتيادي ـــ تسارع مُفاجئ (مع ما يحمله من دلالات على تطور الرؤية الشعرية عن شمس الدين).
وهذا ما أسميه “الوضعيات النقدية التي على الناقد أن يُتقنهَا ليُحسن قراءة هذا النوع من قصائد “محمد علي شمس الدين”
المنظـور النقـدي البنائـي
1ـ الفاعلية الدلالية:
يُلاحظُ ممّا تقدّم أن هذا البناء النقدي لقصيدة “محمد علي شمس الدين ذو فاعلية دلالية عالية المستوى، ومن خلال تداخل مكوناته بنسيج الرؤية الشعرة، هذا البناء ينشأ مع الرؤية في الوقت نفسه، وتتحول عناصره شيفراتٍ ثقافية إنسانية ونفسية تتقاطعُ مع العالمين: الداخلي والخارجي لمحمد علي شمس الدين، ومن هنا يرى بعض النقاد أن القصيدة ليست مجردَ مجموعة من الخواطر أو الصور أو المعلومات، ولكنها بناء متدامج للأجزاء منظم تنظيماً صارماً…”
- الفاعلية النفسية:
وتتبدّى هذه الفاعلية من خلال تعدد الأبنية الشعرية للقصيدة، وتقاطعها وتداخلها، بحيث تصبح أشبه بالشبكة “العنكبوتية” التي على الناقد أن يتقصى كل خيطٍ فيها: أين بدأ؟ وأين ينتهي؟ ومسار حركته الأفقية والعموديّة، وهذا التقصي يُؤتي أكله عندما ينطلق من التفاعلات النفسية داخل كل بناء، بحيثُ يُنتجُ التفاعل النفسي الواحد بناءً معمارياً معيناً، فإذا وصلنا إلى تفكيك جميع هذه التفاعلات أدركنا “الفاعلية النفسية” للنسيج الشعري (البنيوي) للقصيدة.
ومن خلال الفاعليّتين: الدلالية والنفسية لقصيدة “محمد علي شمس الدين” يُستنتجُ أنها [القصيدة] مبنية على استراتيجة ثلاثيّة الأبعاد: البُعد الأول لغوي ألسني بنيوي، والُبعد الثاني إنساني نفسي، والبُعد الثالث ثقافي تاريخي حضاري .
يذهب بعضُ النقاد إلى أن الأسلوب ينبع من ذاتية الفنان أو الكاتب نظرية (Boffon) ومع أن اللغة مشاع لمجموعة بشرية معينة ينتفعون بها حتى إنه يقال: إن لكل امرئ لغته…
ج. خاتمـة:
ثقافة شمس الدين الشعرية اللغوية مؤشرٌ على ثقافته النقدية، وما بُحثَ في “معماريّة” شعره، هو غيضٌ من فيض، وكأني بهذا الشاعر أطلق شرارة البحث النقدي (التفكيكي ـ التركيبي) ولم يُطفئها، الأمر الذي يُحتم على الناقد أن يحفر في أغوار شعره، ليقف على تقنيات واستراتيجيات كل مفردة، وكل جملة، وكل صورة.
وأخيراً، أُضيف الملاحظات النقدية الآتية:
- إن اتّكاء قصيدة شمس الدين الشعرية على الاستراتيجيّة التي دُرست في هذا البحث، هو ما أكسبها خصوصيتها، وميّزها من كثير من قصائد الشعر الحديث المعاصرة.
- هذه القصيدة تتطلب قارئاً مثقفاً، يحسن الولوج إلى بنائيتها، كما يستطيع الخروج منها بدلالاتٍ تسهمُ في تشكيل معالمَ نقديةٍ جديدة.
- ليس من قبيل المبالغة لذا قلت: إن قصيدة شمس الدين تؤسسُ لنقدٍ تفكيكي تركيبي جديد، يحتاج إلى نقادٍ مميزين: لغةً ورؤيةً وثقافةً.
- ومن هنا، فإنّ قصيدة شمس الدين تتحرك في ثلاثة اتجاهات: اتجاه إلى الوراء، يستمدُ من التراث الشعري اللغوي صفوته، واتجاه آنيّ (حالي)، يتفاعل مع معطيات العصر والواقع الشعري الذي عاشه هذا الشاعر، وثالث مستقبلي، أي يفتحُ آفاقاً مستقبلية لشعر جديد، ونقد جديد، وربما نقاد جُدُد، ومن هنا، فان هذه القصيدة عابرة للأزمان والأجيال، بكثافتها، واستراتيجيّة بنائها، وتشظي دلالاتها وبكثافتها.
قائمة المصادر والمراجع:
- شمس الدين، محمد علي، الأعمال الكاملة، دار سعادة الصبّاح، بيروت، ط1 ، 1993
- أرمز، روي، لغة الصورة في السينما المعاصرة، المكتب تر. سعيد عبد المحسن، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، القاهرة، لا ط ، 1992
- الطوانسي، شكري ، مستويات البناء، الشعري عند محمد ابراهيم أبي سنة (دراسة في بلاغة النص)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، لا ط، 1998
- طحّان، ريمون، فنون التعقيد وعلوم الألسنية ( 4 ـ 5)، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1
- القالح، عبد العزيز… ط1، 1981، ط2، 1985.
- ليونز، جون، نظرية تشومسكي اللغوية، تر حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ط1 ، 1985.
- Barthes, R, le Plaisir du texte, le seuil, Paris, 1973.
- Jakobson, R, theorie de la litterature, Ed du seiul, Paris, 1973.
- Riffaterre, M, La production du texte, seuil, Paris, 1979.
- De Saussure, Ferdimant, cours de linguistique generale, payot, Paris, 1979