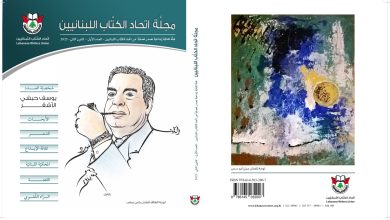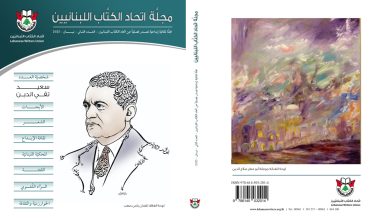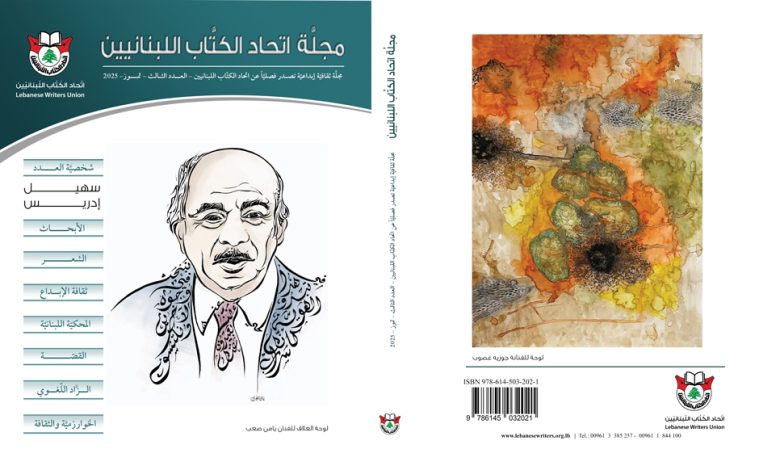
الحداثة الشّعريّة بين النّظريّة والتّطبيق
أ. د. محمد حبلص
كثرت الأقوال والآراء والنظريّات التي هدفت إلى تعريف الحداثة الشعريّة، فمنها ما أصاب الهدف، ومنها ما أخطأه، وقد ظهرت هذه التّعريفات في النّصف الأوّل من القرن العشرين، واستمرّت ناشطةً في بدايات النّصف الثّاني من القرن نفسه، وهي لم تتوقّف إلى اليوم، بل إنّ هذه التّعريفات فتحت الباب أمام الباحثين الجدد ليخوضوا في هذا الموضوع، وكذلك جعلت الشعراء والمتخصّصين في الأدب والمثقّفين يتحاورون أحياناً ويتجادلون أحياناً أخرى في موضوع الحداثة الشعريّة ذلك لأنّ طرح هذا الموضوع جعل الكثيرين في حَيرةٍ إذ اعتبروه يهدف إلى إلغاء التّراث الشّعريّ العربيّ.
ويُنكر الإبداع في غير الحداثة الشعريّة، والسّبب في خَلْق هذه الحيرة في نفوس الكثيرين هو أنّ الّذين طرحوا موضوع الحداثة الشّعريّة كانوا مقصّرين في قول الرأي الجريء فيما يخصّ التّراث العربيّ الشعريّ والقصيدة العربيّة العموديّة. فالقصيدة العربيّة العموديّة لا تناقض الحداثة في شيء، إلّا في المضمون إن هي قصّرت عن مجاراة الزمن ومحاكاة أحداث الحياة، فليس الشكل العموديّ مغايراً للحداثة في القصيدة العربيّة، إذ تستطيع القصيدة العربيّة أن تجمع بين الشكل الكلاسيكيّ القديم والموضوع الحديث، وهي حينئذ تصنّف قصيدة حديثة ، وليس هذا وحسب، بل يمكنها أن تتجاوز حقبتها الزمنيّة في الحيويّة والديمومة وتستمرّ مع الحياة تأثيراً في نفوس النّاس محدثةً الضّجةَ الاجتماعيّة بسبب تداولها، وهذه الخواصّ الّتي نصفها هنا هي خواصّ شعر المتنبيّ، وضمن هذا السّياق وهذا التّعريف يجب أن نفهم قول المتنبيّ:
وما الدّهر إلّا من رواة قصائدي إذا قلتُ شعراً أصبح الدّهر منشدا(1)
إنّني أرى هذا البيت يتخطّى الحال النرجسيّة التي عبّر عنها المتنبيّ في شعره تعبيراً مستمرّاً لم يغب في فترة أو يخفت وهجه، يتخطّاها إلى إضفاء الشاعر صفة التّجدّد المستمرّ على شعره، فهو شعرٌ يُنشده الدهر، ولهذا السّبب هو شعرٌ لا يموت، فالدّهر هو الزمن المفتوح المستمرّ، هو الزّمن المطّرد غير المنفصل، وكأنّي بالشاعر يؤكّد حداثة شعره المستمرّة التي لا تموت في حقبة من حقب الدّهر كما هي حال الكثير من الشّعر الذي يتوهّج في زمن ثمّ يموت في زمن لاحق فيسبقه الدهر ويُخلّفُهُ منسيّاً في حين يبقى شعر المتنبيّ حيّاً لا يموت لأنّ الدّهر اختاره نشيداً له، وهكذا يضع المتنبيّ في هذا البيت المأثور أساس الحداثة في الشِّعر في فترة لم يكن فيها مصطلح الحداثة معروفاً ومتداولاً كما اليوم، يجب ألّا نفهم بيت المتنبيّ المذكور فهماً نرجسياً فقط، بل يجب أن نفهمه في سياقه الصّحيح حيث إنّ الشاعر ببيته المذكور يفخر بشعره لأنّه شعر لا يموت، شعرٌ اختاره الدّهر نشيداً له ، وهو يواكبه في كلّ أحداثه وأحواله، هو شعرٌ مطّردٌ غير منفصل وفاقاً لمفهوم نظريّة الزمن التي تعتبر الزمن (الدّهر عند المتنبيّ) تألّف من وحدات صغرى تنمو وتطرد في حركة نموّ مستمرّة من الثّواني الّتي تولد منها الدّقيقة وصولاً إلى الوحدة الزمنيّة الكبرى الموصوفة بالاستمرار وهي الزمن الّذي لا يتوقّف إلّا حين حصول انفصال بين وحدتين زمنيتين: بين الدّقيقة والسّاعة أو بين السّاعة واليوم على سبيل المثال.
إنّ حصول هذا الانفصال بين الوحدات الزمنيّة في طريق فعلٍ من الأفعال يؤدّي إلى توقّف الفعل، بل إلى موته، وقد تجاوز المتنبيّ كلّ الوحدات الزمنيّة الصغرى ليكتفي بالكبرى وهي الدّهر رفيقاً لشعره ومنشداً مبعداً عنه الموت محقّقاً له البقاء. إنّ بيت المتنبيّ المذكور آنفاً غير محدود بأطر القصيدة الّتي ورد فيها، بل هو ينطبق معنًى على تجربة الشّاعر كاملة والدّليل كلمتا: (قصائدي) في الشطر الأوّل، و (شعراً) في الشّطر الثّاني. إنّ كلمة (قصائدي) – بإضافتها إلى ياء المتكلّم وهو الشاعر- تمثّل كلّ القصائد الّتي قالها، وكلمة (شعراً) بتنكيرها تمثّل كلّ نوع من شعر المتنبيّ سواء أكان مديحاً أم غزلاً أم فخراً فهو شعرٌ يردّده الدّهر على لسانه نشيداً. إنّ بيت المتنبيّ المذكور هو حجّةٌ قويّةٌ لأولئك الّذين اعتبروا أنّ الحداثة في الشِّعر هي حركة تواكب الزمن، ولكنّ المتنبيّ سبقهم بقرون إلى وضع هذا المفهوم ولم يُجهد نفسه في البحث ومقاربة الآراء والأقوال، بل عبّر عن هذا كلّه في بيت خالد كسائر أبيات شعره، بيت قد يظنّه القارئ غير الممعن والمتأمّل بيتاً في الفخر والعنجهيّة، بيد أنّه يدوّن بالدليل السّاطع استمرار حياة شعر المتنبيّ، وهذا الاستمرار هو جوهر الحداثة، فبرأيي ليست الحداثة في الشّعر أو غيره ظرفيّة، فهي لا ترتبط بفترة أو حقبة من حقب الدّهر ثمّ تؤول إلى الزوال، إنّ الحداثة استمرار ولا تعرف الزوال، فما هي الجدوى من شعر حديث في عصرنا ثمّ يصير قديماً في عصر جيل يأتي بعدنا؟!!!.
إنّنا أضفينا عليه صفة الحداثة لأنّه عبّر عن حالنا السياسيّة والاجتماعيّة المحدودة فيما هو تناقض مع الحال ذاتها لدى الجيل الّذي أتى بعدنا. إنّ هذا النّوع من الشِّعر مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بقضايا عصره لا يستطيع تجاوزها أو أن يستمرّ بعد زوالها، ولهذا على الشّاعر الّذي يريد أن يُكتب الخلود لشعره أن يبتعد عن التّأريخ ووصف الأحداث والمناسبات الطّارئة، وأن يجنح إلى صناعة الفنّ في شعره لتصير الحال الفنّيّة صبغة شعره الدّائمة وبمثل هذه الصّناعة يبقى الشِّعر حيّاً متوهّجاً لا يموت ولا يعتريه الخفوت، على الشّاعر الأريب أن يكون فنّاناً ولو كتب شعراً في موضوعات تقليديّة، فالأسلوب الفنيّ هو الّذي يُحيي الشّعر حياة دائمة، فالشعر يموت حتماً بعد فترة قصيرة من كتابته إن لم يُقدَّم إلى القارئ بأسلوب فنيّ ولو طرق موضوعاتٍ معاصرة. إنّ الشّعر هو كلمات تنتظم في سياق يميّزها عن غيرها من الكلمات، يعطيها هويّتها الشعريّة والفنّيّة، هو الصّنعة الفنيّة قبل أن يكون موضوعاً حديثاً، ونحن نعطيه قيمته بواسطة القياس الأسلوبيّ الفنيّ ولا يهمّنا الموضوع في شيء، إنّما الّذي يهمّنا الأسلوب الذي كُتب به الموضوع، والدّليل على صواب هذا الرأي في نقد الشّعر وتقدير قيمته الجماليّة الفنيّة هو تفاوت عدد من القصائد في القيمة الجماليّة كتبها شعراء مختلفون في موضوع واحد، ولولا هذا الاختلاف الأسلوبي بين الشّعراء لما كنّا نستطيع أن نميّز بين شاعر وآخر أسلوباً وفناً وإبداعاً، لكان تساوى الشّعراء جميعاً في القيمة والقدْر، ولتشابهت القصائد والتّجارب.
إنّ المتنبيّ أدرك بعبقريّته سرّ الصنعة الفنيّة في بداية تجربته الشعريّة، فهو دأب على جعل الموضوعات مادّة لصناعة أسلوبه الشعريّ الفنيّ وتحقيق الجمال في قصائده وهذه الميزة التي امتاز بها المتنبيّ نلحظها بوضوح في كلّ الموضوعات التي طرقها، لقد عناه الأسلوب الفنيّ أكثر ممّا عناه الموضوع ولو كان موضوعاً عظيماً في عقله وقلبه ووجدانه كمدحه سيف الدّولة على سبيل المثال، فرغم أنّ المتنبيّ قد أحبّ سيف الدّولة حبّاً عظيماً، بيد أنّه عبّر عن هذا الحبّ ووصفه في شعره بأسلوب شعريّ أذهل القارئين فجعلهم يغفلون عن الممدوح معجبين بالمادح وعبقريته الفذّة، وهذا التفوّق الفنيّ لدى المتنبيّ على معاصريه من الشعراء أعلى مقامه بينهم ووهب شعره ديمومة الحياة، ولا جرم أنّ التفوّق الفنيّ في صناعة الشعر لدى المتنبيّ جعله أيضاً يكافئ سيف الدولة في القدْر والقيمة فكلاهما فارسٌ متفرِّدٌ في مضماره، فسيف الدّولة يتقن فنّ القتال وهو مبدعٌ في ساحة الحرب وكذلك المتنبيّ هو يتقن فنّ القريض، وهو مبدعٌ في كلامه وأسلوبه، وقد جنح المتنبيّ دائماً إلى تثبيت الصنعة الفنيّة في شعره، وخصوصاً في قصائد المدح لكيلا يظهر أقلَّ قدْراً من الممدوح، وليسَ هذا وحسب، بل ليُلفت انتباه القارئين إلى عبقريّته الشعريّة فينشغلون بها، وينسون الممدوح الّذي قيلت القصيدة في شخصه ووصفت مكارمه وسجاياه، ومثال هذا نلحظه في قصيدة أبي الطيَّب (على قدْر أهل العزم)، إذ يقول الشاعر واصفاً بطولة سيف الدّولة الأسطوريّة:
إذا زلقتْ مشّيتَها ببطونها كما تتمشّى في الصعيد الأراقمُ (2)
إنّ المتنبيّ قدّم سيف الدولة للقارئ فارساً أسطوريّاً بين القادة في صورة شعريّة أسطوريّة لا تمتَّ إلى الحقيقة بصلة، أظهره فنّاناً في قيادة الجيش والخيل، إذ يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع فعله الآخرون إنّه يمشّي الخيل بين الفجاج وعلى رؤوس الجبال، وهو- إن زلقت- يمشّيها ببطونها بغير قوائم، وكأنّها الأفاعي تمشي في الصعيد بلينٍ ويُسرٍ، هي صورة بطوليّة لفارس أسطوريّ فنّان في قيادة الجيش وإدارة المعركة أتى بها شاعرٌ أسطوريٌّ يتفوّق على أقرانه في صناعة الصّورة الشّعريّة وخَلْق عناصرها الفنيّة، وهذا التفوّق الفنيّ في شعر المتنبيّ هو الّذي جعله شعراً حيّاً لا يأتيه الموت من جانب، شعراً حداثياً بالمعنى الحقيقيّ للحداثة.
إنّ الشّعر الحيّ هو الشّعر الحديث ولو كان عمره قروناً ودهوراً، والشّعر الميْت هو الشّعر القديم ولو كان عمره يوماً واحداً، فليست الفترة الزمنيّة قياساً للحداثة، إنّما الحداثة روحٌ وجوهرٌ، فقد نجد رجلاً في السّبعين من عمره تعيش في جسده روح الشّباب، وقد تجد شاباً تعيش في جسده روح شيخ كبير. إنّ قياس الحداثة قياسٌ فنيّ إبداعيّ، فبقدْر ما يكون الشاعر فنّاناً مبدعاً يكون مُحْدِثاً ومبدعاً، وبقدْر ما يبتعد عن صناعة الفنّ والإبداع في شعره يكون شاعراً عاديّاً ويكون شعره شعراً بليداً لا حياة فيه ولا حركة، والشّاعر الأريب وحده الذي يُدركُ قياس الحداثة والفرق بين الشِّعر الحيّ والشعر الميْت، ويدرك العناصر الفنيّة التي تفرّق بينهما. إنّ شعر المتنبيّ لم يُكتب له البقاء لأنّ شاعره كان رفيق الأمير سيف الدّولة يعيش في كنف السّلطة، أو لأنّه افتخر بنفسه وأذاعَ صيته في أبيات شعره، بل كُتب لشعره البقاء والحياة لأنّه ركّبه تركيباً فنيّاً إبداعياً، حتّى إنّ افتخاره بنفسه كان افتخاراً فنياً وإبداعياً هو افتخر بعبقريّته الشعريّة ولم يفخر بقومه أو عشيرته، أو جدوده:
ما بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرتُ لا بجدودي(3)
إنّ الممعن في قراءة هذا البيت، المتأمّل معانيه تأمّلاً عقلياً لا يجد فيه عنجهيّة فارغة، بل يجد فيه إيمان الشّاعر بالجدّ والاعتماد على النّفس والابتعاد عن التّغنّي بالشعارات الفارغة الّتي لا تقدّم للإنسان جدوى، يجد فيه تعليماً عقلياً للمتلقّي، تعليماً يجعله يصنع نجاحه بنفسه وجَهْدِهِ. إنّ هذا المعنى العقليّ التعليميّ الّذي نجده في هذا البيت نحن بحاجة شديدة إلى أخذه والعمل به في حياتنا، وهذا دليل على أنّ شعر المتنبيّ نابضٌ بالحياة وتعيش في كلماته الحكمة، ويعيش العقل والفكر، فما زلنا نحن العرب في عصرنا، عصر التكنولوجيا المتطوّرة، نفخر بجدودنا وآبائنا وننسى أنفسنا وخمولها ومرضها. ما زال شعر المتنبيّ في هذا العصر حاجة إلى نهضتنا القوميّة والحضاريّة أكثر من الشِّعر الجديد الذي وُصِفَ بأنّه يمثّل انقلاباً على التّقليد والعمود الشعريّ، وكأنّ الواصفين والمنظّرين فهموا الحداثة شكلاً ولم يفهموها مضموناً، فليست القصيدة التي تأخذ شكلاً تفعيلياً بدلاً من الشكل العموديّ، وتحلّ فيها الجمل محلّ الأبيات قصيدة حديثة من دون النّظر إلى مضمونها ومعرفة الموضوع الّذي وصفته وعبّرت عنه، ففي رأينا قد تكون القصيدة التفعيليّة قديمة والقصيدة العموديّة حديثة في الرجوع إلى مضمونها وهكذا نستنتج أنّ المضمون هو معيار الحداثة وقياسها في الشِّعر وغيره، إذ يحصل أن يكون الرجل حديثاً في زيّه وأناقته، سلفياً في عقله وفكره، ويحصل كذلك أن يكون الرجل سلفياً في زيّه وأناقته، حديثاً في عقله وفكره وهذا المثال ينطبق تماماً على شعر المتنبيّ الذي هو شعرٌ سلفيٌّ في الشّكل، حديثٌ في المضمون، ونقدّم هنا قوله شاهداً على حداثة شعره ومطابقته لحياة الإنسان العربيّ:
وإنّما النّاسُ بالملوك وما تفلحُ عُرْبٌ ملوكها عجمُ(4)
إنّ هذا البيت لأبي الطيّب يؤلمنا حين نقرأه، والسّبب هو أنّه ما زال ينطبق على حالنا نحن العرب إلى يومنا هذا، فمنذ قاله الشّاعر الخالد إلى اليوم ونحن العرب ملوكنا عبيدٌ للعجم، فحالنا أكثر سوءاً من أيّام أفول شمس العروبة في الحقبة الأخيرة من العصر العبّاسيّ وتولّي المماليك فيما بعد السلطة وإدارة الحكم، وهي أكثر سوءاً من أيّام العثمانيين، ففي تلك الفترة حكم العجمُ العرب ولكنّهم حفظوا لهم أرضهم ومقدّساتهم تحت راية الخلافة الإسلاميّة، أمّا اليوم فقد غزا العجم بلادنا واغتصبوا أرضنا المقدّسة وطمسوا آثارنا التاريخيّة والحضاريّة عليها، وهدموا مقوّمات عيشنا ونهضتنا وها هي الجنسيّة الأعجميّة حلم أجيالنا الطّالعة، كلٌّ يعمل لأجل حيازتها، وهي حكمٌ أعجميٌّ أسوأ من الحكم العسكريّ إنّها تسلخ الإنسان العربيّ من أرضه وثقافته وتجتثّه من جذوره، فيضيع في بلاد الغربة روحياً وحضارياً وثقافياً.
هذه هي حالنا، نحن العرب اليوم، بعد مرور أكثر من ألف سنة على ثورة المتنبيّ ودعوته الصّارخة إلى نهضة العرب ويقظتهم من سباتهم. إنّ شعر المتنبيّ هو الشِّعر العابر مساحات الزمن الشّاسعة ولا يتعب ولا يضلّ الطريق إلى الحقيقة والنّور هو العابر بوادي العرب يملأها ضجّةً وثورةً، ولكنّ قومه ما يزالون نائمين في خيامهم والبيداء العربيّة يُحرقها الهجير ولم يتفجّر فيها ينبوع ماء ولم تُظلّل رمالها المشتعلة واحة نخل. إنّه الجدب في الحضارة والعقم في الابتكار والاختراع والإبداع. إنّ بيت المتنبيّ المذكور آنفاً هو روح الحداثة في الشّعر، إنّه بعد مرور زمن طويل وقرون عديدة على قوله ما يزال يحكي وجعنا القوميّ وتخلّفنا الحضاري وضعفنا بين الأمم في ميادين السّياسة وصناعة التكنولوجيا وإنجاب القيادة العربيّة الفذّة الّتي تشفي صدور القوم من كلّ شعور بالهزيمة والتقهقر وتردّ كيد المعتدين إلى نحورهم، لقد عاش المتنبيّ مجد العروبة في حاضرة سيف الدّولة في حلب، وصوّر انتصاراتها بقصائد من الشّعر الملحميّ ويظنّ القارئ لروعة الصّور والمشاهد الّتي يراها في تلك القصائد الملحميّة أنّه يتوهّم ما يرى وأنّ ما يراه ليس سوى خرافات وأساطير مقارنة مع حال العرب اليوم الّذين انهزموا أمام شراذم اليهود الصهاينة، وليس هذا وحسب، بل إنّهم أشعلوا الحروب والفتن والأحقاد فيما بينهم تلبيةً لرغبة ملوكهم العجم. إنّ قروناً عديدة مضت على موت الخلافة العربيّة العبّاسيّة والعرب يزدادون ضعفاً وانهزاماً، ولم يستطيعوا أن يخطوا خطوة واحدة في طريق العلم والحريّة.
إنّ ملوك العرب هم عبيد لدى ملوكهم العجم، وهم يتسابقون للتقرّب منهم ونيل رضاهم والحظوة العظيمة عندهم، ويبقى الشّعر هو النّور الذي يُزيل الغشاوة عن الأعين، ويبدّد الجهل بالمعرفة حين يُلقى على أسماع النّاس الّذين يقدّرون الكلمة ويُصغون بقلوبهم إليها. إنّ الشِّعر هو الحقيقة السّاطعة بخلاف رأي أولئك الّذين يعتبرون الشِّعر انزياحاً عن الحقيقة والواقع، هو انزياحٌ عنهما فنيّاً ولكنّه ملتصقٌ بهما مضموناً وأَرَباً. إنّ القصائد الملحميّة التي قالها المتنبيّ هي تصويرٌ للحقيقة لبطولة العرب بقيادة سيف الدولة، ولكنّ الصورة فنيّة جماليّة، وعلى القارئ ذي العقل أن يدرك هذه العلاقة الخفيّة بين الشِّعر والواقع، بين الشِّعر والحقيقة، وحين لا يتصل الشِّعر بالإنسان والحقيقة يفقد جدواه ويضلّ الطريق إلى أربه العظيم، وهو التّغيير الاجتماعي والثّورة على الطّغاة والجهل، وبثّ نور المعرفة في ظلام الجهل. إنّ الحداثة الشعريّة لا تتنافى مع كون الشّعر مرتبطاً بالحياة والمشكلات الاجتماعيّة والانسانيّة ، بل هي تنافي أن يُكتب بأسلوب واقعيّ مباشر، وتدعوه إلى توثيق علاقته بالإنسان والحياة وما الشِّعر من دون الإنسان وتفاعله معه سوى هلوسة يؤدّيها الشاعر، وقد يحمل الشّعر رسالة الحياة بوجود الإنسان الغائب عن الحياة، فيعيش الشّاعر حينئذ الغربة والمرارة كالمتنبيّ الّذي ما يزال شعره من عهده إلى عهدنا يحاول إيقاظ العرب من سباتهم وإخراجهم من ظلام جهلهم من دون جدوى.
إنّ الشّاعر الأصيل في كلّ فترة يؤدّي رسالته كاملة بصدق ووفاء، ولكنّ الذّنب لا يكون ذنبه إنْ هو فشل في صناعة التّغيير، بل هو ذنب النّاس الّذين ليسوا أهلاً للكلمات وفهمها والأخذ بمعانيها لأنّ سعيهم وراء زخرف الحياة أعمى بصائرهم وجعلهم يفقدون البوصلة الّتي تُفضي بهم إلى الحريّة والكرامة. إنّ الشّاعر في كلّ عصر هو طليعة قومه وقائدهم في المعنى الروحيّ والوجدانيّ، ولكن على قومه أن يدركوا هذه القيادة النّظيفة ويأخذوا بحكمتها، ولكنّ السواد العربيّ، عبر حركة تاريخه، خاضعٌ للسلطان مندهشٌ بعظمته منشغلٌ بأخباره، وهذه هي المشكلة التي آلمت المتنبيّ، وهي غربته على أرض العرب عموماً وعلى أرض مصر خصوصاً، وكيف لا يتألّم المتنبيّ وهو بين المصريين منسيٌّ وكافور مطاعٌ من العضاريط الرعاديد!!!. أوليس كافور في قصيدة المتنبيّ (لا تشتر العبد) رمزاً لحكّام العرب لملوكهم ورؤسائهم جميعاً من دون أن نثتثني أحداً منهم، أوليس هجاء شاعرنا ثورةً حقيقيّة على الحاكم العبد الّذي لا يصلح في كلّ الأحوال لأن يقود البلاد والعباد إلى الحريّة والرقيّ، بلى إنّ قصيدة (لا تشتر العبد) هي النّموذج الأنجح في التّعبير عن الثّورة على الحاكم الّذي لا يصلح أن يكون قائداً ناجحاً، وإنّ كلّ بيت من أبياتها تقصّر عن تأدية مضمونه وتحديد غايته وصناعة الصورة الفنيّة فيه قصيدةٌ حديثةٌ، ولهذا أدعو إلى إمعان النّظر والتّأمّل في شعر المتنبيّ، وأن نقرأه قراءة جديدة.
إنّ قصيدة (لا تشتر العبد)؛ قصيدةٌ صنّفها الدّارسون والنّاقدون السلفيّون والجدد تصنيفاً ظالماً ومقصّراً، إذ اعتبروها هجائيّة، وهي عندهم تنتمي إلى فنّ الهجاء، وهي تمثّل بحقّ أعلى درجات الثّورة، ثورة الشّاعر على الحاكم العاجز عن الفعل الإنسانيّ الجميل، فكيف يستطيع في عجزه أن يصنع للشعب الحريّة والكرامة والنّصر؟
إنّ هذه القصيدة المذكورة تدحض آراء الّذين جعلوا للشكل دوراً في صناعة الحداثة الشعريّة، إذ “لا تعريف موحّداً للحداثة، بل جملة مقوّمات متداخلة مترابطة، يختار أصحاب التوجّهات المختلفة عدداً منها لصياغة ما يتناسب مع مواقفهم ويدعمها”(5) وفي غياب التّعريف الموحّد الّذي يُثبت هويّة الحداثة يجب علينا ألّا نكون أُسارى الآراء التي تُقال فيها، ويجب ألّا نكون متشبّثين بمفهمومٍ واحد عنها وإن صدر عن مرجعيّة عظيمة في الفكر والثّقافة فمن غير الممكن والمنطقيّ أن تصير الحداثة – وهي تسعى إلى التحرّر من قيود التخلّف والسلفيّة والجمود الفكريّ- سجناً لا خروج منه لمن دخله. إنّ الحداثة حركة إبداعيّة تحرّريّة لا تنتشر إلّا في مجتمع حرّ أو قابل للحريّة، لا تستمرّ في مجتمع تحكمه الرجعيّة الفكريّة، وحداثة المتنبيّ مثالٌ صادقَ ينطبق على هذا الرأي، لقد انتشر شعره بين العرب أكثر من أيّ شعر كُتب لشعب من الشعوب، بيد أنّ العرب لم يعملوا بكلماته وحكمه، فظلّت ملوكهم عجماً، بل عبيداً للعجم، وظلّ الجهل مهيمناً على عقولهم يغشاها، ويسدّ أمامهم المنافذ إلى النّور. إنّ رؤية المتنبيّ الحديثة للأمور في زمانه جعلته ينتج شعراً حديثاً يظنّه القاصرون عن فهم روح الحداثة شعراً قديماً مضى عليه الدهر ولو كان هكذا لما ظللنا بحاجة إليه وإلى معانيه لاستنهاض ذاتنا الفرديّة والقوميّة، ولهذا ” لا تنتهي الحداثة وإنّما تكون مرحلة ما بعد الحداثة متضمّنة في الصيرورة التّاريخيّة لمسيرة الحداثة، فالحداثة بطبيعتها دائمة وعمليّة مستمرّة”(6). لقد استمرّ شعر المتنبيّ حضوراً ولكنّ العرب فقدوا الصيرورة، بل فقدوا الطريق إليها ولم يصلوا إلى أسبابها، ما زالوا يعيشون في كينونة الأجداد وأوهامهم التاريخيّة. إنّ عودة أيّ شعب من الشّعوب إلى أمجاده التاريخيّة هي بسبب عجزه حتماً عن الدّخول في صيرورة فكريّة وحضاريّة وإنتاجيّة، وهو حين يعجز عن صُنع الصيرورة يستقبل ما تنتجه صيرورة الشّعوب من غير أن يستطيع الدّخول فيها كالأرض العطشى تشرب كلّ ماءٍ يأتي إليها، أمّا الأرض التي ارتوت ماءً، فهي ترفض الماء الآتي، فيذهب عنها لتشربه أرضٌ عطشى تحتاجه لأجل استمرارها في الحياة. ولأنّ تخلّف العرب عن الأمم والشعوب عظيمٌ عظيمٌ، مخيفٌ مخيفٌ بتنا نسأل في دهشة: هل المشكلة في العقل العربيّ، أم المشكلة في طريقة التّفكير، إنّ المشكلة حتماً في طريقة التّفكير، فمن غير المنطقيّ والعقليّ أن تكون المشكلة في العقل سواءٌ أكان العقل المتخلّف عن الإنتاج عربياً أم أجنبياً، ولو أقررنا بوجود هذه المشكلة فإنّ إقرارنا يعني أنّ سببها تكوينيّ، وهذا السّبب غير منطقيّ وغير عقليّ، لأنّ تكوين العقل واحدٌ فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وهو من سلالة طينيّة واحدة، ولكنّ الله أوجب على الإنسان الاجتهاد والسّعي ليميز العامل من الخامل والعالم من الجاهل، ولهدف أسمى وهو إعمار الحياة في صيرورة مستمرّة. إنّ الفرق بين أمّة متقدّمة منتجة في الفكر والفنّ والصناعة وأمّة متخلّفة عن ركب التقدّم والإنتاح سببه العقل، وهو الفرق بين عقل رجعيّ وعقل تقدميّ. إنّ الله فرض على عباده العمل وطلب منهم الزيادة من العلم وبيّن الفرق في المكانة بين العامل والخامل والعالم والجاهل، فثمّة أممٌ مشت في طريق الحداثة الشاملة ووصلت إلى الأرب المنشود وأمم ارتضت بالقعود. إنّ الحداثة ” ليست مذهباً سياسياً أو تربوياً أو نظاماً ثقافيّاً واجتماعيّاً فحسب، بل هي حركة نهوض وتطوير وإبداع هدفها تغيير أنماط التّفكير والعمل والسلوك، وهي حركةٌ تنويريّة عقلانيّة مستمرّة هدفها تبديل النظرة الجامدة إلى الأشياء والكون والحياة إلى نظرة أكثر تفاؤلاً وحيويّة”(7) إنّ المتنبيّ الذي هو محور بحثنا وقد اعتبرناه فيه أساس الحداثة في الشِّعر لم تكن نظرته إلى الأشياء والأحداث والأمور جامدة، بل كانت نظرة اسشرافيّة مشمئزّة من الواقع الاجتماعيّ السياسيّ الرديء الذي كان يعيش فيه، كانت نظرة سابقة العصر آنذاك، ولهذا استمرّ شعره حياةً ونبضاً وضجيجاً وثورة، هذه الاستمراريّة لشعر المتنبيّ دليل على أنّ حال العرب الاجتماعيّة والسياسيّة ما زالت كما كان يراها منذ أكثر من ألف سنة، حين تسبق حركة الحياة الشِّعر بمعانيه ودلالاته أيّاً كان عربياً أو أعجمياً هذا دليل على جموده وعدم استطاعته مواكبة الأحداث فيتخلّف ويصبح سلفياً وهذا مثال الكثير من الشعر العربيّ والأعجميّ أمّا حين يوافق الحياة، برغم مضيّ زمن طويل على كتابته فهذا دليل حداثته وحيويته، وفي كلّ حال إنّ شعر المتنبيّ لا يعتريه الموت وإن تقدّم العرب تقدّماً عجيباً وهذا حلمنا العظيم- لأنّه شعرٌ مفعمٌ حكمةً ومعرفةً أو هو يحفّز الإنسان إلى الثورة والتّغيير من دون كلل، وكلّ أمّة وإن تقدّمت تقدّماً مذهلاً في ميادين الإبداع كافّة هي بحاجة إلى أن تعيش الثّورة الدّائمة وإلّا ستصل إلى درجة في التقدّم لن تستطيع تجاوزها، فتصل أمم كثيرة إليها- متخلّفة عنها وربّما تسبقها، وعلى الشاعر الذي يريد البقاء لشعره حيّاً وفاعلاً أن تكون لديه نظرةٌ إلى الأمور كنظرة المتنبيّ، أن تكون لديه نظرةٌ تثقب جدار زمنها وتحدث فيه كوّة ترى من خلالها أحداث الأزمان القادمة، وهذه النّظرة الثّاقبة لا يمتاز بها إلّا الشّاعر العبقريّ الذي لا تلده الأمّة إلّا قليلاً، وقد أكّد المتنبيّ أنّه استثناء في زمانه بين الشّعراء وأنّه المتفرّد المتميّز في قوله:
ودع كلَّ صوتٍ غيرَ صوتي فإنّني أنا الطائر المحكيُّ والآخر الصدى(8)
لقد توهّمَ من اعتبر أنّ الحداثة في الشّعر هي التّغيير في شكل القصيدة العربيّة العموديّة، ثمّ يعقبه التّغيير في المضمون وقد ترسّخ هذا التوهّم عند المتخصّصين الأدبيين حين اعتبروا أنّ كلّ قصيدة تأخذ شكلاً جُمليّاً غير عموديّ حديثة، والحداثة الأصيلة لا تأخذ شكلاً ولا ترتبط بنظام عروضيّ، إنّما هي فكرة حديثة مولودة من نظرة حديثة يمكن صياغتها في قصيدة عموديّة أوتفعيليّة، وقد اعتبر أدونيس في مقال له عن الحداثة معتبراً” أنّها أوهام تتداولها الأوساط الشعريّة العربيّة وتكاد على المستوى الصحفيّ- الإعلاميّ- أن تخرج بالحداثة عن مدارها، عدا أنّها تُفسد الرؤية وتشوّه التقييم”(9). إنّ رأي أدونيس ههنا بالغ الأهميّة، فهو يشير إلى أنّ ما يتمّ تداوله حول تحديد مفهوم الحداثة في الصّحافة والإعلام هو تنظير ضبابيٌّ بعيد عن حقيقة الحداثة وجوهرها، بل إنّ التنظير الضبابيّ يجعل الرؤية مغشّاة فيمنعها من إدراك الحقيقة، وهذا الرأي يقينيّ صادرٌ عن شاعر خاض ميدان الحداثة رأيّاً وتطبيقاً، ولكي نجلّي نحن حقيقة الحداثة في الشعر، فقد أسمينا دراستنا (الحداثة الشّعريّة بين النّظريّة والتّطبيق)، إذ إنّ الرأي في الحداثة شيء وتطبيقها في الكتابة شيءٌ آخر، وقد قال الكثيرون آراءهم في الحداثة الشعريّة منهم الفاهمون ومنهم غير الفاهمين والمتخصّصون وغير المتخصّصين، ويصلح أن تُعتبر هذه الآراء مزاجيّة، وقد تسابق المتكلّمون عن الحداثة الشعريّة ليثبت كلّ واحد منهم تفوّقه على غيره، والرأي الصواب لا يكون بدافع التّسابق والتّباري، بل يكون بدافع التعقّل والتفكّر، إذ ليست الحداثة لعبةً في ميدان كلُّ يريد أن يسبق غيره إلى الفوز، إنّها حركة إبداع مستمرّ لا تقبل الخمول والجمود، تدأب على صنع التغيير الجوهريّ غير الشكليّ في كلّ الميادين والمجالات خصوصاً الشّعر، إنّها حركةٌ تفيد الحياة، وهدفها تفوّق المجتمع وليس تفوّق الإنسان فرداً. هدفها تفوّق الإنسانيّة جمعاء، وليس تفوّق شعب على آخر، وقد أشار أدونيس في مقاله (بيان الحداثة) إلى ما أسماه وهم المماثلة “ففي رأي بعضهم أنّ الغرب مصدر الحداثة، اليوم بمستوياتها الماديّة والفكريّة والفنيّة. وتبعاً لهذا الرأي لا تكون الحداثة خارج الغرب، إلّا في التماثل معه. ومن هنا ينشأ وهمٌ معياريّ تصبح فيه مقاييسُ الحداثة في الغرب، مقاييس للحداثة خارج الغرب. وهذه نظرة تصدر عن إقرار مسبق بتفوّق الغرب، ولهذا فإنّ أصحابها والدائرين في فلكها ينعون دائماً على الشعر العربيّ تخلّفه وتقصيره عن اللّحاق بالشعر الغربيّ. كما ينعون على الحياة العربيّة، إجمالاً، تخلّفها وتقصيرها عن الحياة الغربيّة”(10) .وفي الحقيقة أنّ لكلِّ شعب أدبه الخاصّ الذي يحمل هويّته، ويعبّر عنه وعن قضاياه تعبيراً يلائم واقعه ومستقبله أو يخفق في التعبير إذا صدر عن أديب ليس لديه طاقة إبداعيّة تمكّنه من قراءة الواقع واستشراف المستقبل القريب والبعيد. من الظلم أن يُقاس الشعر الغربيّ بالانكليزي أو كلاهما بالشعر العربيّ، وكما لدى الفرنسيين فيكتور هيجو وروفائيل لامرتين ولدى الإنكليز شكسبير، كذلك لدى العرب المتنبيّ وأبو تمام وغيرهما كثير من الشعراء الأعلام الذين استمرّوا عطاءً إلى عصرنا، ويحقّ للعرب- وخصوصاً إذا أخذوا في الاعتبار والقياس الأسبقيّة الزمنيّة أن يفخروا بالمتنبيّ شاعراً عبقرياً أكثر من الفرنسيين بلامارتين والانكليز بشكسبير، فمن الظلم الشّنيع أن نقيم مقارنة بين قصيدة وأخرى سبقتها بقرون عديدة أو بين شاعرين تفصل بينهما مدّة زمنيّة طويلة، وأنا لديّ الجرأة أن أقول: المتنبيّ برغم أسبقيّته الزمنيّة فهو يمثّل عبقريّة شعريّة لم يستطع الدّهر تجاوزها، وهي عبقريّة ما زالت تخاطب الإنسان في كلّ مكان وكلّ زمان:
كلّما أنبت الزمان قناةً ركّب المرءُ للقناة سنانا(11)
لا يجد القارئ المتخصّص صعوبة في إدراك الرسالة الإنسانيّة التي يحملها هذا البيت في قصيدة تعجّ بالمعاني التي تدعو إلى السّلام ونبذ الحرب وإنّ العالم اليوم بكافّة شعوبه وأممه هو بحاجة شديدة إلى الاقتداء بقيم المتنبيّ والعمل بجدّ من أجل الوصول إلى الغاية الإنسانيّة السّليمة التي طمح إليها في البيت السابق. إنّ العالم اليوم الّذي أبدع إبداعاً عظيماً في صناعة التكنولوجيا المدنيّة والعسكريّة يوبّخه المتنبيّ في شعره الّذي مضت عليه قرون من الدّهر على التّقاتل بين شعوبه، يوبّخ الإنسان الّذي تعيش في نفسه بذرة الشّرّ والحقد، ويُسابق أخاه إلى صناعة السّلاح الّذي يمكّنه من قتله. إنّ البيت السّابق يُظهر أنّ الشّاعر يفهم طبيعة النفس الإنسانيّة فهماً عميقاً، وما زال البيت المذكور يصلح إلى يومنا دعوة إلى السّلام ونبذ الحرب والتباغض بين الشعوب، فليست الحداثة في التكنولوجيا والتطوّر الاجتماعيّ والمدنيّ، إنّما الحداثة في جوهر الإنسان، الحداثة في أن يحقّق الإنسان إنسانيته ويفيد بها الحياة. إنّ القنبلة الذريّة التي ألقيت على هيروشيما في اليابان خلال الحرب العالميّة الثانية تمثّل ذروة التطوّر في صناعة التكنولوجيا الحربيّة وتكنولوجيا الدمار الشامل، ولكن هل هذا السلاح الدي دمّر مدينة هيروشيما دماراً شاملاً من الحداثة في شيء. الحداثة ليست تخريباً ودماراً، إنّما هي تغيير في البناء أو هدمٌ لبناء أجمل وأنفع، وليست قتلاً، وبرأيّي إنّ الّذين رفضوا الحداثة الشعريّة رفضوها لخوفهم مِنْ أنّ الحداثة تعني القضاء على التراث الشعريّ، وهي ليست كذلك في حقيقتها وجوهرها، ولأنّها ليست كذلك، فنحن خصّصنا في دراستنا هذه فصلاً أسميناه (المتنبيّ أساس الحداثة) لنؤكّد أنّ الحداثة في الشّعر لا تعني تجاوز العصور الشعريّة السابقة، أو إلغاءً للقصيدة العموديّة، إذ هي ليست شكلاً، كما ذكرنا سابقاً، إنّما هي نظرة وفكرة جديدتان والفكرة الجديدة وليدة النّظرة الجديدة، فالإنسان ينظر في جوهر الأشياء متأمّلاً ثمّ يفكّر تفكيراً جديداً، حينئذٍ يحدثُ في جوهر الكتابة ما لم يكن مألوفاً، وهذا يعني أنّ الشاعر المعاصر يستطيع أن يكتب قصيدة عموديّة حديثة وأن يكتب قصيدة تفعيليّة قديمة، فالأولى حديثةٌ في مضمونها والثانية قديمة في مضمونها أيضاً. فبرأيي ليس للشكل أيّ اعتبار في معيار الحداثة الشعريّة، لهذا لا بدّ في هذا السّياق من الدّعوة إلى الكتابة الإبداعيّة الّتي تصف الحياة معبّرة عنها في تحرّر من وهم الشّكل والنّظام العروضي، يجب على الشاعر ألّا يهتمّ لصورة القصيدة الخارجيّة، بل يهتمّ لمضمونها، يهتمّ لصورتها الداخليّة.
إنّ السيّارة- وهي مثالٌ للاختراع التكنولوجي- تسير سيراً بطيئاً ومتعثّراً بمحرّكٍ قديم وإن كان شكلها (هيكلها) حديثاً وهي تسير سيراً سريعاً حيوياً بمحرّك حديث وإن كان شكلها (هيكلها) قديماً. ومثال السيّارة هو -تماماً- كمثال الإنسان، فالإنسان يكون حديثاً بعقله وليس بصورته الخارجيّة. إنّ جمال الإنسان في صورته لا يجعله إنساناً مبدعاً ومحدثاً، وكذلك القبح في صورته لا يجعله جاهلاً ورجعياً. إنّ العقل هو الأساس في خَلْق الحداثة، والمتنبيّ شاعر العقل، ولهذا السبب العقليّ هو شاعرٌ لم تُلغه الحداثة الشعريّة، بل أثبتت عبقريّته: ولكنّنا- نحن العرب – مولعون بالجدل والتنظير، ويؤثّر فينا ما ينشره الإعلام تأثيراً كبيراً، وإذا أراد أحدنا أن يُفحم محاورَهُ في مسألة، فيقول له: لقد شاهدت كذا على شاشة التّلفزيون، أو سمعته عبر الإذاعة، أو قرأته في الصّحيفة، وهذه الإحالة لا تشير إلى الصّدق الحاسم فيما ينشره الإعلام، إنّما تُشير إلى تأثير الإعلام في عقل الإنسان العربيّ ووجدانه، وتُشير إلى أنّه إنسانٌ انفعاليٌّ غير عقليّ إذ لا تسيطر سلطة الإعلام إلّا على الّذي يتفاعل مع الخبر المنشور من غير مراجعة وتدقيق. إنّ الإعلام لا يستطيع السّيطرة على الإنسان العاقل، لأنّه يحيل الأمور دائماً إلى عقله ومتحرّر من الانفعال السريع، وإن هو انفعل مع الخبر بعد تأكّده من صدقه، فيأتي حينئذ عاقلاً غير متهوّر لأنّه محكوم بالعقل، والانفعال السريع هو بسبب ما أسماه أدونيس (الوهم)، ويجب أن نبوح- نحن العرب- بعللنا، وهي كثيرةٌ، وأعظمها الوهم. إنّ الإنسان العربيّ واهم، محكومٌ بالوهم، وقد وصل به التوهّم إلى ابتعاده عن العقل والمنطق ابتعاداً مطلقاً، فهو على سبيل المثال- بعد ما يقارب- مرور مئة سنة على اغتصاب فلسطين والأرض العربيّة، وهو اغتصابٌ معلنٌ لا لبس فيه ولا خوف، ما زال يخضعه للمؤامرة، فالأعداء وحلفاؤهم يحاربوننا حرباً معلنة، ونحن نقول: إنّهم متآمرون. إنّ الأعداء في مثل هذه الحال التي نوصف بها- نحن العرب- يرتاحون في اقتراف الجرائم الفظيعة المستمرّة، فهم ليسوا مجرمين، بل متآمرون، وليس الذنب ذنبهم، بل ذنب المؤامرة. لم تفلح أمّة قد ابتعدت عن العقل عبر العصور التاريخيّة، بل لم يفلح إنسانٌ أخذ بالشائع والمذاع ولم يُعمل عقله.
إنّ الحداثة حين ظهرت ظهورها الأوّل في الشعر العربيّ اعتبرها العرب كاغتصاب فلسطين مؤامرة. إنّ كلّ ما يحدث في حياة العربيّ هو بسبب المؤامرة ونتيجةٌ له. إنّها الوهم المهيمن علينا، ويجب أن نتحرّر من سلطته. إنّ العروبة هي حتْماً لن تستطيع أن تتحرّر من أعدائها وقد كبر فينا وهم المؤامرة حتّى أصبح نصرُنا- في عقيدتنا- على الأعداء مستحيلاً، فهم لا يُقهرون ولا يُهزمون. متناسين قول الله تعالى: ﴿وكان حقّاً علينا نصرُ المؤمنين. ﴾ (12)
إنّ الإنسان حين يؤمن بفكرة الحداثة التي هي دعوة دائمة إلى التغيير في جوهر النّفس والحياة هو يؤمن بسنّة الله في خلقه: ﴿ إنَّ الله لا يغيّر ما بقومٍ حتّى يغيّروا ما بأنفسهم ﴾(13). وهو حينئذٍ يتحرّر من سلطة الوهم والمؤامرة، لأنّ الحداثة تُلزم من يؤمن بها العمل بثقة ثابتة لا تتصدّع مهما أصابته النوائب والنكبات.
إنّ الإنسان المنهزم الذي افتقد في ذاته قوّته المجابهة والمقاومة يرفض الحداثة، ويكفر بكلّ ما تأتي به، وهل استطاعت مقاومة شعب من الشّعوب، أو أمّة من الأمم الانتصار على عدوّها، وهي ترفض الحداثة فِكْراً ومنهاجاً وسلاحاً. إنّ الحداثة قدرنا الحتميّ، نحن العرب، قدرنا الذي لا مفرّ منه، وعلينا أن نتقبّل قدرنا الجميل بإيمان، وإذا رفضناه، فنحن نخالف سنّة الله في خلْقه والحياة.
إنّ الطّبيعة بكلّ عناصرها تتجدّد اطّراداً، ونحن البشر جزءٌ منها، فيجب علينا أن نتجدّد لكيلا نكون خارجها متناقضين مع سنّتها وقانونها. السبب الرئيس في جعلنا، نحن العرب متخلّفين عن سائر الأمم هو فكرنا الرجعيّ وإيماننا الدائم الذي نتوارثه جيلاً عن جيل بأنّ ليس في الإمكان أفضلُ ممّا كان، يجب على الإنسان العربيّ أن يكون صريحاً صادقاً مع نفسه مؤمناً إيماناً شديداً بأنّ خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيّوبي وكلَّ الفاتحين العظماء الذين أنجبتهم الأمّة عبر مراحل تاريخها الطويل، لا يستطيعون اليوم هزيمة اميركا وإسرائيل بالسيف والرمح والخيل، والأمر العظيم الأهمّ الذي لا بدّ من الإشارة إليه، هو أنّ هؤلاء الفاتحين الأجلّاء يرفضون خوض المعركة الحديثة في ميادين الأعداء بالسّيف والرّمح والخيل، لأنّهم كانوا قادةً عباقرةً أفذاذاً في زمانهم، ولم ينتصروا على الروم والصلبيين بالسّيف فقط، بل انتصروا عليه بالعقل والتدبّر والمعرفة والحداثة، ولو لم يكونوا ذوي فكر تنويري يؤمن بالتجدّد والتحديث لما استطاعوا بناء الامبراطوريّة العربيّة الإسلاميّة وتجربة الخليفة الأمويّ معاوية بن أبي سفيان الّذي انتصر على الروم في معركة ذات الصواريّ البحريّة خير دليل على إيمان القادة العرب القدماء بفكرة الحداثة. إنّ الإيمان بالقول: ليس في الإمكان أفضل ممّا كان دعوةٌ إلى الجمود ورفضٌ لسنة التغيير الذي حثّ الله عباده على العمل لأجل إنجازه في نفوسهم ليصير حقيقةً في حياتهم. إنّ الإيمان بهذا القول هو يناقض طبيعة الإنسان، يناقض فطرته، فهو راغبٌ دائماً بكلّ تحوّل إذ لا يأكل طعاماً واحداً في كلّ يوم، وليس يلبس رداءً واحداً طيلة عمره، وهذا التغيير الذي يرغبه الإنسان في تفاصيل حياته يؤكّده قول الله تعالى﴿ وإذْ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربّك يخرج لنا ممّا تنبت الأرض من بقلها وقثّائها وفومها وعدسها وبصلها﴾(14) وإذا كان الإنسان راغباً بالتغيير في تفاصيل حياته، فلماذا يرفضه في الأدب والفكر ومجالات الإبداع كافّة؟!. ثمّ إنّ الحداثة هي نتيجة طبيعيّة للتفكّر والتدبّر اللّذين حثّ الله بهما الإنسان على العمل بهما، وهاتان ميزتان يتميّز بهما الإنسان عن سائر ما خلق الله من كائنات فالإنسان يظلم نفسه ويحقّرها حين لا يرقّيها في فضاءات الفكر والابداع والتّحديث، يظلمها حين يساويها بالبهائم الّتي بالغريزة تسعى إلى طعامها وشرابها مكتفيةً بهما لأنّها لا تملك ملكة التفكّر والتدبّر. إنّ الله خلق الإنسان وفضّله على كلّ ما خلق تفضيلا ليُعمّر الأرض ويبتدع ويخترع، فكيف له أن يضلّ الطريق ويبتعد عن الأرب وينكر نعمة الله عليه؟!. إنّ الإنسان هو حقيقة هذا الوجود، وهو جوهر الحياة، ولولاه لما خلق الله الحياة، وهي إن خُلِقتْ من دونه، فتكون بلا جمال وبلا معنًى وبلا رسالة. إنّ الذي يرفض الحداثة فكراً وعملاً ومنهاجاً، هو يرفض فطرته الآدميّة الأولى، هو يرفض الصيرورة لأنّه يجهل معناها ومؤدّاها. إنّه يرضى بالكينونة عَجْزاً عن العمل والاجتهاد، فيرضى بالقعود والكسب؛ وإنّ الّذين يدعون اليوم إلى السلفيّة في مجالات مختلفة وليس في الإسلام فقط، هم عاجزون عن صناعة التغيير، والسلفيّة هي كالحداثة يمكن أن تكون وتؤخذ منهاجاً في كلِّ عمل وليس في الإسلام وحده دون غيره، ولكنّ الفكر السلفي قد نجد له مبرِّراً ضعيفاً في ،غير الإسلام، أمّا في الإسلام فهو مرفوض وغير مبرَّر، لأنّ الإسلام يدعو إلى التّغيير الذي لا يكون إلّا بالانفصال عن السلف ورفض الكينونة وهذا يعني رفض ما كان عليه الأوّلون فلهم أعمالهم ولنا أعمالنا وسوف يلقون حسابهم عند الله وسوف نلقى حسابنا ولن نسأل عمّا كانوا يعملون. إنّ عدم سؤالنا من الله عن عمل الأوّلين هو دليل قاطع على انفصال الخلف عن السلف؛ وارتباط السلفيين بالسلف هو بسبب خضوعم لسلطة الوهم الّتي تجعلهم يظنون أنّ انفصالهم عن السلف هو كفرٌ وخروج عن أصول الدّين وهذا الظنّ هو الوهم عينه، إذ إنّ أصول الدّين في الكتاب وليست في عمل أيٍّ من المسلمين، ولو تحرّر السلفيّون من سلطة وهمهم لقبلوا التغيير والتحديث، بل لعملوا لأجلهما من غير كلل ولا ملل. إنّ المسلمين الأوائل، وأعني بهم صحابة النبيّ (ص)، لم يكونوا سلفيين في الفكر والمنهاج، ولم يقنعوا بما أنجزه النبيّ وحسب، بل غيّروا ما بأنفسهم وحدّثوا الجيوش، وكانوا يغيّرون القادة وفاقاً لما تقتضيه ظروف المعركة وميدانها، ولو أنّهم رضوا بالدولة التي أسّسها النبيّ لما فتحوا البلدان ونشروا الإسلام وكما بيّنا آنفاً أنّ الحداثة في الشّعر ليست شكلاً خارجياً هي كذلك في كلّ شيء، وقد سُقْنا في معرض حديثنا عن الحداثة مثال الإنسان في مضمونه وصورته، ومثال السيّارة، إنّ الزخرف ليس دليل حداثة، وأيضاً هذا يتوافق مع فهم أبي شبكة للشعر، إذ اعتبر في قصيدته الشهيرة (اجرح القلب) انّ الشِّعر في مضمونه الحيّ، وليس في زخرفه وألفاظه المنتقاة، فالشعر عند أبي شبكة هو الشّعر الممتلئ حياةً وشعوراً وألماً وحزناً وليس الشعر رنيناً وأناقة بغير جمال داخليّ. إنّ فهم أبي شبكة للشعر يوافق رأينا في الحداثة، فهي- كما بيّنا- ليست صورة خارجيّة، بل هي مضمون ممتلئ دلالةً وإيحاءً وترميزاً؛ ومن قصيدة اجرح القلب إليكم الأبيات الآتية:
اجرحِ القلبَ واسقِ شعرَكَ منه
فدم القلبِ خمرةُ الأقلامِ
وإذا أنت لم تُعذَّبْ وتغمسْ
قلماً في قرارةِ الآلامِ
فقوافيكَ زخرفٌ وبريقٌ
كعظامٍ في مدفنٍ من رُخام(15)
إنّ الكثيرين من الّذين كتبوا عن الحداثة في القرن الماضي قد جاءت آراؤهم في تعريفها خاطئة، وقد أثّرت آراؤهم في تضليل المتخصّصين في الأدب الّذين يدرسونه ويدّرسونه، فصاروا يكتفون بنظرة واحدة إلى صورة القصيدة الخارجيّة ليحكموا عليها حُكْماً غير قابل للمراجعة، فهي عندهم قديمة إذا كانت عموديّة الشكل، واتبعت نظام البيت، وحديثة إذا كانت تفعيليّة، واتبعت نظام الجملة، وفي هذا الحُكْم تضليل للمتخصّص والباحث وإخفاءٌ لجوهر الحداثة.
لقد كثر الحديث في موضوع الحداثة الشعريّة عن الشكل والمضمون وقد تساءل المتحدّثون: هل الحداثة في الشكل أم في المضمون أم فيهما معاً، وهذه الإشكاليّة شبيهةٌ بإشكاليّة العلاقة بين اللّفظ والمعنى، وهل البلاغة في اللّفظ وحده أم في المعنى وحده أم هي فيهما معاً، لقد اختلف اللّغويّون العرب القدماء حول تحديد موضوع البلاغة في التعبير، فمنهم اعتبرها في اللّفظ ومنهم اعتبرها في المعنى ومنهم اعتبرها فيهما معاً متّحدينِ متفاعلينِ، ومنهم من اعتبر البلاغة في العبارة التي تولد مكتملةً بواسطة العلاقات المشتركة بين الكلمات في السياق النصيّ، وفي الخلاصة: إنّ البلاغة في الكلام تعبّر عن نفسها، وهي تظهر واضحةً فلا تحتاج إلى تأويل، وهي تستولي بتمامها على الأسماع والألباب وهكذا هو مثال الحداثة في الشّعر، فالحداثة ليست في الشّكل وحده، ولكن تكون موجودة في الشّكل القديم، وهي تكتمل نضوجاً في كليهما، أمّا الشّكل الحديث وحده، فهو يقصّر عن المضمون الحديث وحده، إذ لا يستطيع تأدية الرسالة الشعريّة التي تعبّر عن العصر وإنسانه وقضاياه، بيد أنّ المضمون الحديث وحده- كما بيّنا- يستطيع حمل الرسالة الشعريّة الحديثة في قالب قديم، والأمثلة السّابقة من شعر المتنبيّ خير دليل على ما نقوله. إنّ مجتمعنا العربيّ- في كلّ جديد وطارئ- تعوّد الانقسام والجدل العقيم. إنّ الأمم المتقدّمة-وهي كثيرة في زماننا- تصنع الحداثة في كلّ شيء، ونحن ننقسم على تعريفها، ونتلقّى منتجاتها مشترين ومستهلكين. إنّنا بعيدون عن جوهرها ولا دور لنا في صناعتها، فكيف يحقّ لنا التنظير؟!!، وقد يقول مجيب عن هذا السّؤال: إنّ الشّعر صناعة عربيّة قديمة وهم سبقوا جميع الأمم إلى صناعته، فيحقّ لهم الحديث عن الحداثة فيه، ولكنّنا نردّ بدورنا على هذا الجواب الافتراضيّ: إنّ اليونان لهم عراقة العرب في صناعة الشّعر، وربّما هناك أمم أخرى، ثمّ إنّ معنى الحداثة في الشعر- كما بيّنا سابقاً- هو ينطبق على غيره ممّا يبدعه الإنسان وهو ينطبق على الإنسان الذي خلقه الله من صورة ولباب. لا شيء يمكن أن يكون غير خاضع لقياس الحداثة، أو يمكن أن يكون خارج حركة الزمن، وخضوع الأشياء للزمن أو ارتباطها به يجعلها قديمةً إن تخلّفت عنه وحديثةً إن واكبيته. إنّ للزمن حركةً، والحركة تطوّر وانتقال زمنيٌّ ومكانيٌّ، لهذا لا يمكننا أن نلصق بالأشياء صفة الحداثة إن لم نستطع بحركتها الانتقال الزمنيّ والمكانيّ، وهذه النظريّة تتحقّق في الشعر وتنطبق عليه حين ينتقل بقوّة طاقة الإبداع الكامنة فيه من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد بواسطة الّلغة القوميّة التي تجمعهما أو بواسطة الترجمة إلى لغة أجنبيّة، وهكذا يحقّق الشعر- وفق هذا المثال- انتقالاً ثالثاً يُضاف إلى الزمنيّ والمكانيّ، وهو الانتقال من الشّعر إلى اللّغة الأجنبيّة التي دخلها وغزا ثقافتها لكونه شعراً واكب الزمن وحاكى حياة الإنسان من دون الوقوف عند حدود وطنيّة أو قوميّة أو زمنيّة. لا يستطيع الشعر أن يحقّق هذا الانتشار والاستمرار من دون وجود طاقة الإبداع فيه؛ وهذه الطاقة الخارقة يحقّقها الشاعر بتجربته الخاصّة، بثقافته الفريدة، بأسلوبه المتميّز، ولا يستطيع تحقيقها بقوّة المال والسلطة والدعاية، تستطيع هذه الأشياء أن تجعل الشاعر ينتشر بواسطة الإعلان والدعاية، ولكنّها لا تستطيع أن تعطيه الديمومة والجمال. إنّ الخلود بين الشِّعر والشاعر يُكتب للشعر. وإنّما الشاعر يخلد بشعره، هذه هي الحقيقة الّتي لا بدّ من إظهارها وثمّة شعراء كثيرون مرّوا في مراحل تاريخيّة متعدّدة لم يكتبوا إلّا قصيدة واحدة، وقد خُلّدوا بها وذاع صيتهم وشعراء آخرون أمضوا حياتهم وهم يكتبون الشعر، وقد خلّفوا وراءَهم ديواناً ضخماً، ولكنّهم ظلّوا مغمورين لم يُحدثوا في النفوس والقلوب أثراً.
إنّ للكلمات أرواحاً تنجذب إليها أرواح القارئين أو تنفر منها، وهذه الأرواح الّتي أعنيها هنا هي الّتي تميّز المتنبيّ عن غيره في صنعها فتمازجت مع أرواح القارئين والسامعين فكتبت لشعره الحياة الدائمة برغم أنّه تعرّض خلال تجربته الشعريّة لكيد الكائدين وخيانة الخائنين وغدر الغادرين، ولكنّ الكلمات الحيّة تبقى أقوى من هؤلاء الحاسدين الطارئين، ولو أنّ أحداً من الشعراء الذين لم يمتلكوا ميزة المتنبيّ تعرّضوا في حياتهم لمثل ما تعرّض له هذا الشاعر العبقري المكافح، لكان ألقى سلاح الكلمات وأعلن الاستسلام، ولكنّ المتنبيّ أدرك أنّ التميّز في عالم الشعر يحتاج القوّة، وهو بغير القوّة لا يكون في الشّعر وفي غير الشّعر، والحداثة كذلك في الشّعر وغير الشِّعر هي القوّة ، وحين نعتبر أنّ المتنبّي يمتلك قوّة شعريّة، نحن نعطي شعره صفة الحداثة إذ من غير الممكن أن يتجرّد الشّعر من صفة القوّة ويكتسب صفة الحداثة، الحداثة والقوّة صفتان متلازمتان لا تنفصلان في فعل أو عمل.
إذا افتقد الإنسان القوّة تخلّف عن مسيرة الحياة واستقبل الأحداث باستسلام وانهزام. إنّ القوّة تتيح للإنسان في كلّ ما يصنع أن يواكب الحياة، وأن يقدّم صناعةً تخدمها وتعبّر عنها، والشاعر القويّ هو الّذي يكتب شعراً فيه عناصر القوّة، والشّعر الموصوف بالقوّة هو شعرٌ حديث لأنّه يستطيع الالتصاق بالحياة فيصف أحداثها المتنوّعة ويواكب حركتها بغضّ النظر عن شكله، بل إنّ القوّة الشعريّة تتمثّل في الأسلوب وهو أمرٌ فنيٌّ يكتسب أهميّة كبيرة في صناعة القصيدة.
وتتمثّل القوّة في المضمون، فإذا تحقّق هذان العنصران في القصيدة جاءت قصيدةً حديثةً سواءٌ أكانت عموديّة أوتفعيليّة. إنّني لا أرى أيّ دور فعليّ لشكل القصيدة في جعلها حديثة. إنّ الحداثة- كما بيّنا سابقاً- تعني الديمومة والتطوّر المستمرّ ووِفقاً لهذا القياس يمكن أن تكون القصيدة التفعيليّة غير حديثة لأنّها غير قادرة على التطوّر المستمرّ، ويمكن أن تكون القصيدة العموديّة حديثة، وتكون الحداثة فيها مكتملة لأنّها قادرة على التطوّر المستمرّ، فهي قصيدةٌ متحرّكة لا تقف عند حدود زمنيّة، بل تتجاوزها إلى حقب متتاليّة من غير جمود أو توقّف عن الحركة. إنّه لخطأٌ كبيرٌ أن نجعل للشكل وظيفة في تأكيد الحداثة أو نفيها في القصيدة، ليست الكلمات كالتكنولوجيا، إذْ إنّ ما نجده اليوم من صناعات كثيرة حديثاً هو يصبح قديماً حتماً بعد أن تلغيه تكنولوجيا جديدة، كالسيّارات والطائرات والأسلحة وغيرها كثير، ولكنّ القصيدة التفعيليّة برغم مُضيّ عقود على ولادتها والّتي اكتسبت عند الكثير من النّاقدين صفة الحداثة لم تستطع إلغاء القصيدة العموديّة. فالقصيدة الّتي تحوي في مضمونها عناصر القوّة هي الباقية والتي تفتقر لعناصر القوّة هي الزائلة سواءٌ أكانت عموديّة أو تفعيّليّة. إنّ قياس الحداثة أساسه الأسلوب والمضمون ولا يولي أهميّة لغيرهما؛ فما هي الجدوى من قصيدة تفعيليّة الشكل، وهي خاوية المضمون ركيكة الأسلوب؟!!!.
ويلتقي رأينا مع رأي الناقد اللّغويّ Richards إذ يرى” أنّ الكلمة لا يمكن أن تُفهم إلّا من خلال السياق؛ وعلاقتها بالكلمات الأخرى. كما أنّ الشكل لا يمكن أن ينفصم عن الموضوع. وهكذا فمن أراد أن يقرأ الشعر عليه أن يضع هاتين الحقيقتين في ذهنه”(16) . وهكذا يبدو الشكل استناداً لرأي Richards غير ذي قيمة معنويّة وفنيّة بغير الموضوع الذي يتألّف من القضيّة التي يصوّرها بالاشتراك العمليّ الإبداعيّ مع الأسلوب الّذي هو اللّغة الشعريّة في انزياحاتها وصورها البيانيّة ومجازاتها. إنّه من الظلم الشديد أن نحكم على القصيدة في جودتها أو رداءتها من خلال شكلها دونما الإيغال في عمقها الموضوعيّ والأسلوبيّ. إنّ مسألة الحكم في القصيدة كمسألة الحكم في الإنسان، فنحن قد تجتذبنا صورة الإنسان بجمالها وأناقتها، ولكنّ مضمونه، وأعني به لبَّه: العقل والقلب والإحساس، قد يُبطل الاجتذاب بعد التعرّف إليه أو قد يعزّزه؛ والفائدة هنا أنّ الحداثة الشعريّة التي تقوم على تفضيل الشكل على المضمون هي حداثة زائفة، وليس هذا وحسب، بل هي هادمة؛ إنّها تهدم التّراث الإبداعيّ العظيم الذي خلّفه الشّعراء العرب خلال عصور خلت وفي طليعتهم المتنبيّ الذي هو أساس دراستنا هذه وجوهرها.
إنّ الصور لا تُعطي المضامين قيمتها في أيِّ شيء؛ والله بيّن لنا في رسالته أنّ قيمة الإنسان العظيمة كامنة في مضمونه، ولا تكمن في صورته، وحين عظّم رسوله الكريم وخاتم النّبيين محمّداً (ص) عظّمه بأخلاقه: ﴿وإنَّكَ لعلى خُلُقٍ عظيم﴾ (17) ولم يعظّمْهُ بصورته وعشيرته؛ ولكنّ هذه الحقيقة الجوهريّة ذات القيمة الخالدة لا يراها إلّا العاقلون الغائصون في قاع المعرفة؛ أمّا غيرهم فلا يرون سوى زخرف الصورة الذي يطغى على أبصارهم، يسحرها، ويحجب قلوبهم عن الرؤية والمعرفة.
إنّ من النّاقدين مَنْ أعجبهم زخرف القصيدة في صورتها الجديدة، وأعجبهم كذلك خروجها عن المألوف، فصنّفوها قصيدةً حديثة من غير أن يقفوا عند جوهرها وقفة نقديّة ترصد عناصر الإبداع التي منها يتكوّن الشعر؛ وفي هذا النقد المرتجل إساءة إلى الشعر، وإتاحة الانتشار لغير الشعر من الكلام الذي هو كقائليه بلا قيمة إبداعيّة وجوهريّة. إنّ الجمال هو في جوهر الأشياء وليس في شكلها؛ وهل استطاع الشّكل الجديد للقصيدة العربيّة أن يجعل صانعيه يتفوّقون على القدماء فنّاً وإبداعاً؟!!!.
إنّ الشِّعر في نظاميه العروضيين: القديم والجديد هو الشّعر؛ وهو فيهما يكون أو لا يكون، والأخلاق العظيمة في الإنسان لا تُستمدّ من صورته، بل هي كامنةٌ في جوهره، في لبّه، وهي تُدرَكُ في فعله وقوله، وبها يكتسب قيمته الإنسانيّة الرفيعة بين البشر، ومثال الإنسان، هنا، هو مثال القصيدة التي لا تصير حديثة أو جميلة بشكلها الجديد، إنّما تكسب حداثتها وجمالها بجوهرها ومضمونها. إنّ كلّ شيء في هذه الحياة أراه يوافق مثال الصورة والمضمون، وبه يُقاس؛ لهذا يجب أن يكون الحكم على الأشياء بالنظر إلى صورها وجواهرها. وألّا يكون بالنظر إلى صورها من دون جواهرها. إنّ مضمون القصيدة في الحكم على حداثتها وتطوّرها يفي وحده بالغرض، وهو لا يحتاج في رأيي إلى الشكل ووظيفته، بَيْدَ أنّ الشكل وحده لا يفي بغرض الحكم على حداثة القصيدة وتطوّرها، فهو بحاجةَ إلى المضمون الذي يعطيه الاستمرار والحداثة الدائمة، وهنا يكمن السّرّ في شعر المتنبيّ وشعر غيره من أقرانه المبدعين، إنّه سرّ المضمون الممتلئ حياةً وحداثةً وإبداعاً، إنّه سرّ العبقريّة الشعريّة التي جعلت العمود الشعريّ الخليليّ شكلاً شعرياً متجدِّداً تنتظم في موسيقاه وبحوره وعروضه موضوعات الحياة كافّة، وعلى نظام هذا الشكل المتجدّد يستطيع الشاعر أن يطرق الموضوع الذي يريد، ويوظّف طاقته الإبداعيّة وفاقاً لإرادته ومأربه.
إنّني أرى انطلاقاً ممّا تقدّم ذكره أنّه لا بدّ من مراجعة قضيّة الحكم على القصيدة العربيّة الكلاسيكيّة، وإظهار الالتباسات الّتي أدّت إلى إصدار الأحكام السّابقة الجائرة، وهذه المراجعة يجب أن تقوم على أساس المضمون، أمّا الشّكل فيأتي مكمّلاً أو بمثابة الشاهد، وهذه المراجعة لا نرجوها لأجل رفع الظلم عن القصيدة العربيّة الكلاسيكيّة وحسب، وإنّما نرجوها لأجل تفضيل الألباب على القشور وتفضيل الإبداع على الزخرف الخارجيّ، ولأجل التنويه بتراثنا الشعريّ الإبداعيّ، وجعله الينبوع الذي ينهل منه الشعراء مفتخرين بالإرث الإبداعيّ العظيم الذي تركه لهم الأجداد؛ وكذلك ليكون هذا الإرث للأجيال القادمة التاريخ الأدبيّ الابداعيّ الذي إليه ينتمون وبه يفتخرون بين الأمم والشعوب كافّة.
إنّ القصيدة العربيّة الحديثة- برغم معاصرتها لحياتنا- لم تستطع تجاوز ما أتى به المتنبيّ الذي مضى على تجربته الشعريّة أكثر من ألف سنة؛ ولهذا اعتبرناه في هذا البحث أساس الحداثة في الشعر العربيّ، ويأتي هذا الاعتبار منسجماً مع قولنا: إنّ الحداثة في الشعر هي في المضمون وليست في الشكل، فالشكل الحديث للقصيدة لا يجعلها حديثة إذا لم يصوّر مضمونها الحياة ويواكب الزمن، والحداثة في الشعر هي رؤية جديدة للحياة، وهذه الرؤية هي الّتي تُبقي القصيدة حيّة، بل فاعلة وإن مضت على كتابتها القرون، ومثال هذا قول المتنبيّ:
أغايةُ الدين أن تُحفوا شواربكم يا أمّة ضحكت من جهلها الأممُ(18)
هل المتنبيّ في هذا البيت طرح قضيّة عابرة تجاوزها الزمن وتجاوزتها حياة العرب؟ أم هو طرح قضيّة معقّدة متأصّلة في ثقافة الأمّة العربيّة.
إنّ هذا البيت الشعريّ طرح قضيّة تعثّر العقل العربيّ في فهم النّصّ الدينيّ، وهذا التعثّر العقليّ يتأذّى منه المثقّف العربي اليوم ويتأذّى منه الشّاعر الّذي مشى في طريق الحداثة خصوصاً؛ وليس هذا وحسب، بل يبدو عاجزاً عن مكافحة هذا الأذى وأسبابه كما فعل المتنبيّ في بيته الّذي سبق ذكره، حيث طرح المتنبيّ جهل العرب الّذي ما زال مستمراً على حاله منذ أكثر من ألف سنة، وطرح عجزهم عن فهم النّصّ الدينيّ وفهم غايته، إذ إنّ غاية الدّين عند المتنبيّ هي غاية علميّة: ﴿ وقل ربِّ زدني علما﴾ (19) وكذلك غاية الدّين الوحدة بين المسلمين: ﴿إنّ الله يجبّ الذين يقاتلون في سبيله صفاً واحداً كأنّهم بنيانٌ مرصوص ﴾ (20) وكذلك غايته أن يكون المسلمون أمّةً واحدة، وألّا يكونوا فِرَقاً وأحزاباً ﴿ إنّ هذه أمّتُكم أمّةً واحدةً وأنا ربّكم فاعبدون ﴾(21). إنّنا من خلال هذه الآيات ومقارنتها مع حياة العرب اليوم ندرك أنّ المتنبيّ في بيته المذكور آنفاً كان شاعراً تغييريّاً، والتغيير عنده يجب أن يحصل في العقل والأسلوب حتّى يكون تغييراً فاعلاً يُفضي إلى غاية الدين الحقيقيّة وهي الوحدة بين المسلمين واحتكامهم إلى العقل والعلم، وهذا ما لم يحصل إلى اليوم. فالوحدة بين العرب هي الحلم الّذي لم يتحقّق، واحتكامهم إلى الجهل هو السائد بينهم. إنّ القصيدة الحديثة هي الّتي تراها ترصد مواقع الخلل في المجتمع، هي الّتي تراها تصوّر المعضلات والخيبات وتذكر أسبابها، وتحثّك على الثّورة والتّمرّد والتّغيير، وليْست القصيدة تلك الحديثة الّتي يمارس الشّاعر في كتابتها لعبة التّخريب الشكليّ. إنّ القصيدة التفعيليّة الّتي تفتقر إلى الجوهر الحديث ليست في حقيقتها سوى قصيدة تخريبيّة. إنّنا ممّا تقدّم نؤكّد أنّ الحداثة مفهومٌ عامٌّ، حركةٌ شاملة، هي في الشِّعر وغيره جوهرٌ وليست صورةً؛ وكلُّ نظرة إلى صورة الأشياء هي قاصرةٌ ولا تستطيع أن تعطيها قيمتها، وإذا أراد المرء أن يُعطي الشّيء قيمته يجب عليه أنْ ينظر إليه نظرة ثاقبةً تخرق القشرة وتدخل اللّبّ.
هوامش البحث:
1- ديوان المتنبّي، قصيدة” لكلّ امرئٍ من دهره ما تعوّدا، ص 373.
2- ————، قصيدة ” على قدر أهل العزم”، ص 388.
3- ————-، قصيدة ” غريب كصالح في ثمود”، ص21 .
4- ————-،قصيدة ” الموت مثل الحول”، ص93.
5- حسن منيمنة، ( ما هي الحداثة).
6- علا شفيق شعبان، الميادين نت،
7- د. إبراهيم الحيدري، ما هي الحداثة.
8- المتنبّي: الدّيوان، قصيدة،” لكلّ امرئٍ ما تعوّدا” ص 373.
9- أدونيس: بيان الحداثة، مجلّة ( ندوة) الالكترونيّة للشّعر المترجم.
10- أدونيس: بيان الحداثة، مجلّة (ندوة) الالكترونيّة للشّعر المترجم.
11- المتنبّي: الدّيوان، قصيدة “وإذا لم يكن من الموت بدّ”، ص 474.
12- القرآن الكريم: سورة الرّوم، الآية 47.
13- القرآن الكريم: سورة الرّعد، الآية 11.
14- القرآن الكريم: سورة البقرة، الآية 61.
15- الياس أبو شبكة: قصيدة “اجرح القلب”.
16- صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النّصّ، ص 150.
17- القرآن الكريم: سورة القلم، الآية 4.
18- المتنبّي: ديوان المتنبّي، قصيدة ” أين المحاجم”، ص 502.
19- القرآن الكريم: سورة طه، الآية 14 .