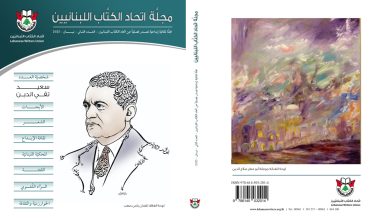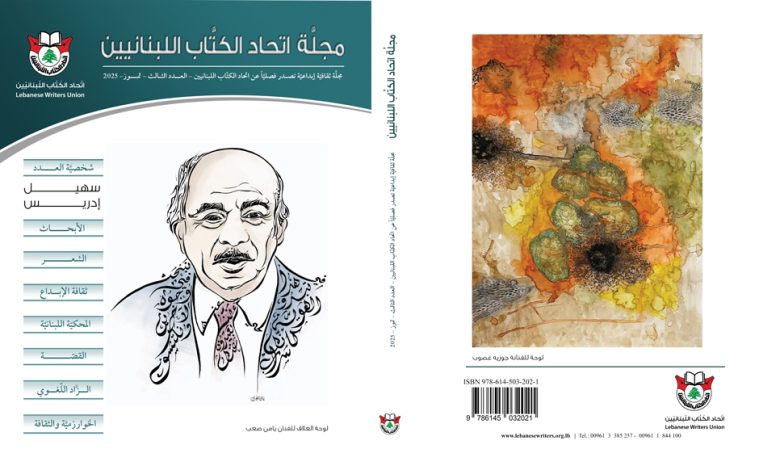
قراءة في رواية “دروب ملوَّنة” لصالح إبراهيم
أ. ملاك درويش
رواية “دروب ملوّنة” تسلّطُ الضّوء على جانبٍ معتمٍ من أمكنتنا الجغرافيّة، تلك الأمكنةُ الّتي أُهملت على خارطة العالم، لأنّ من يسكنُها غجرٌ لا يمتلكونَ بطاقةَ تعريفٍ تؤسّس لهُويّتهم المكانيّة…
طالعْتُ رواية “دروب ملوّنة” بشغفِ قارئةٍ يستميلُها أسلوب الرّوائيّ منذُ المرحلة الجامعيّة، وكأنّني قُبالةَ أنموذجٍ روائيّ يُحتذى به من قبل المبتدئين أو الرّوّاد الجدد لهذا الفنّ الأدبيّ.
غير أنّ التّبدّل الملحوظ الّذي أصاب بسهامِه شخصيّة الرّوائيّ لفت انتباهي، ولا سيّما على مستوى النّفَس السّرديّ ولغة الخطاب، فالرّوائيّ الّذي قرأتُه في “ضوء وتراب” و”الجرس الأخير“، مختلفٌ كلّيّاً عمّا أقرأه اليومَ في “دروب ملوّنة“، وكأنّني به يقول: “حانَ الوقتُ لتجاوزِ الشّعريّة السّرديّة والمذهب الرّومنسيّ نحو الجانب الواقعيّ على مستوى اللّغة والمذهب”.
الرّواية تسلّطُ الضّوء على جانبٍ معتمٍ من أمكنتنا الجغرافيّة، تلك الأمكنةُ الّتي أُهملت على خارطة العالم؛ لأنّ من يسكنُها غجرٌ لا يمتلكونَ بطاقةَ تعريفٍ تؤسّس لهُويّتهم المكانيّة، بعيداً من الهُويّة الوجوديّة المحفورة في ذاكرةِ التّأريخ منذ قرون. من هنا، تتشكّل هُويّة المكان المعادي لقاطنيه، وهنا تنقلبُ الموازينُ، إذ غدا المكانُ هو المؤدّي لدورِ المعاداة، وليس العكس، بوجهه الجغرافيّ الموحّد على اختلافِ توزيعِ سكّانه في ربوع الأرض.
فقد ظلّ مكاناً موحشاً، يفتقرُ إلى أبسطِ مقوّمات الحياة، وموقّتاً لا يضمنُ لأهلِهِ نزعةَ البقاءِ والاستمرار. وهنا تنطرح الإشكاليّةُ الآتية: إلى أيّ مدىً أسهمتِ الهُويّةُ المكانيّةُ في تحديدِ الطّابع الرّوائيّ؟ وكيف ساعدَ هذا التّشكّلُ في تأسيسِ مداميكِ الواقعيّة في المنظور الرّوائيّ؟
وتقتضي المعياريّةُ العلميّةُ لمقاربةِ هذه الإشكاليّةِ الأخذَ ببعضٍ من أدواتِ المنهجِ البنيويّ الاجتماعيّ، وذلك لفتحِ جوانب الفضاءِ السّرديّ على الحمولاتِ الواقعيّةِ الّتي تحاولُ أن تشيَ بها الرّوايةُ.
لا بدّ من الإشارة – في بادئ الأمر- إلى أنّ الرّواية تندرج ضمن أدب الرّحلة، ما يسِمُ فضاءها بالواقعيّة لزاماً، مجاراةً للغرض الّذي يقوم على أساسه هذا الأدب، والمتمثّل في الكشف عن الجوانب النّفسيّة والمجتمعيّة والسّياسيّة، وغيرها… في بقعة جغرافيّة ما، أو أكثر تبعاً لمجرى الأحداث تارةً، وللأهداف الّتي يكنُّها البطلُ الرّحّالة في قرارة نفسه طوراً.
فـ “آدم” شخصيّة نامية في هذا الفضاء السّرديّ، إذ إنّه تحوّل من عاشقٍ يهيمُ بمحبوبته الغجريّة “بافال” إلى رحّالة يهيمُ بقصص الغجر وأغانيهم وعاداتهم… في بقاع الأرض كلّها، من شرقها إلى غربها، ما شكّل فضاءً مختلفاً تحكمه نزعةُ البحث المستمرّ عن حبيبةٍ اختصرت في شعوب منبوذةٍ على مرّ القرون، فأجده يقول: “سكنني شعورٌ بأنّني لا أتبع بافال فحسب، بل أتبعُ قوافلَ الغجر وتجمّعاتهم ومخيّماتهم، وأتحرّى عاداتهم وأوجاعهم. كنْتُ على يقينٍ بأنّ حالة البحث عن بافال ستبقى حالة لحاق بها، وبأنّني لو عدت إلى المنزل وانتظرتها ستعود… مع ذلك ظلّت القوّة الغامضة تدفعني نحو التّرحال…” (ص. 113).
ولعلّ اعترافه الصّريح هذا أمام نفسه، ما هو إلّا محاولةٌ لتشكيل هويّة الدّروب الّتي قطعها، فباتت على ثقل خطاها ومشقّاتها، ملوّنةً لما تخبّئه في جعبتها من حكايات منسيّة على مرّ الأزمان، وعقولٍ إن هُيّئت أَبدعت، وأغانٍ إن انتشرت طغت، وأحلامٍ إن أُعلنت ساد السّلام والوئام، وهذه هي رسالة “بافال” الّتي رسّختها في ذاكرةِ كلّ إنسانٍ غير غجريّ عبر رحلةِ “آدم” العبثيّة في البحث عنها. وهنا قد تجلّت الإبداعيّة، وذلك في “صناعة فضاء روائيّ… انطلق من توظيف مبدع للمكان، في التّدليل على هويّة الشّخصيّات، والأبعاد الأيدجيولوجيّة”، على حدِّ تعبيره في كتابه “عناصر الإبداع في السّرد العربيّ الحديث”، (ص. 42).
لذا، يمكننا القول: إنّ الفضاء المكانيّ على اتّساعه العالميّ، ما هو إلّا رسالة تجاوزيّة للحدود الضّيّقة الصّانعة للقيود والّتي ساعدت بدورها في بلورة مفهوم “الغجر”، فشكّلت ثنائيّة “بافال” و”آدم” مرآةُ لهذا العالم الموازي في رحلة بحثٍ عبثيّة عن مفهوم الحياة، وليس الوطن أو الأمّة.
فلم يكنْ التّصوير الواقعيّ للشّقاء الملازم لتلك الفئة المهمّشة اعتباطيّاً، بل كان رسالةً جليّةً وعابرةً للقارّات، بضرورة إدراك الإنسان لماهيّة التّنوّع والاختلاف، والإيمان المطلق بالآخر الّذي من خلاله أرى العالم، وتالياً نفسيَ من منظورٍ لا هو حضريّ أو بدويّ أو نوريّ أو غجريّ، بل إنسانيّ غير قابل للقياس على موازين الاستعلاء. وهذا ما يؤكّد ماهيّة الهويّة المكانيّة في الرّواية، وارتباطها بالكشف عن رؤية الرّوائيّ إلى العالم، “ذلك أنّ الرّوائيّ إذا سمّى الأمكنة، أو صنعها، أو حدّد إطارها، عليه أن يوظّف هذه البيانات كي لا يقع أسير حياديّة المكان، فيسيء إلى مستوى العمل”، (ص. 12).
خلاصة القول، رواية “دروب ملوّنة” بواقعيّتها المفرطة في تصوير الفضاء المكانيّ الشّموليّ والآخذ بالاتّساع، ما هي إلّا تجربةٌ سرديّة جريئة لكشف اللّثام عن بنية المجتمع الإنسانيّ الّذي أُصيبَ بوباء الفوقيّة والاستعلاء منذ قرونٍ ولم يزل، وهذا ما يسوّغ نهايتها المفتوحة على آفاقٍ يرجو الرّوائيّ منّا تحديدها في قالب الإنسانيّة. وتعدّ “النّبوءة هي قمّة الإبداعيّة، والابتعاد من المباشرة. هي الأفق الّذي نطمح إليه، وهي شديدة الارتباط بالمغزى، وتصنع تالياً السّرديّة بأكملها…”(ص. 41).