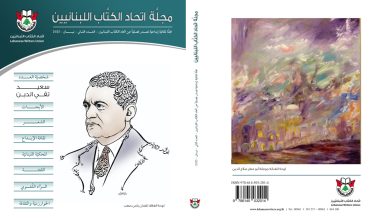– القراءة الثانية – د. سميّة عزّام
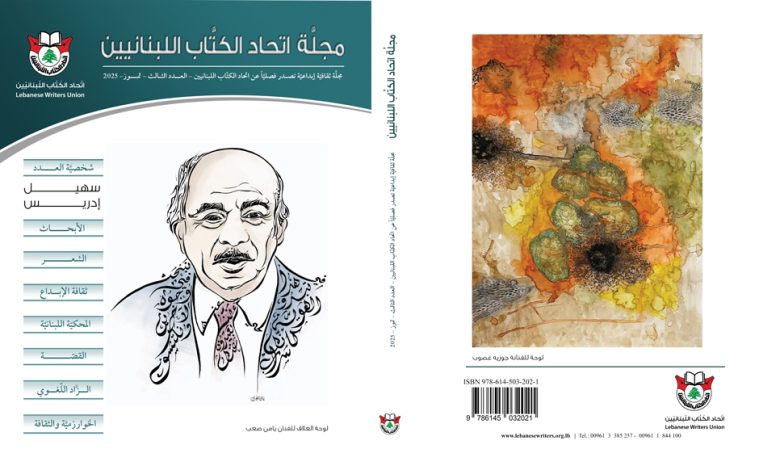
– القراءة الثانية –
“محاولة”… وتجربة “المابين”
قراءة فلسفيّة في تأويل الرموز
د. سميّة عزّام
“محاولة” كلمة مراوغة تختزن أشكال التَّكرار والعودة إلى البدء. تجربة مفتوحة على الاحتمالات وتصوّر الممكنات. لا يقين – في المحاولة- إلا بالتجريب، والبراءة كينونة المحاولة. فالتجربة هي اليقين؛ وليُترك أمر النهايات إلى حين.
“محاولة”؛ وفي اللاتعيين شمول ورحابة، وفي الاختزال بلاغةُ بحثٍ عن الاختلاف والخَلق والتجديد. نخالها الكلمة الظلّ، ظلّ المعنى، أو مرآةً مقعّرة ينطوي فيها عالم مَعيش، وعالم آخر ممكن الوجود.
هل أكتب الشعر تماهياً، أم أنّ تجربة القراءة امتصّت لغة المقروء؟ إن كانت الإجابة في مدار الاحتمال، فاليقين أنّ التأويل حركتُه بَينذاتِيّة؛ حركة تبحث عن مَنفذ للدخول إلى النصّ في محاولة الفهم.
وإذا كانت العتبة “محاولة” غِلالة تحجب بقدر ما تكشِف، فهي تتماهى مع “الأليثيا” Alethea؛ الحقيقة. والكشف عن الحقيقة سمتُه الانسراب والزوغان؛ إذ لا نكاد نمسك بالحقيقة حتى تفلِت من بين أصابعنا. وحقيقة النص قد تكون قابعة في الدّلالات الممكنة لرموز ذات طاقة تعبيريّة توجّه القراءة في منحى وجودي.
لفهم تجربة الشاعر، يقودنا رمز البرزخ إلى الاستدلال على الحالة البينيةّ في انتظار التحوّل. والصليب ينقل لنا فرح تجربة الألم وكمون الحلم بالقيامة. ورمزية الشجرة تأخذنا إلى المكان الطريقي في رحلة تشفّفيّة. هي إذاً، رموز الخلق الجديد في إعادة تشكيل الصورة. فهل بإمكاننا القول: في البدء كانت الصورة؟
البرزخ والوجود المتسائل في “المابين”
يلفتنا في بنية القصيدة مشهد البرزخ في مقطع وسطيّ يربط “الماقبل” “بالمابعد”: مقطعين في البدء بآخرين في الختام. وبإمكان جمع المقطعين من كلّ طرف معاً في وحدة دالّة؛ فتكون القصيدة في عمارتها، إذ ذاك، مبنيّة من ثلاث حركات. والبرزخيّة حدّ قَلِق في طقوس العبور؛ شكل من أشكال الكمون والانتظار والتحوّل.
البرزخ في موقعه البَيّنيّ من وصل وفصل، وفي المستويين البنائيّ والمعنويّ للنص، هو حالة مَن ينتظر الأجوبة طويلاً، حالة تنشأ من معايشة الأسئلة ومعاناتها. فلا يستعجل الفتح دون شرطه؛ وشرطه المجاهدة والصبر والانتظار ، على حدّ ما يذهب إليه متصوّفة الإسلام.
الموت لم يتأخّر؛ لِمَ استعجاله؟ فليُرجأ قليلاً كي تتمكّن الذات من عيش تجربة الحزن والألم، كما جاء في المطلع من الدعوة إلى نسيان الموت، وتذكُّر ما تؤثّثه تجربة أن يحزن هذا الموجود “وحيداً” -مثل “المصلوب”- من مشاعر فرح. والوحدة، في اقترانها بالبرزخ الوجوديّ، تحيل على الاختلاف، وفرادة التجربة، والمصير المنفرد؛ فلِمَ الاستيحاش؟
والاختلاف يكوّنه “الدازين” الذي يقف في “المابين”. و”الدازين” هو الوجود الحرَكي المتسائل عن كينونته، فاعليته تكون في التجاوز والعبور والتحوّل. “المابين” إذاً، ما هو إلّا مقام التوسّط للذات المتسائلة عن كينونتها. فكيف تتكشّف كينونتها؟
الصليب وأصالة الوجود
نعود إلى استنطاق النص: إلى من يتوجّه الشاعر بخطابه في الصيغ الطلبيّة: “دع” و”تألّم” و”زِدْ” و”حذارِ” و”تذكّر” و”تكسّر” و”تبعثر” و”اجمعها”؟ ومن هو هذا “النقيّ”؟ تسعفنا على الإجابة صورة “المصلوب”. وقد اتخذه الشاعر رمزاً له، بل نخاله قد توحّد به. ولفهم تجربة الشاعر نحتاج إلى فهم تجربة المصلوب.
محكومٌ على المصلوب، بوصفه كائناً غريباً وحيداً مختلفاً، بأن يبحث عن مشروعيّته بنفسه وفي نفسه. فلحظاته على الصليب بحدّ ذاتها مشروع حياة أخرى، وأمل بوجود أصيل. وأصالة وجوده تكمن في هذا العُري الكامل بغير أقنعة؛ في التقشّر من الزَّيف، وفي وإزالة الحُجُب كي تتكشّف له الحقيقة النقيّة النضرِة الشفيفة.
لا تشفُّف ولا تحوّل إلّا بالحبّ الخالص، والألم الشفيف، والحالة الزمنيّة البرزخيّة لذات المصلوب بين تذكّر (الماضي)، وانتباه (الحاضر)، وتوقّع (المستقبل). والصليب تأسيس؛ رحلة بحث عن وجود أوّل “كان”، تتأمّله الذات في مرآة الذاكرة، وعن وجود “سيكون” تراه في مرآة الحلم؛ الحلم بالقيامة. فلتتدبّر الذات طريقها إذاً، من القدر صوب المصير!
الشجرة و المكان الطريقي
الشجرة برمزيّتها طريق الصعود؛ هذا المعراج لتأسيس حضور فاعل مستمرّ سائر في الزّمن. هي التجربة والطريق من “الوجود بالقوة” إلى “الوجود بالفعل”. ليست كلمة مُقحمة في النص، وفي وسطه تحديداً، في المركز، وفي اقترانها بالرموز الأخرى. والشجرة فيوض لا تنفد دلالاتها؛ فلنتأمّل. هي محور العالم، ورمز للكون والوصل بين العوالم، والاتصال بين الأرض والسماء.
تختزن رمزيّة التثليث في هيكلها: من جذور خفيّة في باطن الأرض، وجذع ظاهر على سطحها، وأغصان تتعالى نحو السماء؛ فتمثّل دورة الطبيعة للحياة والموت والبعث. هي الحياة في عَودويّتها وتجدّدها وحركتها المستمرّة. إذاً، هي دليل القيامة. وفي عَموديّتها توقٌ إلى العلو والرّفعة. الشجرة تغتذي من التربة والماء وترتفع إلى ما وراء السماء، إلى الحقيقة، إلى النعمة المؤنسة المتجاوزة الثنائيّات، وفق المأثور الإسماعيليّ.
لنعد إلى النص، فنتأمّلَ كيف وصلت الشجرة -في مركزيّتها- الأجزاءَ. ألمٌ لَحظيّ يخُصب فرحاً مستديماً، وموت تكمن فيه صورة القيامة؛ قيامة صورة مجموعة من شتات، ومغايرة لا تشبه ما كانت عليه، بل ما ستصير إليه. هي طريق المكابدة التشفُّفي الصاعد نحو المجد، و ليس مجد “نرجس” بل مجد “المصلوب”. من صورة تتكسّر (بمعنى الانحلال)، فتعود وتُجمع (بمعنى النشور)، ثمّ تتبعثر (بمعنى الانتشار والإخصاب الروّحي).
النقيّ كابد في رحلته التشفّفية الصاعدة إلى صورة غير مرئيّة -لا تُبصَر؛ فمن المنظور إلى المستور، وممّا هو ظاهريّ إلى ما هو باطنيّ. وهنا نتوقّف أمام هذه المفارقة: فإذا كانت عموديّة الشجرة تبدأ من الباطن إلى الظاهر فوق أديم الأرض وفي الأعلى، فكيف يمكننا تفسير الصورة المنشودة: “كلون شفّ فلم يُبصر” في المقطع الأخير من القصيدة؟
لعلّ رمزيّة شجرة الحياة، في استعارتها للنقاء وللبراءة المفقودة في الجنّة، تسعفنا. هذا الرابط بين القوى الإبداعيّة والأبعاد الرّوحية ما هو إلّا رحلة دازين الشاعر المتوحّدة مع صورة المصلوب أو المصطفى -كلّ مصطفى- عبر الأزمنة والأدوار في عبارة “الّذين لم يخطئوا من قبلك”.
وليست رحلة الشاعر معزولة عن مثيلتها للقارئ؛ فمكابدة القراءة مرآة تعكس مخاض الكتابة وولادة القصيدة في صورة “تحجب بقدر ما تكشف” من معانٍ. نخال القصيدة شجرة في يقين حضورها، وتأكيد النموّ الروحي- الإبداعيّ في تكسّرها وجمعها وتبعثرها وإيحائها. يحلم الشاعر بالنقاء، فيكتب حلمه؛ لعلّه في الكتابة يفهم مكانه في هذا العالم، ولعلّنا في القراءة “نتدبّر”.