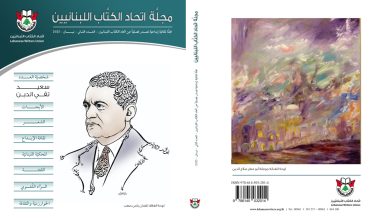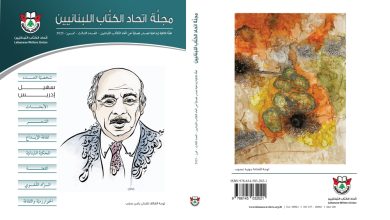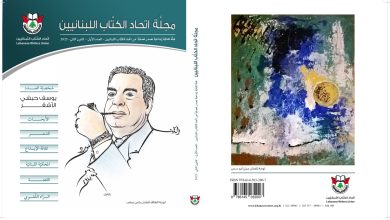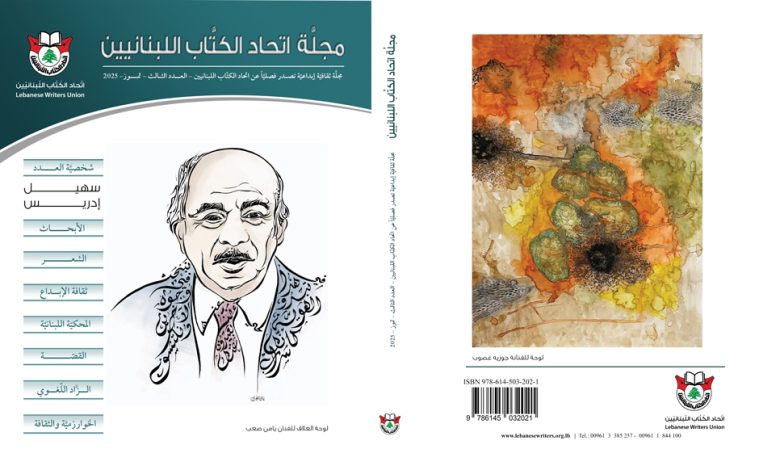
ويسألونَك عن الرّوح…
د. ليلى مرجي
يَحار المرءُ، بالغاً ما بلغ من الفِطنة والموهبة، أن يرصدَ لقصّة محمد بدايةً، وقد تشعّبت خيوطُها وتشابكت بين أرضٍ وسماء… بينَ ترابٍ وقبسٍ سناهُ منحدرٌ من سدرة المنتهى، وإن كانت قصَّتُه محطّةً صغيرةً من محطّاتٍ فاح عطرُها من أرض عاملة إلى أصقاع الدّنيا، هي حكاية من الحكايا الأسطوريّة الكثيرة التي سطًرتها أسودُ عاملة…
كانا يرابطان معاً، في أرض الجنوب المقدّسة، وتحديداً في مدينة بنت جبيل الأبيّة، كانا يسمعان هدير المقاتلات الحربيّة وأزيز الصّواريخ. كانت الانفجارات المدوّية تهزّ الأرض من تحتهما، وهما يقتربان من المكان المقصود حيث عليهما تنفيذ مهمّة عسكريّة، وهما يعرفان جيداً أنّهما يقتربان أكثر وأكثر مع كل خطوة.
وفيما هما يسيران برباطة جأش حيدريّة، التفتَ صديقُنا الى محمد فلم يرَه بجانبه. كان واقفاً كمن يفكر في الإقدام على ما يخاف. ظنّه متردّداً. فتساءل، هل خارت عزيمتُه وهو أسد الوغى، وليثٌ من ليوث كربلاء؟!
فأخذ يرقبُه بتأنٍ، شارد الذهن… ما الذي أصابه!! هل استطاب له العيشُ اللّحظة، وهو الذي اتّخذ الزّهد قريناً وكان يكفيه من مؤنةِ الدّنيا قميصٌ… ورغيف؟!
وأنا ماذا أفعل لو قرّر التراجع؟
ماذا لو أراد الانسحاب؟ ماذا وماذا…
في هذه الأثناء مدّ محمد يدَه الى جيبه، تناول محفظَته ، فتحها، أخرج منها صوراً صغيرة.
يقول صديقُه: “انتظرتُ أن يضمّها الى قلبه، أن يقبّلها، أن يحاكيها، كما كان يفعل عندما كان يظنّ الجميعَ نيام. لكنّه هذه المرّة لم ينظرْ إليها، لم يتأمّل ملامحَ أبنائه، بل راح يمزّقها بسرعة، كأنّه لا يريد أن يترك لنفسه فرصة أخرى للتفكير”.
فهم من نظراتي تعجّباً ممّا أرى. فقال:”لا أريدُ يا صديقي أن يربطَني شيء بهذه الدّنيا الفانية، لا أريد أن يقيّدَ سعيي نحو الله قيد”.
ما هي الّا ساعات واذا بي أسمعُ أنينَه تحت الرّكام، كان جسدي كلُّه عالقاً تحت سقف المنزل الذي أُسقط فوقنا، ناديته: أأنت بخير؟
قال: أنا أنزف… وأنت؟ قلت بعين الله يا صديقي.
مرّت ساعاتٌ وساعات كانت أثقلَ من الحجارة التي تغمرنا، وفجأة سمعنا هدير سيارة. جاؤوا لانقاذنا، صرخنا: “نحن هنا تحت الرّكام”. فأجابنا صوتٌ من بعيد “انتظرونا سنعودُ بعد أن نُحضرَ المعدّات اللازمة لرفع الرّكام وانتشالكم”.
إنّه الصّبرُ، سرُّ المؤمنينَ وزادُهم الذي لا ينفد. يا صبرَ زينب، يا جراحَ الحسين… تذكّرنا كربلاء وما حصل فيها، فكأنّ مخدِّراً سرى في عروقنا وبلسمَ جراحَنا النّديّة. وانتظرنا الى أن وصلوا.
نُقلنا الى إحدى المستشفيات في الجنوب. وبعد أيام من كوننا جرحى ارتقى صديقي شهيداً سعيداً، وبقيت وحدي جريحاً غريباً، ألوك الحسرة على شهادةٍ لم تكن من نصيبي.
لم تفارقني صورةُ صديقي ، صرتُ أتذكرُ شخصيتَه المرحة وقوةَ روحه في كلّ برهة. لقد حكمَ على الدّنيا وما فيها ومن فيها. لقد تفجّرت بداخله ينابيعُ الرّوح الصّافية وتحوّلت مياهُها الى قوى سحريةٍ لا يفهمُها الّا مَن ولجَ طريقَ المقاومةِ الوعرة، الّا مَن عرف الحقَ وأيقن بانتصار الدّم على السّيف، الّا من باع نفسه لله وسعى إلى لقائه كعاشق ذاب عشقاً، فأطلق روحَه الحرّة لتعودَ طاهرةً الى بارئها ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنۡ أَمۡرِ رَبِّي٨٥﴾.
كشذى الوررد
كان حسن طفلاً صغيراً في حرب تموز. شاهد من قربٍ جرائم العدو، وعايش حقدَه على أبناء الجنوب. كان يختبئُ في ملجأ صغير، في قريته، غير مجهز بأدنى مقوّمات الصمود. كانت قذائفُ العدو وصواريخُه تتطاير في كلّ مكان وتصيب النساء والأطفال. وحسن يراقب بغضب. وهنا أقسم يميناً، يذكره جيداً كلّ من كان في الملجأ. أقسم على الانتقام من العدو وإذاقته طعم الهزيمة بسلاح المدفعيّة الذي كان يستخدمه العدو ضدّ أبناء بلدته، لو قدّر له البقاء على قيد الحياة. وفعلاً هذا ما حدث.
شارك في حرب “الدفاع المقدس” وعاد بطلا، تحكي الساحاتُ بطولاتِه وتروي حكايا جهاده. وبعد انتهاء هذه الحرب عاد عنصراً في صفوف التعبئة في المقاومة، وبدأ رحلة البحث عن لقمة العيش في الأعمال الخاصة، حيث كان التوفيق رفيقه.
امتلك حسن روحاً طيّبة. كان يحبّ الحياة، يعرفّ أنْ يفكّ طلاسمها بصمت، وكان يجني أرباحاً ماديّة وفيرة. كان كلما فتح باباً فتح الله له أبواب رزقٍ متعدّدة. فصار يتاجر ويبني ويبيع ويزرع…أذاقته الدنيا حلاوة عيشها. رزق بزوج صالحة طيّبة، وبطفلة جميلة كوردةٍ جورية، وبطفلٍ يتّقد نوراً وذكاءً كمصباح مشعٍّ، يبدّد ظلام ليلٍ دامس.
ولحظة دخول حزب الله حرب الإسناد نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم واسناداً لمقاومته الشريفة. لم يتردّد، أو يفكّر. اتخذ قرار الالتحاق بالمجاهدين. شعر بالكثير من القيود والأغلال التي تُحكم السيطرة على حياته، العائلة، التجارة، الأب الحنون، ولربّما السنوات التي ابتعد خلالها عن هذا الخطّ، لكنّ الروح الحرّة لا تقيّد، وشذى الزهور لا يؤسر…
انطلق إلى المنشأة التي يعرفها جيداً في محيبيب حراً كعصفورٍ أطلق من قفصه الذهبيّ ينشد أناشيد الحرية والكرامة التي تختزل مفهوم الحياة لديه هو وأقرانه المجاهدين. كان خفيفاً بلا قيود، كشذى الورد يفوح في كل الأرجاء، زار الأهل والأقارب والأصدقاء مودّعاً متسامحاً.
وبعد أيام ، حان وقتُ المأذونية، عليه المغادرة، لكن شعوراً ما في داخله، يُلحّ عليه بالبقاء، فالمهمة لمّا تنتهِ بعد، هناك شيء ما عليه القيام به. انتظر. طلب منه مسؤولُه المباشر المغادرة، فباح له بما يشعر، وأخبره أنّ الشهادة باتت قريبة جداً. وأن هناك اتصالا سيأتي، وسيلبي هو… وسينال المبتغى.
جلس لساعاتٍ ينتظر، وفعلا حصل ما كان يحدس به، حسن ابراهيم رامٍ ماهر عليه أن يرد على جريمة جديدة ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة “رب ثلاثين” الحدودية، وأدّت الى استشهاد شاب. تلألأت عينا حسن فرحاً، وتراقصت نبضاتُه شوقاً فقد أوشك امتحانُه على الانتهاء. وسينال درجة الشرف.
أطلق صليات صاروخيّة، آلم العدو… ثمّ أسرع الى ملجئه الآمن، والعدو يرمي من طائراته صواريخ الحقد والغضب.
أصيب زميلٌ له في الموقع. خرج حسن لمساعدته، غير آبهٍ بالخطر، غير مبالٍ بعدوّه الغادر… وسرعان ما طالته شظايا الحقد في صدره الطاهر، فارتقى شهيداً سعيداً على طريق القدس. كان أولَ سعيد تقدّمه قرية “بليدا الجنوبيّة”. افتتح قافلة السعداء التي نمت وكبرت فكان للكثير من العوائل الشريفة، في بليدا، حظٌّ من الشهادة المباركة على طريق القدس المعمّد بالدّم.