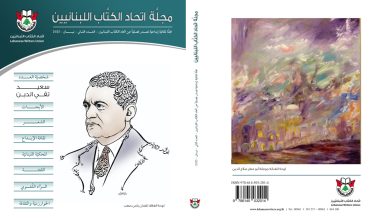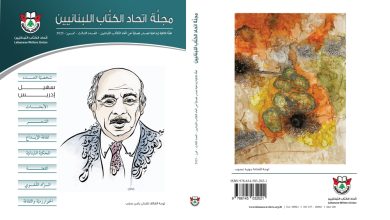بينَ الهَمْـزَةِ والألِـف – أ. د. فايز ترحيني
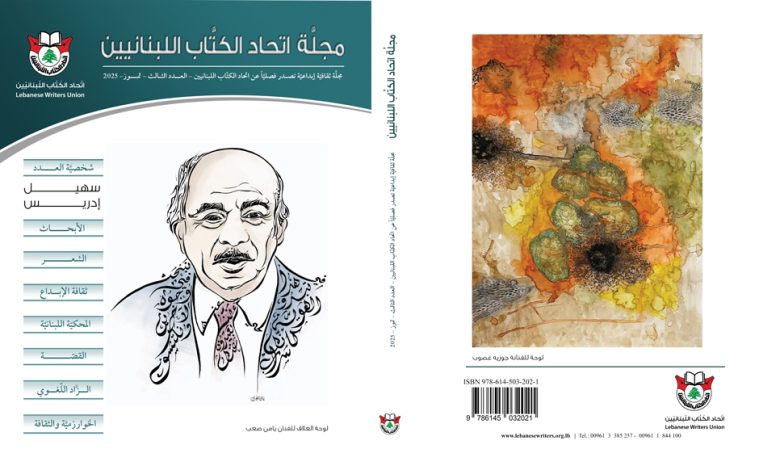
بينَ الهَمْـزَةِ والألِـف
أ. د. فايز ترحيني
الهمزةُ وتبِعــاتُها: الهمزةُ حرفٌ حَـلْـقـِيٌّ تُصْدِرُ صوتاً حُـنْجُـريَّاً خفيفاً يُشبه صوتَ “أ” لكن مع قطعِ النَّـفَس في بِداية النُّطق.
قد تكونُ الهمزةُ من حروفِ المَعاني فتأتي لنداءِ القَـريب، نحو: أَبُنَيَّ؛ أو للاستفهامِ حيث يُسأَلُ بها عن أحدِ شَيْئين أو أشياء كثيرة. وتأتي همزةَ قطعٍ وتُسمَّى ألفَ قطع وهما مُصطلحان لمُسمَّى واحد، أو تأتي همزةَ وَصْلٍ أو ألفَ وصل، وهذان أيضاً مُصطلحان لمُسمَّى واحد، ومن قال غيرَ ذلك لا يُعتَـدُّ برأيه.
همزةُ القطع: سُمِّـيَـتْ بذلك لأنَّها تقطعُ الحُـروفَ عن بعضها عند النُّطقِ بها. وهي تُـلفظُ وتُكتبُ سواءٌ أكانت في بَدْءِ الكلام أم في وَصْله، ولا تُحذفُ عند الوقف، وتُكتَـبُ مُتأثِّرةً بحركتِها وحركةِ الحرفِ الذي سبقُها، وتقبلُ الحركاتِ والشَّـدَّة، وتقعُ في أوَّل الكلمة ووسطِها وآخرِها.
ففي قولنا: إنَّ العِـلمَ أحدُ أسبابِ تقدُّمِ المجتمعات، نجدُ أنَّ الهمزةَ في “إنَّ ثَـبُـتَـت نُطقاً وكتابة فهي همزةُ قطع، بينما سقَطَتْ مِنَ النُّطقِ في كلمة “العلم” و”المجتمعات” لأنَّها همزةُ وصل. وهمزةُ القطع يمكِنُ أن تأتيَ مَفْـتـوحةً: بَرَأَ، أو مَضمومةً: أُمَّةٌ، أو مَكسورةً: إِذْ، أو ساكنةً: رَأْس.
وقد تكتب في أول الكلمة مَدَّة (آ)، مثل فعل: آمَنَ، ومثل اسم: آدم، بعد إبدالٍ وقلبٍ وإدغام. وهي تأتي في الأسماءِ والأفعالِ والحُـروف، وقد تكونُ أصليَّة، مثل: أخذَ وأكلَ، أو زائدة نحو: أكرمَ وأخرَج، فالأصلُ الثُّلاثي: كَـرُمَ وخَـرَج.
تأتي همزةُ القطعِ في الحُروفِ “ما عدا ال التّعريف”، وفي الاستفهام والنداء، وفي الأسماء “ما عدا الأسماء التِّسعة”، وفي الضَّمائر: أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتن. وفي ماضي الثُّلاثيِّ ومصدرِه، نحو: أَكل أكلاً. وفي ماضي الرُّباعيِّ ومصدرِه وأمرِه، نحو: أَرْسَلَ وأرْسِلْ إرسالاً. وفي المُضارع المَهموز الأوَّل: أستَعْـمِلُ، أسْألُ.
همزةُ الوصل: سُمِّيتْ بذلك لأنَّها تُسهِّــلُ النُّطقَ بالسَّاكن الواقعِ بعدها في بداية الكلمة. وهي تثبُتُ نُطقاً في أوَّلِ الكلام، وتسقُـطُ في وَصْله، فتُرسَمُ ألفاً مُستقيمةً “ا” دون همزةِ فوقها أو تحتها. ففي قولنا: الكِتابُ الجيِّدُ خيرٌ مِنْ رفيق السُّوء، نجدُ أنَّ الألفَ في “الكتاب” لُفِظَت لأنَّها جاءت في أَوَّلِ الكلام، بينما لم تُلفظ في “الجيِّد والسًّوء” لأنَّها جاءت مُتَّصلةً وفي وسط الكلام.
وأَلفاتُ الوصلِ في أَوائلِ الأَسماء تسعة: ابْـنٌ وابْـنةٌ وابْنانِ وابْنتانِ وامْرُؤٌ وامرأَةٌ واسْـمٌ واسْـتٌ فهذه ثمانيةٌ تُكْسَر فيها الأَلفُ، والتَّاسعةُ هي الألفُ الَّتي تدخلُ مع اللَّام للتَّعريف وهذه تُفتحُ في الابتداء.
وتأتي همزةُ الوصلِ في أمرِ الثُّلاثي، نحو: اشربْ واسمعْ. وفي ماضيِ الخُماسيِّ وفي الأمرِ منه والمصدر، نحو: ابْتَعَدَ ابْتَعِدْ ابتعاداً. اشتَرَكَ اشترِكْ اشتراكا. وفي ماضي السُّداسيِّ والأمر منه والمصدر، نحو: استخرَجَ استخرِجْ استخراجاً. استعمَلَ استعمِلْ استعمالاً.
تحذفُ همزةُ الوصل خطَّــاً من “أل” إذا دخلت عليها لامُ الجَـر، أو لامُ الابتداء أو همزةُ الاستفهام. وتحذفُ من كلمة ابنٍ وابنةٍ إذا وقعَـت مُفردةً بين عَـلَمَـين، بشرط أن يكونَ العَـلَـمُ الثَّاني والدَ الأوَّل، وأن تكونَ كلمةُ “ابن” صفةً للعَــلَم الأوَّل، وغيرَ واقعةٍ في أوَّلِ السَّطر كِتابة.
وتُحذفُ همزةُ الوصْلِ من كلمة “اسم” إذا دخلت عليها همزةُ الاستفهام، أو إذا كانت في البَسملةِ الكريمة، وذلك بشرطين: أن تُـذكَـرَ البَسملةُ كاملة: بِسْمِ الله الرَّحمن الرَّحيم، فإن ذُكِـرَت ناقصةً ثبُتَتْ الألفُ رسماً وسقطت نُطقاً، نحو: باسم الله. وأن يكونَ مُتعلِّـقُها من فعلٍ أو شِبْهِهِ محذوفاً، فإذا ذُكِـرَ المُتعلِّـقُ ثَـبُتَــت، نحو: أتبرَّكُ باسْم الله الرَّحمنِ الرَّحيم.
وتُحذفُ أيضاً بعد الفاءِ والواو من الأمْرِ المَهموزِ الفاء، مثل: فأْكُل، وأْكُل. وبعد همزَةِ الاستفهامِ مثل: أستعلمتَ عن المسألة؟ الأصل: أئستعلمت عن المسألة؟
تتحوَّلُ همزةُ الوصل إلى همزةِ قطعٍ إذا أفادت العَـلَـمِيَّة، نحو: ابتسِمْ ابتساماً، فإذا تحوَّلت إلى اسمِ علمٍ كتبت: إبتسام بهمزة قطع. ومثلها كلمة الإثنين لأنَّها أصبحت عَـلَمَاً على يوم.
الألف وتبعاتُها:
الألفُ لُغةً همزةٌ ولامٌ وفاء، سُمِّـيَـت أَلفاً لأنها تأْلَـفُ الحروفَ كُـلَّها، وذهب بعضُهم إلى أنَّ الألفَ في قوله تعالى: ألَـــم اسمٌ من أَسماء الله. وهي ساكنةٌ تُــقـدَّرُ عليها الحركاتُ والشَّـدَّةُ تقديرا، وتَخــرُجُ من الجَـوْف، ولا تُصدِر صوتاً مستقلاً، بل تُستخدمُ لإطالة الحركةِ الَّتي تسبقُها والَّتي تناسبُها.
والأَلفُ من حروفِ المَدِّ واللِّين، وقد تأتي ضميرَ الإثنين في الأفعال، نحو فَعَلا ويَفْعَلانِ، وعلامةَ تثنيةٍ في الأَسماء، ودَليلَ رفع، نحو رجُلان. وهي عند النَّحْويين ضروب، (2) منها: وَصْلِيَّةُ وقَطْعيَّة، وقد تحدَّثنا عنهما تحت باب الهمزة، ثمَّ ألفٌ فارِقَةٌ وألفُ إطْلاق وغيرها.
الألفُ الفارِقَة: هي إحدى الحروفِ الزَّائدةِ التي تُكتبُ ولا تُلفظ. سُمِّيت فارقةً لأنَّها تُــفَــرِّقُ بين الواو الأصليَّةِ وواو الجماعةِ المُتَّصلة بالأفعال وفي مواضع أخرى.
تُرسمُ الألفُ الفارقَـةُ بعد واوِ الجماعةِ المُتطرِّفةِ المُتَّصلةِ بفعلٍ ماضٍ أو أمر، نحو: ذَهبُوا واذهبُوا. فذهبوا فعلٌ ماضٍ مَبنيٌ على الضَّمِّ لمجانستها للواو، والألفُ فارقةٌ للتَّفرقة بين واو الجماعة والواو الأصليَّة.
وتُـرسمُ أيضاً في المضارَعِ المتَّصلِ بواوِ الجماعةِ المنصوبِ أو المجزوم، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا﴾. فالفعلُ هنا مَجزومٌ أو منصوبُ بحذف النُّونِ لأنَّه من الأفعال الخمسة، والألف فارقةٌ عِوَضاً عن النُّون المحذوفة.
لكنَّ هذه الألفَ قد تُحذفُ أحياناً من فعلٍ مـا في حالةٍ مُعيَّنةٍ وتثــبُتُ فيه في حالات أُخرى. فمنَ مواضعِ الحذف باتِّفاق كُـتَّـاب القرآن تلك الَّتي جاءت بعد واو الجمعِ في كلماتِ هي: “جاؤوا” الَّتي حُذِفَـت ألفُها في الرَّسمِ القُـرآنيِّ تسعَ مرَّات، منها قوله تعالى: ﴿وَجَاءو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُون﴾. و”باؤوا” وقد حُذِفت ألفُها ثلاثَ مرَّات، كما في قوله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وباءو بِغَضَبٍ مِنَ الله﴾. ثمَّ في كلماتٍ حُذفت ألفُها مرَّةً واحدة، وهي: “فاؤوا” في قوله: ﴿فَإِنْ فاءُو فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، و”عَتَوا” كقوله: ﴿وعَـتَو عُـتٌوّاً كَبِيْرا﴾، و”سعوا” قال: ﴿والَّذيْنَ سَعَـو فِي آياتِنا مُعَاجِزيِن﴾، و”تَــبَوَّؤا” قال: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالإِيمَانَ﴾.
هذه المواضع حُذفت فيها الألفُ الفارقة بعد واو الجماعة تعبيراً عن الحُزنِ والنَّدمِ والأسى والخوف والذُّعر، وتأكيداً على أنَّ النَّقصَ والكذبَ والتَّزويرَ وتغليبَ الباطلِ على الحقِّ والشَّرِّ على الخير حلَّت محلَّ القيم والمبادئ السَّامية. فالنَّقصُ في المعنى استلزمَ النَّقصَ في الرَّسم، وهذا دليلُ بلاغةٍ وفصاحة. ومثله من حيثُ الحذفُ والإثباتُ ما جاء في قِـصَّة موسى والعبد الصَّالح: ﴿وَاتَّخَذَ (الحوت) سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا﴾. حيث حُذِفت الياءُ من كلمة “نبـغِ” لأنَّ نُـقصانَ تمام الغاية يناسبُه نُقصانُ تمام الحرف، وللبحث صِلة.
ويرى البعضُ أنَّ الألفَ الفارقةَ وهمٌ ولا معنى لها ولا دور، أمَّا رسمُها فإنَّما هو اصطلاحٌ إملائيٌّ وليس أكثر.
والألفُ الفارقةُ لا تُرسمُ في آخر الفعل المتَّـصل بواوٍ أصليَّة، مثل: يَـرْجُو، يَهْـفُـو، يَـعْـلُو، ولا تلحق بالاسم، نقول: جاء مُعلمو المدرسة وموظَّفو الشَّركة. أصلُ الكلام مُعلِّمون وموظَّفون حُذِفَت النُّونُ للإضافة ولم يُعوَّضْ عنها بألفٍ فارقةٍ لأنَّها لا تلحـقُ بواو الجمع المُتَّصلةِ بالأسماء.
ألفُ الإطْلاق: تُسمَّى في النَّثرِ ألفَ الإشباع، وتأتي لإطلاقِ حركةِ الرَّويِّ في الشِّعر إذا كانت فتحة، وتدخلُ على الاسم والفعل. والرَّوِيُّ هو الحرفُ الأصليُّ الأخيرُ من البيتِ، وتُسمَّى القصيدةُ باسمه، فنقولُ مثلاً رائيَّة امرئ القيس:
بَكى صاحِبي لمَّا رأى الدَّرْبَ دُوْنَه وأيقَــنَ أَنـَّـــا لاحِـقَـــانِ بقَـيْصَرَا
فقُـلْـتُ لَــــــهُ لَا تَـبــْـــكِ عَــيْـنَــــك إنَّمـــــا نُحاولُ مُـلْـكَـاً أو نَموتَ فَـنُـعْـذَرا
الأصلُ قَيصر ونُعْـذر، فأُطلقَـت حركةُ الرَّويِّ بالألف، والألفُ هنا للإطلاق لا مَحلَّ لها من الإعراب. أو كقول جرير:
أَقِــلّي اللَومَ عاذِلَ وَالعِتابا وَقولي إِن أَصَبتُ لَقَد أَصابا
أو كقول أحمد شوقي:
سَلو قَلبي غَداةَ سَلا وثــابا لعَلَّ عَلى الجَمالِ لَهُ عِتابا
حيث أَطلقا حركةَ الرَّويِّ في “أصابا” “وعِتابا”، وتالياً في “العِتابا” و”ثـابا”. وهذا التَّنوُّعُ في استعمال الهمزةِ والألفِ له دلالاتٌ بلاغيَّةٌ وأثرٌ عميقٌ في الفهم والاستيعاب.
اعتمد الخليلُ في ترتيبِ الحروف وفي مُعجمِه العين على مَخارجِ الحروفِ مُبتدئاً من أقصى الحَـلْـق إلى الشَّفة.
وبحسب هذه المنهجيَّة كان عليه أن يبدأ بالهمزةِ التي تَخرجُ من أقصى الحلق، ثمَّ تليها الهاءُ ثُّـم العين، لكنَّه أهمل الهمزةَ تماماً لِـما يلحـقُ بها من نقصٍ وتغيُّرٍ وحذف، ولم يبدأ بالهاءِ لأنَّها مهموسة ٌ خفيفةٌ لا صوتَ لها، فبدأ بالعين الَّتي تخرجُ من وسط الحلق.
منها الألفُ المجهولة كأَلف فاعل وفاعول وما أَشبَهَـهَـا، وأَلفُ العِوضِ وهي المُبدلةُ من التَّنوينِ المنصوب، وأَلفُ النُّونِ الخفيفة كقوله عز وجل: لَنَسْفَعاً بالنَّاصِيةِ.
وألفُ التَّفضيلِ والتَّصغير، كقولك: فلانٌ أَكْرَمُ منكَ، والنِّداء كقولك أَزَيْدُ؛ والنُّدبة كقولك وازَيْداه، ومنها ألف التَّأْنيثِ نحو: حَمْراء وبَيْضاء ونُفَساء، وأَلف سَكْرَى وحُبْلَى.
ومنها الألفُ المُحوَّلة، وهي كلُّ ألفٍ أصلُها ياءً أو واواً المتحرِّكتين، كقولك: قال وباعَ وقضى وغَزا وأشباهها؛ والتَّثنية في الأفعال، كقولك: يَجْلِسانِ ويَذْهَبانِ، وفي الأسماء كقولك: الزَّيْدان والعُمَران.
ومنها الألفُ الكافية: وهي الَّتي يُكتفَى بها عن الكلمة، وتُغْنِي عن ذكر حروفِها، مثل: ألَم، فنحن ننطقها حروفا، هكذا: ألف، لام، ميم.