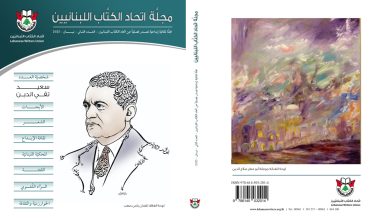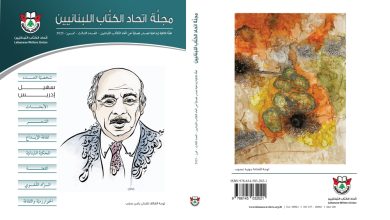قراءة الرّواية، وإعادة قراءة الحياة “الحيّ اللَّاتينيّ”، واكتشاف ما توارى فينا – العميد الشّاعر مجدي الحجّار
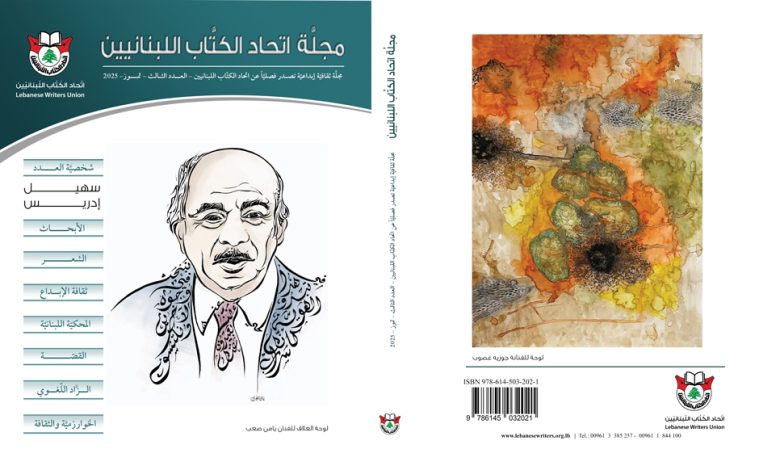
قراءة الرّواية، وإعادة قراءة الحياة
“الحيّ اللَّاتينيّ”، واكتشاف ما توارى فينا
العميد الشّاعر مجدي الحجّار
“إنَّ الطَّريقة التي يقرأ بها الشخص كتاباً هي الطَّريقة التي يقرأ بها المرء الحياة”. حضرني هذا القول لهنري ميلر وأنا أعيد قراءة الحيّ اللّاتينيّ”“1” بعد أربعين عاماً من قراءتي الأولى لها، نضجت ونضج جيلي وكدنا نشيخ، وما زالت هذه الرواية فنّيَّة تغري بإعادة القراءة، واكتشاف أسرار فنّيَّة فيها، لم يكن اكتشافها متاحاً من قبل.
ها نحن نعيد قراءة صفحاتٍ مطويَّةٍ من حياتنا، إذ نعيد قراءة الأعمال الأدبيَّة الشَّامخة، فنقع على مكانٍ جديدٍ من روايةٍ عجیبةٍ نسمّيها الحياة، ونودُّ لو استطعنا إعادة صياغة فصولها حذفاً وإضافةً وتشذيباً، ونكاد نهتف مع رولان بارت: “إنّ الكتاب يضع المعنى والمعنى يضع الحياة”“2”.
أين يكمن سرُّ الجمال المتجدﱢد في هذه الرواية الصَّادرة عام ١٩٥٣؟ حيثُ كان المنجزُ الروائيُّ العربيُّ لمَّا يزل طريَّ العود؟ هل يكمن في هواجسها الحضاريَّة الاجتماعية والوطنية والقوميَّة؟ أم في بنائها الروائيﱢ البارع؟ أم في لغتها الشَّفَّافةِ الراقية؟ أعتقد أنَّهُ يتجلَّى في كلﱢ تلك، وفي جوانب أخرى منها.
1- كلمة في علم الجمال، وكلمة في فنﱢ الرواية:
“إيقاظ النَّفس هو الهدف النّهائيُّ للفنﱢ… ومضمون الفنﱢ يحوي كلَّ مضمون النَّفس والرُّوح، وإنَّ هدفه يكمن في الكشف للنَّفس عن كلﱢ ما هو جوهريٌّ، وعظيم، وسامٍ، وجليل، وحقيقيٌّ كامن فيها… وينقل إلينا تجارب الأشخاص الذين يمثّلهم.. فنصبح قادرين على أن نحسَّ إحساساً أعمق بما يجري في داخلنا”“3”. هكذا تكلَّم هيغل على هدف الفنﱢ. وهو من أعظم الفلاسفة الذين كتبوا في علم الجمال. ولئن كان يقصد في كلامه هنا الفنَّ التَّشكيليَّ، والموسيقى، والشّعر، فإنَّ كلامه هنا أكثر ما ينطبق على فنﱢ الرواية.
ويرى ميلان كونديرا أنَّ قيمة الرواية ترتكز على إظهار إمكانات الوجود المضمرة فيها، والتي لم تزل مخفيَّةً “حتى ذلك الحين. بعبارةٍ أخرى، تكشف الرواية عمَّا هو متوارٍ في كلﱢ واحدٍ منَّا”“4”.
2– كلمة في استعمال ضمائر السَّرد:
تنوَّعت آراء النُّقَّاد حول دلالات استعمال ضمائر السَّرد الثَّلاثة؛ فافترقت كثيراً، واجتمعت قليلاً، إلى أن ارتسمت ملامح عامَّة للراوي المرتبط بكلﱢ ضميرٍ منها. فالراوي العليم الكليُّ المعرفة المرتبط بضمير الغائب يشكّل امتداداً تاريخيّاً، وتقليداً كلاسيكيّاً، وما زال خياراً مفضَّلاً في الروايات الحديثة، ويتيح التَّصرُّف بِحريَّة في صناعة الأحداث، وتحريك الشخصيَّات، وضخﱢ الأفكار بعيداً من شبهة الأنا، والتصاقها بذات الكاتب. أمَّا الرّاوي وضمير المتكلّم، والمتقمّص شخصية أو شخصيات أساسيَّة في في الرواية، فهو الأقدر على الغوص في أعماق النَّفس البشريَّة، والاغتراف من أعماق الكاتب الواعية واللَّاواعية، وكسر حواجز الزمن السّرديﱢ، والاقتراب الحميم من القارئ. ويرى عبد الملك مرتاض في ضمير المخاطب: “وسيطاً بين ضمير الغائب والمتكلّم، فإذا هو لا يحيل على مخارجٍ قطعا، ولا هو يحيل على داخل حتماً.“5” وتبقى براعة الروائيﱢ هي العامل الحاسم في إعطاء الضمائر المستعملة قوَّة السَّرد، وقيمة الرواية.
3- “الحيّ اللّاتينيّ”: بداية قويَّة، ودلالات لها ما بعدها:
“لا ما أنت بالحالم، وقد آن الآن أن تصدﱢق عينيك. أوَما تشعر باهتزاز الباخرة، وهي تشقُّ هذه الأمواج، مبتعدة بك عن الشاطئ، متَّجهةً صوب تلك المدينة التي ما فتئت تمرُّ في خيالك خيالاً غامضاً كأنَّه المستحيل. لا ليس هو بالحالم، فهذه أطياف أمّه وإخوته تضيع في الأبعاد، وما تلبث أن تتبدَّل لعينيه أشباحاً نائيةً، كأنَّما هي رسمٌ اهتزَّت به يد المصوﱢر، فخرج مضطرباً بالخطوط…”“6”. يفتتح الكاتب روايته بضمير المخاطب ليوقظ الصَّوت بطلها ممَّا يشبه الحلم الذي يقترب من التَّحقُّق، ويصل به إلى تلك المدينة التي تداعب أحلام الآلات من أبناء جيله. ثمّ ينتقل إلى ضمير الغائب بسرعة، وبعبارات سيكون لها شأنها في رسم أحداث الرواية. “وللمرَّة الأولى منذ بدأ يعي، شعر بقوَّة هذه الإرادة التي تعصف بوجوده في أن يولد من جديد”“7” وبالسُّرعة ذاتها يستعمل ضمير المتكلّم طارحاً أحد أسئلة الرواية الجوهريَّة: “ولكن ما الذي أبغيه في حياتي هذه الجديدة؟”“8” ويأتيه الجواب فوراً وبضمير المخاطب مجدَّداً: “الذي تريده الآن، هو أن تضع حدّاً لحياتك القديمة”“9”.
أوَّل ما يشدُّ الانتباه في مقدﱢمة الرواية التي لم تتجاوز الصفحتين ونصف الصفحة، هو تناوب ضمائر السَّرد الثلاثة على لسان الراوي عدَّة مرَّات، وبرشاقة عالية. وهو أمرٌ سنراه يتكرَّر كثيراً على امتداد فصول الرواية. قد يبدو الأمر عاديّاً في اللحظة الرَّاهنة من عمر الرواية العربيَّة. أمَّا في مطلع خمسينات القرن الماضي، فإنَّ الأمر لم يكن كذلك، حيث كان السَّرد يكادُ يقتصر على ضمير الغائب، بدرجة أقلَّ على ضمير المتكلّم، وكان ضمير المخاطب نادر الاستعمال. أمَّا التَّناوب، والانتقال السَّريع والمتكرﱢر بين الضمائر، فلم يكن مألوفاً. وقد خدمت هذه التقنيَّة الرواية بقوَّة، لا سيَّما في مطلعها، حيث يتهيَّأ البطل لدلالة جديدة في أرضٍ بعيدةٍ، وللخروج من ليل التقاليد القديمة إلى نهار الحُرﱢية. الباخرة تهتزُّ فوق الأمواج، وروحه كانت أرضاً “خاوية خالية، وعلى وجه القمر ظلام، وروح الله يرفُّ على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. ورأى الله أنَّ النور حَسَنٌ، وفصل الله بين النور والظلام، وسمَّى الله النور نهاراً، والظلام ليلاً، وكان مساءٌ وكان صباحٌ: يومٌ أوَّل””10″. كأنَّ روح البطل عائمة على الأمواج، تصغي إلى رفيف روح الله على المياه، وتنفعل من حيث لا تدري بقوَّة هذه الصور الواردة في سفر التَّكوين؛ لتستمدَّ منها قوَّة الإرادة بعد أن عزم صاحبها على البحث عن ولادة جديدة، خارجاً من ظلام ماضيه إلى نور غده. لقد رأى الله أنَّ النور حسن، فهل ثمَّة ما هو أحسن من نور الحُرﱢية التي تنتظر أبطالها في باريس؟
4- مسألة الحُرﱢية في الرواية وفي حياة كاتبها:
تكاد مسألة الحُرﱢية بمعناها الواسع تشكّل الهاجس الأوّل في الرواية، كما شكَّلت الهاجس الأكبر في حياة سهيل إدريس الحافلة بالنشاط الثقافيﱢ المتوزﱢع بين الإبداع الروائيﱢ والقصصيﱢ والترجمة والصحافة والعمل المعجميﱢ، والتدريس، إضافةً إلى دوره الروائيﱢ بتجديد الأدب العربيﱢ من خلال مجلَّة الآداب ودار الآداب، ودوره في تأسيس اتّحاد الكتَّاب اللبنانيين. كانت “الحيُّ اللاتينيُّ” المحطّة الأولى التي انطلق منها الكاتب لإعلاء شأن الحُرﱢية في الأدب والفكر والحياة.. ورحلة البطل إلى باريس هي رحلة البحث عن الحُرﱢية، وسعيه إلى ولادة جديدة هو سعيه إلى الخروج من رحم التَّقاليد الخانقة، مولوداً جديداً ينمو وينضج بسرعة في هواء الحُرﱢية.
5- الحُرﱢية، والمسؤولية، والفكر الوجوديُّ:
كان تأثير الفكر الوجوديﱢ قويّاً على سهيل إدريس، وهو ما ظهر في روايته الأولى “الحيُّ اللاتينيُّ”. لكنَّه استوعب هذا الفكر بشكلٍ صحيحٍ بعيداً عن المغالطات التي طالبته، وجنحت به نحو العبثية والعدمية. فالحُرﱢية المقترنة بالمسؤولية هي القيمة الكبرى في هذا الفكر، وهي الهاجس الأبرز في الرواية.
وقد بحث عنها البطل في الحياة الاجتماعية من خلال علاقته بالمرأة الغربية، ومقارنتها بمثيلتها الشّرقية، وانجذب إلى ما مثَّلته حبيبته من نموذج افتقده في مجتمعه، حيث الحُرﱢية الشخصية لا تنفصل عن المسؤولية. وتصدَّت الرواية بسخرية لمن أساء فهم الفكر الوجوديﱢ، وجعله مبرّراً لممارسات عبثية تافهة. فحين دخل البطل مع صديقه أحمد إلى إحدى الحانات، باحثاً عن حبيبته جانين ومحاولاً إصلاح ما أفسده في رسالته إليها خلال إجازته الصَّيفيَّة في لبنان، صادف فتاةً عابثةً بهيئةٍ رثَّةٍ تزعم أنَّها من الوجوديَّات. “تزعم أنَّها من الوجوديَّات هؤلاء اللَّواتي يعمرن هذا الحيَّ. ويضحك أحمد، ثمَّ يردف: اسمع… سألت إحداهنَّ مرَّةً: ما معنى الوجوديَّة التي تدينين بها أنت ورفيقاتك؟ فأجابت: أوه.. أن يعيش الإنسان هكذا، عيشةً تحرﱢره من كلﱢ شيءٍ، بلا مسؤولية! وهزَّ أحمد رأسه؛ وهو يقول: مسكين سارتر، كم يجني عليه هذا النَّوع من الفتيات والشُّبَّان”“11”.
6- القيود الاجتماعية في الشرق، قمع للحُرﱢية، وتغييب للمسؤولية:
خلال وجوده في لبنان تلقَّى البطل رسالة من جانين تعلمه فيها بأنَّها حامل، فإذا به يتصرَّف بجبنٍ وأنانيَّة، ويخضع خضوعاً تامّاً لمشيئة أمّه وسطوتها، تلك الأمُّ التي فضَّت الرﱢسالة وقرأتها قبله، والتي كانت على معرفة مقبولة باللغة الفرنسية، ثمَّ أملت عليه ما يجب أن يردَّ به على حبيبته، من نكرانٍ كاملٍ لمسؤوليَّته عن الجنين، تحسُّباً لأيﱢ مقاضاة أمام العدالة، وفقاً للعقل الشرقيﱢ الخائف، وهنا تبلغ الرواية ذروتها في إثارة مسألة الحُرﱢية، وضرورة اقترانها بالمسؤولية، وهو اقتران لا معنى له في المجتمع الشرقيﱢ حين يتعلَّق الأمر بالشرف المزعوم، وبالمفاهيم الدينية والأخلاقية التي تتبدَّل وتتكيَّف بسهولةٍ استجابةً للأنانيَّات والأهواء الذَّاتيَّة.
وقد أجاد الكاتب في اللغة والتعبير والتناوب في استعمال ضمائر السرد الثلاثة عندما تصدَّى لهذه المسألة المحورية في الفصل الثالث من القسم الثالث من الرواية، حيث يبرز ضمير المخاطب ليمثّل صوتاً مختلفاً عمَّا مثَّله من قبل. فقبل ذلك كان ضمير المخاطب صوتاً لضمير البطل أو صدًى للمنطق العادل والسَّليم، أمَّا هنا، فهو النَّقيض الكامل. إنَّه صوتٌ شيطانيٌّ يسوﱢغ الكذب، ويحرﱢض على التهرُّب من المسؤولية.
“إنَّ جانین حامل إذاً. ماذا أنت فاعل؟… ربَّما كان الضعف قد استباح حرمة نفسك لحظةً من اللحظات، فظننت أنَّ التفكير بالزواج منها ليس أمراً ممتنعاً… ماذا سيقول الناس؟ لقد عاد من باريس وفي ذراعه فتاة، لم تكن بكراً… أيَّة فضيحةٍ، وأيُّ عارٍ سينصبُّ على بيتنا؟! بيتنا هذا الذي عاش طويلاً في السَّتر، والفضيلة، والشرف، والدين… بقيت مسألة الضمير… ما الذي يثبت أنَّها حاملٌ منك أنت بالذات؟ أما تزال متردﱢداً يا بنيَّ؟ والتفت فجأةً إلى أمّه. لا، لم تكن هي الّتي تتكلّم… بل إنَّها هي التي تتكلَّم… هي التي تكلَّمت، أم شخص آخر لا يعرفانه؟… لقد سمع كلاماً ، ولا يدري أسمعه بأذنيه أم بأعماقه… وحين أمسك القلم ليكتب، شعر أنَّ وجه أمّه يقف فوق رأسه. لم يعرف إن كانت أمُّه قد لحقت به حقّاً… أم هو قد حمل هذه الرؤية إلى غرفته، وأيّاً ما كان، فقد رأى، وهو يكتب تلك الرسالة ظلَّ ذلك الّأس، رأس أمّه يهتزُّ هادئاً، موافقاً تارةً، معارضاً تارةً أخرى. لعلَّ هذا الفصل هو أجمل فصول الرواية، حيث يبلغ توتُّر البطل النفسيُّ أقصاه. فتتوتَّر اللغة، وتتشظَّى، وتتجمَّع، ويلتبس الموقف على الراوي والقارئ. من الذي يتكلَّم؟ صوت البطل الداخليُّ؟ أم صوت أمّه بأكملها؟ لم تعد أمُّه أمّاً بل أصبحت أمُّه تلقي بأثقالها عليه، وتمعن في سحقه. يستسلم البطل لهذا الصوت الداخليﱢ- الخارجيﱢ، ويبعث برسالته المسمومة إلى جانين، وقد صاغها بأنانيَّة مدمّرة، ولؤم غير مسبوق. (نصُّ الرسالة في الملحق رقم 1).
“وفي اللحظة التي انطفأ فيها النور، رأى يداً تمتدُّ، فتتناول الرسالة، وتختفي… أجل، الآن تنفَّس الصعداء أيُّها النّذل! الآن نم قرير العين أيُّها الجبان.“13” ويرد ضمير المخاطب إلى حالته الأولى، صوتاً لضمير البطل يؤنّبه بشدَّة، ويهيّئه للتمرُّد على الأمﱢ -الأمَّة.
“إنَّ أمَّه لم تدع له أن يفكّر في أمره، وينفذ منه إلى الحلﱢ الذي يراه هو. إنَّها بذلك قد محت شخصه، حطَّمت ذاته، وفرضت عليه شخصها هي، وذاتها هي. فأيَّ عبدٍ كنتَ لها؟ وأيَّ ذليل؟ وعزم على أن يهرب منها، من أمّه، هذه التي تذكّره بعبوديَّته وانقياده…”“14” يتَّخذ رفض الأمّ الوارثة لقيود الأمَّة شكل الهروب أوَّلاً، ثمَّ ينضج وعي البطل على ناره الداخليّة، فيقرﱢر تحمُّلَ مسؤوليّة أفعاله، متلمّساً ملامح قراره الصائب بشأن جانين، وثمرة حبّهما، يرتاد البحر مثقلاً بأعباء قراره المستقلﱢ الذي لم يكتمل بعد.
“وما كان يتمدَّد على الرمال، حتى طفرت إلى ذهنه جانين… ثم خُيّل إليه أنَّها تهبط إلى الماء… وأنَّه يرى يداً تنبثق من الأفق… وما تلبث أن تحطَّ على رأسها، وتأخذ في الضَّغط عليه… ليرى الرأس قد غمرته المياه كلَّه.. ويكاد أن يندفع؛ لينقذ تلك الروح المعذَّبة، ولكنَّه يشعر أنَّ الأوان قد فات… وقد خُيّل إليه… أنَّه رأى يوماً هذه اليد بالذات، تمتدُّ… تتناول رسالةً كانت على مكتبه، ثمّ تختفي”“15” يا لها من يدٍ قاتلة! ويا لها من أمﱟ جسَّدت بعاطفتها المشوَّهة والمتسلّطة كلَّ ما اختزنته أمَّته من عصور التخلُّف والانحطاط، فانصبَّت عليه مرَّةً واحدةً، قاتلةً حبَّه، خانقةً أحلامه، مدمّرةً حياةَ حبيبته. يعود البطل إلى باريس باحثاً عن حبيبته في محاولة متأخّرة لاستعادتها. ويطول البحث، ولا يجد أثراً لها، فيقرﱢر تحمُّل مسؤوليَّاته كلّها دفعةً واحدةً لكي يستحقَّ حُرﱢيَّته التي وجدها في باريس، ويحوﱢلها إلى حُرﱢيَّةٍ داخليَّة سيعود بها لاحقاً إلى لبنان، فلا يقدر أحد على انتزاعها منه. يقاوم اليأس منصرفاً إلى إتمام أطروحته الجامعيَّة، ينخرط في النشاطات الثقافيَّة القديمة مع رفاقه من الطُّلَّاب العرب، ولا يتوقَّف بحثه عن جانين، يتَّسع معنى المسؤولية، فيرتقي بالبطل من الذاتيﱢ إلى الجماعيﱢ، حاملاً هم أمَّته الغارقة في التَّخلُّف، والرازحة تحت الاحتلال الأجنبيﱢ. لا حُرﱢيَّة إذاً بلا مسؤولية، ولا مسؤولية بلا التزام. وهنا يكمن جوهر الفكر الوجوديﱢ الذي بشَّرت به هذه الرواية.
7- الحُرﱢيَّة والالتزام الوطنيُّ القوميُّ:
لم يفصل سهيل إدريس يوماً بين الحُرﱢيَّة والمسؤوليّة القوميَّة المتجسّدة في أدبٍ قوميﱟ إنسانيﱟ. ففي حوار مع سليمان بختي يقول: “على أنَّ مفهوم هذا الأدب القوميﱢ سيكون من السّعة والشمول حتى ليتَّصل اتّصالاً مباشراً بالأدب الإنسانيﱢ العامﱢ، ما دام يعمل على ردﱢ الاعتبار الإنسانيﱢ لكلﱢ وطنيﱟ، وعلى الدعوة إلى توفير العدالة الاجتماعيَّة له، وتحريره من العبوديَّات المادﱢيَّة والفكريَّة البعيدة”“16”. وبالعودة إلى الرواية، نرى كيف توطَّدت العلاقة بين بطلها وصديقه الأعزﱢ فؤاد. فالثاني يمثّل ما كان يصبو الأوَّل إلى اكتشافه في ذاته… إنَّه ذاته القوميَّة التي تسعى للتَّحقُّق والخروج إلى النُّور، وقد عبَّر الراوي عن ذلك عندما جاء فؤاد يودﱢع صديقه قبل عودته إلى وطنه سوريا؛ قائلاً: “فؤاد… أصحيح أنَّه سيغادره؟ فؤاد ذاته الثانية، ونظر هو إلى يده، هذه التي صافحتها يد فؤاد، فخيّل إليه أنَّها… كانت يد عشراتٍ يعرفهم، وألوفٍ لا يعرفهم، تعاهدوا على الصّراع من أجل الوطن العربيﱢ الكبير”“17”.
لقد اكتشف البطل ذاته الأولى في الحبﱢ المتحرﱢر من الحرمان الجسديﱢ من خلال علاقته بجانين، ثمَّ اكتشف ذاته الثانية، ذاته العليا من خلال الصداقة التي ربطته بفؤاد، فاكتمل وعيه بدوره كمثقَّف إزاء قضايا مجتمعه، ووطنه، وأمَّته العربيَّة.
8- العلاقة المتوتّرة بين الشرق والغرب:
كُتبَ الكثير عن الروايات التي عالجت صدمة الالتقاء المباشر بالغرب، ومفاعيلها اللاحقة على حياة من خاض هذه التجربة. واستحوذت أربع روايات على معظم الكتابات النقديَّة المتعلّقة بهذه الصدمة؛ وهي: “قنديل أم هاشم” ليحي حقّي، و”عصفور من الشرق” لتوفيق الحكيم، و”الحيُّ اللاتينيُّ لسهيل إدريس، و”موسم الهجرة إلى الشمال” للطَّيب صالح. والروايتان الأخيرتان -في رأينا- هما الأهمُّ والأعمق في مقاربة الموضوع، وفي معالجته بفنيَّة وجماليَّة عاليتين. وإن اتَّسمت علاقة مصطفى سعيد بالغرب بالحدَّة والعنف في رواية الطَّيب صالح، فإنَّ بطل سهيل إدريس كان أكثر توازناً وهدوءاً في هذه العلاقة المتوتّرة بطبيعتها، وربَّما يعود سبب هذا الاختلاف إلى الظروف الذاتيَّة والمجتمعيَّة لِكلﱟ من الكاتبَين، مع ملاحظة الفارق الزمنيﱢ بين نشر الروايتين، حيث نشرت رواية إدريس عام 1953، ورواية صالح عام 1966، وبقدر ما أدانت “الحيُّ اللاتينيُّ سياسة الحكومة الفرنسية الاستعمارية القمعية في الشمال الإفريقيﱢ، وسلوك جزء من الشعب الفرنسيﱢ المؤيّد لتلك السّياسة، بقدر ما أنصفت الجزء الآخر الرافض لقهر الشعوب، والمتعاطف مع قضاياها. وقد مثَّلت فرنسواز صديقة فؤاد رمزاً للجزء الأوَّل من الفرنسيين، في حين مثَّلت جانين رمزاً للجزء الآخر.
9- الشرق والغرب، ومسألة الهويَّة:
تطرح “الحيُّ اللاتينيُّ” مسألة الهويَّة عبر بطلها الباحث عن معناها الغامض في مجتمع ضيّق الآفاق، ويدفعه سؤال الهويَّة إلى تلمُّس إجابات أكثر وضوحاً لدى الآخر المختلف في الغرب. ويعبّر المفكّر علي حرب عن هذه الفكرة قائلاً: “التغيير هو في الغير، والإنسان يرى في نفسه من خلال غيره ما لم يكن يراه من دونه”“18”. ويقول الراوي في مقدﱢمة الرواية: “كان يستيقظ على نفسه، ويعي هويَّته، فيحاول أن يقوﱢم ذاته في حساب الشخصية الفردية، ولكن يعجزه في آخر الأمر، أن يرسم لنفسه صورةً متميّزةَ الأبعاد، واضحة المعالم. كان يتمثَّله شيئاً فارغاً يعوزه الامتلاء والكثافة، صدفة جوفاء ملقاةً على رمل شاطئ…“19”. وفي باريس يستمع البطل إلى صوته الداخليﱢ الأعلى بضمير المخاطب: إنَّك الآن في باريس… لعلَّك تدرك فيما بعد السبب العميق لمجيئك، ربَّما تدرك ذلك، إذ تعود إلى بلادك””20″. سوف يکبر سؤال الهويَّة في الرواية من مجرَّد هويَّة فرديَّة يبحث صاحبها عن معناها في حياته الشخصيَّة، إلى سؤال جماعيﱟ تحتشد فيه آلاف الأصوات العربيَّة من أبناء جيله. خلال حياته في باريس، عاينَ البطل أنماطاً مختلفة من الفرنسيين والطُّلَّاب العرب، واستفزَّته عنصريَّة البعض في نظرتهم المغلوطة إلى الإنسان العربيﱢ، واستعلائهم عليه، فوجد نفسه حائرا في مواجهة هذا التحدﱢي. هل يكون بالذَّوبان في الآخر ومحو الهويَّة الشرقيَّة؟ أم يكون برفض الغرب والتقوقع داخل الانتماء المحلّيﱢ الضَّيّق؟ إنَّه سؤالٌ جوهريُّ سيطرحه أمين معلوف بعد عقود من صدور “الحيّ اللاتينيّ”، في كتابه الهويّات القاتلة، فيكتب برؤية ناقدة: “إنَّ نظرتنا هي التي تجعل الآخرين يتقوقعون داخل انتماءاتهم الضَّيّقة، ونظرتنا إليهم هي أيضاً القادرة على تحريرهم”“21”. ويرفض البطل التقوقع الذي شاهده لدى بعض زملائه العرب، ويرفض الذوبان في شخصيَّة الآخر المتفوﱢق حضاريّاً، ويختار الانفتاح مع التَّمسُّك بثوابته القوميَّة، أمَّا التقاليد الشّرقية، فمنها ما يستحقُّ المحافظة عليه، ومنها ما يجب تغييره، ويعبّر أمين معلوف عن ذلك أيضاً بطريقة دقيقة؛ ويقول: “أمَّا التقاليد، فلا يجوز احترامها إلَّا بقدر ما تستحقُّ الاحترام، أي بالتحديد بقدر ما تُحترم الحقوق الأساسيَّة للرجال والنساء”“22”.
10- هل التقاء الشرق بالغرب مستحيل حقّاً؟
بعد عثور البطل على حبيبته التي أضاعها، فأضاعت نفسها، عرض عليها الزواج فرفضته، وتوارت إلى غير رجعة تاركةً له رسالةً تشرح موقفها فيها، وتؤكّد أنَّ حبَّه باقٍ في قلبها إلى الأبد، وقد رأى عددٌ من النُّقَّاد في هذا الرفض أنَّ الرواية تؤكّد استحالة النقاء والشرف بالغرب؛ بسبب الموقف الغربيﱢ الرافض لذلك. وكتب مصطفى عبد الغني في كتابه “الاتّجاه القوميُّ في الرواية: “واللافت للنظر أنَّ الفتى حين عاد هذه المرَّة إلى الغرب من جديد، آثر في لحظة ضعفٍ نفسيﱟ أن يتزوَّج من فتاته جانين، فإذا فتاة الحيﱢ اللاتينيﱢ ترفض الارتباط به والعودة معه من جديد. وهذا يعني على مستوى الرمز أنَّه حتى لو أراد الشرق العربيُّ الارتباط بالغرب، فإنّ الطرف الآخر “الغرب” سيرفض هذا العقد، إلَّا في حالةٍ واحدة، هي أن تتمَّ سيطرته عليه تماماً”“23”. واستند الناقد في رأيه هذا إلى عبارة في رسالة جانين هي: لسنا على صعيدٍ واحدٍ… لا، لن أذهب معك، وعد أنت يا حبيبي إلى شرقك البعيد الذي ينتظرك، ويحتاج إليك”“24”. وفي رأينا إنَّ هذا استنتاج غريب، ورمز لم يقصده الكاتب، وفكرة لم تبشّر بها الرواية. وبالعودة إلى الرسالة ذاتها يتَّضح أنَّ موقف جنانين من الزواج بحبيبها عائد إلى سقوطها في هاوية لا تريد لحبّها أن يتلوَّث بها، بعد أن تحوَّلت إلى بائعة هوى. “وعلى الرغم من الأوحال التي تلطّخ وجودي، فإنَّ في نفسي بعدُ موضعاً لم يلحق به التلوُّث، ولئن كان جسدي مقسوراً على أن يقتات خبز الناس، فإنَّ قلبي لا يقتات إلَّا بحبّك… ولعلَّ نصيباً من التبعة يقع على عاتق القدر، هذا الذي جعلك تصل إلى باريس متأخّراً يوماً واحداً على الموعد الذي كان بالإمكان إمساكي فيه دون السقوط في الهاوية. لا يا حبيبي، لسنا على صعيدٍ واحدٍ. لقد وجدت أنت نفسك بينما أضعت أنا نفسي…”“25”. إنَّ موقف جانين موقف نبيل فيه انتصار للحبﱢ، لكنَّها لم تعد على صعيدٍ واحد مع حبيبها عندما تعلَّق الأمر بالزّواج. ودعوتها له كي يعود إلى بلاده، ويناضل من أجلها، تنسجم مع موقفها الثَّابت في مناصرة القضيَّة العربيَّة: “وعد أنت يا حبيبي العربيَّ إلى شرقك البعيد الذي ينتظرك، ويحتاج إلى شبابك ونضالك”“26”. والجملة الأخيرة في هذا الاقتباس الّذي أخذه عبد الغني من الرواية أسقطها سهواً أو عمداً من كتابه للتأكيد على فكرته المسبقة المتعلّقة بالشرق والغرب. فالشرق ينتظر نضاله، وهي مؤمنة بحقّه في النّضال. هكذا يتَّضح لنا الرمز الحقيقيُّ لموقف جانين الأخلاقيﱢ والسّياسيﱢ.
11- توظيف السّيرة الذاتيَّة في الرواية:
يقول كونديرا: “لا شكَّ أنَّ كلَّ روائيﱟ يعترف طوعاً أو كرهاً من حياته، أنَّ هناك شخصيات مختلفة تماماً.. وشخصيات مستوحاة من نموذج حول عمل المخيّلة عن هذه الإيحاءات والملاحظات، ويغيّرها إلى درجة أنَّ الرّوائيَّ ينساها”“27”. وفي ملاحظة ذكيَّةٍ يرى الناقد أحمد درویش: “جنوح كثير من روايات الاغتراب إلى منابع السّيرة الذاتيَّة لإثراء المادَّة الخام بمعطياتها في عمليَّةٍ تبدو وكأنَّها عودةٌ للجذور، من خلال اشتداد البعد المكانيﱢ الذي قد يثير مخاوف انقطاع الصلة مع هذه الجذور، أو انقطاع المرجعيَّة التي يستند إليها الكيان الإنسانيُّ في تماسكه واستمرار وجوده”“28”. ویرى سهيل إدريس في حواره مع سليمان بختي أنَّ بإمكان الروائيﱢ أن يستوحي تجربته الخاصَّة؛ لأنَّه على هذا النحو يعبر أيضاً عن تجارب الآخرين. المهمُّ في العمل الروائيﱢ أن يعبّر عن العامﱢ بواسطة الخاص، وأن يكون موضوعيّاً في ما هو ذاتيٌّ”“29”. لا شكَّ أنَّ “الحيَّ اللاتينيَّ” استفادت من سيرة كاتبها، دون أن يعني ذلك على الإطلاق أنَّ بطلها هو الكاتب نفسه. ففيه ملامح منه تتَّصل بشغفه الأدبيﱢ وتطلُّعاته القوميَّة وثورته على التّقاليد القديمة. لكنَّ بعض النُّقَّاد والمحاورين أهملوا هذه الملامح وألحُّوا على الجانب الشَّخصيﱢ، وكأنَّ قصَّة البطل وجانين هي قصَّة الكاتب نفسه. وفي اقتباس من سيرته الذاتيَّة تميَّز بحسﱢ الدعابة، أسقط سهيل إدریس كسله المزمن في مادَّة الحساب على بطله الّذي تذكَّر في باريس كيف كلَّفه هذا الكسل عندما كان صغيراً “صفعتين على وجهه، وركلةً في مؤخّرته من قدم المعلّم أوصلته توّاً إلى مقعده”“30”. وسوف يتحدَّث الكاتب عن الواقعة ذاتها في سيرته الذاتيَّة “ذكريات الأدب والحبﱢ”“31” الصادرة عام 2002 وبطريقة شبه متطابقة مع ما ورد في “الحيﱢ اللّاتينيﱢ”.
12- الحيُّ اللاتينيُّ ونزار قبَّاني، تأثُّر وتأثير:
“إنَّ أمَّك الجميلة -التي أحببتها من وهج مقالك لها- تنتظر صواري سفينتك العائدة، وصباح جبينك الفسيح””32″. هذا مقطع من رسالة وجَّهها نزار قبَّاني من أنقرة بتاريخ ١٩٤٩/١١/٢٣ إلى صديقه سهيل إدریس. وبعد وفاة نزار نشر سهیل المفجوع بوفاته نصَّ الّسالة في مجلَّة الآداب معلّقاً عليها: “ترى هل كانت هذه الصُّورة السَّفينيَّة التي يتحدَّث عنها نزار وراء المقدﱢمة التي كتبتها لروايتي الحيّ اللاتينيّ، ووراء خاتمتها أيضاً؟”“33”.
بینما كان بطل “الحيﱢ اللاتينيﱢ” يسير مرتبكاً تحت مطر باريس المفاجئ، “مرَّت بقربه فتاة تقرأ في كتاب، وهي تمشي الهوينا، غير عابئة بالمطر، وشعر فجاةً بأنَّ موجةً من ضياء تغمر كيانه، فتقشع عن نفسه غيوم الاضطراب والقلق… هنا في صفحات الكتاب، سيجد راحة ضميره، إنَّ الكتاب وحده سيحرﱢره من قيود هذا العالم المعذّب الذي يعيش فيه… إنَّ نور الحرف هو الذي سيشقُّ له طريق الخلاص”“34”. هكذا تلمَّس سهيل إدريس طريق الخلاص في الحروف، وجعل من هذا الطريق هاجساً قويّاً من هواجس الرواية. وسوف يجد نزار قبَّاني طريق الخلاص ذاته، في واحدة من أجمل قصائده “الرسم بالكلمات”، والتي اختتمها ببيته الشعريﱢ الشهير:
“كلُّ الدُّروبِ أمامَنا مسدودةٌ وخلاصُنا بالرسمِ بالكلماتِ”“35”
وبعدَ صدور “الحيﱢ اللاتينيﱢ” بثلاث سنوات، صدرت مجموعةٌ شعريّةٌ لنزار بعنوان “قصائد”، وفيها قصيدة بعنوان “وجودية”“36” وبطلتها تحمل اسم جانين، وبقراءةٍ سريعة للقصيدة، نشعر بنسائم الفكر الوجوديﱢ تهبُّ علينا قادمةً من “الحيﱢ اللاتينيﱢ”، حاملةً ملامح بطلة الرواية واسمها، متغلغلةً في قصيدة نزار. (نصُّ القصيدة في الملحق رقم 2).
كلمة في خاتمة الرواية:
مثلما كانت مقدﱢمة الرواية قويَّةً وغنيَّةً بالدلالات، جاءت خاتمتها لتزيد من هذه القوَّة، وتوسّع تلك الدلالات، صاعدةً من الذاتيﱢ إلى الموضوعيﱢ الجماعيﱢ. فالوجوه التي تنتظر البطل على الشاطئ كثيرة؛ وأهمُّها وجهان: وجه الأمﱢ، ووجه فؤاد.
لكنَّ وجه الأخير هو أوَّل ما يميّزه البطل العائد: “وتقترب منه الوجوه رويداً رويداً، ثمَّ ينبثق منها فجأةً وجهٌ فَتيٌّ في ملامحه قسوةٌ وقلقٌ، ويطلُّ هذا الوجه الحبيب ليكبر وينمو… حتى يحتلَّ الشاطئ، وکلُّ شيءٍ من ورائه ظلٌّ، ثمَّ يملأ الأفق کلَّه، فلا تری عیناه من دونه شيئاً. وتكون يدُ فؤاد أوَّل يدٍ يصافحها، فيشعر أنَّه يصافح فيها عشرات من الأيادي التي يعرفها، وألواناً من الأيادي التي لا يعرفها… انتشر أصحابها في كلﱢ ركنٍ من بلاد العروبة… حتى يأتيه صوت أمّه ضعيفاً كأنَّما هو ينتحب: وأنا يا بنيَّ، هل نسيتني؟”“37”.
عاد البطل من باريس بوعيٍ جديدٍ لهويَّته ودوره في الحياة، ودفعته سفينة للعودة إلى ذاته العليا التي بحث عنها طويلاً في رمزيَّة فؤاد الذي احتلَّ وجهه شاطئ بيروت، ليحتلَّ شواطئ العرب بأسرها، وكم كان صوت أمّه ضعيفاً كأنَّما هو ينتحب، يحمل هلع مجتمعه الحبيب المكبَّل بالقيود. “الحمد لله… لقد انتهينا الآن يا بنيَّ، أليس كذلك؟”“38” هكذا يأتي صوت الأمﱢ- الأمَّة محاولاً استعادته إلى حضنها القديم الدافئ والخانق، فيجيبها بثقةٍ، وفؤاد رمزُ الأمَّة الجديدةِ بغدها الواثق واقفٌ إلى جانبه يمنحه الطمأنينة والثّقة: يجيبها من غير أن ينظر إليها: بل الآن نبدأ يا أمّي…”“39”. هذه هي رسالة الرواية الكبرى، تكاد تختصر في خاتمتها المقتضبة بعباراتها، المسهبة بدلالاتها.
هوامش البحث:
1- هنري ميلر، الكتب في حياتي، ترجمة أسامة إسبر، دار التكوين، ط1 2013، ص164.
2- رولان بارت، لذَّة النَّصﱢ، ترجمة فؤاد صفا، منشورات الجمل، ط1 2017، ص 46.
3- هيغل، المدخل إلى علم الجمال، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطّليعة، ط3 1988، ص45-46.
4- ميلان كونديرا، الوصايا المغدورة، ترجمة معن عاقل، المركز الثقافيُّ العربيُّ، ط1 2015، ص 269.
5- د. عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيَّات السرد، سلسلة عالم المعرفة، العدد 240، ك1 1998، ص 189.
6- سهيل إدريس، الحيُّ اللاتينيُّ، دار الآداب، ط8 1981، ص 5.
7، 8، 9- المرجع السابق، ص 4.
10- الكتاب المقدَّس، سفر التّكوين، جمعية الكتاب المقدَّس في لبنان، ط1 1993، ص 1.
11- الحيُّ اللاتينيُّ، ص ٠267
12- المرجع السابق، ص 231، 232، 233.
13- المرجع السابق، ص 234.
14- المرجع السابق، ص 236، 237.
15- المرجع السابق، ص 239، 240.
16- سليمان بختي، إشارات النصﱢ والإبداع، دار نلسن، ط1 1995، ص45.
17- الحيُّ اللاتينيُّ، ص 258، 259.
18- علي حرب، خطاب الهويَّة، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط2 2008، ص42.
19- الحيُّ اللاتينيُّ، ص 6.
20- المرجع السابق، ص ٠12
21 – أمين معلوف، الهويات القاتلة، ترجمة جبور الدويهي، دار النهار، ط3 2000، ص 25.
22- المرجع السابق ص 12.
23- د. مصطفى عبد الغني، الاتّجاه القوميُّ في الرواية، سلسلة عالم المعرفة، العدد 188، 2 آب 1994، ص 113.
24- الحيُّ اللاتينيُّ، ص 281، 282.
25- الحيُّ اللاتينيُّ، ص 280، 281.
26- الحيُّ اللاتينيُّ، ص 282.
27 – ميلان كونديرا، مرجع سابق، ص 270.
28- أحمد درويش، تداخلات النصوص والاسترسال الروائيُّ تقاطعات رواية السّيرة الذاتيَّة ورواية الاغتراب، مجلَّة فصول، المجلَّد 16، العدد 4، ربيع 1998، ص 35.
29- سليمان بختي، مرجع سابق، ص 54، 55.
30- الحيُّ اللاتينيُّ، ص 31.
31- سهيل إدريس، ذكريات الأدب والحبﱢ، الجزء الأوَّل، دار الآداب، ط1 2002، ص26، 27.
32، 33- سهيل إدريس، رسائل نزار قبَّاني إلى سهيل إدريس، مجلَّة الآداب، العدد 5/6 أيّار/ حزيران 1998، ص 27.
34- الحيُّ اللاتينيُّ، ص 47،48.
35- نزار قبَّاني، الأعمال الشعريَّة الكاملة، الجزء الأوَّل، منشورات نزار قبَّاني، لا. ط ت1 2000، ص466.
36- المرجع السابق، ص 330.
37- الحيُّ اللاتينيُّ، ص 283، 284.
38، 39- المرجع السابق، ص 285.
الملاحق:
– ملحق رقم 1، نَصُّ رسالة البطل إلى جانين.
“صديقتي جانين: تلقَّيتُ رسالتك التي تبلغينني فيها أنَّك تنتظرين مولوداً، على ما قال لكِ الطبيب. وقد دهشتُ حقّاً حین فهمت أنَّكِ لم تعلني هذا النَّبأ السَّعيد لجميع أصدقائك، وهم ليسوا قليلين، هؤلاء الأصدقاء الذين أعرف أنَّه كان لك مع بعضهم علاقات غير طاهرة. أمَّا علاقتنا نحن الاثنين، فأحسبك لا تشكّين بأنَّها کانت بريئة. ولهذا أجدني، وتجدينني أنت كذلك، غير متأثّر البتَّة بهذا النَّبأ. وليس لي أن أقدﱢم لك أيَّة نصيحةٍ أو إشارة. تحيَّاتي الصَّادقة لكِ”.
الحيُّ اللاتينيُّ ص 233.
-ملحق رقم 2، نَصُّ قصيدة “وجودية”:
كان اسمها جانين…
لقيتها –أذكر- في باريس من سنين
أذكر في مغارة (التابو)
وهي فرنسيَّة…
في عينها تبكي سماء باريس الرماديَّة
وهي وجوديَّة
تعرفها من خفّها الجميل
من همسات الحلق الطَّويل
كأنَّه غرغرة الضَّوء بفسيقه
تعرفها من قصَّة الشَّعر الغلاميَّة…
من خصلةٍ في اللَّيل مزروعةٍ
وخصلةٍ.. لله مرميَّه
كان اسمها جانين
بنطالها سحبة كبرياء
خيمة حسنٍ تحتها… يختبئ المساء
وتولد النُّجوم
وخُفُّها المقطَّع الصَّغير
سفينةٌ مجهولة المصير
تقول للجاز ابتدئ…
أريد أن أطير…
مع العصافير الشتائيَّة
إلى مسافاتٍ خرافيَّة
أريد أن أصير
أغنيةً أو جرح أغنية
تمضي بلا اتّجاه
تحت المصابيح المسائيَّة
في حارة ضيّقة
في ليل باريس الرماديَّة
كان اسمها جانين…
وهي وجوديَّة
تعيش في التابو.. وللتابو
ولیلها جازٌ وسرداب
صندلها المنسوج من رعود
يزيد من إغرائها
وكيسها الرَّاقص من ورائها…
صديقها في رحلة الوجود
تقول للَّحن: انهمر
أريد أن أرود
جزائراً في الأرض منسيَّة
جزائراً مرسومةً بأدمع الورود
ليس لها سورٌ… ولا بابٌ… ولا حدود
كانت وجوديَّة
لأنَّها إنسانةٌ حيَّة
تريد أن تختار ما تراه
تريد أن تمزﱢق الحياه…
من حبّها الحياه…
كانت فرنسيَّة
في عينها تبكي سماء باريس الرماديَّة
كان اسمُها جانين