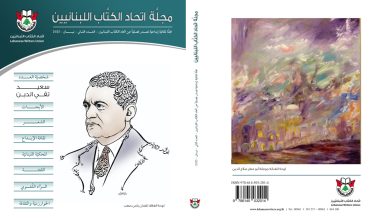سهيل إدريس: “مؤذِّن” الحداثة ورائد التنوير – أ. شوقي بزيع
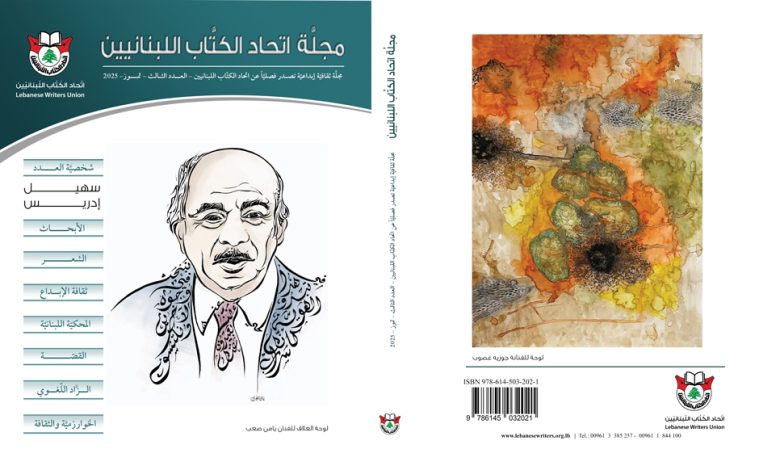
سهيل إدريس: “مؤذِّن” الحداثة ورائد التنوير
أ. شوقي بزيع
كم يصعب على شخص مثلي أن يختزل بالقليل من السطور شخصاً استثنائيَّ الحضور والغياب من طراز سهيل إدريس. ليس فقط لأنه الصديق والأب الرمزيُّ الذي رعى تجربتي الشعرية منذ زمن الصبا، واحتضنها على صفحات “الآداب”، وفي دار النشر التي تحمل الاسم نفسه، بل لهويات إدريس المركَّبة، وهو الروائي والناقد والمترجم والمعجمي والناشر والمثقَّف الموسوعي، الذي تضيق بأدواره الكتب والدراسات والمصنفات.
فلسنا هنا إزاء مثقَّف من الطراز العادي، بل إزاء حالة نادرة وشبه يتيمة في صحراء العرب المترامية الأطراف. إذ نَدر لمثقَّف عربي أن تعهَّد بيديه العاريتين أن يدفع صخرة الهزيمة إلى الخلف وأن يقسم جسمه، كعروة بن الورد، إلى جسوم كثيرة كما فعل سهيل إدريس. فمن قلب بيروت خرج ذلك الفتى النضر الوجه والقصير القامة ليضيئ في الظلمة العربيَّة أطول الشموع وأكثرها التصاقاً بالدمع. ووسط مجتمع بيروت المحافظ خلع ذلك الشاب الخجول عمامته وجبَّته ووصايا والده ليلتحق بالسوربون وليتَّصل بأفكار الحداثة وفلسفات التنوير ويعود إلى مدينته محمَّلاً بالوعود. كان باستطاعته بالطَّبع أن يجد كأترابه البيروتيّين، طريقاً أقصر إلى الثروة كأنْ يشتغل بالتجارة أو المقاولات أو يدير محلاً للحلوى. وكان باستطاعته أن يواصل تلاوة القرآن في المساجد أو يواصل رفع الأذان على قمَّة مآذنها، ولكنَّه آثر بدلاً من ذلك أن يرفع أذانه الخاصَّ فوق كلﱢ بقعة من بقاع العرب مناديّا بصوته الرخيم أن: حيَّ على الثقافة، حيَّ على التنوير.
هكذا وُلِدت “الآداب” من احتكاك شرارتين اثنتين، إحداهما انبثقت من الجنون الشخصي لسهيل إدريس والأخرى من الجنون القومي الجماعي الذي وجد في جمال عبد الناصر ضالَّته وقابلته وعنوانه. وإذا لم يكن على امتداد الأفق العربي مجلَّة ثقافيَّة جامعة تنتصر للحداثة وقيمتها دون أن تتعارض مع الالتزام ورغبة الأمَّة في التوحُّد، فقد انبرى الفتى العائد من فرنسا لتأسيس المجلَّة التي اتَّسعت صفحاتها لكلﱢ صعاليك العرب وسارقي نار اللغة الجديدة بدءاً من بدر شاكر السيَّاب والبيَّاتي والحيدري ونازك الملائكة وأدونيس وصلاح عبد الصبور وعبد المعطي حجازي وحتى الأرتال المتأخرة من جيلَي الستّينات والسبعينات. ولم يكن السجال المرير الذي دار أواخر الخمسينات وأوائل السّتينات بين مجلتَي “الآداب” و”شعر” ليفتَّ من عضد سهيل إدريس ويقلّل من انحيازه إلى فكرة الالتزام التي نادى بها سارتر في الغرب بل إنَّه هبَّ في خياراته حتى النهاية، تماماً كما ذهب في خياراته الأخرى المتوجّسة من قصيدة النثر والتي ترى فيها خروجاً على الحساسيَّة العربيَّة ودفعاً باللغة الشعريَّة نحو التسيُّب والفوضى الكاملَين. ومع ذلك فإنَّه لم يكن منغلقاً على ما يرِدُه من ملاحظات وآراء مخالفة من قِبلِ ؟؟ كما من قبل بعض الأصدقاء الذين طالبوه مراراً بنقل السّجال بين الخيارات والأساليب الشعرية إلى داخل “الآداب” نفسها وفتح المجلَّة بالتالي أمام رياح المغامرة والتجدُّد، التي تهبُّ من كلﱢ صوب. وما نشْره للعديد من قصائد النَّثر في “الآداب” وللمجموعات النثريَّة في الدَّار المسمَّاة باسمها سوى الترجمة الفعليَّة لانفتاحه الذهني ولقبوله التدريجي بمتغيّرات الثقافة والعصر.
ورغم فرادة المجلَّة وتنوُّعها وجدَّتها، فإنَّ من الظلم ألَّا نرى من سهيل إدريس سوى دور المحرﱢض والمحرﱢك والمنشّط الثقافي. ذلك أنَّ دوره الرﱢيادي في تأسيس الرواية العربيَّة ونهوضها لا يقلُّ عن أدواره الأخرى. فروايته “الحيّ اللاتيني” بتقنيَّاتها الجديدة وطروحاتها الإنسانيَّة والحضاريَّة وأسلوبها الواقعي الرَّشيق هي إحدى العلامات السَّرديَّة الفارقة ليس في زمنها وحسب وإنَّما في الأزمنة اللاحقة لصدورها. إنَّ أسئلة الهوية والحبﱢ والمنفى والمكان وعلاقة الأنا بالآخر، التي طرحتها رواية إدريس هي نفسها الأسئلة الماثلة أمام جيلنا الحاضر والتي ستنتقل عدواها إلى الأجيال اللاحقة. وما يصحُّ على “الحيّ اللاتيني” يصحُّ على “الخندق الغميق” و”أصابعنا التي تحترق” حيث نرى الصورة الأكثر تجسيداً لروح بيروت الممزَّقة بين الخيارات والمتناهَبة بين قيود الماضي ونداءات المستقبل. ومع ذلك، فإنَّ الكثيرين يعرفون أنَّه كان يمكن لسهيل إدريس أن يذهب بعيداً في عوالم الرواية والقصَّة لو لم يأخذ على عاتقه مهمَّات النهوض بمجلَّته الرائدة والوقوف إلى جانب عشرات المواهب والطاقات الإبداعيَّة التي يحتاج تفتُّحها إلى عنايته وجهده.
على أنَّ المجلَّة وحدها لم تكن كلَّ شيئ، بل كان إلى جانبها مهمَّات وأثقال جسام لا يملك واحد مثلي سوى التساؤل عن الطاقة الهائلة التي أُعطيت لهذا الرجل لكي يجد السبيل إلى تحقيقها. فإلى جانب المجلَّة كانت “دار الآداب” تأخذ ما تبقَّى من أعصاب الرجل العصامي وهمَّته ووقته. وإلى جانب الدار وجد سهيل إدريس الوقت اللازم لترجمة بعض أعمال جان بول سارتر وألبير كامو وغيرهما، فضلاً عن مساهمته الرئيسة في تأليف “المنهل” الذي كان وما يزال يعتبر أحد أهمﱢ المعاجم الفرنسيَّة – العربيّة. وإذ أسهم إدريس في تأسيس اتّحاد الكتَّاب اللبنانيّين في منتصف السّتينات من القرن الماضي فقد خاض، خلال فترة رئاسته له وفي الفترات اللاحقة أيضاً، الحروب الشعواء والمعارك الضاربة للدفاع عن حُريَّة الكتَّاب واستقلاليَّتهم وحقّهم في التعبير بعيداً عن الظلم والاعتقال والتكفير ومصادرة الرأي.
كنت أرغب بالطبع أن أتحدَّث عن سهيل إدريس خارج هذا الإطار التوثيقي الذي وجدت نفسي مدفوعاً إلى كتابته ليس من قبيل الوفاء والعرفان لشخصه ودوره في زمن العقوق والخيانات الصغيرة والكبيرة فحسب، بل ربَّما لأنجو من التحديق المباشر في ذلك الوجه الصبوح والدائم الابتسام والمفعم بالمودَّة والحنوﱢ. لكنَّ الكلام عنه لا يستقيم دون أن أعرﱢج قليلاً على الإنسان فيه وعلى الرجل الذي سعيت خائفاً ومرتبكاً إلى زيارته عشيَّة الحرب الأهليَّة في مكتبه في العازاريَّة لكي أحظى بفرصةٍ لنشر أولى قصائدي على صفحات “الآداب”. لم يترك لي الكاتب الكبير يومها فرصة للتلعثم أمام قامته وحضوره، بل سرعان ما بدَّد بدماثته وتواضعه كلَّ ما انتابني من هواجس وتهيُّؤات وأخذ بيدي سريعاً على طريق المغامرة الشعريَّة. لم أكن لأصدﱢق أنَّ الرجل القصير الآخر الذي يقف إلى جانبه لدى زيارتي الأولى إلى مكتبه هو حنَّا مينا بشحمه ولحمه. ولا صدَّقت في المرَّة الثانية، وكان مكتبه قد انتقل إلى الخندق الغميق، أنَّ الرجل الممشوق القوام والبهيَّ الطلعة الذي يقف إلى جانبه هذه المرَّة هو نزار قبَّاني. ومن دهشة إلى دهشة وبين ذهول وذهول أتاح لي سهيل إدريس فرصة التعرُّف إلى العشرات من الشعراء والكتَّاب والمبدعين العرب. ورغم فارق السنﱢ الذي بيننا، وهو بعمر أبي تماماً، فقد استطاع بتواضعه الجمﱢ ودماثة خلقه أن يزيل فجوة الزمن تلك وأن يثبت أنَّ الصداقة كالشعر تماماً هي شأن لازمنيٌّ وأن لا صلة لها بالأعمار. ولعلَّ تلك الصداقة وحدها هي الفخُّ الأجمل الذي نصبه لي صاحب “ذكريات الأدب والحب” في سنوات عمري المبكرة بحيث وجدتني بشكل تلقائي أدفع إليه بمجموعاتي الشعرية الثلاث عشرة كلها بدءاً من “عناوين سريعة لوطن مقتول” وحتى “لا شيء من كل هذا” و”صراخ الأشجار”.
لقد اجتمعت في سهيل إدريس خصال وصفات متباينة نَدر أن أسلمتْ نفسها لأحد. فإلى الجهد المضني والمثابرة البتوليَّة لديه رغبة لا تقاوم لافتراع الحياة والتهامها. وإلى احترام الوقت والتنسُّك المعرفي لديه أنف شهواني لا يخطئ الهدف وعينان جاحظتان أبداً نحو أبعد ما في النساء من أسرار ولجج مطويَّة على غموضها. وإلى عصبيَّة وانفعال لا يملك دفعاً لهما في لحظات الخيانة والغدر والجحود كان يملك بديهة أخفَّ من أيدي النشَّالين، وكان يرتجل النكات كما يرتجل السحرة الحمائم من تحت قبَّعاتهم. يكفي أن أذكر في هذا السياق طرفة واحدة من عشرات الطُّرف التي تعكس بديهته السريعة وذكاءه اللمَّاح. ففي دورة من دورات معرض الكتاب العربي في الثمانينات كان الشاعر الراحل نزار قبَّاني قد عهد بمؤلَّفاته ومنشوراته إلى “دار الآداب” لكي تقوم بتوزيعها بعد أن اضطرَّ إلى مغادرة لبنان إثر مقتل زوجته بلقيس وتفاقم الوضع الأمني في بيروت. كنت يومها قد أصدرت مجموعات شعريَّة ثلاثاً، كما أذكر. وإذ لفتني أنَّ كتب نزار قبَّاني تلاقي رواجاً لا مثيل له وتشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الجمهور، فقد خطر لي أن أضع نسخاً من مجموعاتي الشعريَّة وسط كتب نزار قباني. وحينما سألني سهيل إدريس عن الغرض من فعلتي تلك قلت له “ربما تباع كتبي بفعل العدوى، أو لأنَّ أنظار القرَّاء تلتفت إليها في هذه الحالة”. لم يُظهر الدكتور سهيل حماسة لما أفعله ولكنه لم يرد أن يحبطني بل اكتفى بابتسامة ذكيَّة وذات مغزى حتى إذا عدت بعد يومين من هذه الحادثة إلى جناح “دار الآداب” في المعرض بادرت صاحب الدار بالسؤال: “كيف حال المبيعات يا دكتور؟” فأجاب سهيل إدريس ضاحكاً: “المفاجأة ليست في كون مجموعاتك الشعرية لم تعد تباع منذ يومين، بل في كون كتب نزار قبَّاني نفسه لم تعد تباع أيضاً!”.
لعشر سنوات خلت لم أكن أرى في سهيل إدريس ما يشير إلى قنوط أو انكسار أو استسلام أمام المرض، رغم اندحار حلمه القومي وانكفائه أمام عشرات الحروب العربية الخاسرة. وحده رحيل نزار قبَّاني هو الذي كسره من الداخل وطحن روحه إلى أبعد الحدود كما أسرَّ لي ذات لقاء. وإذ تضافر عليه مرضا الضغط والسكَّري وأتلفا كليتيه اللَّتين كان يضطرُّ إلى إجراء “غسيل” لهما لثلاث مرَّات في الأسبوع، فقد قرَّر سهيل إدريس أن يختفي عن الأعين لكي لا تتهشَّم أمامنا صورة الشخص النضر والمعافى والطافح بالحياة، الذي عرفناه من قبل. ثم ما لبث أن أغمض عينيه بهدوء ساحباً حياته من عهدة المختبرات الهزائم والأنابيب وحقن الدم ونُذر الحرب التي تعصف بوطنه باتّجاه الأحلام البيضاء التي لن يشاركه في رؤيتها أحد.