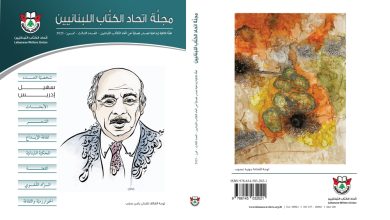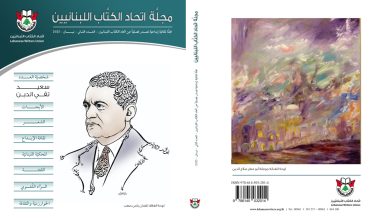سهيل إدريس، ريادة مشروع ثقافيﱟ قوميﱟ عربيﱟ حديث – أ. د. عبد المجيد زراقط
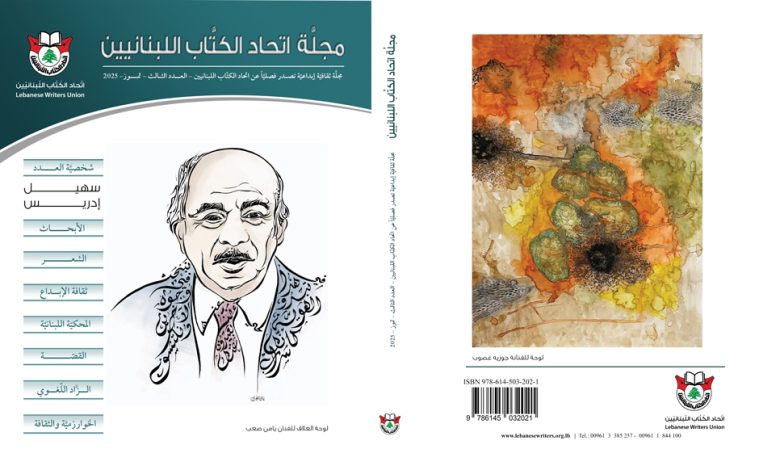
سهيل إدريس، ريادة مشروع ثقافيﱟ قوميﱟ عربيﱟ حديث
أ. د. عبد المجيد زراقط
في مسار تحقيق المشروع الثقافيﱢ…
د. سهيل إدريس (1925- 19/2/2008) روائيٌّ وقاصٌّ ومترجمٌ وباحثٌ ومعجميٌّ، وناشر مجلة الآداب ورئيس تحريرها وصاحب دار الآداب ومديرها العامُّ، وناشطٌ ثقافيٌّ… .
انتظم عمل إدريس، في هذه المجالات جميعها، في مسار تحقيق مشروعٍ ثقافيﱟ قوميﱟ عربيﱟ حديثٍ، في مرحلةٍ من التاريخ، هي النصف الثاني من القرن العشرين، كانت بيروت فيها عاصمة الثقافة العربية، وأحد مركزَيها (المركز الآخر القاهرة)، وينشط فيها روَّاد مشاريع ثقافية عربية هي: المشروع الثقافيُّ العربيُّ الذي كان سهيل إدريس أحد روَّاده، كما قلنا قبل قليل، والمشروع الثقافيُّ الماركسيُّ، الممثَّل بمجلَّتي الثقافة الوطنية والطريق، اللتين كان يحرﱢرهما حسين مروة ومحمد دكروب، والمشروع الثقافيُّ الليبراليُّ، الممثَّل بمجلة شعر، التي كان يرأس تحريرها يوسف الخال، والمشروع الثقافيُّ السوريُّ القوميُّ الاجتماعيُّ، الممثَّل بمجلة فكر ومنشورات الحزب السوريﱢ القوميﱢ الاجتماعيﱢ.
كانت الحياة الثقافية في بيروت، في تلك المرحلة، حياةً عربيةً. وكانت بيروت، فيها، واحة الثقافة العربية، ينشط، في نعيمها، المثقفون العرب، على اختلاف انتماءاتهم، بِحُرﱢية، فغزر الإنتاج الثقافيُّ، ولا سيما الأدبي منه، شعراً وقصةً وروايةً ومسرحاً، وتنوَّع، وكان، في معظمه، جديداً، وينحو نحو مزيدٍ من التجديد، وكان لمجلة الآداب ودارها الدور الأساس في إغناء هذه الحياة الثقافية وتطويرها، في مسار السعي إلى تحقيق المشروع الذي أُنشئتا من أجل تحقيقه.
امتلاك “العدَّة” اللازمة: المبادئ والأدوات
كان سهيل إدريس، في بدء تلك المرحلة، قد امتلك العدَّة، إن صحَّ التعبير، التي تؤهِّله لأن ينهض بأداء هذه المهمَّة؛ فهو بعد تخرُّجه من الكلّية الشرعية، سنة 1940، تخلَّى عن زيّه الشرعيﱢ والمشيخة، وسافر إلى باريس، ليتابع دراساته العليا، في جامعة السوربون، وينال شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، منها، وموضوعها:” القصة العربية الحديثة، والتأثيرات الأجنبية فيها، من عام 1900 إلى عام 1940″. وهو، في ما قام به، يفعل ما فعله حسين مروه، الذي خلع الجبَّة والعمامة، وانتمى إلى الحزب الشيوعيﱢ، وراح ينشط في تحقيق مشروعٍ ثقافيﱟ ماركسيﱟ تحرُّريﱟ تغييريﱟ، وسبقهما إلى هذا الصنيع طه حسين، الذي غادر الأزهر الشريف إلى الجامعة، في القاهرة، ثم في باريس، ثم عاد ليؤدﱢي دوره النهضويَّ المعروف…
إن كان حسين مروه انتمى إلى الحزب الشيوعيﱢ، وعمل من منظورٍ ماركسيﱟ على دراسة التراث العربيﱢ القديم والمعاصر، وإن كان طه حسين قد رأى أنَّ مستقبل الثقافة، في مصر، وتالياً في الوطن العربيﱢ، يجد مرجعيته في الثقافة الغربية، فإنَّ تجربة سهيل إدريس كانت مختلفة؛ إذ إنه، أولاً، لم ينتمِ إلى أيﱢ حزبٍ، ولم ينشط في العمل السياسيﱢ المباشر، وإنَّما كان منتمياً، كما كان يقول، إلى أمَّته العربية وثقافتها وهمومها، وملتزماً بهذا الانتماء، وثانياً، عمل على الإفادة من التراثين العربيﱢ والغربيﱢ، بغية إنتاج أدبٍ عربيﱟ جديدٍ يصدر عن مرجع هو الواقع العربيُّ المعيش، وكان مؤهلاً للقيام بذلك؛ فهو يمتلك ثقافة عربية قديمة وحديثة، وثقافة غربية قديمة وحديثة، وثالثاً، عمل على المواءمة، أو التوفيق بين المشروع القوميﱢ العربيﱢ، بوصفه مشروع حركة تحرُّر وتحديث، وبين الفلسفة الوجودية السارترية، ومبادئها: الحرية والمسؤولية والالتزام. وهذا لا يعني الانغلاق على الذات، ولا يعني كذلك التخلّي، في الإنتاج الأدبيﱢ، عن الصنيع الفنيﱢ والجمالية الأدبية.
عمل إدريس، في سبيل تحقيق مشروعه الثقافيﱢ، على امتلاك الأدوات الثقافية التي تتيح له ذلك، فعمل، منذ ترك المشيخة، في الصحافة، في جريدتَي بيروت وبيروت المساء، وفي مجلتَي الصياد والجديد. ونشر، سنة 1948، أولى رواياته: “سراب” مسلسلة في جريدة بيروت المساء.
بقي يعمل في الصحافة حتى العام 1949، وهو العام الذي سافر فيه إلى باريس. وعندما عاد منها أسس، سنة 1953، مع شريكَيه منير بعلبكي وبهيج عثمان، مجلة الآداب، ثم استقلَّ بها سنة 1956. وفي هذه السنة أسَّس مع الشاعر نزار قباني دار الآداب، ثم استقلَّ بها سنة 1961. وأنشأ مع رئيف خوري وحسين مروه جمعية “القلم المستقل”، التي انشقَّت عن جمعية “أهل القلم”. وكان مسؤول النشاط الثقافيﱢ في جمعية المقاصد، ومن المناظرات التي نظَّمها المناظرة التي جرت بين طه حسين ورئيف خوري، وكان موضوعها: الأدب للأدب أو الأدب مسؤول. وفي سنة 1968، أسَّس مع قسطنطين زريق وجوزيف مغيزل ومنير بعلبكي وأدونيس اتحاد الكتَّاب اللبنانيين، وتولَّى أمانته العامَّة لِعدَّة دورات.
تفرَّغ سهيل إدريس للعمل في هذه المؤسسات الثقافية، وتوقَّف، كما تفيد قائمة إنتاجه الأدبي، عن كتابة الرواية والقصة القصيرة، ما عدا كتابته سيرة مرحلة من حياته، تحت عنوان: “ذكريات في الأدب والحب” عرفت جرأة في الاعتراف.
دور مجلة الآداب ودارها وأهميتها
يبدو أنَّ ذلك التوقُّف يعود إلى أنَّ العملَ الثقافيَّ، في تلك المؤسسات، أخذ معظم وقته، فكانت مجلة الآداب مساحة لجميع الأقلام العربية المجدﱢدة، ما أدَّى إلى كشف مواهب، ونبوغ مبدعين، ونهوض حركة نشر وتوزيع مزدهرة، وتطور حركة نقد، وإثارة سجالات، ونشر ترجمات، وبلورة قيم أدبية وقومية وطنية وإنسانية…، وتشكيل ذائقة أدبية جديدة، وتحمُّل أهواء الأدباء والنقَّاد ونزواتهم ومعاناة استبداد الرقابة…، وهذا هو الدور الذي أدَّته دار الآداب على مستوى نشر الكتب الأدبية والفكرية والمترجمة، وخصوصاً ترجمة كتب الفلسفة الوجودية السارترية، ومنها: الغثيان، وسنُّ الرشد، ووقف التنفيذ والسيرة الذاتية لسارتر.
ولما كان إدريس مترجماً، ويعرف معاناة المترجمين، وضع معجم “المنهل”، سنة 1970. وهو معجم فرنسيٌّ – عربيٌّ، مع د. جبور عبد النور، ليسهّل أمور المترجمين، ويسهم في معرفة المثقفين العرب بالإنتاج الثقافيﱢ الغربيﱢ.
نتاجه الأدبيُّ
كتب سهيل إدريس القصة القصيرة والرواية والمسرحية والدراسة. مجموعات قصصه القصيرة هي: أشواق- 1947، نيران وثلوج- 1948، كلُّهنَّ نساء- 1949، الدمع المرُّ- 1956، رحماكِ يا دمشق- 1965، العراء- 1977. ويبدو أنَّه جمع هذه المجموعات في كتابين هما: أقاصيص أولى وأقاصيص ثانية- 1977. وألَّف مسرحيتين هما: الشهداء وزهرة من دم، وثلاث دراسات هي: في معركة القومية والحرية، مواقف وقضايا، وأطروحته لنيل شهادة الدكتوراه: القصة العربية…، وثلاثيته الروائية المعروفة.
منظور واتجاه روائيَّان
كتب سهيل إدريس قصصه القصيرة ورواياته من منظور الالتزام الذي ذكرناه آنفاً؛ فثلاثيَّته الروائية: الحيِّ اللاتيني- 1952، والخندق الغميق- 1958 وأصابعنا التي تحترق- 1962، تصدر عن هذا المنظور، وتنطق برؤيته، ما جعلها تمثّل اتجاهاً في الرواية اللبنانية، يمكن تسميته بالاتجاه الذي يتشكل بناء رواياته بتأثير أفكار فلسفية مسبقة.
وكان تاريخ الرواية اللبنانية قد عرف، في آونةٍ سابقةٍ، نماذج تمثّل هذا الاتجاه الذي تصدر نصوصه عن أفكار مسبقة. ومن هذه النصوص رواية “العائد” لخليل تقي الدين، وروايتا “لقاء” و”مرداد” لميخائيل نعيمة. فهذه النصوص تستخدم الأحداث وسيلة لعرض أفكار مسبقة، منبثقة من مذهب وحدة الوجود والحلولية الفلسفيﱢ.
ثنائية روائية حضارية
تمثّل روايتا الحي اللاتيني والخندق الغميق ثنائية تضاد، فالاسم، في كلﱟ من الروايتين، ليس دالاًّ على المكان الجغرافيﱢ فحسب، وإنَّما هو دالٌّ على فضاء حضاريﱟ؛ فالحيُّ اللاتينيُّ حيٌّ جامعيٌّ يُقيم فيه طلبة جامعة السوربون في باريس، تجري فيه الأحداث في فضاء العلم والعلمانية والحرية والتقدم…، والخندق الغميق حيٌّ قديمٌ من أحياء بيروت، تجري فيه الأحداث، في فضاء يصفه ميخائيل نعيمة بقوله: “…، عاش أجيالاً خلف سجف كثيفة من العادات والتقاليد القديمة…”، وهو دالٌّ على الواقع الذي تعيشه الأمَّة في خندقٍ غميقٍ، يذكّر بما جاء في رواية “أديب” لِطه حسين: “الحياة، في مصر، هي الحياة في أعماق الهرم…”، والحياة في الحيﱢ اللاتينيﱢ هي الحياة بعد الخروج من أعماق الخندق الغميق والهرم، إلى العالم الواسع، والعمل على تحديث ذلك العالم القديم من منظورٍ قوميﱟ عربيﱟ – وجوديﱟ. وسيرة هذا العمل الشاقﱢ ترويها رواية “أصابعنا التي تحترق”.
بين السيرة الذاتية والرواية
ما يجدر ذكره، في هذا الشأن، هو: ليست هذه الثلاثية سيرة ذاتية، وإنما هي روايات يختار المؤلّف، من منظوره، وقائع من سيرته الذاتية، ومن الواقع المعيش، ويقيم منها، من منظوره أيضاً، بوصفها مادة روائية حكائية، بناءً روائياً متخيَّلاً، ينطق برؤية هذا المنظور إلى العالم وقضاياه، فما هو هذا المنظور؟ وما هي تلك الرؤية؟
المنظور الروائيُّ والفلسفة الوجودية السارترية
أسهمت مجلة الآداب ودارها، وصاحبهما سهيل إدريس، في نشر مبادئ الفلسفة الوجودية السارترية التي ازدهرت في أوروبا، وخصوصاً في فرنسا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فجاءت هذه الفلسفة كأنَّها ردة فعل على تلك الحرب الوحشية التي خلخلت منظومة القيم، فدعت إلى مبادئ الحرية والمسؤولية والالتزام بهما، وهي المبادئ التي تحقق للفرد تحرُّره من القيود الاجتماعية، وللأديب ثورته على الواقعية، بمعنى انعكاس الواقع في الأدب.
وقد نشطت المجلة والدار وصاحبهما وكتَّابهما في نشر الترجمات والدراسات التي تعرﱢف الفلسفة الوجودية السارترية وأعلامها وآثارهم الفكرية والأدبية.
وراح إدريس يشجّع الكتَّاب والمثقَّفين على الاعتقاد بمبادئ هذه الفلسفة والتبشير بها، فأدَّت هذه الجهود إلى رواج الفكر الوجوديﱢ، خلال العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين، ولدى فئات من الأدباء والمفكرين كانت تناهض الفكر الماركسيَّ الذي كان ينشط بفاعلية في الحياة الثقافية، كما كانت تناهض، في الوقت نفسه، الفكر الليبراليَّ التابع، من منظور قوميﱟ عربيﱟ وطنيﱟ يسعى إلى التحرير والتغيير.
الالتقاء الإبداعيُّ واختلاف الانتماء
تفيد قراءة الإنتاج الروائيﱢ الذي صدر، في تلك المرحلة، أنَّ روايات سهيل إدريس، وروايتي ليلى بعلبكي: “أنا أحيا”- 1958 و”الآلهة الممسوخة” -1960 صدرت من منظور فكريﱟ واحدٍ، وأنَّ الأفكار الفلسفية الوجودية المسبقة تحكم مسار بنية الرواية إلى التشكُّل.
والجدير بالاهتمام أن يلتقي إدريس وبعلبكي، إبداعياً، في تمثيل اتجاهٍ روائيﱟ واحدٍ. وقد كان كلٌّ منهما ينتمي إلى تيار ثقافيﱟ- سياسيﱟ مناهضٍ للآخر؛ فإدريس كان من روَّاد المشروع القوميﱢ العربيﱢ النهضويﱢ، الناصري خصوصاً، وبعلبكي كانت من روَّاد “تجمُّع شعر”، المنضوي تحت لواء مشروعٍ ليبراليﱟ تابعٍ مناهضٍ للمشروع القوميﱢ العربيﱢ…
فهل يعني هذا أنَّ الإبداع أكثر صدقاً في تجسيد الموقف الحقيقيﱢ، وتمثيل التجربة الأدبية؟ ما يدعونا إلى البحث عن تفسيرٍ لهذا الالتقاء الروائيﱢ الذي يبدو، في الظاهر، مفارقة، وهو، في الحقيقة، صدور من منظور الفكر الوجوديﱢ السارتريﱢ، القائم على الالتزام بِحُرﱢية الإنسان العاديﱢ، الفرد، ومسؤوليته، وسعيه إلى تحقيق ذاته، بوصفه مشروعاً يتحقَّق بالجهد الفرديﱢ، من دون أيﱢ التزامٍ حزبيﱟ.
تقول لينا فياض، الشخصية الرئيسة، في رواية “أنا أحيا”، لحبيبها بهاء: “أنت عبدٌ للحزب، وأنا حرَّة. لن أخضع لأفكار أيﱢ كائن، وإن كان هذا الكائن إلهاً” (أنا أحيا، ص. 192). وترفض الشخصية الرئيسة، في رواية “أصابعنا التي تحترق” العمل الحزبيَّ قائلةً: “إنَّ أيَّ التزامٍ حزبيﱟ مُهدﱢدٌ لِحرﱢيتي”، ولا تنخرط في صفوف أيﱢ حزبٍ، ولو كان يؤيدها (أصابعنا التي تحترق، ص. 66).
وهذا الموقف الأخير، كما يقول يوسف الشاروني، “شديد الشبه بالموقف الوجوديﱢ على نحو ما عبَّرت عنه سيمون دي بوفوار، في روايتها “المثقَّفون” (راجع: دراسات في الأدب العربيﱢ المعاصر، ص. 201).
خصائص هذه الروايات
تنتج هذه التجربة الروائية بنًى روائية يحكم تشكُّلَها اعتقادُ الراوي العليم المهيمن – كلّيﱢ المعرفة، والمشكّل منظوره الراوي نسيج الرواية ومسارها إلى اكتمال التشكُّل، فتتصف هذه البنى بخصائص يمكن أن نتبيَّنها في روايات سهيل إدريس، كما يأتي:
يختار إدريس أحداث رواياته، أو مادَّتها الأوَّليَّة – المتن الروائيَّ، من تجربته الشخصية المعيشة، ويقيم منها بناءً روائياً – المبنى الروائيَّ، من منظوره الفكريﱢ آنف الذكر.
فيروي، في الخندق الغميق حكاية حياته، قبل ذهابه إلى باريس، في حيﱟ عريقٍ من أحياء بيروت القديمة. ويبدو واضحاً أنَّ الراوي يصدر، في إقامته البناء الروائي، عن أفكار مفادها أنَّ الفرد حرٌّ، في تصرُّفه ومسؤول عن هذا التصرُّف، فيختلق أحداثاً يجبر، فيها، الفتى أسرته المحافظة على قبول خياره في أن يكون شيخاً، ثمَّ في أن يخلع الجبَّة والعمامة، ويدخل الجامعة، وفي أن يجعل أخته تخلع الحجاب، وتجالس حبيبها، وتقبّله، وفي أن يقنع معارضيه بآرائه، وينتصر عليهم في النقاش…
وفي “الحي اللاتيني” يروي حكاية لقاء الحضارتين: الشرقية والغربية، المتمثّل بلقاء الطالب اللبنانيﱢ، العربيﱢ، الشرقيﱢ الذي يحضّر شهادة الدكتوراه في جامعة السوربون، والمرأة الغربية، وسوف نتحدث عن هذا اللقاء، بشيءٍ من التفصيل، في فقرة تالية.
وفي” أصابعنا التي تحترق” يروي حكاية تحقيق أحلام الشابﱢ العائد من باريس، حاملاً شهادة الدكتوراه، في إصدار مجلة أدبية، والزواج من فتاة تتحلَّى بأخلاق أسرتها المحافظة.
واللافت، في هذه الرواية، تراكم فضائح الشذوذ الجنسيﱢ عند الأديبات: رفيقة شاكر وسلمى العكاري وعبلة سلطان، من دون مسوﱢغٍ روائيﱟ فنّيﱟ لذلك التراكم سوى إرادة الراوي.
تبدو هذه الروايات كأنَّها سيرةٌ ذاتيةٌ، في ثلاثة أجزاء، غير أنَّ تحكُّم اعتقاد الراوي الفكريﱢ الذي شكَّل منظوره الروائيَّ في اختيار الأحداث وتعديلها، وإقامة بنائها، أفقدها صفات تلك السيرة، ولم يكسبها خصائص الرواية المنبثقة من الواقع، لتمثّله وتعادله.
يرى القاصُّ والناقد يوسف الشاروني، في هذا الصدد، أنَّ روايات سهيل إدريس “لا تتَّصف بخصائص السيرة الذاتية، من حيث التزام المؤلّف الواقع الذي عاشه، أو واقع الشخصيات التي تناولها”، ولا تتَّصف “بخصائص العمل الروائيﱢ؛ حيث تكون الوظيفة الفنية للشخصيات هي الكشف عن الموضوع الروائيﱢ” (نفسه، ص. 198).
وقد أنتجت هذه التجربة الروائية، كما يبدو، بنًى روائية مختلقة هجينة، تشكّل أنظمة علاقاتها إرادة الراوي العليم المهيمن الذي يختار الوقائع، ويعدﱢلها، ويقيم منها بناءً روائياً متخيَّلاً، موظَّفاً في خدمة اعتقاده الفكريﱢ الذي شكَّل منظوره الروائيَّ، ماجعل هذا البناء يتَّصف بتفكُّك الحدث وترهُّله، وكثرة المصادفات، وجهوزية الشخصية…
ثنائيَّة شرق – غرب
لم تكن رواية “الحي اللاتيني” الرواية الأولى، ولا الأخيرة، التي روت حكاية اللقاءِ الحضاريﱢ بين الشرق والغرب؛ فالروايات التي روت هذه الحكاية كثيرة، ومنها، على سبيل المثال: “تخليص الإبريز في تلخيص باريز”، لرفاعة الطهطاوي، و”عصفور من الشرق”، لتوفيق الحكيم، و”أديب” لطه حسين، و”قنديل أم هاشم” ليحيى حقي، و”موسم الهجرة إلى الشمال”، للطَّيّب صالح و”الإقلاع عكس الزمن”، لإميلي نصر الله، و”المرأة والورد”، لمحمد زفزاف، و”الغربة”، لعبد الله العروي، و”ما لا تذروه الرياح”، لعرعار محمد العالي… .
وإن كانت هذه الروايات تروي حكاية لقاء الشرق، ممثَّلاً بالمثقَّف، والغرب الاستعماريﱢ، فإنَّ روايتَي عوض شعبان “الآفاق البعيدة” و”المغيب في مونتفيديو”، ترويان حكاية هذا اللقاء، بين الشرق، ممثَّلاً بالعامل والغرب- أميركا اللاتينية، وهو غرب غير استعماريﱟ، وينتمي إلى العالم الثالث، مثله مثل العالم الشرقيﱢ. وقد كتبتُ دراسةً عن هذا اللقاء المختلف تبيَّنتُ فيها خصوصيته، ونشرتها في كتابي:” في الرواية وقضاياها”.
يمثّل الشرق، أو “الأنا”، في رواية “الحي اللاتيني”، طالب الدراسات العليا، اللبنانيُّ، في جامعة “السوربون”، في باريس، وتمثّل الغرب، أو “الآخر”، الطالبة الفرنسية، في معهد الصحافة العالي، جانين مونتيرو… .
الطالب الشرقيُّ يُخفق، في البداية، في الوصول إلى المرأة الفرنسية ووصالها، وهو ما ينجح فيه زملاؤه، فيزداد شعوره بالحرمان، ثم يلتقي جانين مانتيرو، يحبُّها وتحبُّه، ويعيشان معاً، في هناء، وهما يعيان الفروقات بين شخصيتيهما: هو أسمر، آتٍ من مجتمع تحكمه التقاليد العربية القديمة، ومبادئ دينية وأخلاقية، ملتزم بقضايا قومه ووطنه..، وهي شقراء، جميلة، ذكية، مثقَّفة، تعمل لتؤمّن مصاريف دراستها، مقبلة على الحياة بِحُرﱢية وشغف… . هو شخصية، من دون اسم، ليدلَّ على الرجل الشرقيﱢ بِعامَّةٍ، وهي شخصية متميّزة ومعيَّنة باسمٍ وصفاتٍ تميّزها، لتدلَّ على المرأة الغربية الأفضل…
عاد إلى بيروت، ليمضي إجازة. وصلته رسالة منها، أخبرته فيها أنَّها حامل. كان عليه أن يتَّخذ موقفاً يقرﱢر فيه مصير هذا اللقاء بين الطرفين، فوجد نفسه بين قوَّتين تتجاذبانه: الأولى حبُّه ومبادئه المعلنة: الالتزام بالحُرﱢية والمسؤولية، والثانية التقاليد والعادات والمبادئ الموروثة، وقرارات المجتمع التقليديﱢ- الأسرة الممثَّلة بالأم… . ولم يلبث أن اتَّخذ قراره بالتخلّي عن حبيبته الحامل، واتَّهمها بأنها حامل من رجل آخر.
ويبدو أنَّ رفض الاقتران بالمرأة الغربية لم يكن قراراً فردياً؛ ففؤاد، وهو زميله وصديقه، يقول: “لن أتزوج ” فرانسواز”، على الرغم من حبّي لها وحبّها لي، ومن صفاتها الجيّدة، لأننا مدعوُّون، ياعزيزي، إلى مواجهة كثير من قضايانا القومية التي لا تعني أحداً سوانا…”.
لكنَّ مبادئ الطالب الملتزم تجعله يعيد النظر في قراره؛ فعندما عاد إلى باريس، راح يبحث عن حبيبته.. وعندما التقاها، كانت قد غدت “فتاة رصيف”. رفضت أن تعود إليه، وقالت له: “عد إلى شرقيتك…”، وعاد ليتزوج، كما جاء، في رواية “أصابعنا التي تحترق”، ليتزوج فتاة تتحلَّى بأخلاق أسرتها المحافظة…، فينتصر، في شخصيته المزدوجة، الرجل الشرقيُّ، رائد المشروع القوميﱢ العربيﱢ…
في تشكيل بناء الرواية وشخصياتها
تحكم المصادفات، وهي تمثّل تحكُّم الراوي، في تشكيل سياق هذه الرواية، ويسمّيها هذا الراوي العليم “قدراً”. ومن نماذج ذلك التحكُّم، تحكُّم المصادفة بمصير العلاقة التي تمثل محور الرواية، أي قضية لقاء الحضارتين، فتكتب جانين رسالة له ترفض فيها عرضه للزواج منها، بعد أن غدت “فتاة رصيف”، جاء فيها: “إنَّك تدري جيّداً أيَّ درك انحطَّ إليه وجودي، ولعلَّ نصيباً من التبعية يقع على عاتق القدر، هذا الذي جعلك تصل إلى باريس، متأخراً يوماً واحداً على الموعد الذي كان بالإمكان إمساكي فيه دون السقوط في الهاوية”(الحيُّ اللاتينيُّ، ص. 281).
وهكذا تتحكَّم المصادفة، وتحول دون تنفيذ قرار الزواج الذي اتَّخذه الرجل. وهذا القرار غير مسوغ روائياً؛ وذلك لأنَّ ذلك الرجل رفض الزواج من تلك المرأة عندما كانت امرأته وحده، وتحمل ثمرة لقائهما في أحشائها، ثم قرَّر الزواج منها وهي”فتاة رصيف”. وجاءت المصادفة، لتحول دون تنفيذ هذا القرار، وهذا ما يريده الراوي، فيلوي عنق الأحداث خدمةً للفكرة الوجودية القائلة بمسؤولية الفرد عن أعماله؛ فهو يتَّخذ القرار، لكنَّ المصادفة- القدر تحول دون ذلك. وهو إنَّما ينصاع لإرادة القدر، ولا يستطيع تغيير ما يقرﱢره.
هذا، في ما يتعلَّق بمسار تشكُّل البناء الروائيﱢ. أمَّا في ما يتعلَّق بالشخصيات، فيبدو أنَّ بطل الرواية الرئيسة مزدوج الشخصية، متناقض التصرُّفات؛ فهو، كما مرَّ بنا قبل قليل، ملتزمٌ بالحُرﱢية والمسؤولية في العلن، وشرقيٌّ- عربيٌّ تقليديُّ الشخصية في الحقيقة. وهو فرديٌّ متحرﱢر، يسعى إلى إشباع لذائذه في الوقت نفسه الذي يريد أن يكون فيه منتمياً إلى جماهير أمَّته، مشغولاً بقضاياها، ساعياً إلى تحمل مسؤوليته من أجل تحقيق أهدافها.
إنَّ هذه الشخصية، كما تبدو، شخصيةٌ جاهزة، منجَزة في الذهن، وليست شخصية حية نامية في الواقع المعيش. وهي، في الحقيقة، تُجسّد الفكرة المركزية في اعتقاد المؤلّف، المتمثّلة في الجمع أو المزج بين الفكر الوجودي السارتريﱢ وريادة المشروع القوميﱢ العربيﱢ الحديث. الأمر الذي جعل شخصيات الرواية الأخرى تدور في فلك الشخصية الرئيسة. لهذا، فإنَّ تنوُّع أساليب السرد، المتمثلة باستخدام الرسائل والمذكّرات وتعدُّد الرواة، كان شكلياً؛ إذ بقي الراوي العليم المهيمن متحكّماً في تشكيل البناء الروائيﱢ.
ويبدو أن الالتزام بأفكارٍ فلسفيةٍ أدَّى، كما يقول محيي الدين صبحي، إلى “اتّخاذ الشكل التقريريﱢ، في كثير من المواضع؛ الأمر الذي أدَّى إلى هبوط المستوى الفنيﱢ” (راجع: مجلة الآداب، تشرين الأول، 1959، ص. 77).
في الختام
قال سهيل إدريس، في أحد حواراته عن الشخصية الرئيسة في ثلاثيته: أردتُ أن أطوﱢر معنى البطولة في الرواية العربية…، ويبدو أنه حقَّق ما أراده؛ فتمثَّلت هذه البطولة في شخصية إنسانٍ عربيﱟ عاديﱟ، فرد، ملتزم بقضايا أمَّته وهمومها وثقافتها، يسعى إلى تحقيق مشروع ثقافيﱟ قوميﱟ عربيﱟ حديث، ملتزماً، في الوقت نفسه، بمبادئ الفلسفة الوجودية السارترية. وهو، في صنيعه هذا، إنَّما يكتب سيرته الذاتية، كما يرى إليها، من منظوره الذي تشكّله مبادئه التي تحدثنا عنها، في ما سبق.