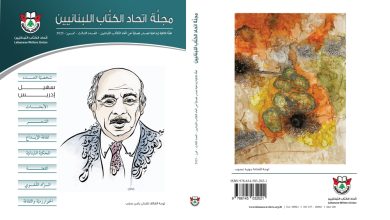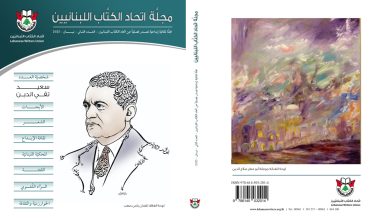البعد السّيرذاتيُّ في أدب سهيل إدريس: قراءة في رواية “الحيﱢاللاتينيﱢ” نموذجاً – أ. د. درية فرحات
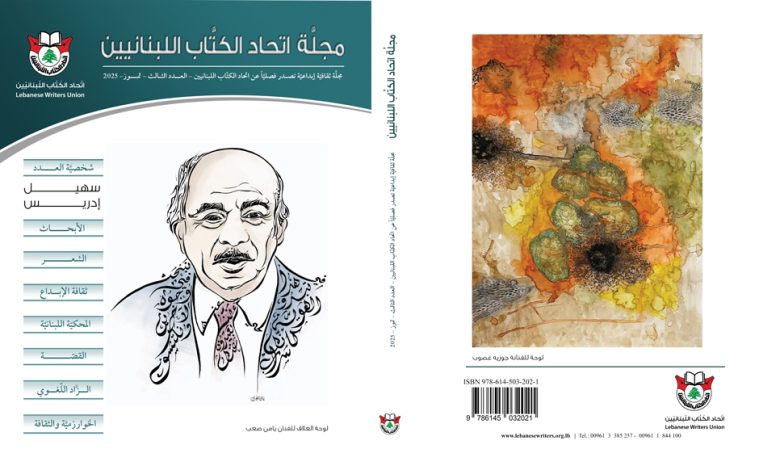
البعد السّيرذاتيُّ في أدب سهيل إدريس: قراءة في رواية “الحيﱢاللاتينيﱢ” نموذجاً
أ. د. درية فرحات
المقدﱢمة
تُعدُّ السّيرة الذاتيَّة جنساً أدبياً له خصوصيته التي تتجلَّى في التقاء الأدب بالحياة، حيث يتحوَّل الكاتب إلى بطل نصّه، مستعرضاً محطَّات من حياته الخاصَّة ضمن بناء سرديﱟ جماليﱟ. ويُعدُّ أدب السّيرة الذاتيَّة واحداً من أكثر الأجناس الأدبيَّة التصاقاً بتجربة الكاتب الشخصيَّة، حيث ينصهر الواقع الذاتيُّ بالخيال الفنّيﱢ في سرد يتجاوز التَّوثيق نحو الإبداع.
في هذا السّياق، يبرز اسم سهيل إدريس بوصفه أحد أهمﱢ الأصوات التي قدَّمت تجربة روائيَّةً ذات طابع سيرذاتيﱟ واضح، وتُعدُّ رواية “الحيﱢ اللاتينيﱢ” أبرز أعماله التي تستلهم من حياته الشخصيَّة، لاسيَّما حقبة إقامته في باريس، وتحوُّلاته الفكريَّة والثَّقافيَّة خلال تلك المرحلة.
ينتمي هذا النَّصُّ إلى ما يُعرف بــ”الرواية السّيرذاتيَّة”، وهو جنسٌ أدبيٌّ يقع في منطقة وسطى بين السيرة الذاتيَّة والرواية، حيث تتقاطع الذات الكاتبة مع الذات السَّاردة والذات المشخَّصة، بشكل يجعل من التمييز بين الحقيقة والتخييل أمراً بالغ الصعوبة. يبدو واضحاً أنَّ سهيل إدريس لم يخفِ الطابع الذاتيَّ لروايته، بل لجأ إلى تفاصيل سيرته كطالبٍ لبنانيﱟ في باريس، لينسج منها رواية تعكس صراعاته الثقافية والوجدانيَّة والفكريَّة.
وقد تابع سهيل إدريس عمله بروايتين هما “الخندق الغميق” 1958، و”أصابعنا التي تحترق” 1962، وفيهما ينطبق البعد السّيرذاتيُّ.
وتتمثَّل أهمية هذا البحث في كونه محاولة للكشف عن مظاهر البعد السّيرذاتيﱢ في “الحيﱢ اللاتينيﱢ”، وتبيان الأساليب التي استخدمها إدريس في تحويل سيرته إلى بناء روائيﱟ ذي بُعدٍ فنّيﱟ. وسنسعى في هذا السياق إلى دراسة العلاقة بين الواقعيﱢ والتّخييليﱢ، بين الذاتيﱢ والموضوعيﱢ، ضمن رؤية نقديَّةٍ تستند إلى المفاهيم الحديثة للسيرة الذاتيَّة والتخييل الذاتيﱢ.
الإشكاليَّة
وتُبنى هذه الدراسة على الإشكاليَّة الآتية:
كيف تتجلَّى ملامح البعد السّيرذاتيﱢ في رواية “الحيﱢ اللاتينيﱢ” لسهيل إدريس؟ وما التقنيَّات التي استخدمها الكاتب في صوغ تجربته الشخصيَّة في قالب روائيﱟ أدبيﱟ بعيد من التقريريَّة والمباشرة؟
المنهج
اعتمدت هذا الدراسة على المنهج الوصفيﱢ التَّحليليﱢ، مستنيرةً بمفاهيم نظرية السيرة الذاتيَّة، كما صاغها فيليب لوجون (Philippe Lejeune) وغيره، إلى جانب مقاربات التخييل الذاتيﱢ، التي توسّع من أفق القراءة، وتساعد على تحليل تمثلَّات الكاتب لِذاته داخل النصﱢ الروائيﱢ.
1- مفهوم السيرة الذاتيَّة وتطوُّرها في الأدب العربيﱢ الحديث
1–1 تعريف السيرة الذاتيَّة:
السيرة الذاتيَّة هي جنس أدبيٌّ يعمد فيه الكاتب إلى سرد قصة حياته الشخصيَّة، مستعرضاً مراحل تطوُّره الذاتيﱢ، من الطفولة إلى النُّضج، مروراً بمحطَّاتٍ فكرية ونفسية واجتماعية شكَّلت هُويَّته الفردية. وقد عرَّف فيليب لوجون السيرة الذاتيَّة بأنَّها “سردٌ استعاديٌّ نثريٌّ يقوم به شخص واقعيٌّ عن وجوده الخاصﱢ، مُركّزاً على حياته الفرديَّة، وبشكلٍ خاصﱟ على تاريخ شخصيَّته”[1].
وبذلك تتأسس السيرة الذاتيَّة على ثلاثية متلازمة: المؤلّف، والراوي، والشخصيَّة، إذ يجسّد الثلاثة شخصيَّةً واحدة، هي ذات الكاتب، وهو ما يشكّل “الميثاق السّيرذاتيَّ (Pacte autobiographique) الذي يمنح القارئ إحساساً بأنَّ ما يُروى حقيقيٌّ وذاتيٌّ في آن.[1]
ارتبط هذا الجنس الأدبيُّ منذ القدم بحاجة الإنسان إلى توضيح ما أثَّر فيه، ليُساعد الآخرين على التقرُّب من حقيقة أمره كما يراها هو. محور السيرة الذاتيَّة هو “أنا” الكاتب أو ذاته، وبتعبير آخر يكون البطل هو نفسه.
وفي السيرة الذاتيَّة سرد ومظهره ذكر الأحداث وتأريخها، مع العلم بأنَّ هذا السرد لا يكون تسجيلاً آليّاً وموضوعيّاً لما غبر من الأحداث، ولكنَّه يصبغ بالذاتيَّة التي تظهر من خلال اختيار قسم منها وإهمال قسم آخر، كما تظهر من خلال طريقة العرض.
1-2 السيرة الذاتيَّة والرواية: حدود وتقاطعات
على الرغم من التمايز البنيويﱢ بين الرواية والسيرة الذاتيَّة، إلا أنَّ الحدود بينهما غالباً ما تتداخل، خاصَّةً حين يختار الكاتب الشكل الروائيَّ للتعبير عن تجربته الذاتيَّة، في ما يُعرف بـ”الرواية السّيرذاتيَّة” أو “التّخييل الذّاتيﱢ” (Autofiction). ويُعدُّ هذا النوع من الكتابة مزيجاً من الاعتراف والابتكار الفنيﱢ، حيث يتقمَّص الكاتب دور الراوي والشخصيَّة الرئيسة، لكنَّه يحتفظ في آنٍ بمسافة تخييلية تحميه من الانكشاف التام.
1-3 السيرة الذاتيَّة في الأدب العربيﱢ
عرف الأدب العربيُّ أنماطاً بدائيَّةً من السيرة الذاتيَّة، كما في كتب التراجم والمذكَّرات لدى العلماء والمؤرﱢخين، لكن السيرة الذاتيَّة بالمعنى الحديث بدأت تتشكَّل مع النهضة العربيَّة. ومن الأعمال ذات الطابع السّيريﱢ: “أنا” لعباس محمود العقاد، و”حياتي” لأحمد أمين.
لكن مع تطوُّر الرواية العربيَّة، بدأ يظهر نوع جديد من السيرة الذاتيَّة المتخفّية في شكل روائيﱟ، حيث تُسرد التَّجربة الشخصيَّة بِلغةٍ روائيَّة، مع استخدام تقنيَّات السرد، والوصف، والتَّخييل، وهو ما نراه بوضوح في رواية “الحيﱢ اللاتينيﱢ” لِسهيل إدريس، والتي تمثّل نموذجاً مبكراً لما يسمى بـ”الرواية السّيرذاتيَّة”.
1-4 خصوصية السيرة الذاتيّة في السّياق العربيﱢ
تواجه السّيرة الذاتيَّة في الثقافة العربيَّة عدَّة تحدﱢيات، من أهمّها الرقابة الاجتماعيَّة والدينيَّة، ما يجعل كثيراً من الكتَّاب العرب يتجنَّبون البوح الكامل، ويميلون إلى الإيحاء والتورية بدلاً من المكاشفة الصريحة، وهو ما يفسر لجوء عدد كبير منهم إلى التخييل الذاتيﱢ، كوسيلة فنّيَّة للهروب من ثنائيَّة “الحقيقة/ الفضيحة” التي تلاحق السيرة الذاتيَّة الصرفة.[1]
2- سهيل إدريس – بين الذات والكتابة
2-1 لمحة عن حياة سهيل إدريس
وُلد سهيل إدريس في بيروت في العام 1922، ونشأ في بيئة دينيَّةٍ تقليديَّةٍ، حيث تلقَّى تعليمه الأوليَّ في المدرسة الإسلاميَّة – المقاصد، ثم انتقل لاحقاً إلى الجامعة الأمريكيَّة في بيروت، قبل أن يُغادر إلى باريس في العام 1952 لمتابعة دراساته العليا، حيث نال الدكتوراه في الأدب من جامعة السوربون عن أطروحةٍ حول “البطل في الرواية العربيَّة”.
وقد شكَّلت إقامته في فرنسا مرحلة حاسمة في تشكُّله الفكريﱢ والثّقافيﱢ، إذ احتكَّ بالثقافة الأوروبية، واطَّلع على الفلسفات الغربيَّة والتيارات الأدبيَّة المعاصرة، ما انعكس بوضوح في مشروعه الأدبيﱢ والنقديﱢ لاحقاً.
إلى جانب كتاباته الروائيَّة، كان إدريس فاعلاً ثقافياً بارزاً، حيث أسَّس دار الآداب، وأطلق مجلَّتها الرائدة في العام 1956، والتي أصبحت من أبرز المنابر الفكريَّة في العالم العربيﱢ. وارتبط اسمه بترجمة العديد من الأعمال الفرنسيَّة إلى العربيَّة، مثل أعمال جان بول سارتر وألبير كامو، ما جعله جسراً حيوياً بين الثقافتين.
سهيل إدريس رائد من روَّاد الحداثة في الرواية، إذ إنَّه لازمَ بيروت مدى حياته العامرة، لولا قيامه برحلتين ثقافيتين، إحداهما إلى القاهرة في مصر، حيث قصد جامعة الأزهر، وهو يبني على عمامة المثقَّف العربيﱢ التقليديﱢ، حداثة في الرأي والرؤية، عاصرَها منذ طفولته، وأمامه روَّاد من النهضة العربيّة الثقافية الثانية. أمَّا الثانية فكانت رحلته إلى باريس، حيث أمكن للحيﱢ اللاتينﱢي أن يأسره ويسحره ويجعله يستوعب البعد النفسيَّ الخاصَّ للحيﱢ الذي لطالما أحبَّه: الخندق الغميق في بيروت. كادت تأخذه المشيخة من الحداثة الثقافيَّة، لكنه انفتح بلا هوادة[1].
2-2 الرواية كمرآة للذات
من يقرأ روايات سهيل إدريس، وخاصة “الحيُّ اللاتينيُّ”، يلاحظ أنَّ البُعد الذاتيَّ ليس مجرَّد خلفية، بل هو عنصر بنيويٌّ يُحرﱢك السرد ويمنحه مصداقيَّةً وجدانيَّةً. فالكاتب لا يختبئ تماماً خلف القناع الروائيﱢ، بل يُلمّح إلى حضوره في ثنايا الحكي من خلال تجارب شخصيَّة مضمرة، تبدأ من بيروت المحافظة وتنتهي في باريس المتحرﱢرة، مروراً بأزمات الهُويَّة والانتماء والثقافة[1].
وقد أشار إدريس نفسه، في أكثر من مناسبة، إلى أنَّ شخصية البطل في “الحيﱢ اللاتينيﱢ“ مستوحاة إلى حدﱟ كبيرٍ من سيرته كطالب لبنانيﱟ في باريس. ويقول في أحد الحوارات: “كتبت “الحيَّ اللاتينيَّ” وأنا ممتلئ بالحياة، مشحون بالتجربة، كنت أكتب نفسي من خلال البطل دون أن أخون اللغة الفنيَّة.[1]”
2-3 بين الثقافة الشرقيَّة والغربيَّة: تمزُّق الذات
يبدو سهيل إدريس في كتاباته ممزّقاً بين ثقافتين: ثقافة شرقيَّة تقليديَّة غرست فيه قيم الدين والمجتمع، وثقافة غربيَّة حديثة فتحت له أبواب الحُريَّة الفرديَّة والتفكير النقديﱢ. وقد شكَّلت هذه الازدواجيَّةُ مصدر توتُّرٍ مستمرﱟ في شخصياته الروائية، وفي مقدﱢمتها بطل “الحيﱢ اللاتينيﱢ“، الذي يعاني من اغتراب حضاريﱟ وفكريﱟ، يتجلَّى في حيرته بين القيم الموروثة والحداثة الأوروبيَّة التي وجد نفسه جزءاً منها.
هذا ما يمنح الرواية أبعاداً تتجاوز السرد الذاتيَّ إلى مستوى التمثيل الثقافيﱢ لِصراع الأنا مع الآخر حيث لا تعود باريس مكاناً جغرافيّاً فحسب، بل رمزاً للتحدﱢي الفكريﱢ والانفتاح، مقابل بيروت التي تُمثّل الأصل والجذور، ولكن أيضاً الانغلاق أحياناً.[1]
2-4 التخييل الذاتيُّ في تجربته الروائيَّة
لا يمكن اختزال تجربة إدريس في “الاعتراف” بالمعنى التقليديﱢ، بل هو يُمارس نوعاً من التخييل الذاتيﱢ، حيث لا يروي حياته حرفيّاً، وإنَّما يُعيد تشكيلها وفق مقتضيات الفنﱢ الروائيﱢ. لذا، فالبطل ليس صورة طبق الأصل من المؤلّف، بل تجسيدٌ فنّيٌّ لذاته المتخيَّلة، أي أنه يحمل من الكاتب عناصر جوهريَّة، لكنَّه يُعيد إنتاجها سرديّاً ضمن بناء رمزيﱟ.
وهنا تبرز براعة إدريس في استخدام أدوات الرواية من تعدُّد الأصوات، والبناء الزمنيﱢ، ووصف الفضاءات، والعلاقات المعقَّدة، لخلق نصﱟ يتجاوز السيرة نحو الإبداع، من دون أن يفقد صدقه الوجدانيَّ[1].
3- البعد السّيرذاتيُّ في رواية “الحيﱢ اللاتينيﱢ”
3-1 الرواية السيرذاتيَّة: بين الحياة والخيال
تشكّل رواية “الحيﱢ اللاتينيﱢ“ (1953)عملاً محوريّاً في أدب سهيل إدريس، بل يمكن القول إنَّها روايته الأشدُّ التصاقاً بتجربته الحياتيَّة. يختار الكاتب ضمير المتكلّم ليروي قصة طالب لبنانيﱟ يسافر إلى باريس لاستكمال دراسته في السوربون، وهو ما يتطابق مع تجربة إدريس نفسه، ما يجعل القارئ يُحسُّ منذ الصفحة الأولى أنَّه أمام “أنا” المؤلّف متجسّدةً داخل النصﱢ، لا مجرَّد شخصيَّة متخيَّلة.
لكنَّ إدريس، مع ذلك، لا يقدﱢم اعترافاً مباشراً أو سرداً توثيقيّاً لحياته، بل يُعيد بناء هذه التجربة ضمن قالبٍ روائيﱟ فنّيﱟ، يدمج فيه بين الذاتيﱢ والموضوعيﱢ، وبين الحقيقة والخيال، ما يمنح النَّصَّ طابعاً سيرذاتيّاً بامتياز.
3-2 البطل والراوي: حضور “الأنا” الكاتبة
يؤدﱢي الراوي –وهو البطل ذاته– دوراً محورياً في تجسيد البعد السّيرذاتيﱢ. وتكاد تتطابق ملامح البطل مع سيرة الكاتب: شابٌّ قادمٌ من بيروت، مُثقَلٌ بالثقافة العربية التقليدية، يخوض تجربة انفتاحٍ في باريس، ويعيش تمزُّقاً بين الالتزام والانعتاق، بين الشرق والغرب، بين الحبﱢ والعقل، “كنت في الحيﱢ اللاتينيﱢ تائهاً بين الكتب والنساء، بين صوت أمّي من بيروت وأحاديث الرفاق في مقاهي باريس”[1].
يُظهر هذا السطر عمق البعد الذاتيﱢ في النصﱢ، حيث يتكلَّم البطل عن ذاته ومزاجه وأفكاره، لا من منظورٍ روائيﱟ خارجيﱟ، بل من صوت داخليﱟ معترف، وهو ما يعزﱢز من صدقية الطابع السّيرذاتيﱢ.
عند قراءة الرواية، يلمس القارئ بوضوح تقاطع حياة البطل مع حياة المؤلّف في عدَّة نقاطٍ منها:
– الرحلة إلى باريس: مثل بطل الرواية، انتقل سهيل إدريس إلى باريس للدراسة في السوربون.
– التكوين الثقافيُّ: ينحدر البطل من بيئة محافظة في بيروت، ويصطدم بثقافةٍ غربيَّةٍ مختلفةٍ، في موازاة واضحة مع حياة إدريس.
– العلاقة العاطفية: علاقة البطل بـ”جانين” توازي علاقة إدريس بفتاة فرنسية خلال إقامته في باريس، وهو ما أشار إليه لاحقاً في لقاءات صحفية.
– التحوُّل الفكريُّ: يتحوَّل البطل من شابﱟ متديّنٍ ومحافظٍ إلى شخصٍ متحرﱢرٍ فكرياً، بعد احتكاكه بالثقافة الغربيَّة، وهي رحلةٌ فكريَّةٌ خاضها إدريس نفسه.
لكن على الرغم من هذه التقاطعات، فإنَّ الرواية لا تُقدﱢم سرداً توثيقيّاً مباشراً، بل تُعيد تشكيل الواقع من خلال أدوات الفنﱢ الروائيﱢ: الحوار، الوصف، الرمز، والإيحاء.
وإن برز هذا البعد السّيرذاتيُّ في الرواية، فإنَّ الكاتب يحاول أن يخرجها من هذه الخانة، فتميَّزت رواية “الحيﱢ اللاتينيﱢ“ بتنوُّع الضمائر وعدم الاكتفاء بضمير المتكلّم، فضلاً عن عدم إلحاق اسم معيَّن بالبطل على غرار الشخصيات الأخرى في الرواية، ما جعل من هذا البطل ممثلّاً لشريحة واسعة من المثقَّفين العرب الذين عانوا من اهتزاز العلاقة بالغرب، فضاعوا وفتَّشوا عن ذواتهم وارتكبوا “كثيراً من الحماقات” قبل أن يجدوا أنفسهم.
3-3 المكان بوصفه تجربةً شخصيَّةً
تؤدﱢي باريس، وبالتحديد الحيُّ اللاتينيُّ، دوراً مركزياً في الرواية، ليس فقط بوصفه فضاءً جغرافيّاً، بل بكونه رمزاً حضاريّاً وفكريّاً. فالحيُّ اللاتينيُّ، المعروف بكونه قلب الثقافة الفرنسية وموطن الطَّلَبة والمثقَّفين، يصبح في الرواية رمزاً للتحوُّل الذاتيﱢ والانفتاح على عالمٍ جديدٍ. وهو يمثّل الفضاء الذي يعيد فيه البطل/ الكاتب تشكيل ذاته، خارج القيود الاجتماعية التي كانت تحاصره في بيروت.[1]
وبالمقابل، تظهر بيروت بصورتها المحافظة والمرتبطة بالواجبات العائليَّة والدﱢينيَّة، ما يضع الذات في صراعٍ مكانيﱟ وثقافيﱟ. وهذا التوتُّر بين مكانَين يتماهى مع الصراع الداخليﱢ في السيرة الذاتيَّة، حيث يسعى الإنسان إلى تجاوز واقعه الضيّق نحو أفقٍ أرحب.
3-4 التجربة العاطفيَّة: بين الحقيقة والتخييل
تؤدﱢي العلاقة العاطفية بين البطل والفتاة الفرنسية دوراً محورياً في الرواية. فهي ليست فقط قصَّة حبﱟ، بل تجربة هزَّت كيانه، ودفعت به إلى مراجعة الكثير من أفكاره. وفيها يظهر البعد السّيرذاتيُّ بوضوح؛ لأنَّ الكاتب لا يصف فقط علاقة عاطفية، بل يكشف عبرها عن حيرته بين الرغبة والتحفُّظ، بين الجسد والفكر، بين الشرق والغرب.
وقد ذهب بعض النقَّاد إلى أنَّ إدريس أسقط مشاعره وتجربته الذاتيَّة على هذه العلاقة، لكن من دون أن يُصرﱢح بذلك مباشرةً، بل عبر قناعٍ روائيﱟ شفَّافٍ يسمح له بالبَوْح من دون أن يقع في المباشرة أو الفضيحة[1].
4- الرواية السّيرذاتية بين التخييل والاعتراف
4-1 الرواية السيرذاتية: حدود النوع
تُعدُّ “الحيُّ اللاتينيُّ” مثالاً واضحاً على ما يُصطلح عليه اليوم بالرواية السّيرذاتيَّة. وهي نوعٌ هجينٌ يقع بين الرواية والسيرة الذاتيَّة، حيث يوظّف الكاتب مادَّته الذاتيَّة (حياته الخاصة) ضمن قالبٍ تخييليﱟ. ويؤكّد فيليب لوجون أنَّ السيرة الذاتيَّة ترتكز على تطابقٍ بين المؤلّف والراوي والشخصية، بينما في الرواية السيرذاتية يختلُّ هذا التطابق لصالح التخييل مع احتفاظ النصﱢ بملامح قوية من التجربة الشخصيَّة[1].
وفي حالة “الحيﱢ اللاتينيﱢ“، فإنَّ سهيل إدريس يقدﱢم ذاته من خلال بطلٍ لا يحمل اسمه، لكنَّه يعكس تجربته بشكلٍ يكاد يكون مباشراً، ما يضع النصَّ ضمن المنطقة الرمادية، فلا هي روايةٌ خياليَّةٌ تماماً، ولا هي سيرة خالصة.
4-2 التقنيَّات السرديَّةُ بين الاعتراف والتخييل
البنية الزمنيَّة:
لا تتبع الرواية خطّاً زمنياً خطياً، بل تمزج بين الحاضر والماضي، وبين الذﱢكريات والتأمُّلات، فبرزت التقنيَّات السرديَّة الزمانيّة من الاسترجاع والاستباق. فالبطل لا يروي الحدث كما وقع، بل كما وعاه لاحقاً، في ضوء التحول الداخليﱢ الذي أصابه.
وظَّفَ الكاتب نسقاً زمنيّاً متنامياً ومتسلسلاً في تطوُّره السرديﱢ والكرونولوجيﱢ المُتعاقِب، إذ انطلق من الحاضر إلى المستقبل أو من لحظة الوصول إلى باريس إلى لحظة العودة إلى بيروت بعد حصوله على شهادة الدّكتوراه كأنَّ الزمن السرديَّ في النص زمنٌ دائريٌّ: بيروت- باريس- بيروت. وعلى الرغم من تسلسل الأحداث منطقيّاً وسببيّاً وكرونولوجيّاً فهناك انحرافات زمنية إمَّا إلى الماضي لاسترجاعه”فلاش باك” في أثناء تذكُّره لبنان وناهدة وأسرته وأصدقائه وإمَّا في استشراف المستقبل لِما ينتظره من طموح وتطلُّعٍ علميﱟ ونضاليﱟ أو لقاء غراميﱟ ورومانسيﱟ.
الحكي الذاتيُّ والبُعد الفلسفيُّ:
تتجاوز الرواية مجرَّد الحكي عن أحداث شخصية، لتتأمل قضايا مثل: الهُوية، الحُرﱢية، الثقافة، الدين، الحب. وهو ما يمنح “الحيَّ اللاتينَّي” بُعداً فكريّاً يجعل منها ليس فقط مرآة للذّات، بل أيضاً وثيقةً فكريةً تعكس جدل الحداثة في السياق العربيﱢ.
4- 3 جدلية الذات والآخر
تُجسّد الرواية صراعاً ثقافيّاً وفكريّاً عميقاً بين “الذات العربيَّة” و”الآخر الغربيﱢ”. فباريس ليست فقط مكاناً جديداً للبطل، بل هي تجسيد لآخر مغاير ثقافياً، يضع الذات أمام سؤال الانتماء. وهذا التوتُّر بين الداخل والخارج، بين الشرق والغرب، يتكرَّر في النصﱢ، ويُعدُّ سمةً مركزيةً في الأدب السّيرذاتيﱢ لِما بعد الاستعمار.
يعيش البطل تمزُّقاً بين الانبهار بالغرب والخوف من الذوبان فيه، وهو ما يطرح أسئلةً تتجاوز الفرد نحو الجماعة، ويحوﱢل السيرة الذاتيَّة إلى مرآةٍ لِهوية حضارية قلقة.
4- 4 مستويات البوح وحدوده
على الرغم من الطابع الاعترافيﱢ في الرواية، إلا أنَّ إدريس لا يبوح بِكلﱢ شيء. فهناك دوماً مسافة أمان يحتفظ بها الكاتب، فلا يقدﱢم كلَّ تفاصيله الشخصيَّة، بل يُلمّح دون تصريح. وهذه المسافة هي ما يجعل من “الحيﱢ اللاتينيﱢ“ روايةً تخييليةً، لا سيرةً خالصةً؛ فهي لا تستجيب لرغبة الكشف الكامل، بل تسعى إلى جماليَّة الاعتراف، لا إلى وقائعيته. فإنَّ “الرواية السيرذاتيَّة ليست فضاءً للاعتراف بقدر ما هي مختبر للذات تُعيد فيه ترتيب ذاكرتها وتعيد خلق هويتها من جديد”[1].
4- 5 البعد التاريخيُّ للنصﱢ
لا يمكن اختزال “الحيﱢ اللاتينيﱢ“ في بعدها السيرذاتيﱢ فقط، إذ هي أيضاً وثيقة أدبية تمثّل مرحلة من تحوُّلات الفكر العربيﱢ في الخمسينات. فالبطل يمثّل جيلاً عربيّاً مثقفاً عاش انفجار الوعي القوميﱢ واليساريﱢ، واختبر التحديث في عقر دار الغرب، ليعود محمَّلاً بأسئلة كبرى حول الدين، والمرأة، والحُرﱢية، واللغة.
وهذا ما يمنح الرواية وظيفةً مزدوجةً: فهي من جهة تجربة فردية، ومن جهة أخرى هي نصٌّ جماعيٌّ يحكي مأزق المثقف العربيﱢ في مواجهة التحوُّلات العميقة التي عرفها العصر.
الخاتمة
تُعدُّ رواية “الحيﱢ اللاتينيﱢ“ لسهيل إدريس نموذجاً مبكراً وناضجاً لما بات يُعرف في النقد الحديث بـ “الرواية السّيرذاتية”، حيث تندمج التجربة الفرديَّة مع البناء الروائيﱢ ضمن فضاءٍ سرديﱟ متعدﱢد المستويات. لقد استطاع إدريس أن يحوﱢل سيرته الذاتيَّة، كطالب عربيﱟ في باريس في الخمسينات، إلى مادة تخييلية تطرح أسئلة وجوديَّة وثقافيّة تتجاوز الفرد نحو الجماعة.
وقد تجلَّت السيرة الذاتيَّة في “الحيﱢ اللاتينيﱢ“ من خلال توازي تجربة البطل مع تجربة الكاتب، خاصَّةً في النشأة، الرحلة إلى باريس، والصراع الثقافيﱢ والوجدانيﱢ.
عبَّر الفضاءُ المكانيُّ في الرواية (بيروت/ باريس) عن تمزُّقٍ داخليﱟ بين الأصل والانفتاح، التقليد والتجديد، وهو ما يضيف بعداً رمزيّاً إلى النص.
على الرغم من الطابع الاعترافيﱢ، تحافظ الرواية على مسافةٍ فنّيةٍ تفصِل بين الواقع والسرد، ما يجعلها أكثر من مجرَّد سيرة: إنها سيرة مُمَسرحة داخل قالب روائيﱟ متكامل.
ويمكننا القول إنَّ “الحيَّ اللاتينيَّ” تمثّل نقطة تحوُّلٍ في مسار الرواية العربيَّة نحو أشكال أكثر جرأة في التعبير عن الذات، وأسهمت في توسيع مفهوم “الذات الكاتبة” في الأدب العربيﱢ.
وقد استطاع سهيل إدريس أن يوظّف الشخصيَّات التي تتقابل فضائيّاً وحضوريّاً: الشرق/ الغرب، وجنسيّاً: الذكورة العربيَّة/ الأنوثة الغربيَّة، ولونيّاً: الأسمر العربيُّ/ الغربيَّة الشقراء، لرصد التفاوت الحضاريﱢ والاختلاف الوجوديﱢ.
هوامش البحث:
1 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Seuil, 1975, p. 14
2 Gérard Genette, Figures III, Seuil, 1972, pp. 215–223.
3 عبد الله إبراهيم، السّيرة الذّاتيّة: تحوّلات النّوع وجماليّات التّخييل، المركز الثّقافيّ العربيّ، 2014، ص103.
4 وفيق غزيريّ، سهيل إدريس الأديب الموسوعيّ، ثقافة وفنون/ العدد 277، تموز 2008.
5 عفيف دمشقيّة، سهيل إدريس بين الشّرق والغرب، مجلة “الآداب”، عدد خاص،1980.
6 سهيل إدريس، حوار مع مجلة “الوطن العربيّ“، العدد 241، 1985.
7 محمد برادة، الذّات في الرّواية العربيّة، دار الطّليعة، بيروت، 1991، ص. 88.
8 شكري عياد، الرّواية والسّيرة الذّاتيّة، مجلة فصول، المجلد الرابع، العدد الثاني، القاهرة، 1984.
9 سهيل إدريس، الحيّ اللاتيني، دار الآداب، بيروت، الطّبعة الخامسة، ص. 27.
10 نوال نصر، “باريس عند سهيل إدريس: المدينة كمفصل في تشكّل الذّات”، مجلة الفكر العربيّ المعاصر، عدد 121، 2010
11 حسان بدر الدين، الرّواية العربيّة والسّيرة الذّاتيّة: تقاطعات سرديّة، المركز الثّقافيّ العربيّ، 2016، ص. 104.
12 Philippe Lejeune, Je est un autre: l’autobiographie de la littérature aux médias, Seuil, 1980, p. 56.
13 عبد الله إبراهيم، السّيرة الذّاتيّة: تحوّلات النّوع وجماليّات التّخييل، المركز الثّقافيّ العربيّ، 2014، ص 172.
قائمة المصادر والمراجع:
- إبراهيم، عبد الله، السيرة الذاتيَّة: تحوُّلات النوع وجماليَّات التخييل، المركز الثّقافيّ العربيّ، 2014.
- إدريس، سهيل، حوار مع مجلة “الوطن العربيّ”، العدد 241، 1985.
- إدريس، سهيل، الحيُّ اللاتينيُّ، دار الآداب، بيروت، الطبعة الخامسة.
- بدر الدين، حسّان، الرواية العربية والسيرة الذاتيَّة: تقاطعات سرديّة، المركز الثقافي العربي، 2016.
- برادة، محمد، الذات في الرواية العربية، دار الطّليعة، بيروت، 1991.
- دمشقيّة، عفيف، سهيل إدريس بين الشرق والغرب، مجلة “الآداب”، عدد خاص،1980.
- عياد، شكري، الرواية والسيرة الذاتيَّة، مجلة فصول، المجلَّد الرابع، العدد الثاني، القاهرة، 1984.
- غزيريّ، وفيق، سهيل إدريس الأديب الموسوعيّ، ثقافة وفنون/ العدد 277، تموز 2008.
- نصر، نوال، “باريس عند سهيل إدريس: المدينة كمفصل في تشكُّل الذات“، مجلة الفكر العربيّ المعاصر، عدد 121، 2010.
- Gérard Genette, Figures III, Seuil, 1972.
- Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Seuil, 1975.
- Philippe Lejeune, Je est un autre: l’autobiographie de la littérature aux médias, Seuil, 1980.