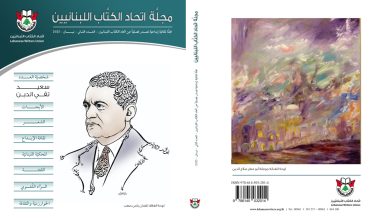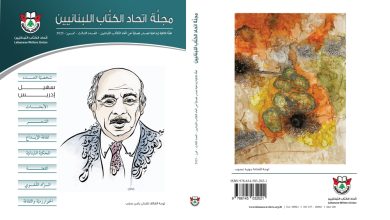تلقّي “الحي اللاتيني” لسهيل إدريس وتعدُّد المعنى قراءة من منظور نظرية التلقّي – أ. د. مهى جرجور
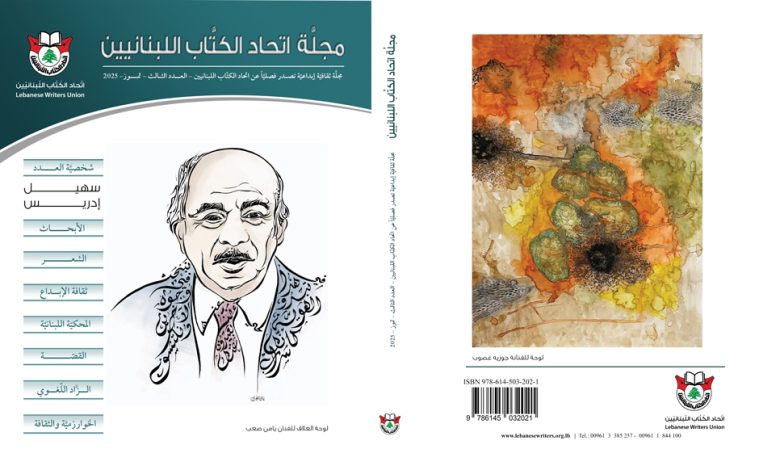
تلقّي “الحي اللاتيني” لسهيل إدريس وتعدُّد المعنى
قراءة من منظور نظرية التلقّي
أ. د. مهى جرجور
سهيل إدريس (2008-1925) يُعدُّ من أبرز الأدباء والمثقفين اللبنانيين العرب في القرن العشرين، وله حضور واسع في الساحة الأدبية والفكرية من خلال أعماله الروائية، وترجماته، ونشاطه الثقافيﱢ المؤثّر، ووضعت في رواياته العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت تجربته الأدبية والفكرية. روايات تركت بصمة في عالم السرد العربي وهي: “الحي اللاتيني عام 1953 التي تُعدُّ واحدة من أشهر الروايات العربية في القرن العشرين، وقد اختارها اتحاد الكتَّاب العرب ضمن أشهر مئة رواية عربية، و”الخندق العميق” عام 1958 و”أصابعنا التي تحترق” عام 1962. روايات خالدة، جسَّدت مراحل مهمَّة من حياته، ومن تاريخ الأدب اللبناني والعربي وتطوُّره، وتوَّجته رائداً من روَّاد الحداثة، عبر مقاربتها قضايا عصره ولا سيما الاجتماعية منها والفلسفية. واقترن اسم إدريس بمقالاته التي كتبها في الأدب والفكر القومي، وبمجلة “الآداب” التي شكَّلت منذ ظهورها مطلع 1953 عن دار الملايين منبراً رفيعاً للأدباء والشعر. وباتّحاد الكتَّاب اللبنانيين الذي اشترك في تأسيسه عام 1968، وانتخب أميناً عامّاً له 3 مرات.
اهتمَّ إدريس بالأدب العربي بعد عودته من باريس وتعرُّفه إلى ثقافة الغرب، وبشكل خاص إلى فلسفة سارتر الوجودية، وذلك من منطلق حرصه على إبراز الأدب الجديد الواعي.
وستقتصر هذه القراءة الموسومة تلقّي “الحي اللاتيني” لسهيل إدريس – قراءة من منظور التلقّي وتعدُّد المعنى”، على تلقّي رواية “الحي اللاتيني” لما تمثّله من دور ريادي في الرواية اللبنانية. تبدأ هذه القراءة من عرض نبذة عن أهم ما جاء في الدراسات التي وضعت عنها، وتبيّن أشكال تلقّي بناء الشخصيات والتوتر الحاصل نتيجة اختلاف الآفاق بين القارئ الضمني والقارئ الحقيقي واندماج الآفاق والمعنى الذي يتشكّل منه[1]، تبعاً لنظريات جماليات التلقّي، التي أتى بها هانس روبرت ياوس (Hans Robert Jauss) وفولفغانغ إيزر(Wolfgang Iser) التابعان لمدرسة كونستانز (Konstanz) الألمانيَّة، ردّاً عن الأسئلة التالية:
كيف تلقَّى الباحثون، موضوع البحث، الرواية، وما هي نقاط التشابه والاختلاف بينهم على مستوى التلقّي؟ وكيف أسهم كلٌّ من الحذف والفراغات فيها في تشكيل أفق توقُّع القرَّاء المختلفين المتخصصين؟ وإلى أي مدى يلتقي التحليل الذي نجريه بوصفنا قارئاً من القرن الحادي والعشرين مع قراءات سابقة في الرواية على مستوى تلقّي بناء الشخصيات الرئيسة في الرواية؟ وما هو الموضوع الجمالي المتشكّل من اندماج الآفاق؟ في محاولة لمعالجة الإشكالية التالية: أأتت رواية “الحي اللاتيني” للدعوة فعلاً إلى الحرية المطلقة أم أنَّها ترسّخ الموروث الشرقي والعودة إلى التقاليد؟
أولاً: سهيل إدريس: قارئاً نهماً متلقّياً واعياً للفلسفة الوجودية
ونستهلُّ دراستنا هذه من منظور نظرية التلقّي، مع سهيل إدريس القارئ والمتلقّي والمتفاعل مع الفلسفة الوجودية كما قدَّمها جان بول سارتر Sartre Jean Paul (1905-1980) وألبير كامو Albert Camus (1913-1960)، والتي تدور مفاهيمها الفلسفية حول الحريَّة والمسؤولية والالتزام وعلاقة “الأنا” بالآخرين، ما عزَّز حضور هذه الفلسفة في الأدب العربي الحديث.
وبدا تلقّي سهيل إدريس لفلسفة سارتر في خياره الترجمة هذا، وانعكس تأثُّره بشكل واضح في أعماله القصصيَّة والروائية، معبّراً من خلالها عن هموم جيله وقلقهم، وعن بحثهم عن معنى الوجود في عالم يتغيَّر في الغرب ويبقى في الشرق على حاله. فانكبَّ على أعمال أعلامها منذ الخمسينيات، قراءةً وترجمةً، مستوعباً تفاصيلها، ناقلاً أبعادها الفلسفية العميقة، طارحاً أسئلة الالتزام، والاغتراب، والقلق، والآخر، والموت والحياة… ناقلاً المصطلحات والرموز، بانياً الحوارات الفلسفية، مقارناً بين المجتمعين الغربي والشرقي، ناقلاً إلى القارئ العربي التجربة الروائية الوجودية الغربية بأبعادها الفلسفية الوجودية كاملةً، مستكتباً المثقفين اللبنانيين، والسوريين، والفلسطينيين، والمصريين من ذوي العلاقة بالفكر الوجودي في “الآداب”. وترجم هذه الفلسفة في سياق عربي، دعا فيها إلى التمرّد ضد القيود السياسية، وضد الكبت بأشكاله المتنوعة دامجاً إيَّاها بالحسّ القومي، متعاملاً معها على أنها أداة فكريَّة لتحرير الفرد العربي من قيوده الاجتماعية وتقاليده البالية. ولم يكتف بالترجمة، بل انتقل إلى الإنتاج الإبداعي، فهو يعدُّ من الأوائل الذين نقلوا الفكر الوجودي إلى العالم العربي، وظهّره في الرواية بما تمثله من مواقف فلسفيَّة وأدبيَّة وسياسيَّة.
ثانياً: تلقّي “الحي اللاتيني” لسهيل إدريس: شهادات ودراسات
أثارت أعمال سهيل إدريس ردَّ فعلٍ مختلف مدى سنين طويلة، ولا سيَّما بعد انتشارها الواسع، وإصداراتها المتكرّرة، ولاسيَّما رواية الحي اللاتيني. وتهافت الباحثون عليها، فكتبت عنها المقالات، وأُبديت الآراء، وأُجريت البحوث الأكاديمية على مستويي الماستر والدكتوراه في لبنان والعالم العربي، موظفةً المناهج الأدبية المختلفة. وفي ما يلي نعرض نماذج من شهادات بعض الأدباء المعاصرين حول سهيل إدريس، ورواية الحي اللاتيني، إلى جانب عرض أهم ما جاء في بعض الدراسات التي وضعت عنها، بهدف القبض على مواضع التحوُّل في التلقّي واستخلاص نتائج القراءات المتعدّدة لهذه الرواية، في مراحل زمنية وتاريخية مختلفة.
– شهادات شخصية وأدبية
تتضمَّن شهادات أو مقالات تاريخية عن شخصية سهيل إدريس الأدبية، وعن دوره الثقافي والاجتماعي. وتتّفق على أنّ شخصيته قوية، لا تنفصل عن نصوصها، بشهادة الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي[2]، وعلى أنَّه شخصية متعلّقة بالأدب ومثقَّفة وملتزمة باللغة العربية وعاشقة لها. يعرض مواقفه من القضايا التي عاصرها بجرأة أدبية، ويعيد تشكيل العلاقة بين النص والواقع العربي في “الحي اللاتيني” عبر مناقشته ثنائية الشرق والغرب[3]. وعلى أنَّه لم يكن كاتباً بل كان “مؤسسة ثقافية”[4].
ووجد نجيب محفوظ أنّ رواية “حي اللاتيني” هي علامة فارقة في الرواية العربية الحديثة[5]. وفي السياق نفسه كتب ميخائيل نعيمة: “بعد قراءتي الحي اللاتيني يخالجني أمل أن الرواية العربية ستنهض نهضة قوية على يد المؤلف وأيدي الموهوبين والمتحمسين مثله من أدباء الجيل الطالع”[6].
ويفصّل الباحث الفلسطيني فيصل درَّاج (1943- ) رأيه في رواية الحي اللاتيني، وتقنياتها الجديدة، وطروحاتها الإنسانية والحضارية، وأسلوبها الواقعي، ويقول “بأنَّها إحدى العلامات السردية الفارقة، ليس في زمنها وحسب، بل الأزمنة اللاحقة…”[7].
ورأى الشاعر اللبناني شوقي بزيع (1951- ) “أنَّ أسئلة الهوية والحب والمنفى والمكان، وعلاقة الأنا بالآخر التي طرحتها رواية إدريس هي نفسها الأسئلة الماثلة أمام جيلنا الحاضر والتي ستنتقل عدواها إلى الأجيال اللاحقة، فهي، على نحو ما، رواية جيل، كذلك هي المزيج من الرغبة والطموح والنوستالجيا القومية والتفاؤل الذي كان ركيزة لما يمكن أن نسميه آنذاك بـ “الحلم العربي”، وقد آلى سهيل إدريس على نفسه أن ينشر هذا الحلم.”[8]
– تلقي النقّاد والمتخصّصين لأعماله
تمَّ تناول “الحي اللاتيني” لسهيل إدريس في الدراسة من نواحٍ مختلفة، منها ما هو على مستوى البنية، ومستوى الخطاب السردي، وتحليل الخطابات الحضاريَّة والاجتماعيَّة والنفسيَّة… ودُرست فيها قضايا الصراع بين الشرق والغرب، واغتراب الشخصية… في محاولةٍ لتحديد ملامحها الوجودية.
ويمكن تصنيف هذه الدراسات ضمن محاور بناءً على موضوعاتها وأساليبها النقدية. وفي ما يلي، عرض لنماذج منها، وأبرز الآراء الواردة فيها، مع ملخَّصات مقارنة تُظهر تباين أو تقاطع الرؤى النقديَّة حولها، مذيّلة بقراءة خاصَّة من منظور التلقّي، تهدف إلى فهم كيفيَّة تلقّي القرَّاء العرب لهذا النص، وتحليل التوتر بين أفق التوقُّع لديهم والفجوات الجماليَّة التي تفرضها الرواية[9] في قراءة تأويليَّة تبحث عن المعنى في الرواية وتعدّده من خلال إبراز دور القارئ في إنتاجه. ذلك أنَّ المعنى، بحسب نظرية التلقّي، لا يُنتج فقط من النص أو قصد المؤلّف، بل من التفاعل بينهما، حيث يملأ القارئ “الفجوات” في النص بناءً على خلفيته الثقافية والاجتماعية. هذا في محاولة للقبض على تطوُّر تلقّيها عبر السنوات، والبحث فيها، على الشكل التالي:
على مستوى التحليل الحضاري والاجتماعي، تلقى الكاتب والناقد المصري يوسف الشاروني (1924-2017) الرواية، وكتب عنها بحثاً بعنوان “الحي اللاتيني: عرض وتحليل”، نُشر في مجلة الآداب[10]، أشاد فيه بتجربة “البطل العائد من باريس” التي تجسّد التحولات الثقافية آنذاك. وكان من بين الأوائل الذين كتبوا عن الرواية، عام 1954. وأتى تلقّيه منبثقاً من قناعة أن أيَّ تحليل يجب أن يرتبط بحياة المؤلف، وهذا بحسب ما كان سائداً وتبعاً للنظرية الأدبية المعتمدة في ذلك العصر، وبأنه تالياً “لا يمكن فصل العمل الأدبي عن تاريخ المؤلّف..”[11].
وتلقَّى رجاء النقاش(1934-2008) الرواية بعد صدور طبعتها الأولى، وكتب عنها مقالاً بعنوان “مشكلات ونماذج في الحي اللاتيني” نُشر في مجلة الآداب [12]. ورأى أنَّ هذه الرواية هي عرض لعقدة الشرقي المزمنة تجاه الغرب، وأنَّ إدريس يمثل حركة جريئة في الأدب العربي تضع العرب أمام قضية كبرى في “وسط عالمي”، قضية توجّه المأساة في الرواية”[13].
أما الناقد المغربي أحمد المديني (1949- ) فكتب في 25 شباط 2009 مقالة بعنوان: “الحيّ اللاتيني” لسهيل إدريس: أو مسار “العربي الشريف”[14] جاء فيها أنَّ الرواية “كأنَّما كتبت لإذكاء الروح القوميَّة، ونصُّها هو الدستور النثري الأدبي للتعبئة حول هذه الدعوة. وسواء اقتنعنا بالحبكة الغرامية (بطل الرواية وجانين مونترو) أو سذجناها، فإنَّ مسارات الشخصيات المحيطة بها ذهبت من البداية، مسبقاً، قصداً، وبوعي، كي تفشل كلَّ المشاريع ولا يبقى غير أفق واحد هو الذي يلائم طريق بطل همُّه الأساس أن يكون عربيّاً شريفاً”. مستشهداً بما جاء في الرواية على لسانه[15]، مشيراً إلى أنَّ البطل، ومع عودته إلى “بيروت كان قد ربح الشهادة، وخسر الحي اللاتيني، لينطلق في حياة جديدة، بمؤازرة فؤاد، مرموزاً إليها باليد الأولى التي صافحها لدى وصوله إليها، “… فيشعر أنه يصافح عشرات الأيدي التي يعرفها، وألوفاً من الأيدي التي لا يعرفها انتثر أصحابها هنا في بيروت، وهناك في دمشق، وهنالك في القاهرة والقدس وبغداد وتونس، وفي كل ركن من بلاد العروبة” [16]. ويرى أنَّ أقوى دليل على ما يقول إدراج الرواية في منهاج التدريس في الثانوية العامة لما تمثّله من قيمة نضالية قومية، ومذهبية لتنوير الجيل الصاعد وإشعاره بأهمية الهوية الوطنية وقوة بنائها إزاء الهويات الأخرى”[17].
في حين أنَّ الباحثتين الجزائريتين شريفة غراربة وفائزة بوكروش وضمن منظور نقد ثقافي، وبعد حوالي ثلاث وستين سنة تقريباً من صدور الرواية، وجدتا أنَّه على مستوى السلطة، قدَّمت الرواية خطاباً ذكوريّاً انتقاميّاً من “الآخر” الأنثوي أو المستعمِر، واكتشفت أنَّ طريق تحقيق الذات يكون من خلال البحث عن هدف أسمى من البحث عن المرأة، يكمن في البحث عن الحرية في البلاد العربية والنضال من أجلها[18].
وعلى مستوى التحليل النفسي: تلقَّى أحمد كمال زكي الباحث والناقد المصري (1927- 2008) رواية الحي اللاتيني عام 1954، ودرسها من الناحية النفسية، مركزاً على دراسة عقدة أوديب عند البطل، التي رأى أنَّه تخلَّص منها في المشهد الأخير من الرواية. أما على المستوى الفنّي، فأشار إلى أنَّ الرواية في قسمها الأول لا تتطوَّر، وإنَّما تدور حول نفسها؛ لذلك يجد القارئ مشقَّة في تخييل الجوﱢ العامﱢ. أمَّا في القسم الثاني، ومع ظهور شخصية “جانين”، فينجلي كلُّ شيء، ويتَّضح الغموض…”[19]. وأشار أيضاً إلى أنَّها “أقرب إلى نفس الكاتب منها إلى عقله”[20].
وهكذا فعل الباحث جورج طرابيشي (2016-1939)، الذي أكَّد أنَّ الروايتين: الحي اللاتيني والخندق العميق (1958) ترويان سيرة حياة سهيل إدريس، وأنَّ البطل في الحي اللاتيني كان يتذكر أمَّه في كل موقف يشعر فيه مع المرأة الأجنبية بضعف أو فشل. وانطلق من هذا الرأي ليدعّم تحليله النفسي لشخصية البطل، مشيراً إلى أنَّ “المثلث الأوديبي يتولَّى دور البطولة فيه الابن كمتمرّد، من جهة أولى، وكمتحالف مع الأم من جهة ثانية. على الرغم من النرجسية البعيدة التي تسبح فيها الروايتان… فإنَّ مزية مؤلّفهما التي لا تُنكر له أنَّه قدَّم فيهما إخراجاً اجتماعيّاً -إن صحّ التعبير– للعقدة الأوديبيَّة”[21].
ونلاحظ أنَّ القراءات التي صدرت في المراحل الأولى بعد نشر الرواية، تشدﱢد على علاقة الأحداث بحياة صاحبها بشكل لصيق. ولكن، ما لبث أن تبدَّل الأمر مع الدراسات التي أجريت على الرواية مع انتشار البنيوية في ستينات القرن العشرين، والتي تدرس بنى الأعمال الأدبية من الداخل وتفسّرها بمعزل عن التاريخ والمؤلّف والمتلقّي.
على مستوى الخطاب السردي والبناء الفني، انكبَّت دراسات أخرى على تحليل رواية الحي اللاتيني من حيث تركيبها، وبنيتها، وخصائصها، وخطابها، وتجريبها الفني، وخصوصية طرحها ولا سيَّما بناء الزمن السردي، وبناء المكان، وطرائق رصد الأمكنة والشخصيات وسرد الأحداث وعلاقتها بالمكونات السردية الأخرى. واتَّفقت جميع الدراسات، موضوع البحث، على أنَّ إدريس وظَّف مجموعة من التقنيات السردية الحديثة في سرده، ومن بينها تعدُّد نظام الراوي، وتكسُّر زمن السرد.
وتناول الباحث المغربي حسن المودن (1963- ) في العام 2008 في بحثه “التحليل النفسي للأنا وبوليفونية المحكي” الرواية من منظور نفسيﱟ، وأقدم على تحليل “الأنا” في الرواية عبر تحليله الحوار الداخلي المتعدﱢد الأصوات[22]، مظهراً ما تعانيه الشخصية من صراعات داخليَّة وانقسامات.
ورأى الباحث غالي شكري (1998-1935) أنَّ “الفنَّان كان رائعاً وهو يقدﱢم لنا الوجوه العديدة للمرأة الغربية والشاب العربي من خلال عدَّة نماذج، ثمَّ في قدرته على توظيف هذه الوجوه في صياغة الوجه الأساسي للرواية: الشاب اللبناني وجانين. ولكن غياب أحد العناصر المهمَّة في هذا الوجه -وهو الفتاة العربية (وأرفض أن تكون ناهدة أو هدى هذا العنصر) – فوَّتَ على القصَّاص فرصة تعميق وجهة نظره الفكرية وبنائه الفني على السواء. فقد غاب بذلك أحد شروط الصراع والتفاعل، وبغيابه فقَدَ الصراع تجربته الكبيرة”[23].
على مستوى التأثُّر بالوجودية، تناولت مجموعة من الدراسات الفلسفات الكبرى كـ الوجودية (بخاصة سارتر) وتأثيرها في بناء شخصياته، وبيَّنت ملامح هذا التأثير، بدءاً من اختيار المثقَّف العادي شخصيةً رئيسةً له وليس تصوير البطل المثال، مع التركيز على الحرية الفردية والالتزام، والتمرُّد على القوالب الاجتماعية في بحثها عن هويَّتها الخاصة بعيداً من القيود السياسيَّة والاجتماعيَّة، ومن خلال طرح أسئلة فلسفية تبرز تشظّي الذات وهزيمتها أمام أزمات الواقع، مستخدماً لغة رمزية تعبّر عن الضياع والشعور بالاغتراب.
وفي السياق نفسه، أشار الباحث والناقد المصري رجاء النقاش (1934- 2008) إلى تأثُّر إدريس بسارتر على مستويي الأسلوب ومضمون القص، لجهة:
– وجود تشابه في الأحداث بين ما حدث مع جانين في الحي اللاتيني و”مارسيل” بطلة ” سن الرشد” ، الجزء الأول من سلسلة “دروب الحُرﱢية” لسارتر. ومع الإشارة إلى اختلاف موقف الكاتبين لاختلاف ما يشغل كلّاً منهما من مشاكل اجتماعية. فسارتر لا يقترح الإجهاض حلّاً، ويمنح مارسيل حرية اختيار الحفاظ على مولودها.
– التشابه بين شخصيتَي جانين الفرنسية وناهدة العربية، والتي تتمثل في معاناة كلﱟ منهما من قهر اجتماعي ونفسي، منعهما من تحقيق رغباتهما، واستخدامهما كأدوات في يد الآخرين والظروف، والاستسلام لليأس والإحباط، على الرغم من اختلاف الحضارتين اللتين تنتمي كل منهما إليها. طارحاً السؤال حول احتمالية المصالحة بين العالمين المختلفين[24].
وفي مقلب آخر من مقالب البحث، تمَّت دراسة الرواية على أنَّها نصٌّ “رحليٌّ” “يمارس شعريته من خلال المفارقة الزمنية، نص يتداخل بين السيرة والتخييل”[25].
وعليه اختلفت قراءة هذه الرواية باختلاف المناهج الأدبية والمنطلقات. وعلى الرغم من الاختلاف في المقاربات سواء أكانت مقاربة الشكل والبنية، أم مقاربة ثقافية، فإنَّ جميع الدراسات، موضوع البحث، اتَّفقت على أنَّ الرواية تعكس أزمة هويَّة بين عالمين، بين قيم الحداثة الغربية والقيود الشرقية، رابطةً ذلك بالحرية الوجودية والقومية العربية، ضمن بنية فنية تسير بين الواقعية والفلسفية.
واختلفت في تحديد بنيتها؛ فبعضهم ربطها بعقد إدريس النفسية، وبعضهم الآخر ربطها بشخصيته التي صُنّفت بالشخصية العربية الملتزمة همَّ الحُرﱢية والتغيير. ورأى آخرون أنَّ النصَّ يُعيد إنتاج عنفٍ سلطويﱟ ضدَّ المرأة ويرسّخ الخطاب الذكوريَّ المهيمن في الشرق آنذاك، بعدما حجَّم المرأة وجعلها رهينة نظرة الرجل إليها، وجعل مصيرها مرتبطاً بالرجل وسلوكه تجاهها أو موقفه منها، سالباً منها حقَّها في السعادة.
خامساً: قراءة من منظور نظرية التلقّي
تترك رواية الحي اللاتيني بتركيبتها السردية، وتمركزها حول تجربة الاغتراب والهوية، القارئ المعاصر أمام قراءات متعدﱢدة تفسح في المجال أمام مستويات متعدﱢدة من التلقّي، عبر استكشاف ملامح القارئ الضمني بما يمثّله من بنية ثابتة داخل النص، وتوجّه القارئ الحقيقي لاكتشافه.[26]
وتتبدَّى ملامح هذا القارئ في النص من خلال ما يطرحه من أفكار تخرق أفق توقُّعات القارئ الحقيقي، وتوجَّه لقارئ نموذجي يستوعب أبعاد الانقسام بين المجتمعين الشرقي والغربي، وقراءة الرموز الثقافية المتقاطعة بينهما.
فمَن يمكن أن يكون هذا القارئ الحقيقي، وما هي آفاق توقُّعه، التي تمكَّنت بنية “حي اللاتيني” من خرقها؟ إنَّ القارئ الحقيقي متعدﱢد ومختلف، ويمكن أن يختلف باختلاف ثقافته وعصره، فيأتي تلقّيه بحسب مكتسباته السابقة والخلفية الثقافية والتاريخيَّة التي يستقبل بها العمل؛ فالقارئ العربيُّ الستينيُّ مثلاً، قد يرى في الرواية تعبيراً صريحاً عن تمزُّق الهوية والتمرُّد على التقاليد، وقد يربطها بسياق التمرُّد الفكري على الاستعمار والجمود الاجتماعي، أو قد يرى فيها انعكاساً لتجاربه الخاصَّة في عالم متغيّر ومتداخل الثقافات. أمَّا القارئ الشاب المعاصر فقد يتلقَّى الرواية من منظور شخصيّ، فيراها قصة تجربة فرديَّة في مجتمع آخر، من دون التفاعل بالضرورة مع رموزها الإيديولوجية، وقد يرى إلى بنيتها أنَّها بنية مبنيَّة على الرغبة في الاكتشاف وإشباع رغبات نفسيَّة وجسديَّة لم يعمل على إشباعها في المجتمع العربي، خوفاً من محدﱢدات عديدة، أخلاقية واجتماعية. في حين أنَّ قارئاً مطَّلعاً على الثقافة الفرنسية قد ينجذب إلى الرؤية المقارنة بين الحضارتين، ويعيد قراءة الخطاب بوصفه نقداً ثقافياً مزدوجاً… وقد لا يجد في نهاية “جانين” سوى حُرﱢية شخصية، يرفع عنها أي حكم أخلاقي أو ديني. وبناء عليه، كيف أسهم كلٌّ من الحذف والفراغات في الرواية في تشكيل أفق التوقع؟ وهل تندمج مع أفق التوقع الذي ترسمه الرواية من خلال بنية القارئ الضمني فيها؟ وإلى أيﱢ مدى يلتقي التحليل مع قراءات سابقة في الرواية على مستوى تلقّي بناء الشخصيات الرئيسة في الرواية؟
- الحذف والفراغات وتشكيل أفق التوقُّع:
في ضوء نظرية التلقّي، يمثّل كلٌّ من الحذف والفراغات النصّية آلية نصّيَّة تكمل إحداهما الأخرى، ويشكّلان معاً جسراً بين الكاتب والقارئ الحقيقي المتعدﱢد، حيث يُمنح القارئ دوراً إبداعيّاً في استكمال النص وبناء معناه. وتتعلَّق أهمُّ مواضع الحذف في رواية “الحي اللاتيني” في نقاط تتمحور حول الاقتصاد في تقديم المعلومات والتفاصيل في مواقف محدَّدة، بهدف أن يتمَّ جذب القارئ ليملأها، على أكثر من مستوى:
– الحذف في استرجاع الماضي: الرواية تستخدم الاسترجاع الخارجي لتقديم مشاهد من ماضي البطل في الشرق، لكنها لا تروي كلَّ تفاصيل هذا الماضي بشكل مباشر، بل تترك فراغات تجعل القارئ يستنتج دوافع سفر الشباب إلى فرنسا لمتابعة دروسه.
– الحذف في بناء شخصية “جانين”: نرى أنَّ الراوي أغفل الإفصاح بوضوح عن خلفية “جانين” الثقافية وعن شخصيتها الجامعية، مُركّزاً على علاقتها بالرجل، واختصر كل ما عدا ذلك. وفي هذا السياق تتجاوز علاقة البطل بها البعد الرومانسي لِتشكّل مسرحاً لِفهم التوتر بين الشرق والغرب، الذات والآخر، في محاولات لملء فراغ الانتماء وغياب الهدف، ما يدعو القارئ إلى إعادة بناء معنى الموقف انطلاقاً من مواقفه الذاتية حول الحُبﱢ والآخر. هذا بالإضافة إلى حذف في سرد تفاصيل عن حياتها، ولا سيَّما بعد أن تبلَّغت ردَّه على رسالتها، وحصر ذلك ببعض جمل مدوَّنة في مذكراتها.
– الحذف على مستوى بناء الشخصيات، والصوت السردي، فعلى الرغم من أن السرد ذاتيٌّ، إلَّا أنَّ هناك تغييباً لأصوات الآخرين ولمنظور الآخر، ما يترك “فراغاً حواريّاً” ويزيد من انعزالية البطل ونرجسيَّته. ومنه الحذف في تصوير المرأة الشرقية الممثَّلة بالزوجات المحتملات، والحذف في شرح تفاصيل العلاقات بين الشخصيات. على سبيل المثال، علاقة البطل المستقبلية بـ”ناهدة” الفتاة الشرقية التقليدية.
- أفق التوقُّعات وخرقه على مستوى بناء الشخصية وتلقّيها
هو مجموعة التوقُّعات المسبَقة التي يحملها القارئ تجاه النص بناءً على ثقافته، وذائقته، وتجربته. وهو الجسر الذي يربط بين النص والقارئ. ويختلف في طبيعته بين القارئ النموذجي (الذي يُفترض فيه استيعاب كل ما يطرحه النص) والقارئ الحقيقي (الذي يتفاعل مع النص من خلال خلفيته الشخصية والثقافية، وقد يغيّر أفق توقعه أو يرفض النص إذا خالف توقعاته)؛ فالقارئ العربي في خمسينات القرن العشرين، عندما يقرأ “الحي اللاتيني”، يتوقَّع سرداً تقليديّاً محافظاً، لكنَّه يُفاجَأ بتعبير صريح عن الجسد والرغبة والكبت الذي يعيشه الشباب العربي: رجالاً ونساء. أمَّا الأجنبيُّ فيفاجأ بمدى سيطرة الأم بما تمثّله من سلطة بطريركية قادرة على التأثير القويﱢ بقرارات ابنها الشاب وتوجُّهاته، ويرى إلى الشخصية الرئيسة على أنَّها شخصية مسلوبة الإرادة إلى حدﱟ كبير، تدَّعي بما ليس فيها، وتقبل لنفسها ما لا تقبله للآخرين. ما يجعله يتَّخذ موقفاً ما على المستوى الشخصيﱢ من أحداث الرواية، فتتحقَّق المتعة الأدبية ويتجدَّد المعنى بالنسبة إليه.
وعليه، شكَّلت قصَّة الشخصية الرئيسة (البطل) وعلاقتها بالمرأة، على اختلاف أدوارها وتجربتها، الحدث الأساسي الذي دارت حوله الأحداث، وتمحور أفق التوقع حوله، لأنَّه جعلها هدف بحثه خلال سفره، وهو الآتي من الشرق المكبوت إلى الغرب المتحرﱢر، لذلك تركزت محورية الدلالة على هذا البحث وما توصَّل إليه. فكيف تمَّ تلقّي الشخصيات الرئيسة: البطل، جانين، الأم؟
- تلقّي الشخصية الرئيسة: لم يسمﱢ إدريس الشخصية الرئيسة، بل اكتفى بالإشارة إليها بضمير الغائب “هو” ليجعل من التجربة تجربة عامَّة تعني كلَّ شرقيﱟ يحيا الظروف نفسها، مانحاً الشخصية أبعاداً أكثر شمولية. على مستوى بناء الشخصية ووصفها الداخلي، رأى درَّاج أنَّها تعاني الاغتراب في المجتمعَين الشرقي والفرنسي، وذلك من خلال ما يظهر عليها من قلق مستمر وغياب الإحساس بالأمن والأمان والسلام الداخلي[27]، بالإضافة إلى العقد النفسية الكثيرة التي تعتريه، وقد توقَّف عندها الباحثون، أمثال أحمد زكي وجورج طرابيشي.
وفي هذا السياق رأى طرابيشي أنَّ “كراهية الأب المتجذرة فيه (البطل)… على شكل تمرُّد اجتماعي ذي طابع تقدُّمي…” وأنَّ لواء مبدأ اللذة جعله يحدﱢد، بطريقة لا واعية، أنَّ مانحة اللذة (المرأة) يجب ألَّا تشبه أمَّه…” بما تحمله من قيم سامية، ما أدخله في صراع نفسي جعله مشتتاً بين وجهيهما في كلﱢ موقف يضعف فيه مع المرأة أو يفشل[28].
ومن منظورنا نرى أنَّ الشخصية الرئيسة تحيا الازدواجية: ازدواجية بين ادﱢعائها ضرورة التحرُّر المطلق، وبين قبولها نتائج تحرُّر المرأة، وهذا ما يحيلنا عليه تشكيكها في بنوَّة الطفل الذي أتى كردﱟ أوَّل على رسالة جانين. فلقد كان واضحاً أنَّه لم يفكّر باحتمالات الحمل قبل حدوثه ويتَّخذ الاحتياطات اللازمة. ما يحيل إلى شعور سابق عنده بالاطمئنان مغلَّف بغياب الإحساس بالمسؤولية والرغبة في تحمُّل العواقب تأتَّى من معرفته المسبقة بالمجتمع الغربي حيث التحرر والانفلات من أيﱢ قيد. ولكن، بعد معرفته بموضوع الحمل، فكَّر باسمه، بميراثه، وخشي من أن تستغل جانين “رسالته الرد” كدليل إثبات على أبوَّته، فيؤخذ منه ما لا يريد منحه لمن في رأيه لا تستحق! ولم يخشَ أن يكون مخطئاً وأن تكون فعلاً حاملاً منه. ولم يتردَّد فقذفها بأبشع الاتّهامات. وهنا تبدو الغلبة للمعايير الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في ذاته على أيﱢ حسﱟ إنساني أو عاطفي أو أخلاقي.
وتذرَّع بسهولة بموقف والدته الرافض لهذا الحمل وهذه العلاقة، محمّلاً “جانين” مسؤولية تصرُّفه وما تأتَّى منه لاحقاً من أحداث أنهت علاقته بها. ويحيلنا هذا الموقف إلى نرجسيَّته التي تزيّن له سهولة التملُّص من المسؤوليات، وترفض أن تكون امرأة، مهما علت المكانة التي تحتلُّها في حياته سبباً في التأثير على حياته سلباً، أو أن تثنيه عن هدفه.
وهنا، نتلمَّس في كلام جانين صوت الروائي، تبعاً لما أورده على لسانها إذ قالت: “إنَّ دنياك التي تحلم بها أوسع وأعظم من أن يستطيع الثبات فيها شخص ضعيف مثلي. إنَّك الآن تبدأ النضال، أما أنا فقد فرغت منه، ومات حسُّ النضال في نفسي…”[29]. ما يجعل المتلقي يتساءل عن نوع النضال الذي خاضته جانين، وما هو نوع النضال الفعلي الذي خاضه البطل بين دفَّتَي الرواية على مستوى الفعل؟!
ويلتقي أفق التوقُّع هذا مع ما أشار إليه طرابيشي أنَّ البطل كان قرَّر إنهاء علاقته بجانين وهو في قمَّة تعبيره عن حبّه لها، مستنداً إلى قوله: “أعاهدك يا جانين على ألَّا أدعك، بعد الآن، ما دمت في باريس”. فجانين، إذاً، مكانها في باريس، ولا مكان لها في وطنه، حيث تكون أمُّه.
وأيضاً ممَّا كتبته جانين في مذكّراتها: “سأصارح حبيبي العربي بأنّي سأحبُّه كما تحبُّ المرأة الرجل في الشرق، لا تطلب مقابلاً ولا تنتظر عوضاً…”[30]، والذي وجد فيه نبلاً، توقَّع أنَّه سيكلّفها أغلى الأثمان، انطلاقاً من معرفته المسبقة بالرجل الشرقي المشبع بالموروث الأبوي والذي لا يمكنه أن يتصوَّر أن يصدر عن أداة اللذة – المرأة في نظره نبلٌ مماثلٌ، لذلك يعمد إلى تجريدها من القيم، ليتمكن من التخلُّص منها وتسويغ موقفه.
وتتكشف في هذا الموقف حقيقته الزائفة، الحقيقة التي تنفي عنه صفة الحبﱢ الحقيقيﱢ، ليبيّن أن تعلُّقه بجانين كان مجرَّد حاجة في تلك البلاد البعيدة ليشعر بالراحة، مجرَّد علاقة ملجأ تقيه الغربة وأعراض الوحدة، علاقة لا رغبة في التزام فيها، ولا نيَّة لاستمرارية.
وبناءً عليه، ومن منظور معاصر، نرى أنَّ البطل مجرد رجل أنانيﱟ، يبحث عن اللذة بأنانية مطلقة، ويسوﱢغ لِنفسه ما لا يقبله لغيره، وأنَّ التحليلات الأدبية، وأفق توقُّعات القرَّاء هي ما منحه هذا البعد النضالي والبطولي الأكبر بكثير من أفق توقُّعات القارئ الضمني الذي ميَّز شخصية فؤاد، ومنحها الدور الأهم على هذا الصعيد.
- تلقّي بناء شخصية جانين: جانين في “الحي اللاتيني” شخصية معقَّدة تمثّل نموذج امرأة غربية في علاقاتها العاطفية. مرَّت بتجارب مؤلمة: خيانة خطيبها هنري، ثمَّ علاقة عاطفية وجسدية مع البطل العربي، وحمل واتّهام بالخيانة وإجهاض، وانتهى بها الأمر إلى رفض الزواج من البطل، على الرغم من عدوله عن موقفه لاحقاً بعد عودته إلى باريس. اختارت جانين الانفصال عنه وترك رسالة تشرح فيها دوافعها، مؤكّدة اختلاف الحضارتين وصعوبة التلاقي الحقيقي بينهما. وعليه، اختارت جانين الانفصال عن الرجل مرَّتين: مرَّة عن الفرنسي الجنسية، ومرَّة عن اللبناني الجنسية، وفي كل مرَّة لسبب يرتبط بفعل أقدمَ عليه الرجل، يتمحور حول خيانة أو شك واتهام. فتخرق بذلك أفق توقُّع القرَّاء الشرقيين الذين يرون أن الزواج في حالتها هو الحل الأمثل لتخفي ما يوصف “بالعار والفضيحة” في المجتمع الشرقي المحافظ، أو لتضفي على علاقتها به طابعاً شرعيّاً. لكنَّها لم تأبه لذلك، واختارت الابتعاد منه وتحمُّل وزر خيارها هذا. ثم تختار أن تدخل في علاقة من دون زواج مع شاب عربي آخر… هذا ما يخرق أفق توقُّع القارئات الشرقيات اللواتي يلتزمن العفة والمطلوب منهنَّ عدم التفريط بها. فيتعاملن معها على أنها فتاة خارجة على التقاليد وأنّه يفترض أن تعاقب وأن يبتعد عنها البطل ليعود ويتزوج المرأة الشرقية “ناهد”، فيكون زواجها به مكافأة لها على صونها شرفها.
وفي القراءات، موضوع البحث، اختلف تلقّي بناء شخصية جانين وما تمثّله، فنُظر إليها في بادئ الأمر على أنَّها من أنبل الوجوه التي أبدعتها الرواية العربية قط، ومآلها المأسوي ما زادها… إلا نبلاً”[31]، وأنَّها حصدت تعاطف المتلقّين، وحرَّكت الأمل في النفوس إلى درجة اعتقد أنَّ نجاح هذه العلاقة يمكن أن يؤدﱢي إلى مصالحة بين الشرق والغرب.
أمَّا من منظور نسوي، فيمكن قراءة موقف جانين على أنَّه موقف قوَّة ينمُّ عن استقلالية، وقدرة على اتّخاذ القرار لأنَّها، من هذا المنظور، رفضت أن تكون مجرد امتداد لرغبات الرجل الشرقي أو الغربي. وأنَّه يعبّر عن فهم لخصائص المجتمع الشرقي الذكوري ورفض لأن تكون رهينته. وأنَّ ما آل إليه وضعها يحيل إلى نتيجة الهيمنة الذكورية التي تؤكّد أنَّ الضياع والتهميش هما مصير حتميٌّ للمرأة التي لا تقبل الأدوار الاجتماعية المعدَّة لها مُسبقاً.
أمَّا من منظور القراءة الوجودية، فإنَّ موقف جانين هو موقفٌ وجوديٌّ بامتياز: فهي حرَّة، وقد اختارت وجودها الأصيل كما تشاء. لكنَّها تدفع ثمن هذه الحرية قلقاً وضياعاً ومسؤولية مطلقة عن مصيرها. لا تلجأ إلى تبرير اختياراتها أو إلقاء اللوم على الآخرين، بل تعترف بمسؤوليتها الكاملة عن حياتها، في عالم بلا مرجعية مطلقة، حتى لو أدَّى ذلك إلى نهاية مأساوية.
إلَّا أنَّ هذا المعنى يتبدَّد إذا ما قرأنا شخصية جانين من منظور الأصوات المنادية بتمكين المرأة المتزايد عبر التعليم والتكنولوجيا… وتؤمن بضرورة النضال من أجل تأمين نمط حياة أفضل، عبر العمل والترقّي الوظيفي، على الرغم من الضغوطات الكثيرة التي ما تزال تتعرَّض لها في المجتمع المعاصر: ضغوطات حياتيَّة واجتماعيَّة مختلفة، فترفض مآل جانين الأخير، وتقول بضرورة تقديم صورة عن نساء ناجحات، مكتفيات بذواتهنَّ، منجزات. من هنا، يدلُّ قرار جانين الانفصال عن البطل الشرقي على أنَّها شخصية تعي المشكلة القائمة بينهما، وترفض الذوبان في شخصيته وفي ما يمثله. أما خيار الضياع هذا فليس مسوغاً في الرواية وغير مقنع، إلَّا إذا أدخل في إطار مفاهيم نرجسيَّة شرقيَّة عميقة، لإنهاء آخر احتمال للبطل بالتعاطف معها، ولإنهاء أي إمكانية للعودة بينهما، وليعطي نفسه عذر العودة إلى الشرق واستكمال حياته فيه من دونها.
- تلقّي شخصية الأم: تؤدي الأمُّ دوراً محوريّاً في السرد، لكنَّها تأخذه في اتّجاه مغاير لما يتوقَّعه القارئ الحقيقي، لأنَّ ما رويَ على لسان الشخصية في القسم الأول من الرواية عن جانين، يبيّن مدى حبّه لها، ومدى تثمينه لشخصها ونوع العلاقة العاطفية التي تجمعهما، ما يزيّن للقارئ فكرة زواجهما أو على الأقل البقاء معاً، لا أن يتخلَّى عنها عند أوَّل تحدﱟ، وبالشكل القاسي الذي اختاره. وهنا يطرح السؤال: لو تسلَّم الرسالة في فرنسا، أو لو أخبرته بالموضوع وجهاً لوجه، ولو لم تدر أمُّه في اللحظة نفسها بالموضوع، هل ستكون ردَّة فعله بهذه القسوة؟ أم ما كان مقبولاً بالنسبة إليه في فرنسا لم يعد مقبولاً ما إن وطئت قدمه لبنان، وما يقبله على نفسه بعيداً من أهله لا يقبله وهو بينهم؟
من هنا، تمَّ خرق أفق توقُّع القارئ الحقيقي عندما خرق السرد الموقف الذي كان يعدُّ له، ألا وهو قبول علاقة الشاب الشرقي المسلم بالفتاة الفرنسية المسيحية أو الملحدة، وبخاصة أنَّه لم يأتِ على ذكر أهله في القسم الأول من الرواية حيث أسهب الراوي في سرد تفاصيل تطوُّر علاقتهما.
يُحدث هذا الموقف صدمة جماليَّة تجعل القارئ يعيد التفكير في موروثاته، في ما كان يعتقده صحيحاً. تضعه أمام ذاته، تماماً، كما حدث مع الشخصية الرئيسة في الرواية، ليعيد التفكير في ما له وما عليه. لم يخرق موقف الأم توقُّعات القرَّاء الشرقيين؛ لأنَّ الدور الذي تمثّله هو دور نمطيٌّ بامتياز، لكن موقف الـ”هو” الشخصية الرئيسة.. هو من صنع الفرق بسرعة انصياعه ورضوخه لأمّه بكلﱢ ما تمثّله من سلطة تدافع عن الشرف والفضيلة والدين، بدلاً من أن يحاول إقناعها، أو يواجهها أو يتمرَّد على قرارها، ولو جزئيّاً. لكنَّ ما حصل أتى ترسيخاً لما لم يرفضه، ويشكّل جانباً مهمّاً من تكوينه الثقافي والتربوي الذي سرعان ما نفاه، بعدما وطئ بلاد الغربة مجدَّداً، في محاولة لتصحيح الموقف.
- اندماج الآفاق
توجَّه البطل إلى الغرب حيث اعتقد أنَّه سيؤمّن له ما يريد، من دون أن يحمل أيَّ عبء على كتفيه، في بلاد تؤمّن له حرية الهرب من المسؤولية ساعة يشاء، متذرﱢعاً بمسوﱢغات كثيرة. لكنَّه يُصدم بالواقع الذي يعطي بحساب، ويستهلك الجسد من أجل متعة العيش من دون رادع أو شعور بالندم. لكن، حين قابل جانين، تغيَّرت المعادلة إلى حين. ثمَّ اكتشف أنَّها تقع تحت ضغط مشكلات اجتماعيَّة ونفسيَّة تفوق تصوُّره تعقيداً، بسبب الحرية الجنسيَّة التي كان يسعى إليها. فاكتشف أنَّ الحرية المطلقة ليست حلّاً، ولا سبباً لسعادة، وإنَّما قد تجرُّ على صاحبها المزيد من المصاعب، ما وضعه في مواجهة حقيقيَّة مع ذاته، مع ما يريده وما يتوقَّعه. وللخروج من المأزق، تمسَّك أكثر بشرقيَّته، وثمَّن تمسُّك الشرقيات بالعفَّة، وبنى أفقاً جديداً يرسّخ الكبت مساحةً آمنة ليحيا الجميع فيها. والتقى أفق التوقُّع هذا مع توقُّع أهله ورفاقه والشرقيات، أفق واحد يلائم همَّه الأساس المستجدَّ في أن يكون “عربيّاً شريفاً”، بعد أن حوَّل موضوعه نحو موضوع أسمى، سوَّغ من خلاله خيار الابتعاد عن فرنسا وما تمثّله، محاولاً من خلال تجربته طرح الطروحات التي تساعد على تطوير المجتمعات العربية.
ولا شكَّ في أنَّ الرواية استطاعت استمالة عدد كبير من القرَّاء عند صدورها لأنَّها خيَّبت أفق انتظارهم سواء أكان على مستوى تجاربهم الأدبية أم على مستوى معتقداتهم الإيديولوجية. ما أثار الكثير من الأسئلة المرتبطة بالمجتمع وعاداته وتقاليده. وعليه، حاول إدريس دمج مفهوم “الذات الوجودي” بمفهوم “الهوية العربية”؛ فهو لم يتبنَّ الوجودية تبنياً تامّاً، بل أعاد طرح “الهوية العربية” على أنَّها مشروع وجودي قيد التكوين، بناء “عربي جديد”، حرٌّ ومفكّر. وانتقد من فهم فلسفة سارتر بشكل منقوص، وبأنَّها فلسفة التفلُّت من كلﱢ واجب وقيمة.
انطلاقاً ممَّا سبق، مارس إدريس الكتابة بوصفها فعلاً سياسيّاً، وفعل تغيير، ملتزماً بمجتمعه ومشكلاته. فجاءت أعماله حجر أساس في بناء الرواية العربية الحديثة.
هوامش البحث:
[1] هانس روبرت ياوس (2016). جماليّة التلقّي: من أجل تأويل جديد للنصﱢ الأدبيﱢ (ط1)، تر. رشيد بنحدو. تونس: كلمة للنشر والتوزيع. ص35-36.
[2] مستغانمي، أحلام (2008). “سهيل إدريس المتظاهر بالموت”. مجلة الآداب، ص 43-44. تمَّ الاسترجاع في (1 حزيران 2025 – 10 مساءً) من: https://al-adab.com/sites/default/files/aladab_2008_v56_04-06_0043_0044.pdf. مجلة الآداب الالكترونية.
3 زلط، أحمد (2009). “الشرق والغرب: نموذج الحي اللاتيني.” الثقافية (75)، 138-140. تمَّ الاسترجاع في (1 حزيران 2025 – 10 مساءً) من: https://archive.alsharekh.org/Articles/255/18563/419660
4 درَّاج، فيصل (2008). سهيل إدريس داخل جيله وخارجه. مجلة الآداب (3-4).
[5] كتب على غلاف رواية الحي اللاتيني، طبعة 1953
[6] كتب على غلاف رواية الحي اللاتيني، طبعة 1953
[7] فيصل درَّاج. م.ن.
[8] شوقي بزيع، (29-2-2008). “عن رحيل سهيل إدريس أو الموت بالتراضي”. جريدة السفير( 10936)، تمَّ الاسترجاع في (1 حزيران 2025 – 10 مساء) من: https://archive.assafir.com/ssr/1487632.html
[9] روبرت هولَب (2000). نظريَّة التلقّي: مقدﱢمة نقديَّة (ط1)، تر. عزّ الدين اسماعيل. القاهرة: المكتبة الأكاديميَّة. (نشر العمل الأصلي 1984). ص 15.
[10] يوسف الشاروني (نيسان 1954). الحي اللاتيني: عرض وتحليل. مجلة الآداب (4)، ص 46.
[11] م.ن.
[12] رجاء النقاش (1 يونيو 1954). “مشكلات ونماذج في الحي اللاتيني”. مجلة الآداب (6)، 46-49.
[13] م.ن.
[14] أحمد المديني(25 شباط 2009) “الحيّ اللاتيني” لسهيل ادريس: أو مسار “العربي الشريف”. تمَّ الاسترجاع في (2 حزيران 2025 – 9 صباحاً) من: https://shorturl.at/t6kQ4
[15] سهيل إدريس، م. ن، ص 234
[16] م. ن، ص 263
[17] المديني أحمد، م.ن.
[18] شريفة غراربة وفائزة بوكروش (2017). الانتقام الذكوري من الآخر في السرد العربي المعاصر رواية الحي اللاتيني لـسهيل إدريس أنموذجاً – دراسة في النقد الثقافي. (رسالة ماستر أعدَّت بإشراف د. محمد جودي)، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة: الجزائر، ص 69.
[19] أحمد زكي (4 نيسان 1954). نقد وتعليق. مجلة الآداب (2)، ص 78.
[20] م. ن. ص 76
[21] جورج طرابيشي (1982). عقدة أوديب في الرواية العربية، “سهيل إدريس العقد الأوديبية والحدود التقدمية، ص 278-332. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر. ص 278-279.
[22] المودن، م. ن.، ص 76-81
[23] في مقالة له مقتبسة من كتابه “أزمة الجنس في القصة العربية” الذي صدر بطبعته الأولى عام 1993، وأعادت نشره مؤسسة الهنداوي عام 2013، نشرت مقالات منها على موقعها الإلكتروني. غالي شكري: أزمة الجنس في الرواية العربية. الفصل الرابع، تمَّ الاسترجاع في (1 حزيران 2025 – 10 مساءً) من: https://www.hindawi.org/books/95190396/4/
منصر، أمير، وبولعسل كمال (آذار 2021). “شعرية الفضاء في الرواية الرحلية العربية العاصرة رواية الحي اللاتيني لسهيل إدريس أنموذجاً”. مجلة المدوَّنة (1) (8)، ص 359-378.
[24] رجا النقاش، م. س. ن
[25] منصر، أمير، وبولعسل كمال (آذار 2021). “شعرية الفضاء في الرواية الرحلية العربية العاصرة رواية الحي اللاتيني لسهيل إدريس أنموذجاً”. مجلة المدوَّنة (1) (8)، ص 359-378.
[26] جرجور، مهى، تنسيق مهى جرجور وتحرير جوزف لبُّس (2020). دليل مناهج البحث العلميﱢ في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة، قسم اللغة العربيّة وآدابها، الجامعة اللبنانيّة [طبعة إلكترونيّة]، ص 41.
[27] درّاج ، م. ن. ص 53- 55
[28] جورج، طرابيشي: م. س. ن. ص 219- 220
[29] سهيل إدريس، م.ن. ص 157.
[30] م. ن. ، ص188-189.
[31] جورج طرابيشي، م. س. ن. ص 309.
قائمة المصادر والمراجع:
- إدريس، سهيل (1953). الحي اللاتيني. بيروت، دار الآداب.
- إيزر، فولفغانغ (1995). فعل القراءة: نظريَّة جماليَّة التجاوب (في الأدب)، تر. حميد لَحمداني والجلالي الكدية. فاس: منشورات مكتبة المناهل.( نشر العمل الأصلي 1976)
- خورشيد، فاروق (1954). “حول نقد الحي اللاتيني”. مجلة الآداب (6)، 93 – 94. تمَّ الاسترجاع في (1 حزيران 2025 – 10 مساءً) من: http://search.mandumah.com/Record/370697
- دراج، فيصل (2008). سهيل إدريس داخل جيله وخارجه. مجلة الآداب (3-4). تمَّ الاسترجاع في (1 حزيران 2025 – 10 مساءً) من: http://search.mandumah.com/Record/370697
- زلط، أحمد (2009). “الشرق والغرب: نموذج الحي اللاتيني.” الثقافية (75)، 138-140. تمَّ الاسترجاع في (1 حزيران 2025 – 10 مساءً) من: https://archive.alsharekh.org/Articles/255/18563/419660
- زكي، أحمد (4 نيسان 1954). نقد وتعليق. مجلة الآداب (2)، ص 76-78. تمَّ الاسترجاع في (1 حزيران 2025 – 10 مساءً) من: https://archive.alsharekh.org/Articles/255/18563/419660
- سرور، نجيب (شباط 1955). نرجس في الحي اللاتيني. مجلة الآداب (2)، 26-30، 53- 55. تمَّ الاسترجاع في (1 حزيران 2025 – 10 مساءً) من:
https://archive.alsharekh.org/Articles/255/18563/419660
- الشاروني، يوسف (نيسان 1954). الحي اللاتيني: عرض وتحليل. مجلة الآداب (4)، ص 57-62. تمَّ الاسترجاع في (1 حزيران 2025 – 10 مساءً) من: http://search.mandumah.com/Record/370697
- الشملي، سهيل (1998). البطل في ثلاثية سهيل إدريس (1). بيروت: دار الآداب.
- طرابيشي، جورج (1982). عقدة أوديب في الرواية العربية، “سهيل إدريس العقد الأوديبيَّة والحدود التقدُّمية، ص 278-332. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر.
- شوقي بزيع، (29-2-2008). “عن رحيل سهيل إدريس أو الموت بالتراضي”. جريدة السفير( 10936)، تمَّ الاسترجاع في (1 حزيران 2025 – 10 مساءً) من: https://archive.assafir.com/ssr/1487632.html
- غراربة، شريفة وبوكروش، فائزة (2017). الانتقام الذكوري من الآخر في السرد العربي المعاصر رواية الحي اللاتيني لـ سهيل إدريس أنموذجاً – دراسة في النقد الثقافي. (رسالة ماستر أعدَّت بإشراف د. محمد جودي)، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة: الجزائر.
- المديني، أحمد (25 شباط 2009). “الحيّ اللاتيني” لسهيل ادريس: أو مسار “العربي الشريف”. تمَّ الاسترجاع في (2 حزيران 2025 – 9 صباحاً) من: https://shorturl.at/t6kQ4
- مستغانمي، أحلام (2008). “سهيل إدريس المتظاهر بالموت”. مجلة الآداب ، ص 43-44. تمَّ الاسترجاع في (1 حزيران 2025 – 10 مساءً) من:
https://al-adab.com/sites/default/files/aladab_2008_v56_04-06_0043_0044.pdf.
- منصر، أمير، وبولعسل كمال (آذار 2021). “شعرية الفضاء في الرواية الرحلية العربية المعاصرة رواية الحي اللاتيني لسهيل إدريس أنموذجاً”. مجلة المدوَّنة (1) (8)، ص 359-378.
- المودن، حسن (2008). “الحي اللاتيني: التحليل النفسي للأنا وپوليفونية المحكي” . تمَّ الاسترجاع في (31 أيار 2025 – 8 مساءً) من:
https://libraries.aub.edu.lb/blacklight/catalog/b1769520x?externalv=1&src=oai
- النقاش، رجاء (1 يونيو 1954). “مشكلات ونماذج في الحي اللاتيني”. مجلة الآداب (6)، 46-49. تمَّ الاسترجاع في (31 أيار 2025 – 8 مساءً) من: https://archive.alsharekh.org/Articles/255/18563/41966
- هولَب، روبرت (2000). نظريّة التلقّي: مقدّمة نقديّة (ط1)، تر. عزّ الدين اسماعيل. القاهرة: المكتبة الأكاديميّة.(نشر العمل الأصلي 1984).
- ياوس، هانس روبرت (2016). جماليَّة التلقّي: من أجل تأويل جديد للنصﱢ الأدبيﱢ (ط1)، تر. رشيد بنحدو. تونس: كلمة للنشر والتوزيع. (نشر العمل الأصلي 1982).