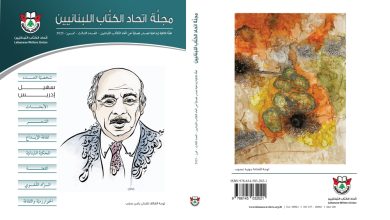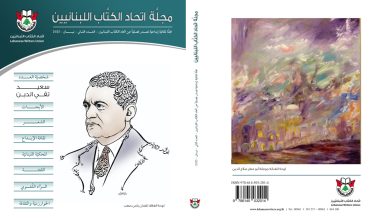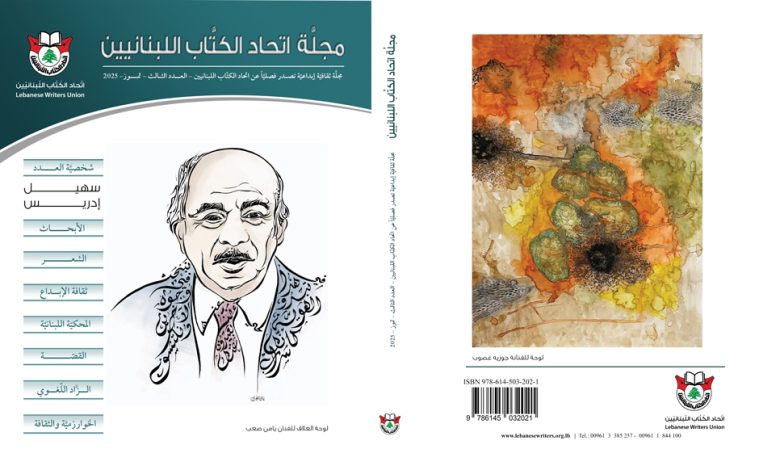
الفاعل السرديّ بين الانكفاء والمقاومة، الشخصية في رواية خمسة أصوات مثالًا
أ.د. سعيد حميد كاظم/ جامعة كربلاء- كلية العلوم الإسلاميّة- قسم اللغة العربيّة.
 الملخّص:
الملخّص:
لا يخفى ما للشخصية من عمقٍ تأثيريّ في الفعل السردي؛ إذ لها من المحمول الذاتي الذي يُقيم اصطفافًا بين المظهر والفعل السرديّ والعمق المعكوس في النصّ الروائي، وبوجودها تمنح العناصر السرديّة معنًى يبوح بمكنوناتها، ويكشف عن الدّافع النفسي لسلوك الشخصية الظاهريّة والعميقة؛ ولما لها من دورٍ فاعل في بنية النّص الروائيّ فإنَّ الروائيين يعوّلون كثيرًا على الشخصيات بوصفها الفاعل السرديّ الذي يحقّق رؤية النص ومضمراته؛ ولما لها من انميازٍ؛ فإنّها تهيمن على حركة النصّ الروائيّ ولربما تختزل أحداثًا، وبها تتكوّن عملية بناء متين يأخذ القارئ إلى مديات مدهشة بالقراءة وصيرورة الحكاية؛ لذا فهي تؤكّد الفاعلية السرديّة بما تؤدّيه من أدوار تعمل على إدارة الصراع وتوجيهه بما يجعل الرواية متجدّدةً، وهذا ما وسمت به رواية “خمسة أصوات”[1] للروائي العراقيّ غائب طعمة فرمان.
ولعلّ ما تنهض به رؤية البحث إلى الشخصيّة[2] بوصفها فاعلًا نوعيًّا له قوانينه من حيث النظرُ والفكرُ والعاطفةُ وحركةُ الصراع التي تربط مظهر القول الخاصّ بالفاعل مع عمق المعنى المتولّد عن القصد الدلاليّ ب مباشرةً، سواء أكانت سطحيةً في مضمارها السرديّ وغير مباشرة أم كانت عميقةً وعليها تتقوّم الرؤى السرديّة؛ وهذا ممّا يؤدي إلى تحقّق المتعة والنفع، وتوفير قدر مناسب من الإقناع ؛ فضلًا عن الارتقاء بمدلولاتها إلى درجة الكيان المعرفيّ النوعيّ الذي يَسمُ العمل السرديّ بالإضافة الروائيّة .
Summary: It is undeniable that personality has a profound impact in the narrative action; it bears a subjective burden that establishes a hierarchy between appearance, action, and the reversed depth in the narrative text. Its presence grants narrative elements a meaning that reveals its hidden layers and uncovers the psychological reality of the deep character’s behavior. It may condense events and through it, a process of construction is formed through reading and the unfolding of the story. Thus, it affirms the narrative effectiveness through the roles it plays in managing conflict and directing it, which keeps the narrative fresh. The research’s perspective regards the character as a qualitative actor with its own laws concerning perception, thought, emotion, and the movement of conflict that links the appearance of the actor’s speech with the depth of meaning generated by the semantic intention directly, whether superficial in its narrative domain or indirect, or deep, which frames the narrative perspectives. This leads to the achievement of enjoyment and benefit, providing a suitable degree of persuasion, in addition to elevating its connotations to the level of a qualitative cognitive entity that distinguishes the narrative work within the additional novelistic framework.
المهاد النظريّ:
تُعدّ الشخصية عنصرًا مهمًّا من عناصر العمل الروائيّ، فهي من المقومات الرئيسة في الرواية كما تُعدّ ركيزة العمل الروائيّ في الكشف عن القوى التي تحرّك الواقع من حولنا وعن حركيّة الحياة وواقعيتها، فبها يتمكّن الروائيّ من التعبير عن رأيه، وأن يوصل إلى القارئ هدفه الذي يسعى إليه؛ ولذا فقد عُني الروائيّون بشخصياتهم الروائية؛ لأنّه لا يمكن لهم أن يصوّروا مجتمعًا من دون شخصيات فاعلة فيه وفي أحداثه.
على أنّنا لا نعدم أنّ هنالك تمرّداً من بعض الشخصيات على كاتبها، لأنّها تتحرك وتتكلم لا كما يُخطط لها، وأنها تفرض وجودها، وقد يكون هذا الأمر مقصودًا من لدُن الكاتب لإظهار تناقضات الحياة، أو أن يعبّر عن التناقض الحاصل الذي يتعارض مع هدفه، إذ إن الروائي هو من يحاول أن يجعل هذه الشخصيات وحدها من تستطيع أن تعبّر عن الحياة والمجتمع والناس وبوساطتها يمكن أن يُقدّم الحلول الناجعة بحسب رؤيته هو ، كما لا يمكن إغفال الحركة التي تبعث بها الشخصية في العمل الروائي بعنصري التفاعل والاندماج.
لقد تحوّلت العناية -فيما بعد- في الدراسة الروائيّة المعاصرة من الشخصية إلى (وظيفتها) و(عملها)، وإذا كان الأدب القديم قد أعطى الشخصية اسمًا من دون أن يسند إليها أيّة صفة أخرى، كي يوكل إليها القيام بممارسة الأحداث والأفعال، فإنَّ السرد الحديث قد أخذ بعين اللحاظ انسجام هذه الأحداث التي تمارسها الشخصية، مع طبيعتها النفسية والمزاجية والثقافيّة، وهكذا ظهر المضمون السيكولوجي للشخصية في الأدب والنقد؛ وذلك بتقديم ما يعتمل في جنباتها النفسيّة التي تعيشها الشخصية بعدّة تصنيفات للشخصية: أنواعها، وتطابقها، وتقاطعها، ومنها: تصنيف الشخصية في سكونية ثابتة لا تتغير طَوال السرد، وحركيّة تنماز بالتغيير الدائم داخل السرد، ثمّ شخصية محورية (أو رئيسة)، وثانوية، وشخصية معقّدة ذات عمق سيكولوجي([3]) .
إنّ خلق الشخصية علامة مميزة لنشوء الرواية، وإن مقياس الإبداع الروائي يكمن في خلق الشخصيات القادرة على إقناع القارئ وإمتاعه والتأثير فيه؛ والنقاد حين يتحدثون عن الشخصيات فإنهم يطلقون صفات تحدد مرتبة كل شخصية، ومن أكثر الصفات دورانًا هي المحورية، الرئيسة، الثانوية، الهامشية ومنها (ثابتة، نامية، بسيطة، مركبة)([4])
، كذلك الشخصيات المسطّحة التي تدور على فكرة واحدة ولا تتطور ويمكن كشفها بيسرٍ، خلاف الشخصية العميقة التي لها القدرة على إثارة الدهشة؛ فإذا أثارت الدهشة فهي عميقة وإذا كان خلاف ذلك فهي غير عميقة، وأنّ الروائيّ يعوّل كثيرًا على الشخصيات العميقة، ولكي يخلق تنوّعًا في العمل الروائيّ لا بدّ أن يردفها بالشخصية المسطّحة، كما أن هنالك الشخصية السلبية والشخصية الإيجابية، ويمكن القول إنّ الشخصية الروائية تتعدّد بتعدّد الأهواء والمذاهب والايديولوجيات والثقافات والهواجس([5])؛ لذلك أصبحت الشخصية عنوانًا لقدرة الكاتب على إبداع الرواية الجادة، وكانت الدعوة في الدراسات الحديثة إلى خلق شخصيات جديدة تنماز بالنمو والحركيّة.
أ – مرحلتي الإرهاص والتأسيس:
وتمضي هذه المرحلة نحو الكشِفِ عنِ اشتِغالِ المَعنى برُؤية تَحريريَّة واعِيَة تُؤمِنُ بأنَّ التَّنوّعَ لا يَتأتّى إِلّا مِن التَّمايُزِ، لذلك قدّم الروائي تنوّعًا يرتكز على أكثر من رؤية منها استلهامية يبدع بأدائها تلك الأصوات السرديّة، وأخرى رؤية استقرائية تعمل على تَفكيكِ مَركزيَّة القِراءة ، لِتُقدِّمَ بَديلاً تأويليًّا حَداثيًّا يعتمد على تَمثيل الجُغرافيا الفِكريَّةِ، وتَعدُّدِيَّة المَرجِعيّاتِ، وإنّما هذا التنوّع المقصود في الأصوات والأسماء وتعدّد الأمكنة إنّما يُخَلخِل النَّزعَةَ الأُحادِيَّة في الطَّرحِ، إذ تَظهرُ الرُّؤيةُ المعرفيَّةُ بوصفِها انحيازًا إلى قِيَم التَّواصُلِ، واختبار الفرضيات، وتجويد آليات التفكير والتحليل، و”التقصّي”،و”تحليل الاحتمالات”؛ لاستكشاف أفق المخاطَب والتَّعدُّد، والحوارِ الحضاريِّ، وهو ما يَعكسُهُ التَّنوُّعُ في الحُقولِ والمَرجعيَّاتِ.
لقد انبنت رواية (خمسة أصوات) على وفق نسق فنّيّ متماسك يعتمد آلية التعدّد الصوتيّ (النظام البوليفوني[6]) الذي يعتمد على الراوي المتنوع في تناول الأحداث وتقديم وجهات النظر المختلفة بحيث يحقّق للرواية تماسكها وتلاحمها، من دون أن يتدخل الروائيّ في مجريات الأحداث، وفي فرض إيديولوجيته الخاصة على شخصياته، بل تركها تتصرف بحرية تامة في الفضاء السرديّ لتعبّر عن وجهات نظرها بإزاء ما يدور حولها من أحداث، لتتسم رؤيته بالموضوعيّة؛ لأنّه يتجنّب التدخل بطريقة مكشوفة أو مقحمة، حتى ليشعر القارئ في بعض الأحيان أنّ الكثير من الشخصيات السلبية والانتهازية تحظى بشيء من عطف المؤلّف ورعايته بمنحها الحرية للتعبير عن وجهات نظرها ومنظوراتها الخاصة([7]).
ولعلّ الروائي ينتهج القصدية في توجيه الخطاب السرديّ نحو المتلقي ليكون على صلة وطيدة لفهم الوقائع والظواهر لتوليد الجاذبية إليها، ولكشف دراسة الخطاب؛ وبهذا فقد أراد أن يبيّن التأثيرات الاجتماعية والثقافيّة والتأريخيّة وصلتهم بالواقعين الحياتيّ والفنيّ، ولعلّه يسعى إلى تضافر الشكل والمضمون للتعبير عن التجربة الأدبيّة وشمول المؤتلف والمختلف ليكونا في أعطاف النصّ، وإنّما ينجم هذا الاختلاف للتعبير عن البناء الفكريّ الداخليّ لرؤية الشخصيات حيث التبئير والصيغ الزمنية وخطاطات السرد لتشييد عالم تخييليّ وإضفاء مزيد من التعمّق نحو التصوّر (السيسو نصيّ) ليظلَّ مؤطّرًا بمقاربات نسقية إلى حيث تتوجّه الحبكة لمضمونها من أجل رصد تحولاتها؛ لما لها من أثرٍ في الرؤية السرديّة فيما تؤكّد الأصوات الساردة إعلاء حضور الذات، على حين يبقى العمل السرديّ يدفع بالقارئ إلى ضرورة تنامي الوعي وهو يبحث عن القيمة الجماليّة والثقافيّة، بل وبإزاء الإعلاء من شأن الفعل السرديّ ليكون المهيمن في إحداث الأثر.
وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ الروائي قد تعمّد تجسيد الانطباعات الفردية للشخصيات وبيان أهوائها؛ فضلًا عن تصوير الأخلاق والأفعال والمشاعر الفرديّة وبيان النظم الاجتماعية والأهداف الفرديّة، بل ثمة دعوة يصفها الروائي ألا وهو التأمل في “الفعل” نفسه؛ فضلًا عن تحوّل القيمة المهيمنة من الأحداث إلى الشخصية، ولعلّ الروائيّ يعمل جاهدًا على تطوير البنية الداخلية للرواية وتحقيق هُويتها، ولم يقف عند هذا الحدّ، بل يعمل على تكريس الهُويّة لشخصياته، ولا يخفى كذلك أنّ للغة دورًا كبيرًا “وهي تستردّ الأزمة الداخلية للشخصية بطريقة يحسّ فيها المتلقي بأنّه أمام أزمته هو؛ فقد أبرزت بؤس حياتنا ببؤس حياة الشخصية، ولا سيّما حين تتناول الكتابة حقيقية من حقائق الحياة، يهجس بها كلّ إنسان؛ لذلك يشعر المتلقي بأن لغة الشخصية باتت لغته الخاصة، تنطق بهمه بصوت الشخصيّة أيضًا”([8]) ، وتَحوّلاتِها مِن مُستَقَرّات مَنهجيَّة إلى أَدَوات مَرِنَة قابِلَة لِلتَّعديل والتَّوظيف نحو نَّسق قِيميّ للمعرفةِ، ولإيضاح الرؤى المخفيّة؛ أمّا فيما يخصّ الشخصيات ذاتها؛ فإن د. نجم عبد الله كاظم يرى أن جلّ الشخصيات التي يختارها فرمان هي من أصول واقعية عرفها الكاتب وربما عاش معها أو عايشها([9])؛ ولذا فقد استعاض عن رؤيته بخمسة أصوات تختلف في اتجاهاتها لكي تكون الرواية متنوعة وثرية مما يمنحها تنوّعًا فكريًّا، كما أنّ غائب يطمح في روايته إلى أن تنسجم وتطلعات القرّاء.
ولعلّ المراحل التي تخطّتها مسارات الرواية إنّما هي مرحلة تشكّل المضمار السرديّ الذي تعاضدت على كشف رؤيته أصوات سرديّة عملت على تلاحم الرواية في إظهار واقع مؤتلف ومختلف، متعدّد الرؤى؛ لذا آل الروائيّ غائب طعمة فرمان إلى أنْ يستيعضَ بأصواتهم للكشف عن المداليل المتنوّعة، فكان الصوت الأول( سعيد ) وهو يعمل محرّرًا أدبيًّا في إحدى الصحف، ومتخصّصًا في نشر شكاوى الناس، فهو إما أن يردّ على تلك الشكاوى، أو أنّه يسعى إلى تقديم الحلول الناجعة لها، إذا ما تطلّب منه ذلك، ويمكن القول عن شخصية (سعيد) بالشخصية الإنسانيّة، كما يمكن تسميتها بالشخصية المثقّفة، وهي شخصية مؤثّرة وفاعلة في المجتمع، وهذا ما يجعلها تفكّر بالآخرين كما تفكر في ذاتها؛ ممّا يضيف همومًا أخرى إلى جانب همومها، ولعلّ هذا ما سيزيد من شقوته ليقول متمنّيًا:
“لو أعرف من أنا؟ مهما تكن النتيجة قاسية لزال جزء كبير من شقائي. فليس كلّ الناس قصاصين أو أصحاب مواهب. ومع ذلك يعيشون حياة مطمئنة. لو أعرف إلى أي صنف من الناس “أبوّب” لوطنت نفسي على ذلك، وعشت مرتاح البال. ولكنني لا أعرف من أنا، لا أعرف…”[10] ، فما يدور في خلجات حياته يضعه أمام خيارات مؤلمة، وبين تقلّب الحال واتّساع الحلول يجعل من الحيرة سبيلًا لأمره، ولعلّ الجانب الأدبيّ الذي انماز يجعل حيرته في ازدياد فكيف له أن يجمع بين رهافة الحسّ وقساوة الواقع، بل يزيد من تفكيره تجاه ذاته وتجاه الآخرين قبل الولوج إلى أعمال أخرى، ولكن على الرغم من هذا التردّد ومحاورة ذاته بمونولوج داخلي يوضح فيه أنّه في حيرةٍ دائمة دفعت به إلى أن ينسى حتى نفسه ، إلّا أنّه لم يتوانَ عن متابعة شؤون الآخرين والنظر فيها، فحينما جاء سعيد إلى عمله في الجريدة، ورأى رسالةً اعتنى بها، وطال فيها استبصاره، كما رأى عليها توقيعًا لـ (نجاة) تطالبه بالحضور لمعاينة ما تعانيه وما حلَّ بها، ولما جاء سعيد “ارتدّ حين رأى امرأةً تحمل طفلاً، واقفة وسط حوش صغير مربع الشكل. ربّما لأنّ عباءتها لا تحجب إلّا ظهرها، وصدرها عارٍ أكثر من المألوف، وربما لأنها تحمل طفلًا، والاسم نجاة كان يوحي له بشيء رومانتيكي له وشيجة بالأفلام السينمائية. إلا أن الرجل قال”تفضل، تفضل”. وكانت هي تبتسم مرحبة، وكأنها تعرفه. كان البيت صغيراً جداً ويبدو مظلماً رغم النهار الصاحي. ما إن دخل حتى غلفته رائحة عفونة قديمة . وصل في خطوتين إلى إيوان صغير عارٍ إلّا من كرسيّ خيزران وضع قرب زاوية لاح في غير موضعه، وكأنما استعير من بيت الجيران ليجلس عليه سعيد. دعاه الرجل إلى الجلوس. كان يبدو ربّ البيت على الأكثر هو زوجها –فكّر سعيد بذلك- وما علاقتي أنا بين زوج وامرأة؟”[11] ، وبمثل هذا الاختبار تضع الشخصية(سعيد) أمام قرار جريء، بل لابدّ أن يختار، وبعد الحوار بينهما وتوقعات (سعيد) لما يطلبانه منه تيقّن أنّ الرجل المتحدّث معها ليس زوجها، وبعد الأسئلة والأجوبة المتكرّرة وصل سعيد إلى الحقيقة: وهي أن الزوجة المذكورة هي زوجة صديقه (حميد)، وكان هذا الخبر مدعاة إلى أنْ يجعل (سعيد) في حيرة، بل إن حيرته ستزداد حينما يُراد منه التدخل في حياة صديقه (حميد)؛ ولذا راح يخاطب نفسه “لعينٌ أنت يا سعيد، كم يعيقك الخجل عن أداء أشياء كبيرة في حياتك. كان بوسعك أن تذهب إليه يوم أمس، وتقول الحقيقة في وجهه، حميد، أنت متزوج ولك ولدان مريضان. لماذا تخجل من زواجك وتخفيه؟ ولماذا تزوّجت إذن؟ كل السقم المرسوم على زوجتك من الإهمال، وربما من قلة التغذية، بينما أنت تغدق على الرايح والجاي، وعلى الخمرة والموبقات. نحن -أنا وإبراهيم وعبد الخالق وشريف- نهرب إلى بلقيس لأنه ليس لنا من ينتظرنا في البيت. وأنت لماذا تهرب؟ من بيتك؟ وتفضل بلقيس القذرة عليه”[12] ، لقد اشترك هذا الهمّ الاجتماعي مع الهم الوطنيّ؛ فضلاً عن الهمّ الثقافيّ فتارة يكاشف (حميد) بحقيقة زواجه ومصير طفلته، لكنه يفشل في إقناعه أو العدول عن رأيه؛ بل في نهاية المطاف سيطلّقها حميد وسيزيد من بؤسها وتموت طفلتها ويموت معهما الأمل، وهذا ما سيشكل عند (سعيد) خيبة أمل تضاف إلى خيبة أمله في الخروج بنتائج إيجابية تجاه الوضع السياسيّ آنذاك، كما أن الهمّ الثقافي يزداد في ذاته حينما يرى نفسه محاطًا بالممنوعات والمحذورات والجميع ينظرون إليه على أنّه مشبوه، وستتعقد أزمته بعد أن يصبح عاطلاً عن العمل وبعدما تُغلق الجريدة، ستزداد أزمته أكثر ولا سيّما بعدما شعر بأنه يقتطع اللقمة من عافية أبيه المريض، وهذا ما لا يحتمله (سعيد) وهو مرهف الحسّ والشعور، ولذا يعتزم السفر.
أما الصوت الثاني (إبراهيم) فهو خرّيج كلية الحقوق ويعمل محرّرًا للجريدة نفسها التي يعمل فيها (سعيد)، وأنّ هنالك مشتركات بينه وبين (سعيد) فهو يعاني الاغتراب والوحدة والعزلة فهو يقول: “أنا لا أعتبر نفسي أعيش مع عائلة. طَوال حياتي أعيش في غرفة خالية إلّا من أنفاسي”[13]، إلا أنه أكثر انفتاحًا وطموحًا لثقته بنفسه، وأنه يسير بخطى واثقة ولا سيما في زواجه من ابنة عمه التي نجح في صنع الاستقرار العائلي، ولذا فإنه يقول لأصحابه ” أنا متزوج الآن، وزوجتي وحدها في انتظاري”[14]، ولم يكن كـــ (حميد) خائبًا في علاقته الزوجية، وممّا تكشف عنه الرواية أنّ الانسجام بين إبراهيم وعائلته دفعت به إلى أن يشعر بشعورها ويعتني بها، وأصبحا يعيشان في حياة مليئة بالسعادة والاحترام؛ ذلك أنّ شخصيته انطوت على وعي ثقافيّ، فيمكن عدّها بالشخصية الإيجابية وهو يؤكّد المنطلقات الفكريّة والديمقراطية التي تحاول قراءة الواقع وتشخيص أبرز مشاكله، ولكن من دون تقديم الحلول لتلك المشاكل.
الصوت الثالث (شريف) هذا الشاعر المتمرّد ويعمل أيضًا في الجريدة مع زملائه، لكنه يعيش في عالم الأحلام فيتأمّل فتاة كان قد وضع لها في ذاكرته عالمًا مليئًا بالمحبة وإن كان من طرف واحد، وأنه سيتخلى عن كلّ شيء من أجل أنْ يناجيها ويحتضنها وأن يلامس جسمه جسدها، فهذه الشخصية تختلف تمامًا عن سعيد الذي كان كثير الانشغال بهموم وأحداث مجتمعه على أن هذا الشاعر لا يفكر إلا في ذاته، ومما زاد من ألم شريف أنه يتخذ مومسًا لا تتفاعل معه بالحبّ والمودة، وإنمّا يفكران كلاهما بنزع اللذة عن جسدين ولعلّ هذا سيكسر توقعاته، وسيزيد هذا الأمر في تعاسته ولا سيما أنّه شاعر مشرّد يقضي ليله هائمًا في الشوارع، لا يفكّر إلا بنفسه متغافلًا عمّا يدور من أحداث ولا يبدي تفاعله معها؛ فهو شاعر مغرور يسيطر شعور الأنا عليه، ليقول مدّعيًا بعد ذلك العبقرية والفلسفة “أنا بودلير العصر.. لا أحد يجاريني في ذلك، ذقت الجوع، وسكنت فنادق الدرجة الرابعة، وبصقتني طرقات التشرّد”[15] ، وهو إنّما قال ذلك كونه يعيش في مجتمع مليء بالتخلف والجهل، ولعل تأثر الكاتب بالأفكار الوجودية قد انعكس بشيءٍ أو بآخر في شخصية (شريف)، وهكذا تظلُّ “اللغة مشحونةً باللامتوقعات”[16] ، فهو يعمل على إبراز الشيء وضدّه للتعبير عن المتناقضات في الواقع، ولم يقف عند هذا الحدّ، بل أراد أن يتمرّد على الأطر الجامدة في المعتقدات الاجتماعية الريفية التي وصفها بالجمود الذي يقتل تطلّعات الفرد كما يقتل حرّيته وإنسانيته فيقول:
“لا. لي حياة واحدة فلماذا أقضيها في قرية؟ قال حميد مبتسماً: تخليت عن أصلك. أجابه شريف متحدّياً: ستتخلّى عن عقلك كلّه إذا ذهبت.ستكون غريباً.قال حميد وكأنه يقنع نفسه: سأكون في بلدي. فالعراق ليس بغداد وحدها. قال شريف: العراق بغداد فقط.”[17].
وبسبب هذا الطموح المتنوّع وما يفرضه الواقع السياسيّ والاجتماعيّ عليه سيحول من دون تحقيق ما يرجو وسيقبع في حياة التمرّد والمجون وملاحقة العاهرات؛ ذلك أنه يجد في ذلك وسيلةً للمواجهة على الواقع الذي يفرض حلوله على المثقفين ويهمّش أدوارهم، وهنا يتراءى لنا أنّ “غائب طعمة فرمان” يتماهى مع علم الاجتماع وكأنّه عالم اجتماع يؤمن بما أورده “علي الوردي”؛ إذ إنّه جعل شخصيّات الرواية عيّنات انتخبها من الواقع المعيش ليجعلها تتحدّث عن نفسها من دون أن يتدخل فيها، فالروائي هنا- غائب فرمان- وقف عمّا وقف عنده “علي الوردي”؛ إذ وقف الوردي عند البنى المحرّكة للثقافة والحضارة بوصفها ظاهرةً اجتماعيةً لا يمكن فصلها عن السلوك المجتمعي. والخاصّ بمجموعة من الأفراد أو الجماعات التي لها تراثها وتأريخها المخالف للثقافات الأخرى، فضلاً عن اتصالها بالمعارف الأخرى ابستيمولوجيا وفق مبدأ ترابط العلوم بعيدًا عن الفكرة الواحدة والحقيقية الواحدة([18]) لكن الوردي يرى وحسب ما مرَّ بنا أنّ العقل العربي تحركه بنًى تشكّلت طَوال تأريخ مديد، هذه البنى ما زالت تمارس فعلها فينا على الرغم من تباعد الزمان وتغير الأحوال([19]) ، أمّا “غائب فرمان” فلم يرجع إلى تأريخ المجتمع، بل عايش هذا المجتمع وعاين شخصياته ليحفَّز ثقافة المتلقيّ التأريخيّة ويصبّها على الشخصيات؛ وعندئذٍ فقد أحدث “غائب طعمة فرمان” تفاعلًا في ذهن المتلقي ونفسه؛ وهذا التفاعل تكون نتيجته مع مراد الروائي والتواصل معه إلى أن يصل بالمتلقي إلى تغيير شيء من المألوف السياسيّ والاجتماعيّ؛ لا أن يكتفي بالوصف والتحليل كما فعل الورديّ.
ويبقى الصوت الرابع هو (عبد الخالق) الذي يعمل في إحدى الدوائر الحكوميّة، وهو من الشخصيات المثقّفة، وتلك الثقافة جعلته ينفر وهذا المجتمع المتخلّف، مما سيولّد التنافر عدم الانسجام ومنها إلى خلق أزمة ومعاناة لديه، كما أن هذه الوظيفة ستقيّده وستحاصر حرّيته، ولذا فإنه كثيرًا ما يشكو غربته، وأنه يعيش حياةً مزيفةً، وما هو إلّا عبارة عن حصان مستأجر عند الحكومة “أيها الحصان المستأجر عند الحكومة حان وقت انطلاقك إلى موقعك”[20]، ثمّ يقول: “أحسّ بأنني أعيش حياة مستعارة مزيفة”[21]، لكنّ ثقته بنفسه دفعت به ألّا يستسلم لليأس، وعلى الرغم من ذلك فإنّ القرارات السياسية المجحفة ستسلبه وظيفته ليبقى يعيش حياةً مزيفةً، لا جديد فيها، ولربما هي دعوة للتحرّر الذاتيّ في قبالة ما يعانيه من أطواق تصفّد حياته.
إن آخر الأصوات في الرواية هو (حميد) وهو الصوت الخامس، ويعمل في أحد المصارف الحكوميّة، وأنّه شخصيّة سلبية، فقد ترك عائلته تعاني الفقر والجوع مدافعًا عن نفسه أنّ أباه قد زوّجه وهو صغير؛ ولذا فإنّ له الحقّ -كما يزعم- أن يتركها، وأنّه يتنصّل من مسؤوليته تجاه عائلته، ولذا حين سأله “سعيد بحدة: لماذا تزوجت إذن. وهل أنا الذي تزوّجت؟ … مَن زوّجك إذن؟ لست أدري. فتحت عيني فوجدت نفسي متزوّجاً”[22]، وبهذا العذر غير المسوّغ سيعيش “حميد” على هامش الحياة؛ ذلك لأنّ الحياة التي يعيشها قد فُرضت عليه وليس له فيها من قرار، فكيف له أن يتحمّل مسؤوليته تُجاه وطنه والناس، ولذا فقد اقتصرت مسؤوليته على معاقرة الخمر لتصبح –فيما بعدُ- شغله الشاغل، وقد أعطى الروائيّ للشخصية الخامسة سمة العجز في اتخاذ القرار، ولعل ما أراده الروائي في روايته هو حال المثقفين في الخمسينيات، وأنّه ليس للمثقفين في ذلك العصر أيُّ صوت يمكن سماعه أو التفاعل معه؛ ولذا فقد ختم الروائيّ غائب طعمة فرمان روايته بأنّ هؤلاء الخمسة لم يحقّقوا أهدافهم؛ بل وصلوا إلى طريقٍ مسدود، لكنّ القارئ وبمزيد من الإمعان والنظر يجد بالقراءة أنّها اسقاطات الواقع وما تفرزه البيئة من أحداثٍ يؤثران في عملية بناء النصّ ومآلاته ؛ إذ “القراءة ممارسة، والتجربة ممارسة، هكذا تبدوانِ لنا عندما نأخذ كلّ واحدة منها على حدة، وكل واحدة منها حين تمارس في علاقتها بالأخرى تقدم إنتاجاً”[23] ، فمجموع المواقف التي وسمت بها الأصوات الخمسة على اختلاف مضامينها وإنْ كانت متباينةً إلّا أنّها أفصحت عن أدوارها في تمثيل واقعٍ متباين، ولعلّ السعي الحثيث للروائي في إقامة هذه الأواصر السرديّة لتأسيس علاقة جدلية بين المتخيل والتاريخ والواقع ، وليس ذلك فحسب ، بل أنّ هنالك علاقة متبادلة قوية بين المتخيل والتأويل ، عليه يجب أن يُنظر إلى التأويل على أنّه ” شيء يُجري على التخييل ، بالأحرى على أنّه شيء يُجري في التخييل ، يصبح، عندئذٍ ، موقف مناهضة التأويل موقفًا يتعذّر الدفاع عنه ، لأنه مساوٍ لرفض شكل مهمّ من أشكال التخييل ( الحديث ) الذي يُعنى بالتأويل : أي إنّه يعني بمدياته وحدوده وضرورته وقصوره “[24]، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ مرحلتي الإرهاص والتأسيس وإن شكّلا أغلب رؤية الرواية ومعالمها الأساسيّة ، كذلك وإن أسهما في الكشف عن ثيم الرواية ومدلولاتها لكنّ مرحلة الإسناد التي أردف فيها الروائي بعض الشخصيات كان لها الأثر المهم في توجّه الرواية وبيان أهميتها.
ب – مرحلة الإسناد:
هي امتداد للمرحلة السابقة نحو صناعة تآزر سرديّ يفصح عن تآلفهما من حيث عدم تحديد منطقة عازلة بينهما؛ لذا فالشخصية من حيث تفكيرُها تكون في ضمن كيان نظريّ ومنهجيّ، أمّا فيما يخصّ الشخصيات الثانوية، فإن الروائيّ قد أراد لها أن تساند شخصياته الرئيسة، وأنّها تتقن الاختفاء تحت مجازية النصوص ؛ لذا يحتاج المتلقّي إلى مرجعيات : ثقافيّة – معرفيّة – تاريخية ، لفهم معنى النصّ الروائي واستيعاب فكرته، فالشخصيات الثانويّة لا تقلُّ أهميةً عنها، فهي تسهم إسهاماً فاعلاً في بناء الشخصيات الأساس وأحداث الرواية ومؤازرتها([25])، ولهذا فقد ذكر شخصية نسويّة هي (حليمة)، لكي لا يهمّش دورها، كما لا يتغافل معاناتها فذكر بؤسها وحرمانها ومقارعتها شتّى أنواع العذابات، هذا البؤس الذي ذكره الروائيّ إنّما تُلقى مسؤوليته على عاتق أهلها، الذين لم يحسنوا اختيار الزوج المناسب؛ وهذا ما ستدفع ضريبته الزوجة نفسها فبعد ما كانت واحدة، بعد زواجها سيتعدّد أطفالها وسيضيفون همًّا لهمومها ولاسيما أنّهم بعد ذلك سيرحلون جميعًا، و سيخبو ذلك الأمل في مجاهيل الظلام وبلا رجوع، وممّا يلفت الانتباه أن أطر الصراع السرديّ قد كشفت مضامينه الشخصية بشتّى أنواعها الرئيسة والثانوية وما يتفرّع عنهما ؛ إذ لمركزيّة وجودها استدلالات ناجحة وموجّهات مؤثّرة ؛ ولعلّ هذا ما ينسجم والرؤية التي تحدّث عنها (فليب هامون) بما أسماها “(بلاغة الشخصية) الموجّهة بإرغامات أيديولوجية ومصافٍ ثقافيّة ليؤكّد مركزية الإنسان في الحكاية التي تحضر في الحكي من خلال جدلية الانفصال والاتصال في علاقة الشخصية في العوامل الأخرى ممّا يشكّل بؤرة التحوّلات السردية”[26]، ولذا فإنَّ نصّ الرواية يكون نصًّا مفتوحًا في تفاعله مع المتلقّي وكذا الحال مع مؤوّله ؛ وهذا ما أشار إليه “فولفغانغ إيزر” في دراساته النقديّة فما ” هو أساسيّ بالنسبة لقراءة كلّ عمل أدبيّ هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه “[27] ، بل لا بدَّ من توجّه استيعاب القارىء إلى فهم يمكن أن يقال عنه ويستلزم ” فهم النصّ فهمًا لمادة الموضوع التي يتحدث عنها النصّ ، في الدوافع الإدراكية الّتي تكمن خلف البحث؛ وذلك لفهم النص وجعله موضوعًا للبحث . ولهذا السبب ينبغي أن يشتمل الفهم النصيّ على عملية فهم ذاتي أيضًا : إذ إنّ ما ينبغي فهمه ليس كلمات النصّ وعلاقاتها فقط ، بل أسباب ممارسة النصّ دعواه في القارىء أيضًا ؛ وذلك لأنّ القارئ هو المخاطب المباشر في ذلك النصّ “[28]، وهذا ما سيجد صداه في واقع المتلقي حين يتفاعل مع المضمون ويستخلص الحقائق الكامنة فيه، ولعلّ الروائي على مقربة كبيرة من روحية هذا التفاعل بل يعدّ ذلك ركنًا أسياسيًّا في عمله لا يمكن تجاوزه أو إغفاله.
ولم يترك الروائيّ (حليمة) وحدها إنّما جعل من يطالب بحقوق المرأة، وهي شخصية (علياء) لتتحاور مع (إبراهيم) زوج أختها( آمنة) وهي شخصية حيوية واثقة بنفسها، لتقول لإبراهيم “بعد أن فرغت من تقليب الجريدة: على أية حال، ليست جريدتكم لكلّ الناس. لأيّ طبقة إذن؟ سألها إبراهيم منتظراً أن تحرج. لنصف المجتمع. قالت بحتمية صارمة، وفتح إبراهيم عينه وفمه. كانت تبدو رصينة وكأنها تؤدي امتحاناً في الاجتماعيّات. إذا كنت تقصدين عددًا من المتعلمين فهي والجرائد الأخرى لأقلّ من عشر المجتمع. لا، أقصد المرأة. المرأة نصف المجتمع فأين ركن المرأة فيها؟”[29]، كذلك فقد ذكر (صبرية) التي تعمل في المبغى، وذكر (ستار، وأمّ سعيد، وسلمى، وبلقيس، د. رؤوف، …) . لأنّه لابدّ للمتلقي أن يقرأ ما بين السطور وأن يقف على غايات النصّ وأسبابه ؛ إذ من ” الظّنّ بأنّ كلّ سطر في النصّ يخفي معنى سرّيًّا آخر ، كلمات ، بدلًا من التصريح ، تخفي ما لم يُقَلْ ، ومجد القارئ يكون باكتشاف أنّه يمكن للنصوص أن تقول كلّ شيء عدا ما يريد مؤلّفوها أن تعنيه . وما إنْ أن يدّعي اكتشاف المعنى المزعوم ، تكون على يقين من أنّه ليس المعنى الحقيقيّ ، إذ يكون ذلك الأخير هو الأبعد “[30]. وفي هذا يدرك المتلقي أنّ المعنى لا نهائي ، ويتبدّل بتبدل القرّاء، لذا فإنّ في رواية “غائب طعمة فرمان” يشكّل الهاجس السياسيّ جوهر الفعل الروائيّ، فــأبطاله خاضعون لضغوط المؤسسة السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة، فتراهم يحاولون التمرّد تارةً، والهرب تارةً أخرى، وقد يسقطون في حالة انكسار داخل مقموع، لكنهم من جهة أخرى يمارسون أفعالهم اليومية متآلفين إلى حد كبير مع حركة الواقع الخارجي ذاته([31])؛ لهذا يسعى المسار السرديّ إلى مسارٍ يجمع بين الشيء وضدّه من أجل قصد تأجيج الصراع ؛ كي يبوح الواقع بمضمراته نحو أفق تعبيريّ جديد؛ فضلًا عن التماهي بين الذات الساردة والآخر، لتبقى تلك الأسئلة “النقديّة” التي أرادها الروائي أنْ تكون حاضرةً في نصّه، بل وعمل على تعميقها لتحوّل الكثير من تلك المفاهيم والتصوّرات التي تعجّ بها الساحة الثقافيّة العربيّة من تناقضات إلى آراء بعدما كانت تمضي على أنّها قناعات لا يمكن مناقشتها، بل لإبراز الدليل الواعي للكشف في الجانب الآخر القمع الأبويّ الذي يمارس سلطته، فيكبح هذه الطموحات بمزيد من الرفض، وتظلّ الرؤى الساردة تمور في التيه، وليس ثمة انفراج لتحقيق هذا المشروع للوصول إلى المعاني والدلالات الخبيئة والمتعدّدة في النصوص المقروءة في ضوء معاييرها ومقترحاتها.
كما أنّ شخصيات “غائب فرمان” هي شخصيات متواضعة وتحمل الكثير من الخصائص المتناقضة الإيجابية والسلبية: الخير والشرّ، الشجاعة والجبن، التسامي والانحطاط؛ إنّها بكلمة واحدة شخصيات واقعية منتقاة بعناية خاصة من الواقع الاجتماعيّ ذاته لكنّها مقدمة بمنظور وظيفيّ خاصّ تكافئ عالم التجربة الواقعية والتاريخية بمعنى أنّ عالم الرواية يساوي عالم التجربة([32]) .
إن ثمة آراء عدّة تقف وراء تعدّد الشخصيات في العمل الروائيّ لغائب طعمة فرمان؛ منها: أن تعدّدها يكفل للروائيّ تقديم صورة أوسع عن المجتمع العراقيّ آنذاك وعن حياته الفكريّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة و…، كما أنّ تعدّدها إنّما يعمل على إغناء الرواية بالاختلافات، وتوزّع الأدوار بينهم للحد من مركزية البطل الذي تستند إليه الروايات التقليدية؛ وهي إنّما دعوة لتعدّد الأصوات المناهضة للسلطة القامعة؛ فضلًا عن أنّ هذا التعدّد يضمن للقرّاء التنوّع والاطّلاع على اختلاف مشاربهم.
لقد انطوت رواية (خمسة أصوات) على شخصيّات سرديّة متنوّعة وفاعلة في الأحداث، من أجل إبراز صراع بين رؤى مختلفة، تضمن لتعدّد القرّاء تطلعاتهم في التعبير عن مطامحهم ؛ ولذا فهي لم تكن بوحًا فرديا أو انثيالات فردية إنّما هي معاناة جماعية تعاني من الاضطهاد والقمع، كذلك أنّ رفض الأصوات بمجموعها للواقع السياسيّ والثقافيّ والاجتماعيّ، إنّما يدلّ على توحّد الشعب في رفضه لسياسة السلطة (المهيمنة) على ذلك الواقع بمجموعه، وبالمقارنة بين الرؤى السرديّة المتخيّلة المعلنة والرؤى السرديّة المخبّئة ، نعثر على ما أراد الروائي أنْ ينوّه عنه ألا وهو الزمن الحاضر ببناء نصّ سرديّ له القدرة على صناعة واقع سرديّ داخلي ؛ أي : بمعنى الانحياز لهذا الإبداع وليس إعادة إنتاجه ، وفي اللحظة ذاتها يعمل على تأسيس نص سرديّ وبنائه يهيمن على واقع النصّ الخارجيّ والداخليّ.
واشتركت تلك الأصوات في كشف المسكوت عنه بوسائل الإعلام، وأنها على وعي للأفعال الاضطهادية، على الرغم من أنّ هذه الشخصيات لم تكن على مستوًى واحد من الصمود، وأن سبل المواجهة متنوعة وهي أصوات تمارس أدوارها من دون أن تصمت.
نتائج البحث:
وبهذا التجسيد والإيضاح أنّما أراد الروائي “فرمان” أن يكون للشخصيات الأثر الفاعل وأن تتميّز روايته بأنّها رواية يستميل بعناصرها السرديّة لتكون رواية “شخصية” وهي بدورها تكشف الأحداث والزمكان؛ ولذا استطاعت رواية ” خمسة أصوات” أن تجعل الشخصيات فاعلةً، ولعلّ ما يميّز الشخصيات أنّها مترابطة بعلاقة الطموح والمغامرة، وهي شخصيات تبطن غير ما تظهر، وأنها موزعة بين طموحاتها كما أنها تتوزع بين الواقع والحلم بين الخوف والتحدي، كذلك أن التشديد على الصوت في العمل الروائيّ، إنما يؤكّد حضور المؤلف داخل عمله الروائيّ، وقد كشف البحث عن النتائج الآتية:
– بهذا التحوّل عوّل الروائي على الشخصية في تغيير المسارات السردية المصحوبة بتنامي وعي الشخصية بذاتها وبالآخر، وما اختيار الروائيّ الأصوات إلّا ليتجاوز النمطية في الكشف السرديّ وبيان حالات الانشطار والتشظيّ؛ ولعلّ ما تبوح به الشخصيات من تناقضات إنّما لكشف الأقنعة بسبر الأغوار لمعرفة أكثر تكشف عن عوالمه التخييلية ، وهكذا تنسج الرواية بخيوط التحوّلات، وممّا عمّق انفصال الذات عن كينونتها أنّها تخرج عن واقعها إلى محض ذكريات تعيش عليها بحيث تستأنف سرد تحوّلات حياتها الموجهة بالعلاقة مع الآخر فتنتقل من دائرة الاستسلام إلى دائرة الفعل لقياس التحولات والتقلبات باسترجاعات كشفها عالم السرد حيث التحوّل من الضعف إلى القوة ومن الغياب إلى الحضور، وإعلان التمرّد على دائرة التهميش والإقصاء وعن كلّ ما يحاصرها لتأسيس سياق دلاليّ يهيّئ للتلقي لمعالجة الانهيارات والإحباط النفسيّ، ولعلّ الرواية تبني فكرة الاختلاف وسيلة .
-لقد اتّخذ الروائي لغةً بوصفها طاقةً إيحائيةً رمزيةً وحيث يمتح السرد تفاصيله نحو لحظة انعتاق تتجه نحو الحدود والأسوار لمناقشة المخفي والمسكوت عنه وفرض الذات بمختلف أشكال المقاومة بوصفها قيمًا ثقافيةً تتجلّى فيها الأفكار وتكريس أثر النصّ على المتلقي باستحضاره لصناعة عمل سردي تتداخل فيه الشخصيات على نحوٍ جديد.
-إنّها شخصيات تمثّل ايدلوجيات متعدّدة وأذواق و حضارات مختلفة؛ وهي التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها عمليات السرد الروائيّ لها دلالتها وإحالاتها المجازية مع مرجعيتها الواقعية.
الهوامش:
1-ينظر: شعرية الخطاب السردي، محمد عزام، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2005م، ص12-13.
2- ينظر: في مفهوم الشخصية الروائية، د. إبراهيم جنداري ، جريدة الأديب ع28، 2004م،ص6.
3- ينظر: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، د. عبد الملك مرتاض، عالم المعرفة، الكويت، 1998م، ص73.
4-جدل الشخصية الروائية وسلطة الواقع، دراسة في عالم غائب طعمة فرمان الروائي، فاضل ثامر، جريدة الأديب ع 13، 2004، ص6.
5- اتجاهات النقد الروائي في سورية، عبد الله أبو هيف، دمشق، 2006م، ص264.
6- ينظر: جماليات الشخصية في الرواية العراقية، د. نجم عبد الله كاظم، مجلة الأقلام،ع4، 2009م، ص120.
7- خمسة أصوات، رواية، غائب طعمة فرمان، دار المدى للثقافة والنشر، بغداد، ٢٠٠٨م، ص137.
8- المصدر نفسه ، ص 39.
9- -خمسة أصوات، رواية،ص 54-55.
10 -المصدر نفسه، ص88.
11 -المصدر نفسه، ص 234.
12 -خمسة أصوات، رواية،ص 14-15.
13 – القراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد في المغرب, د. سعيد يقطين, ص126.
14 -خمسة أصوات، رواية، ص 19.
15 ينظر: علي الوردي, قراءة في أرائه المنهجية، نخبة من الباحثين، الحضارية للطباعة والنشر، العراق بغداد، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت لبنان، ط1، 2008م, ص63.
16 ينظر: أسطورة الأدب الرفيع، د.علي الوردي، ط2، دار كوفان للنشر، بيروت-لبنان، 1994م, ص105, ينظر: العقل في المجتمع العربي بين الأسطورة والتاريخ، شاكر شاهين، دار التنوير للطباعة والنشر، 2010م. ص30.
17 خمسة أصوات، رواية، ص62.
18 خمسة أصوات، رواية، ص68.
19 خمسة أصوات، رواية، ص133-134.
20 القراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد في المغرب، د. سعيد يقطين، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2014م، ص28.
21 – تحرير: سوزان روبين سليمان و إنجي كروسمان – القارىء في النص : مقالات في الجمهور و التأويل ، ترجمة : د. حسن ناظم و علي حاكم صالح ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت / لبنان ، 2007م ، ص 198-199.
22 ينظر غائب طعمة فرمان روائيا، د. فاطمة عيسى جاسم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2004م، ص88.
23 -ينظر: السرد النسوي العربي من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصية، د. عبد الرحيم وهابي، دار الكنوز للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٦م، ص ٢١.
24 – تحرير: سوزان روبين سليمان و إنجي كروسمان – القارىء في النص : مقالات في الجمهور و التأويل ، ترجمة : د. حسن ناظم و علي حاكم صالح ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت / لبنان ، 2007م ، ص 129.
25 – ديفيد كوزنز هوي – الحلقة النقدية : الأدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية ، ترجمة : خالدة حامد ، منشورات الجمل ، كولونيا / المانيا ، بغداد / العراق ، 2007م ، ص 212 .
26 خمسة أصوات، رواية، ص90-91.
27 – وليم راي – المعنى الأدبي :من الظاهراتية الى التفكيكية ، ترجمة : د يوسف يوئيل عزيز ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد / العراق ، 1987م ، ص 175.
28 ينظر: المقموع والمسكوت عنه في الرواية العربية، فاضل ثامر، جريدة الأديب ع 9، 2004م، ص6.
29 جدل الشخصية الروائية وسلطة الواقع، دراسة في عالم غائب طعمة فرمان الروائي، فاضل ثامر، جريدة الأديب ع 14، 2004، ص6.
قائمة المصادر والمراجع:
– اتجاهات النقد الروائي في سورية، عبد الله أبو هيف، دمشق، 2006م.
– أسطورة الأدب الرفيع، د.علي الوردي، ط2، دار كوفان للنشر، بيروت-لبنان، 1994م.
– العقل في المجتمع العربي بين الأسطورة والتاريخ، شاكر شاهين، دار التنوير للطباعة والنشر، 2010م.
– القراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد في المغرب، د. سعيد يقطين، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2014م.
– القارىء في النص : مقالات في الجمهور و التأويل ، تحرير: سوزان روبين سليمان و إنجي كروسمان ،ترجمة : د. حسن ناظم و علي حاكم صالح ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت / لبنان ، 2007م .
– غائب طعمة فرمان روائيا، د. فاطمة عيسى جاسم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2004م.
– السرد النسوي العربي من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصية، د. عبد الرحيم وهابي، دار الكنوز للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٦م.
– الحلقة النقدية : الأدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية ، ديفيد كوزنز هوي، ترجمة : خالدة حامد ، منشورات الجمل ، كولونيا / المانيا ، بغداد / العراق ، 2007م .
– جدل الشخصية الروائية وسلطة الواقع، دراسة في عالم غائب طعمة فرمان الروائي، فاضل ثامر، جريدة الأديب ع 14، 2004م.
– جماليات الشخصية في الرواية العراقية، د. نجم عبد الله كاظم، مجلة الأقلام،ع4، 2009م.
– خمسة أصوات، رواية، غائب طعمة فرمان، دار المدى للثقافة والنشر، بغداد، ٢٠٠٨م.
– شعرية الخطاب السردي، محمد عزام، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2005م.
-علي الوردي, قراءة في أرائه المنهجية، نخبة من الباحثين، الحضارية للطباعة والنشر، العراق بغداد، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت لبنان، ط1، 2008م.
-في مفهوم الشخصية الروائية، د. إبراهيم جنداري ، جريدة الأديب ع28، 2004م.
– في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، د. عبد الملك مرتاض، عالم المعرفة، الكويت، 1998م.
– المعنى الأدبي :من الظاهراتية الى التفكيكية ، وليم راي – ترجمة : د يوسف يوئيل عزيز ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد / العراق ، 1987م.
– المقموع والمسكوت عنه في الرواية العربية، فاضل ثامر، جريدة الأديب ع 9، 2004م.
[1] -(خمسة أصوات) رواية صدرت عام (1967) للروائيّ العراقيّ “غائب طعمة فرمان” هي أول رواية متعدّدة الأصوات؛ إذ إنَّ دلالة الصوت إنّما يعبّر عن مستويات متعدّدة من البناء الدرامي والبناء الفنيّ، ولعلّ الروائي قد وظّف تقنية الصوت لكشف التقاطعات والآراء المختلفة لبيان ما يضجُّ به الواقع العراقيّ آنذاك؛ لذلك عكست تجربة الإنسان العراقي في مواجهة الظروف بشتى أنواعها وهي تجمع بين الواقع والخيال.
[2] -الشخصية الروائيّة هي أحد أركان العناصر السرديّة و الحبكة الروائيّة؛ إذ لا تبنى حكاية من دونها ؛ إذ تُعدّ مفتاحًا مهمًّا لفهم الأحداث وتطور الحبكة، بل تُعدّ الطاقة الدافعة التي تدور حولها كلّ عناصر السرد، وهي على أنواع ولها سماتها ووظائفها ودلالاتها في العمل الروائي.
[3] ينظر: شعرية الخطاب السردي، محمد عزام، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2005م، ص12-13.
[4] ينظر: في مفهوم الشخصية الروائية، د. إبراهيم جنداري ، جريدة الأديب ع28، 2004م،ص6.
[5] ينظر: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، د. عبد الملك مرتاض، عالم المعرفة، الكويت، 1998م، ص73.
[6] البوليفونية (بالإنجليزية polyphony) في الموسيقى، يقصد بها أي موسيقى حيث يصدر نغمتان أو أكثر في نفس الوقت (المصطلح مشتق من اللغة اليونانية “الذي يعني أصوات كثيرة”، والبوليفونية عكس المنوفونية (أي الصوت الواحد مثلما في الترتيل) سمة بارزة تميّز بين الموسيقى الغربية وموسيقى كلّ الحضارات الأخرى .
[7] جدل الشخصية الروائية وسلطة الواقع، دراسة في عالم غائب طعمة فرمان الروائي، فاضل ثامر، جريدة الأديب ع 13، 2004، ص6.
[8] اتجاهات النقد الروائي في سورية، عبد الله أبو هيف، دمشق، 2006م، ص264.
[9] ينظر: جماليات الشخصية في الرواية العراقية، د. نجم عبد الله كاظم، مجلة الأقلام،ع4، 2009م، ص120.
[10] خمسة أصوات، رواية، غائب طعمة فرمان، دار المدى للثقافة والنشر، بغداد، ٢٠٠٨م، ص137.
[11] خمسة أصوات، رواية ، ص 39.
[12] -خمسة أصوات، رواية،ص 54-55.
[13] – خمسة أصوات، رواية ، ص88.
[14] -المصدر نفسه، ص 234.
[15] -خمسة أصوات، رواية،ص 14-15.
[16] – القراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد في المغرب, د. سعيد يقطين, ص126.
[17] -خمسة أصوات، رواية، ص 19.
[18] ينظر: علي الوردي، قراءة في أرائه المنهجية، نخبة من الباحثين، الحضارية للطباعة والنشر، العراق بغداد، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت لبنان، ط1، 2008م, ص63.
[19] ينظر: ينظر: أسطورة الأدب الرفيع، د.علي الوردي، ط2، دار كوفان للنشر، بيروت-لبنان، 1994م, ص105, ينظر: العقل في المجتمع العربي بين الأسطورة والتاريخ، شاكر شاهين، دار التنوير للطباعة والنشر، 2010م. ص30.
[20] خمسة أصوات، رواية، ص62.
[21] خمسة أصوات، رواية، ص68.
[22] خمسة أصوات، رواية، ص133-134.
[23] – القراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد في المغرب، د. سعيد يقطين، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2014م، ص28.
[24] – تحرير: سوزان روبين سليمان و إنجي كروسمان – القارىء في النص : مقالات في الجمهور و التأويل ، ترجمة : د. حسن ناظم و علي حاكم صالح ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت / لبنان ، 2007م ، ص 198-199.
[25] ينظر غائب طعمة فرمان روائيا، د. فاطمة عيسى جاسم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2004م، ص88.
[26] -ينظر: السرد النسوي العربي من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصية، د. عبد الرحيم وهابي، دار الكنوز للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٦م، ص ٢١.
[27] – تحرير: سوزان روبين سليمان و إنجي كروسمان – القارىء في النص : مقالات في الجمهور و التأويل ، ترجمة : د. حسن ناظم و علي حاكم صالح ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت / لبنان ، 2007م ، ص 129.
[28] – ديفيد كوزنز هوي – الحلقة النقدية : الأدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية ، ترجمة : خالدة حامد ، منشورات الجمل ، كولونيا / المانيا ، بغداد / العراق ، 2007م ، ص 212 .
[29] خمسة أصوات، رواية، ص90-91.
[30] – وليم راي – المعنى الأدبي :من الظاهراتية الى التفكيكية ، ترجمة : د يوسف يوئيل عزيز ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد / العراق ، 1987م ، ص 175.
[31] ينظر: المقموع والمسكوت عنه في الرواية العربية، فاضل ثامر، جريدة الأديب ع 9، 2004م، ص6.
[32] جدل الشخصية الروائية وسلطة الواقع، دراسة في عالم غائب طعمة فرمان الروائي، فاضل ثامر، جريدة الأديب ع 14، 2004، ص6.