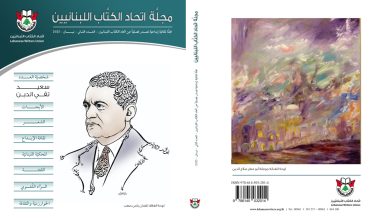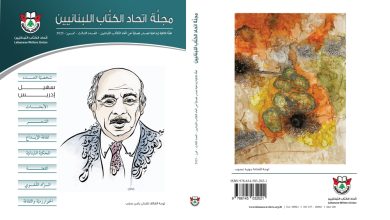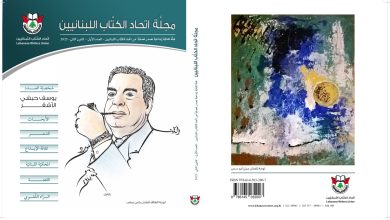مي زياده والقضايا الوطنية: سياسة الكيل بمكيالين

مي زياده والقضايا الوطنية
سياسة الكيل بمكيالين
أ. أحمد أصفهاني
صدر كتابي “مي زياده… صحافية” عن “دار الساقي” في بيروت خلال نيسان سنة 2009. وكان متوقعاً له أن يلقى اهتماماً إعلامياً لسببين أساسيين:
الأول، أنه يكشف وللمرّة الأولى جانباً مجهولاً من نشاط مي الصحافي والأدبي في أواخر عشرينيات القرن الماضي، عندما تولت الإشراف الكامل على القسم النسوي الاجتماعي في مجلة “السياسة الأسبوعية” الصادرة في القاهرة. وكانت تلك الفترة الوحيدة التي تتولى فيها مسؤولية تحريرية.
الثاني، أن العاملين في الصحف والمطبوعات العربية في لندن، حيث أقيم، غالباً ما يعطون رعاية خاصة لنتاجات زملائهم، كنوع من الدعم والتضامن مع أبناء المهنة الواحدة. وهكذا استفاد الكتاب من صداقة الزمالة الإعلامية.
لكن أبرز تعليق على الكتاب لم يُنشر في جريدة أو مجلة، وإنما وصل إليّ عبر البريد الإلكتروني من المستعربة الألمانية أنتيا زيغلر Antje Ziegler، التي كانت تُعد إطروحة الدكتوراه في جامعة بون. وبعد أن أعربت عن سرورها بالكتاب، خصوصاً الفصل السابع الذي يتحدث عن المرحلة المصرية في حياة مي، أخبرتني أنها أصدرت قبل أشهر كتاباً ضخماً بعنوان “مي زياده ـ كتابات منسية” (دار نوفل، بيروت 2009). وأضافت تقول إن أطروحتها للدكتوراه تعالج في بعض فصولها تلك المرحلة بالذات. وختمت رسالتها المؤرخة في 26 تشرين الثاني 2009 بالقول: “أريدك أن تعرف كم أنا مقدرة لعملك المميز. إنه مساهمة شديدة الأهمية للدراسات. وأنا ممتنة للغاية أنه ظهر في هذا الوقت بحيث يمكنني العودة إليه كمصدر في أطروحتي”(1).
طلبتُ كتاب زيغلر من بيروت، فوصلني خلال أيام. عكفت على قراءته فوراً (958 صفحة) لأجد أنه عمل موسوعي فعلاً، لا شك في أن المؤلفة بذلت فيه جهداً كبيراً إذ جمعت مئات المقالات المجهولة لمي، وحققتها بأسلوب أكاديمي دقيق. لكن أهم ما في الكتاب مقدمته الشاملة التي أحاطت بحياة مي ونشاطاتها الأدبية والاجتماعية. وقد نشرتُ في جريدة “الحياة” عرضاً ضافياً لكتاب زيغلر، أبديت فيه ملاحظات نقدية حول المقدمة على وجه التحديد. وما أن وصل مقالي إلى المؤلفة حتى بادرتني برسالة ثانية بتاريخ 16 شباط 2010 أعربت فيها عن ارتياحها الكامل لملاحظاتي، قائلة: “أشعر أنني اصبحت مفهومة بطريقة لم أكن أتوقعها”. ودارت بيننا بعد ذلك حوارات شملت جوانب من الأطروحة الجامعية التي تعمل عليها.
من خلال تبادل الأفكار، برز بيننا نوع من التباين في تحديد طبيعة علاقة مي بالشؤون السياسية على مستويات عدة. كانت زيغلر تعتبر أن كتابات مي في “المرحلة المصرية” يمكن أن يُنظر إليها بوصفها ذات أبعاد سياسية. في حين أنني كنتُ أطرح تساؤلات مشروعة حول خلفيات تجنب مي الخوض في المسائل السياسية المرتبطة بأوضاع بلاد الشام ومصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد وصلنا إلى نتيجة، على الأقل من جهتي أنا، مفادها أن التباين ناشئ عن تمايز في فهم كل واحد منا لمعنى السياسة وكيفية ممارستها أو التعبير عنها. المستعربة الألمانية تعتقد بأن نشاطات مي الاجتماعية وأفكارها الإصلاحية تدخل في باب السياسة. في حين أن الموقف من القضايا الوطنية والقومية، بالنسبة لي، هو مقياس الحكم على العمل السياسي.
وبغض النظر عن رأي كل واحد منا في مفهوم العمل السياسي والنشاطات المرتبطة به، فإن سلبية مي تجاه السياسة بالمطلق كانت معروفة على نطاق واسع لدى غالبية معارفها من الصحافيين والأدباء. وحدث خلال انهماكي في إنجاز كتاب “مي زياده… صحافية”، الذي تطلب مني قراءة كل ما توافر لي من الكتابات المنشورة لمي والدراسات التي تناولت حياتها وأدبها، أنني توقفت ملياً أمام ظاهرتين مترابطتين:
الأولى، عبارات قالها معارفها وأصدقاؤها وأكدوا فيها أن مي كانت تبتعد كلياً عن الخوض في المواضيع السياسية. ويؤكد أنطون الجميّل، صديق مي والمواظب على حضور ندواتها: “لم تشغل السياسة مياً قط عن الأدب، وكانت تتحاشى الخوض في غمارها أو الدخول في معتركها. ومع ذلك كانت تقرأ معظم الصحف السياسية وتتتبع أخبار السياسة وتساير تطوراتها. فإذا جرّ الحديث في ناديها إلى السياسة وانساق الزائرون في تيارها، وانتقل الكلام من دولة الآداب إلى دولة الأحزاب، رأيت مياً وقد تحولت إلى الإصغاء، واتجهت إلى الإنصات، وأعرضت عن الكلام جانباً. فإذا ما تناولت الأحداث السياسية في كتاباتها، تناولتها من حيث أثرها في الحركة الفكرية والنهضة القومية لأنها كانت كثيرة الاعتزاز بشرقيتها”(2).
والثانية، أن نتاجها الأدبي يخلو تماماً من أي موقف وطني أو قومي تجاه ما كانت تتعرض له بلادنا في ظل الانتداب الفرنسي والإنكليزي. ولعل غياب مأساة فلسطين في الربع الأول من القرن العشرين عن كتاباتها، يعتبر أكثر الأمور استغراباً. وذلك لأن فلسطين مسقط رأسها وملعب صباها، ولأن ما حل بالشعب الفلسطيني من جراء المخطط الصهيوني ـ الإنكليزي كان من المتوقع أن يثير عند مي فيض المشاعر الإنسانية التي غالباً ما حرّكتها عندما تناولت أحداثاً “غربية” أقل إيلاماً!
ولم تكن مي حريصة فقط على أن تنأى بنفسها عن السياسة، بل نراها تتشدد في هذه الناحية حتى مع ضيوف مدعوين للمشاركة في مناسبات ثقافية وأدبية متنوعة. في مطلع 1926 انهمكت بترتيب الاحتفال الخاص بالعيد الخمسين لمجلة “المقتطف” التي يرأس تحريرها يعقوب صرّوف صديق عائلة زياده. وأقيم الاحتفال في صيف ذلك العام بحضور حشد من الصحافيين والأدباء والشعراء المصريين والسوريين. وكان النجاح حليف مي التي عملت بكل قوتها على تجنب المواقف السياسية، حتى أن شكيب أرسلان رد على دعوتها له للمشاركة برسالة قال فيها: “وكانت السيدة القديرة والكاتبة النحريرة في غنى عن تنبيهي إلى أن الموضوع يجب أن يُنزه عن السياسة”(3).
وفي حال طرأت ظروف تفرض على مي التطرق للمواضيع السياسية، فسرعان ما تلجأ إلى التخلص من “ورطتها” بإعلان براءتها: “إن معارفي السياسية قليلة جداً، واعترف بأنني متطفلة إذا ما تهجمت على تواريخ الشعوب ومصيرها”(4). غير أنها تقول في الرسالة نفسها الموجهة إلى صديقها أمين الريحاني: “… بل يروقني حديث السياسة وكل حديث تأتيني به. فلا تبخل بأخبارك ومقالاتك حتى السياسية منها”(5). وتكشف هذه المقاطع جوانب من حالة الضياع التي لازمت مي طيلة حياتها في ما يتعلق بهويتها وانتمائها.
من الواضح أن مي مثقفة من طراز رفيع، وتتابع بدقة أخبار السياسة العالمية والنزعات الفكرية والثقافية الجديدة في العالم. ولم تتردد في توجيه انتقادات حادة إلى ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى، وإلى روسيا بعد انتصار الثورة الشيوعية فيها. فلماذا الصمت، إذن، عن المآسي الأقرب إليها جغرافياً ووطنياً؟ وما هي خلفية عدم التصدي للممارسات الاستعمارية الفرنسية والإنكليزية في عالمنا العربي… وخصوصاً في منطقة الهلال الخصيب؟
هذه الدراسة تحاول تقديم الأجوبة اعتماداً على نتاج مي من جهة، وعلى ظروف عائلتها “الشامية المسيحية” المقيمة في القاهرة (المُحافِظَة) من جهة أخرى… وأخيراً على طبيعة العلاقات التي ربطت مصيرها بمصير شخصيات مصرية وشامية ذات انتماءات مختلفة، لعل أبرزها عضوية الحركة الماسونية الفاعلة بقوة في كل مناحي الحياة المصرية خلال تلك المرحلة.
إشكالية الهوية والانتماء
أبدأ أولاً بطرح هذا السؤال: ما هي الصورة التي تتبادر إلى أذهاننا على الفور عندما نأتي على ذكر الأديبة مي زياده؟
أربع صور أساسية تطغى على ما عداها(6)، نسردها حسب ترتيبها الزمني:
أولاً – ندوة الثلاثاء التي تنعقد في منزل آل زياده إبتداء من العام 1913 وحتى العام 1935، وإن كانت تقطعت إجتماعاتها وانفرط عقد أبرز حضورها في السنوات التي أعقبت وفاة والد مي (1929) ووالدتها (1932). وكانت تستضيف كبار الأدباء المصريين، وكذلك الأدباء السوريين المقيمين في مصر أو الذين يزورونها بين حين وآخر(7).
ثانياً – العلاقة الأدبية والعاطفية التي ربطتها بجبران خليل جبران المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك منذ أول رسالة كتبتها له في 29 آذار 1912 وحتى آخر رسالة في العام 1931 سنة وفاته. وهي علاقة معقدة وغريبة نظراً إلى أنهما لم يلتقيا أبداً، مع أن الظروف كانت تتيح لهما ذلك لو أنهما بالفعل أرادا اللقاء في أوروبا التي زارها كل منهما على حدا.
ثالثاً – ما تردد عن توله عدد من كبار الأدباء والصحافيين السوريين والمصريين بمي، سواء بادلتهم هي المشاعر نفسها أو حافظت على مسافة من المودة والاحترام بينها وبينهم. والحقيقة أن مي كانت تستمتع بتوله الرجال بها وعشقهم لها وتدبيج القصائد والمقالات فيها، وهي تعترف في رسالة بعثتها إلى صديقها عباس محمود العقاد من برلين في 30 آب 1925 بهذه “المتعة” إذ تقول: “… ولكن طبيعة الأنثى يلذ لها ان يتغاير فيها الرجال وتشعر بالازدهاء حين تراهم يتنافسون عليها”.
رابعاً – الانهيار النفسي والجسدي الذي حل بها ابتداء من منتصف الثلاثينيات بعد وفاة والديها وجبران في غضون سنوات قليلة. وأدى ذلك إلى مأساة إحتجازها في مستشفى الأمراض العقلية (العصفورية) في إحدى ضواحي بيروت، بمسعى من أقربائها آل زياده. ومع أن تحرك عدد من المفكرين والأدباء، من بينهم أنطون سعاده زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي، نجح في إطلاق سراحها بعد مواجهات قانونية معقدة، وتمكنت من الرجوع إلى القاهرة لاستكمال معركتها باستعادة حريتها الكاملة وسيادتها غير المنقوصة على أموالها وممتلكاتها، إلا أن تلك التجربة المريرة خلّفت جروحاً عميقة في نفسها وفي جسدها بحيث لم تستطع العودة إلى سابق تألقها ونشاطها، فتوفيت في 19 تشرين الأول 1941 وحيدة منسية في أحد مستشفيات القاهرة.
ونلاحظ من هذه النقاط الأربع أن عطاءها الأدبي وكتاباتها وخطبها وترجماتها لا تحتل موقعاً متقدماً في نظر غالبية القراء، بل وحتى عند النقاد… أللهّم إلا في سياق التأريخ للأدب، والنسائي منه على وجه التخصيص، خلال مطلع القرن الماضي. والأهم من ذلك، غياب أي رصد وتحليل لمواقف مي من الأحداث السياسية والقومية في مرحلة هي الأدق والأعقد على صعيد تاريخنا المعاصر.
وعند هوامش الصور الأربع التي ذكرناها أعلاه، يمكننا أن نتلمس ظلالاً أخرى قد لا تكون وحدها كافية للمساهمة في تحديد هوية مي الأدبية وشخصيتها الفكرية. وهذه الظلال تترافق دائماً مع الصور الرئيسية فلا تنفصل عنها مطلقاً، إذ من دونها لا يمكن إحلال مي المكانة التي تتبوأها في كتب الأدب، خصوصاً تلك التي تغطي النصف الأول من القرن العشرين. وقد وجد النقاد صعوبة في فصل “الظل” عن “الصورة” عندما حاولوا تناول إنجازات مي في الأدب: “… فأعلم أن مي هي آنسة شرقية سورية المنبت تعيش في مصر ذكية الفؤاد مهذبة الفكر مطلعة على آداب الغرب لطيفة الشعور عليمة بسنة الحياة. ثم احفظ هذا التعريف وافتح أي كتاب من كتبها على أي صفحة من صفحاته عند أي سطر من سطوره لا تجد إلا ما يطابق تعريفك ويوافق القول المنتظر ممن يكون على هذه الصفة (…) بهذه الروح الرؤوم جعلت مي مباحثها كلها سمراً مؤنساً وصيّرت الدنيا كلها غرفة استقبال لا يصادف فيها الحس ما يصدمه ويزعجه، أو هي صوّرتها متحفاً جميلاً منضوداً لا تخلو زاوية من زواياه من لباقة الفن وجودة الصنعة”(8).
والحقيقة أن الكتابة عن مي زياده، حتى ولو كانت تهدف إلى دراسة نتاجها الأدبي والأسلوب الجديد الذي اعتمدته، إلا أنها سرعان ما تحيد بنا إلى واحدة من الصور المذكورة أعلاه. ولا شك في أن ما كتب عن حياتها الخاصة وعلاقاتها الشخصية ورسائلها الكاشفة، إضافة إلى ما كان يدور في ناديها الأسبوعي، يفوق بكثير كل ما قيل في نتاجها الأدبي وأساليبها البيانية. فنحن “نعرف جيداً أن في حياة مي زياده الكثير من القصص المبهمة يقف وراءها، في أغلب الأحيان، تعطش ذكوري لا يعلن عن نفسه بسهولة. لهذا كانت قصصها الحياتية، الصحيحة والمختلقة، على كثير من الألسن”(9). وفي مثل هذه الحالة، خصوصاً في مجتمع متزمت، تنتشر الإشاعات وتزداد المبالغة في السرديات.
لكن هذا البحث يسعى إلى تبيان الأسباب التي جعلت مي تتجنب المواضيع السياسية الحساسة مهما كان الأمر، علماً بأنها عايشت إحدى أدق المراحل في تاريخ بلاد الشام ومصر: الحرب العالمية الأولى وما جرته من ويلات على المشرق، “الثورة العربية الكبرى” سنة 1916، سقوط الدولة العثمانية وتفكك المقاطعات التابعة لها، خضوع سورية والعالم العربي للاستعمار الفرنسي- الإنكليزي تحت غطاء الانتداب الذي قررته عصبة الأمم، معركة ميسلون والقصف الفرنسي لدمشق سنة 1920، الثورة المصرية بين 1919 و1922، الثورة السورية الكبرى سنة 1925، ثورات واضطرابات متتالية في فلسطين… إلخ. إن تجاهل مي لهذه الأحداث الوطنية المصيرية، أو التطرق إليها بحساسية مفرطة تتجنب إعلان أي موقف، يثير علامات استفهام حول هويتها وانتمائها وميولها السياسية والاجتماعية.
وُلدت ماري زياده في مدينة الناصرة بفلسطين العام 1886. والدها إلياس زخور زياده من بلدة شحتول (كسروان ـ جبل لبنان) إستوطن الناصرة منذ العام 1879 وعمل في التدريس. والدتها نزهة خليل معمّر من منطقة حوران، لكن الإقامة في الناصرة. وفي العام 1907 (بعضهم يقول العام 1908) هاجرت العائلة المؤلفة من الأب والأم والإبنة الشابة إلى القاهرة. وباستثناء خمس سنوات قضتها مي المراهقة في المدرسة الداخلية التابعة لراهبات الزيارة في عينطورة (جبل لبنان) ثم في مدرسة الراهبات اللعازاريات في بيروت، فإن القسم الأول من حياتها كان في فلسطين والقسم الأخير في القاهرة.
ثمة فارق كبير على كل المستويات بين مدينة الناصرة الصغيرة التي نزحت عنها عائلة مي زياده مطلع القرن العشرين، وبين القاهرة المزدحمة بالناس من جنسيات مختلفة، والتي تخفق بالأفكار والنزعات والنشاطات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية. فالناصرة، كما كل أنحاء ولايات سورية العثمانية، كانت ما تزال تنوء تحت وقع سياسة التتريك، إلى جانب التدخل الأوروبي السافر في أعقاب الفتن الطائفية خلال الفترة من 1840 إلى 1860. أما القاهرة، فهي العاصمة المزدهرة لـ”مملكة” مستقرة إلى حد بعيد مقارنة بالمناطق المحيطة بها. فمنذ أن حصلت أسرة محمد علي باشا على وضعية خاصة في مصر بموجب اتفاق لندن سنة 1840، أخذت بلاد وادي النيل تخط طريقها المستقل في مسار منعزل عن بقية مكونات العالم العربي.
وكانت حملة نابليون بونابرت على مصر سنة 1798 قد شكلت أول احتكاك جذري معاصر بين المشرق العربي والحضارة الأوروبية. واستطاع محمد علي باشا توظيف المعارف الغربية لإقامة إدارة داخلية فاعلة، وإنشاء جيش قوي تمكن من احتلال سورية سنة 1831، وكاد يصل إلى حدود استنبول لولا تدخل الدول الأوروبية لوقف حملات إبنه إبراهيم باشا وإرغامه على الانسحاب إلى مصر، مقابل إبقاء الحكم وراثياً في أسرته. لكن الإنكليز عمدوا إلى احتلال مصر سنة 1882، ثم فرضوا عليها الحماية سنة 1914 بذريعة نشوب الحرب العالمية الأولى.
كانت مي في الحادية والعشرين من العمر عندما حطت عائلتها الرحال في القاهرة. شابة مثقفة منفتحة على الحضارات العالمية، تستكشف طريقها الجديد في مدينة كبيرة موغلة في التاريخ والتقاليد الاجتماعية القديمة. “انتقلت إلى القاهرة مع ذويها حيث مجال العمل أرحب وأطلق، غير أن إمكاناتها المادية المحدودة حتمت عليها أن تبقى غريبة هنالك أيضاً: فلا الأوساط الراقية كانت تعرفها فتقدر موهبتها، ولا مواردها المالية كفت لتتيح لها الظهور، فاضطرت إلى أن تحيا على الهامش حيناً، فتألمت وشكت إلى نفسها حرقة النفس وعزمت على أن تلمع… أو تموت”(10).
خطواتها العملية الأولى بدأت بإعطاء دروس خصوصية لبنات شخصية مصرية معروفة هي إدريس راغب الرئيس الأعظم للمحفل الماسوني الأكبر الوطني المصري، وهو المحفل المؤسس والمهيمن على عدد من المحافل في مصر وسورية وفلسطين ولبنان(11). ويحيط الغموض بهوية الطرف الذي كان واسطة التعارف بين بيت زياده وبيت راغب، إذا ما أخذنا في الاعتبار الفارق الطبقي الواسع بينهما. إلا أننا نرجح أن يكون يعقوب صروف أحد صاحبي مجلة “المقتطف” ورئيس تحريرها هو ذلك الشخص. فمن جهة أولى هو شامي مثل إلياس زياده، ومن جهة ثانية على علاقة مع إدريس منذ أن كان هذا ينشر مقالاته في “المقتطف” أثناء مرحلتها البيروتية. ومن جهة ثالثة، وهي الأهم، إنتماء صروف وراغب إلى الحركة الماسونية في مصر.
وكذلك لا يمكننا الجزم في السبب الذي جعل راغب يمنح والد مي، رخصة إصدار مجلة “المحروسة”(12) للتعيّش منها. “وقيل إن مي كانت متورطة معه (أي إدريس راغب) في اعتناق مبادئ الماسونية، وليس بخافٍ على أحد ما للماسونية من صلة بالحركة اليهودية الصهيونية. وكانت مي تفاخر بأنها من أصل يهودي، وتزهو بأن نسبها القديم يرجع إلى اللاويين. وإن كان (عباس محمود) العقاد يقول: “ولم تكن مي من أعضاء المحافل الماسونية على ما أعلم”!(13) وتستند هذه الملاحظة إلى عبارة وردت في إحدى رسائل جبران خليل جبران إلى مي(14): “وقد سررت جداً لانتسابك إلى عائلة لاوية”. وبغض النظر عن دقة هذا الكلام والشكوك المحيطة به، فإن مجلة “المحروسة” أمّنت مصدر رزق لوالدها، وفي الوقت نفسه أتاحت لها مجال نشر بواكير كتاباتها باللغة العربية. وداخل أروقة مكاتبها التقت العديد من الصحافيين والكتاب السوريين والمصريين.
أطلت مي على الساحة الثقافية المصرية سنة 1913 لتلقي كلمة جبران خليل جبران في حفلة تكريم الشاعر خليل مطران الذي أنعم عليه الخديو عباس بوسام رفيع المستوى. صبية في السابعة والعشرين من العمر، سافرة ومثقفة وذات إطلالة آسرة. فهذا طه حسين، الكفيف، يسترجع ذكرياته عن تلك الليلة فيقول: “كان الصوت نحيلاً، وكان عذباً رائعاً، وكان لا يبلغ السمع حتى ينفذ منه في خفة إلى القلب، فيفعل فيه الأفاعيل”(15). أما حافظ محمود فينظر إليها من ناحية أخرى: “كانت في نفس الوقت خطيبة مثيرة. كانت من أقدر الخطيبات في عصرها على إثارة خيال الشباب، فأياً كان الموضوع الذي تعالجه في محاضراتها كان لا بد أن تمزج الكلام فيه بعبارات الحب والحسن والجمال والخيال والآمال… ولهذا لم يكن غريباً أن تسمع بين الحاضرين من يستعيض عن التصفيق بالآهات عند بعض مقاطع المحاضرة”(16). وهذا سلامة موسى، الذي سافر إلى أوروبا وتنعّم في أجواء انفتاحها الاجتماعي والثقافي وكان ينظر إلى ذاته بوصفه عنوان التقدم والثورة على النمطية التقليدية البالية، لم يجد ما يقَيّم به مي الأديبة إلا أنها إستطاعت “ان تجعل احتراف الأدب عند الفتاة المصرية والسورية زينة أنثوية لا استرجالاً كريهاً”(17)، بل ولم يرَ في مي نفسها إلا أنها “حلوة الوجه، مدللة اللغة والإيماءة، تتثنى كثيراً في خفة وظرف”.
بعد تلك الإطلالة أمام “النخبة المصرية”، حظيت مي برعاية واهتمام أحمد لطفي السيد الذي لعب دوراً حيوياً في تأسيس الجامعة المصرية سنة 1908. وكان له تأثير واضح على مي، خصوصاً في موضوع الهوية والانتماء. ذلك أنه دعا إلى تحديد مفهوم الشخصية المصرية، ورفض ربط مصر سياسياً بالعالم العربي أو تركيا أو العالم الإسلامي، وآمن بالقومية المصرية كأساس لانتماء المصريين. واعترفت مي بجزء من تأثير السيد غير المباشر في حديث صحافي أدلت به لمجلة “الهلال”: “إن أهم ما أثّر في مجرى حياتي الكتابية ثلاثة أشياء: أولها النظر في جمال الطبيعة، والثاني القرآن الكريم بفصاحته وبلاغته الرائعة، والثالث الحركة الوطنية المصرية التي لولاها لما بلغتُ هذه السرعة في التطور”(18).
فتحت الساحة الثقافية المصرية ذراعيها احتفاء بكتابات مي ذات الأسلوب الإبداعي الخاص. وتسابقت الصحف، ومعظمها يملكه “الشوام” على نشر مقالاتها، في حين تعددت الدعوات للاستماع إلى محاضراتها. وحتى في ذروة تألقها وشهرتها، ظلت مي تعاني من ضبابية الانتماء وضياع الهوية. ونحن نلاحظ ذلك من خلال قراءتنا لكتاباتها، إضافة إلى المتابعة الدقيقة لسيرتها الشخصية. وربما كان الأمر مرتبطاً بوضعها العائلي: أب لبناني، أم شامية، ومسقط رأسها وطفولتها في فلسطين، وحياة جديدة اجتماعياً وثقافياً ومهنياً في مصر. ولم تكن أزمة الهوية حكراً على مي في تلك المرحلة الانتقالية، عندما تهاوى “النظام القديم” المتمثل بالسلطنة العثمانية، لتهب مكانه رياح الغرب الاستعماري على العالم العربي بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. إن التوجهات الوطنية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين تكشف لنا أن غالبية الكتاب والمفكرين والأدباء السوريين، في الوطن وفي المهجر، أظهروا تخبطاً في التعبير عن هويتهم.
كان اختلاط مفهوم الهوية مع مفاهيم أخرى متضاربة السمة الأبرز التي طبعت تفكير رواد عصر اليقظة* الاجتماعية منذ منتصف القرن التاسع عشر. ذلك لأن هيمنة الحكم العثماني على حياة السوريين لأربعة قرون متتالية أسفرت عن انحطاط عام في مختلف المجالات، وأخطرها على الإطلاق فقدان الشعور الوطني أو الوعي القومي. “كان التضعضع القومي عاماً وكاد يقضي على شخصية الأمة قضاء مبرماً، فلم يبق لها سوى بعض المؤسسات، كالمراجع الدينية والمعابد والسلطة الاقطاعية ونظام العشيرة أو رابطة العائلة الدموية (…) فكانت النتيجة تخبطاً اختلطت فيه السياسة بالدين والاجتماع بالسياسة…”(19). وزاد التدخل الأجنبي الأوروبي المباشر، أو من خلال الإرساليات التبشيرية والتعليمية، حدة التخبط في مسألة الانتماء، خصوصاً وأن فكرة الوطن والوطنية لم تكن قد أصبحت واضحة بحيث تؤدي إلى نشوء بوادر وعي في صفوف الشعب.
مي زياده هي ابنة تلك المرحلة، من دون أن نتجاهل طبعاً ظروفها الشخصية والعائلية وحساسية مشاعرها المرهفة. وسيكون من باب التعجيز أن نطلب منها تعريفاً علمياً دقيقاً لمفهوم الوطنية أو لمفهوم القومية، كمدخل لا بد منه لتحديد الهوية والانتماء. فهي تستعمل مفردتي الوطنية والقومية في عدد من مقالاتها وخطبها، لكنها تكتفي بالصفات العامة المتداولة في مصر وسورية خلال تلك الفترة المبكرة، حينما كانت الوطنية مشاعر عاطفية فضفاضة. ففي خطاب ألقته في بيروت سنة 1922، خصصت القسم الأكبر منه(20) للحديث عن الوطنية: “الوطنية! يا للكلمة الساحرة المنبهة كل فكر، الملهبة كل قلب، الشاحذة كل عزيمة”. ثم أعطت صفات عدة لما أسمته “وطنيتنا الحديثة”، منها: الطبيعية، العائلية، المقدسة، النشطة، الأخوية، الودودة، الحارة، المثبتة، الروحانية وغيرها.
أما القومية، فإن مي ترى فيها “الوحدة الشعبية” أي المجتمع المرتبط بوطنيته. ولأنها عايشت عن كثب في سورية ومصر التعصب الديني والمذهبي، فقد حذرت من الخلط بين القومية والدين(21): “القومية هي الرابطة الدنيوية التي ما داخلتها فكرة الدين إلا أنزلت المحن بالقوم، وفرّقت شملهم”. وأضافت تقول: “إن القومية تجعل المرء قوة فاعلة”.
كانت مي تمتلك شعوراً وطنياً فضفاضاً غير واضح المعالم: “وطني يحتاج إليّ احتياجه إلى كل فرد من أبنائه وبناته. وطني يحتاج إليّ، وعيون إخواني فيه ترعاني. أريد أن أبعث حبي لأبناء وطني لهيباً. أريد أن أسكب نفسي في نفوس أبناء وطني كوثراً (…) أريد أن أحيا رغم الجراح والآلام لأكون في حياة وطني الناهض حياة”(22). هذه العاطفة الصادقة لا تجيب عن سؤال الهوية. إنها مجرد مشاعر تخفق في وجدان كاتبتها، من دون أن تلزمها بأي موقف حازم، لأن “الوطن” المقصود غير موجود على أرض الواقع، لا في ذهن الكاتبة ولا في ذهن القارئ. ولا نبالغ إذا قلنا إن تلك الكلمات، ومثيلاتها في نتاج مي، تخفي أزمة ذاتية تجاه معضلة “الهوية” عبّرت عنها في مقال آخر عنوانه “وطني” حيث تقول: “وُلدت في بلد، وأبي من بلد، وأمي من بلد، فلأي هذه البلدان أنتمي؟ وعن أي من هذه البلدان أدافع؟”(23)
ومن المناسب هنا التمييز بين الانتماء من حيث هو هوية، ثم الوعي لهذه الهوية (أي الوجدان القومي)، وبين الدعوات التي تُطلق لتحسين أوضاع الوطن والشعب. ونحن نقرأ في كتابات مي اقتراحات عديدة لتنظيم الانتاج وتحسين الظروف الاجتماعية والعمل من أجل الخير العام: “ألا فليكن هذا شأننا في مجهودنا الجديد لحياتنا الجديدة. ولتكن الحماسة الوطنية وفكرة الوحدة القومية مراكز نور وحرارة نجدد عندها ما تراخى من عزائمنا لنمضي بعدئذ متسابقين إلى حيث تحقق الشعوب آمالها وتقوم بما فرض عليها في موكب الأمم الحية الناهضة”(24). وهذا كلام صحيح لكنه مُغرق في العموميات. فما الذي تقصده الكاتبة بعبارة “فكرة الوحدة القومية؟” كما أنها تذكر “غاية الوحدة القومية” في موضع آخر من المقال ذاته، فكيف يتم تحقيق هذه الغاية على أرض الواقع؟
يبدو لنا أن مي لم تستطع تجاوز أزمة عدم الانتماء. فعندما تستدعي المناسبات أو الظروف ضرورة أن تكون أكثر وضوحاً، نراها تلجأ إلى طرح المزيد من الأسئلة المعبّرة عن الضياع: “… وها أنذا أردد سؤالاً ألقيته على نفسي مراراً خلال هذا البحث: أين أنا الآن؟ أين أنا؟”(25) وفي الأوقات الصعبة والحرجة، تطلق صرخة مرّة: “إنما أريد وطناً لأموت لأجله أو لأحيا به”(26). ومأساة مي التي لاحقتها طيلة حياتها تكمن في أنها لم تنتم إلى وطن، كي تصبح قضاياه قضيتها الأساسية. إن غياب مثل هذا “الوطن” أفقدها مجال التماهي مع شعبها، وأدخلها دائرة الشك والتخبط. هذا على المستوى الذاتي. أما من الناحية الأخرى، فنحن نعتقد بأنها حملت مشاعر إيجابية تجاه الدول الغربية، خصوصاً فرنسا وبريطانيا، حتى ولو حاولت تغطية ميولها بالقول: “إني أحب فرنسا وإنكلتره ليس حباً سياسياً لأني لا أعرف من السياسة شيئاً. ولكني أحب آدابهما وشعرهما وأفراداً من أمتهما”(27). وما كانت لتتردد في التعبير عن ذلك في مناسبات مختلفة، فتتكشف للقارئ ميولها الحقيقية… حتى وإن كانت تحرص على النأي بنفسها عن السياسة ومشاكلها!!
الكيل بمكيالين
تختلف مي زياده عن غالبية كتاب عصر فجر النهضة ومفكريه وأدبائه في أنها ابتعدت عمداً عن الخوض في المسائل السياسية المحلية والعالمية، حتى ولو كانت تتعلق بالقضايا الوطنية والقومية سواء في موطنها الأصلي سورية أو في موطنها الثاني مصر. وهذا أمر يثير الاستغراب إذا علمنا أن عدداً كبيراً من أصدقائها السوريين والمصريين، ورواد ندوتها الأسبوعية، كانوا منخرطين في العمل السياسي الحزبي على مستويات عدة، خصوصاً المهاجرين السوريين (الشوام) المقيمين في مصر أو المغتربات الأوروبية والأميركية.
جبران خليل جبران وأمين الريحاني وشبلي الشميل وخليل سعاده وولي الدين يكن وطه حسين وعباس محمود العقاد ومحمد حسين هيكل وفرح أنطون، على سبيل المثال لا الحصر، كانوا يحملون هموماً وطنية عبرّت عن نفسها بمواقف سياسية معلنة، وكتابات فكرية نهضوية، ونشاط في جمعيات وأحزاب في الوطن والمهجر، ومشاركة في مؤتمرات قومية، بل والوصول إلى مناصب في البرلمان والحكومة، كما في حالة بعض معارفها المصريين. لكن هذا لا ينطبق بصورة عامة على القسم الأكبر من الجالية الشامية المقيمة في مصر، “فبالرغم من أن الشوام في بلادهم يعشقون السياسة والعمل السياسي وينخرطون في الأحزاب منتسبين أو مؤيدين، فقد كانوا في مصر قلة نادرة في ميدان السياسة المباشر، حتى في الفترات التي تعددت فيها الأحزاب”(28).
وكان باستطاعتنا تفهم ابتعاد مي عن السياسة إسوة بأبناء جلدتها، لولا أنها اتخذت مواقف سياسية في مسائل أخرى وعبّرت عنها بشكل يثير تساؤلات حول حقيقة مشاعرها تجاه الغرب الاستعماري الذي هيمن على المنطقة بعد انتصاره في الحرب العالمية الأولى. ومن هذه الناحية، نرى أن مي شذت عن القاعدة، مع أنها كانت عميقة الاطلاع وعلى دراية تامة بالأوضاع التي يعاني منها وطنها السوري الخاضع للانتداب الفرنسي – الإنكليزي، والمعرض جزؤه الفلسطيني للضياع بسبب المشروع الاستعماري الصهيوني. وفي الوقت نفسه لم تجد قضايا التحرر الوطني في مصر تأييداً مباشراً وصادقاً في كتابات مي، على الرغم من أنها كانت تنشر في عدد من أبرز الصحف المصرية آنذاك.
ونحن نعلم من خلال مرويات زوار ندوتها الأسبوعية أن تجنب المواضيع السياسية لم يكن مقتصراً فقط على كتاباتها في الصحف والمجلات، سواء في سورية أو في مصر، بل هي اتخذت المنحى نفسه حتى في ندوتها التي استضافتها في منزلها العائلي. إذ أن المرء يتوقع منها في مثل هذه الحالة أن تتحرر من القيود التي فرضتها على نفسها في مقالاتها المخصصة للنشر. ونكرر هنا عبارة أنطون الجميّل، الصديق المواظب على حضور ندواتها: “لم تشغل السياسة مياً قط عن الأدب، وكانت تتحاشى الخوض في غمارها أو الدخول في معتركها. ومع ذلك كانت تقرأ معظم الصحف السياسية وتتتبع أخبار السياسة وتساير تطوراتها”(29). ونفهم من هذه الملاحظة أن مي كانت على دراية تامة بالشؤون السياسية، غير أنها تجنّبت إبداء الآراء السياسية لأسباب سنحاول الإضاءة عليها أدناه.
وليس الجميّل الشخص الوحيد الذي لاحظ هذه الظاهرة في شخصية مي، فهناك أمثلة عدة من فترات مختلفة تشير إلى تهربها من السياسة. كتب أنطون سعاده مقالاً في صحيفة “الزوبعة” الصادرة في الأرجنتين عندما بلغه نبأ وفاتها، تحدث فيه عن لقائه بها وقتما تعرضت للحجر الصحي في بيروت سنة 1937. فقد زارها في المستشفى برفقة صديق مشترك هو أنيس ناصيف الذي قدّم لها سعاده بعبارة أنه زعيم سياسي. ويعلق سعاده في مقاله على ردة فعل مي بالقول(30): “فأبدت مي تذمرها من السياسة بكلام قد غاب الآن بين طيات الحوادث”.
وهناك حادثة أخرى معبرة تكشف أمامنا ناحيتين من علاقة مي بالسياسة: الأولى أنها تتمتع بوعي سياسي دقيق. والثانية أنها حريصة على الابتعاد كلياً عن التدخل في السياسة. ففي إحدى رسائلها المبكرة إلى جبران(31) تخبره عمّا يعانيه اللبنانيون في ظل متصرف عثماني جديد. تقول: “جاء متصرف لبنان الجديد، ومنذ ساعة وصوله أخذ بالعزل والنصب، تابعاً في ذلك خطة سلفائه الكرام. واللبنانيون يتملقون ويقبلون أقدام ذلك الأرمني. أعوذ بالله من المظلوم إن حكم. ترى متى نرى بيننا شخصيات فولاذية؟ ومتى ينفض اللبنانيون عن نفوسهم غبار الهوان؟ لماذا لا تكتب في هذا المعنى؟ الجمهور يحب أفكارك يا جبران ويترنم بها، فقل لهم كلمة تذكرهم أنهم رجال، وأن الرجولة لا تطيق الذل”. ومع أنها تلجأ إلى دغدغة أحاسيس جبران لتشجيعه على الكتابة، فنحن نعتقد بأنها أرادت من شخص آخر (هو جبران في هذه الحالة) أن يتكلم بلسانها، ويتخذ موقفاً سياسياً لا تريد هي أن تتورط به. وقد لبى جبران طلبها، وكتب مقالة “ويل لأمة…” من وحي تلك الرسالة(32).
وتحاول الباحثة وداد سكاكيني أن تجد مبرراً لعزوف مي عن السياسة، فترى أن فوضى العمل الحزبي في تلك الفترة هي التي دفعتها إلى تجنبها بصورة حاسمة(33): “كانت الأحزاب السياسية في عصرها وبلادها تتنافس، ويتهم بعضها بعضاً بغير الحق وفي حدة الدعوات الوطنية للحكم والظهور، فتجافت (أي مي) عن الخوض في حديث السياسة المحلية وإن لم يفتها الاطلاع على خفاياها. فإذا تكلم في ندوتها أحد الحضور بموضوع سياسي محدد لم تشارك في الكلام إلا إذا كان يتعلق بكرامة الأقطار العربية وشؤون نهضتها”. لكن هذا الكلام لا يُفسّر صمتها الغريب عن الخوض في المسائل الوطنية، كما يتبيّن لنا.
تُظهر مي في العديد من مقالاتها وخطبها وعياً سياسياً واضحاً، يرفده اطلاع واسع على أنظمة الحكم والسياسات الدولية في تلك المرحلة. ولعل كتاب “المساواة” الصادر سنة 1922 خير دليل على غزارة معارفها ودقة فهمها للأفكار التي ظهرت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. فالكتاب أثار اهتمام قطاع واسع من الكتاب والمفكرين في العالم العربي، لأنها عالجت فيه مسائل الرق والمساواة والتحرر في ضوء الإيديولوجيات السائدة والمتصارعة في مطلع القرن العشرين مثل الشيوعية والاشتراكية والديموقراطية. “وأفردت فصولاً لتأريخ كل مذهب من المذاهب السياسية والاجتماعية قديماً وحديثاً. ولم يفتها التحدث عن الديموقراطية والأرستقراطية والفوضوية والعدمية حديث المطلع على المشكلات الإنسانية، المؤمن بلزوم القضاء على الرق والعبودية والفاقة، ومختلف وسائل الاستثمار والاستعمار”(34). وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن أنطون سعاده، المقيم في البرازيل حينذاك، أعد نقداً للكتاب نشره على سبع حلقات في جريدة “الجريدة” التي كان يصدرها في سان باولو (البرازيل) والده الدكتور خليل سعاده. وظهرت الحلقات بين 7 و14 كانون الأول سنة 1922(35). ويشير هذا الأمر إلى أن كتب مي كانت منتشرة في المهجر الأميركي، وتحظى باهتمام خاص في الصحافة المهاجرة التي كانت تتابع نتاجها الأدبي.
ويؤكد معاصرو مي، خلال الربع الأول من القرن العشرين، أنها كانت الأكثر اطلاعاً على التيارات الفكرية العالمية المعاصرة. وتنقل سلمى الحفار الكزبري(36) عن الصحافي السوري المقيم في مصر إبراهيم المصري “أنه كان يتردد على ندوة مي، وكان يتسلح بقراءة أحدث الكتب الفرنجية (الطازجة) لعله بذلك يتحداها ويعجزها. ولكنه كان يفاجأ دائماً بأنه لا يكاد يستهل الكلام في كتابه الوارد لتوه في بريده الأدبي حتى تفيض مي في الحديث عنه وفيه، عن قراءة واستيعاب دقيقين”. وكان واضحاً للجميع أنها نجحت في دمج “الثقافتين الشرقية والغربية”(37) خصوصاً في أسلوب كتابتها الأدبية، وتفوقت بذلك على أبناء وبنات جيلها. ومع أنها أيدت الأفكار الاجتماعية التقدمية بصورة عامة، إلا أنه “لم يكن لها فيها نهج خاص”(38).
وعلى الرغم من أن مي حاولت دائماً تجنب التطرف في أي شأن سياسي أو اجتماعي، إلا أنها لم تتردد في إظهار عداوتها الشديدة لألمانيا بطريقة تصل إلى مستوى الموقف العنصري! وهي تبرّر مشاعرها السلبية تلك بأن ألمانيا مسؤولة عن اندلاع الحرب الكبرى، كما كانت تُعرف يومذاك. ففي مقال نشرته في مجلة “المحروسة” سنة 1914 تحت عنوان “جيراننا والموسيقى”، تحدثت عن جيران أزعجوها “بصرير آلاتهم الحديدية”… لتصل إلى العبارة التالية: “وأما الأمر الذي لا أسامحهم عليه أن موسيقاهم ألمانية. فأني منذ إشهار الحرب أتحاشى كل ما هو ألماني من مؤلفات وموسيقى وفنون. إن ألمانيا التي تدوس حقوق الضعفاء، وتتبختر غروراً على الأقوياء، وتفتك بالأطهار والأبرياء، ألمانيا الضخمة التي تحاول هدم مدنية شيدتها مدنيات، لا تستحق أن تُكرّم الآن بأفرادها، مهما كان أولئك الأفراد عظماء وأبراراً”(39).
وتكاد لا تفوّت فرصة إلا وتستهدف ألمانيا بعبارات قاسية، بل ومهينة في بعض الأحيان. في سنة 1915 أغرقت البحرية الألمانية سفينة “لوزيتانيا” في المحيط الأطلسي، فكتبت مي قطعة وجدانية معبّرة. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، أثيرت سنة 1919 مسألة السفينة لجهة التعويضات. فأعادت مي نشر النص مع تعديلات طفيفة: “وإذا سألتك (أي السفينة) أرواح العناصر مذهولة: إذاً كيف فُتك بك؟ أجيبي: إن الذي قضى عليك ليس التحالف الملقب بالإنساني بل الجبير المنعوت بالجرماني”. وفي مقال لاحق بعد أيام تستعمل العبارة التالية “…المستسلم لذي الهوس الجرماني”(40). وتتكشف حقيقة مشاعرها في رسالة إلى صديقها أمين الريحاني بتاريخ 24 أيلول 1915: “.. وعلى ذكر قاسم أمين، هل علمت أن المكتبة الخديوية التي أصبحت المكتبة السلطانية تطهرت نهائياً من ميكروبات الألمان؟”(41)
ويقول الباحث فاروق سعد نقلاً عن طاهر الطناحي(42) إنه “لما قامت الحرب (العالمية الثانية) كتبت رسالة بليغة في فلسفة الحرب بعنوان: “رسالة إلى هتلر” ندَّدت فيها بمساوئ الحرب وما تجره على الإنسانية من شقاء ووبال”. ونحن نشك في هذا الأمر، لأن الحرب اندلعت في أيلول سنة 1939، في حين كانت مي قد دخلت مرحلة التدهور الصحي والنفسي الذي أدى إلى وفاتها سنة 1941.
لكن هل نظرت مي إلى القوى الأخرى المشاركة في الحرب العالمية الأولى مثلما نظرت إلى ألمانيا، ونقصد بذلك الدولتين الاستعماريتين الكبريين: بريطانيا وفرنسا؟ يحظى هذا السؤال بمشروعية صادمة كون هاتين الدولتين قد أصبحتا القوتين المستعمرتين في سورية ومصر بعد انتصارهما في الحرب. كما أنهما تآمرتا لتقسيم بلادنا بموجب اتفاقية “سايكس ـ بيكو”، في حين أقدمت بريطانيا من جهتها على إعطاء “وعد بلفور” بمنح اليهود “وطناً قومياً في فلسطين”! ويبدو لنا أن مي، بشكل أو بآخر، تماهت مع الغرب الأوروبي، أو تجاهلت سياساته الاستعمارية، بغض النظر عن ممارساته العدوانية. فعلى سبيل المثال، هي “شديدة الإعجاب بشخصية موسوليني”، وترى “من بياناته وخطبه دروساً في فني الكتابة والخطابة مع ما يجب أن يكونا عليه من بساطة في الأسلوب إلى إحكام في التعبير، إلى النفس الحار، إلى براعة التنسيق وانتظام الأفكار والموضوعات”(43).
لماذا اتخذت مي مواقف إيجابية من دولة ما، وأخرى سلبية تجاه دولة ثانية؟ وما هي العوامل التي منعتها، طوعاً وبقرار ذاتي، من خوض غمار السياسة في وقت اعترفت هي نفسها بأن الحركة الوطنية المصرية كانت من أهم ما أثر في مجرى حياتها الكتابية والتي لولاها “ما بلغتُ هذه السرعة في التطور”؟
نجد في أحيان كثيرة أن بعض الباحثين يشطّون في آرائهم وينسبون إلى مي مواقف سياسية أو اجتماعية لا وجود لها في الواقع. فالباحثة وداد سكاكيني تقول: “وتغلو مي، على اعتدالها، في النقمة على الاستعمار وسياسته، فتتحدث وتكتب في الموضوعات التي تجدها أجدى على الوطن في البناء والنضال. ولم تكن تريد للمرأة العربية أن تخوض في السياسة وهي في خطواتها الأولى للتحرر مما عاق نهضتها وتعليمها”(44). ومن ناحية أخرى، نشرت إحدى المجلات في بيروت(45) مقالاً وردت فيه هذه العبارة: “مي زياده ثائرة مارونية من كسروان حملت لواء الثورة على كل ما هو تمييز اجتماعي…”. هذا الكلام لا معنى له، ويجب وضعه في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1976). لكن رأي سكاكيني يستدعي مناقشة هادئة.
تخطئ سكاكيني مرّة أخرى عندما تتناول ما أسمته كتابات مي في الشؤون السياسية والوطنية بعد الثورة المصرية سنة 1919، إذ تقول: “وما كادت ثورة مصر عام 1919 تندلع بغضبها على الاستعمار وتستجيب بأهدافها لرأي معلمها (أي معلم مي) أحمد لطفي السيد، حتى كانت مي من الدعاة لتنمية النزعة الوطنية والثوروية، فنشرت المقالات الجريئة حولها وسمّت أيام الثورة بالأيام العصيبة”(46). والخطأ هنا يظهر على مستويين:
الأول يتعلق بأحمد لطفي السيد الذي لم يكن معادياً للوجود البريطاني في مصر، بل كان يرى فيه فرصة لتطوير البلد وتحديث المجتمع المصري. والثاني أننا لم نجد في مقالات مي وخطبها في تلك المرحلة، على وجه التحديد، أية “جرأة” في تسمية الاستعمار الإنكليزي المهيمن على مصير وادي النيل برمته. ولا نعثر في كتاباتها على أية دعوة علنية إلى إنهاء الاحتلال. إن أقصى ما جاد به يراع مي آنذاك هو مقالات وجدانية عمومية تشيد بالمشاعر الوطنية المصرية، وتدعو إلى النهضة ومساهمة المرأة في مسيرة العلم والتقدم، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وما شابه ذلك من مسائل محلية… مع الابتعاد الكلي عن الإشارة إلى مكمن الداء، ألا وهو سيطرة الاستعمار البريطاني على مقدرات البلاد بالاتفاق مع الخديوي وحاشيته، وكذلك القوى المستفيدة من العلاقة مع الإنكليز.
لا يوجد في كل ما وقعنا عليه من كتابات مي ما يجعلنا نطلق حكماً يقينياً يوضح سبب نفورها من السياسة، وإن كان بمقدورنا تلمس بعض الأسباب اعتماداً على سيرة حياتها، إضافة إلى ملاحظات عدد من الذين عملوا معها أو صادقوها في مراحلها المختلفة. أول ما يتبادر إلى الذهن وضعها العائلي، ذلك أن والدها إلياس زخور زياده كان “غريباً” في القاهرة من ناحية الانتماء الوطني ومن ناحية الانتماء الديني. ولعله كان يخشى من التورط في دهاليز السياسة المحلية ما يمكن أن يؤثر على أوضاعه المهنية والشخصية. صحيح أن جريدة “المحروسة” التي امتلكها وأشرف عليها حملت في مرات عدة مقالات سياسية ساخنة أدت إلى معاقبتها بالإغلاق مؤقتاً، لكن الصحيح أيضاً أن كتبة تلك المقالات كانوا من المواطنين المصريين الذين هم أدرى بشعاب بلدهم. ولا شك في أن حرص إلياس زياده الزائد عن الحد أصاب بعدواه مي، فالتزمت به حتى آخر يوم من حياتها. وقد لاحظ سلامة موسى هذه المسألة، فقال في حديث صحافي بعد وفاة مي: “لو دعت إلى تحرير المرأة في مصر، وكافحت لتحقيق ذلك، لوجدت نفوراً عظيماً لأنها لم تكن مصرية ولم تكن مسلمة”(47).
ولا بأس هنا من إجراء مقارنة سريعة من خلال عرض مواقف مي عندما يتعلق الأمر بفرنسا! كانت سورية، خصوصاً الشام ولبنان، ضحية للممارسات الوحشية الفرنسية وبالتحديد بعد القضاء على أول حكومة سورية مستقلة في أعقاب معركة ميسلون، والقصف العشوائي لدمشق، وتدمير مبنى المجلس النيابي، وطرد حكومتها الشرعية. ومع أن مي كانت في ذروة تألقها الأدبي والصحافي في تلك الفترة، إلا أنها التزمت صمت القبور في مقالاتها ورسائلها، متجاهلة مجازر الفرنسيين في سورية. وهذا ما لاحظته سكاكيني عندما قالت إن مي شكرت للأمير فاعور الذي زارته في سورية وكتبت عنه في “الأهرام” شهامته “وما أبداه نحو أبناء ملتها الذين آووا إلى رعايته في القنيطرة والجولان ومجدل عنجر عند اقتحام غورو أرض الوطن. لكن مياً لم تندد في مقالتها بفظاعة الغاصبين المحتلين”(48).
ولعل أوضح ما يكشف عن توجهات مي السياسية في ما يتعلق بالقضية السورية هو النداء الذي وجهته إلى “الزعيم سلطان باشا الأطرش ودروز الجبل عموماً”، في فترة اندلاع الثورة السورية الكبرى سنة 1925. نُشر هذا النداء في مجلة “المقطم”* (العدد 11145 تاريخ 28 تشرين الأول 1925)، وفيه تتجاهل حقيقة أن الثورة التي انتشرت في أنحاء عدة من سورية لم تكن “درزية” فقط، وإنما هي ثورة وطنية قومية هدفها طرد المستعمر الفرنسي ونيل الاستقلال الناجز والسيادة غير المنقوصة. تقول في ندائها الملوّن بعاطفة طفولية ساذجة: “أسير إليكم مسوقة بالشعور معكم، آسية على كل قطرة تراق من دمائكم، متفجعة لكل ما ينزل بدياركم من الرزايا. وأول ما ينطلق به لساني هو التمني أن تكفوا عن القتال. ألا حبذا التهاون والتفاهم في هدوء وأمان”! وبعد أن تثني على تقاليد أهل الجبل وعاداتهم، تصل إلى مسألة غريبة لا نجد لها أي تفسير في خضم الثورة العارمة في سورية، إذ تقول: “أطلب منكم الجري على عاداتكم القومية من صون النساء في وسطكم، الشرقيات والغربيات منهن على السواء. أطلب مسالمة لجميع المقيمين في جواركم والذين قد تنزلون بينهم بداعي إجراءاتكم الحربية”… طبعاً لم يرد في هذا النداء أي ذكر لفظائع الاحتلال الفرنسي!
وهناك حادثة أخرى يرويها الشاعر خليل مردم الذي زار مي في 19 آذار سنة 1926، ثم نشر مقالاً بعنوان “مي” في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق(49)، قال فيه: “ثم سألتني عن كارثة دمشق (…) وأخذت أقص عليها ما شهدته بعيني من الواقعة، فكانت تُظهر ألماً وحزناً واستياء وتقول: (لا أقدر أن أتصور دمشق خربة محروقة، تلك المدينة التي يتمثل بها جمال المشرق وجلاله، وتبعث في نفس الرائي الحرمة والروعة). وتمنت انفراج الثورة السورية”. هذا، وبكل بساطة، رد فعل مي على نكبة دمشق على أيدي المستعمرين الفرنسيين. إذ إنها لم تتناول بوضوح الجريمة الفرنسية التي عبّر عن هولها الشاعر أحمد شوقي في قصيدته المشهورة: سلام من صبا بردى أرق/ ودمع لا يكفكف يا دمشق!
فلسطين الوطن الغائب!
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، دخلت فلسطين مرحلة مصيرية خطرة في ظل المخطط البريطاني لإنشاء وطن قومي لليهود على حساب سكانها الأصليين. وتمثل الرفض الشعبي الفلسطيني في سلسلة من المؤتمرات والإضرابات والمظاهرات والاشتباكات العنيفة، ليس مع العصابات الصهيونية المسلحة فقط، بل أيضاً مع القوات البريطانية التي وقفت بكل إمكاناتها إلى جانب اليهود. وهذه أمثلة على التحركات الفلسطينية خلال الفترة التي كانت مي ناشطة فيها: اضطرابات عمّت أنحاء فلسطين في نيسان سنة 1920. اشتباكات دامية في يافا سنة 1921. ثورة البراق سنة 1929 حيث تدخل الطيران الإنكليزي ضد الفلسطينيين. وبالتزامن مع هذه الثورة، عُقد في القدس المؤتمر النسائي العربي الأول بتاريخ 16 تشرين الأول 1929 بحضور أكثر من 300 سيدة. ولا شك في أن مي كانت تتابع تلك التطورات، خصوصاً أن بعض الصحف في القاهرة(50) دأب على تغطية الأحداث من وجهة نظر مؤيدة للحق الفلسطيني. وبالمقابل، فتحت صحف أخرى مثل “المقطم” صفحاتها لكتاب يهود صهاينة، منهم إلياهو ساسون وإيلي شولال اللذان نشرا مقالات سنة 1922 تبرر الاستيطان اليهودي في فلسطين.
وفي هذا السياق، من الضروري الإشارة إلى زيارة اللورد بلفور إلى فلسطين في آذار سنة 1925، حيث أعلن الفلسطينيون الإضراب العام رفضاً لوجوده واحتجاجاً على وعده المشؤوم. ومن أهداف الزيارة أيضاً “رعاية” الاحتفال بافتتاح الجامعة العبرية في القدس بتاريخ أول نيسان 1925. وقد حضر أحمد لطفي السيد، صديق مي وراعيها، الاحتفال ممثلاً للحكومة المصرية ما أثار موجة من الانتقادات الحادة ضده في فلسطين وفي مصر(51). لكن جريدة “الأهرام” دافعت عنه بحرارة وبررت له مشاركته. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مي كانت كاتبة أساسية في “الأهرام” على مدى سنوات، وغالباً ما احتلت مقالاتها الصفحة الأولى.
ومن بين كل المشاكل التي عانت منها منطقتنا في الفترة ما بين الحربين العالميتين، إحتلت المسألة الفلسطينية صدارة الهم القومي بمواجهة مشروع الاستيطان الصهيوني. ومن المستغرب والمستهجن أننا لم نعثر، في ذروة نشاط مي وشهرتها بين 1915 و1930، على أي كتابة تتناول بشكل مباشر وصريح تطورات الساحة الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذه الحالة: لماذا تجاهلت مي أو تجنبت الخوض في ما يجري على أرض فلسطين، مسقط رأسها وملعب طفولتها ومقر إقامتها قبل هجرة العائلة إلى مصر؟
تضعنا المسألة الفلسطينية أمام مجموعة من الأمور الحساسة حول موقف مي مما كان يجري على أرض فلسطين. والتساؤل مشروع لاعتبارات عدة: أولها أن مي ولدت في فلسطين (مدينة الناصرة) وقضت معظم سنوات شبابها هناك قبل الانتقال إلى القاهرة سنة 1907. وثانيها أن الأحداث الفلسطينية الدامية وقعت خلال فترة بروز مي وتألقها في عالم الأدب والصحافة. وثالثها أن عدالة المسألة الفلسطينية ونضالات الفلسطينيين بوجه المشروع الصهيوني حفزت عدداً كبيراً من الكتاب (بينهم كاتبات وأديبات) على الانحياز العلني إلى جانب الفلسطينيين، وفي الوقت ذاته إدانة الممارسات الاستعمارية البريطانية التي كانت تشجع الاستيطان اليهودي غير الشرعي.
حملت مي أحاسيس خاصة وعميقة تجاه مدينة الناصرة، مسقط رأسها، عبّرت عنها بصورة شعرية رقيقة بعد أن غادرتها مع والديها إلى العاصمة المصرية: “كم سأفتقدك أيتها الناصرة! سأعيش على ذكراك عندما تنقضي حياتي وأيامي في غابات لبنان، أو في أرض مصر البعيدة. سوف أظل أحلم بجمال سمائك الزرقاء الصافية، وكواكبها الموشحة بالبراقع الشفافة، وبتلك الأمسيات العذبة حيث كان بصري يتيه في اللانهاية راغباً في أن ينعكس أديمها اللازوردي على صفحة نفسي (…). أيتها الناصرة لن أنساك ما حييت، سأجتر ذكرى تلك الهنيهات العذبة التي عشتها في ظل بيوتك الصامتة. سأحتفظ بذكرى خلجات قلبي الفتي، وعندما تطوف أفكاري حولك ستخمد مصابيحك شيئاً فشيئاً، ولكن روحي ستظل تحيا فيك إلى الأبد! لقد كنت يا مدينة الأزاهر مسرح أجمل أيام العمر، وكان قلبي أكثر تعلقاً بك من سائر مدن فلسطين”(52).
ولم تكتفِ مي بالكتابة عن الناصرة فقط، بل تضمن ديوانها “أزهار حلم” الصادر بالفرنسية سنة 1911، وهو باكورة نتاجها الأدبي، مجموعة من المقطوعات عن فلسطين. وذكرت سلمى الحفار الكزبري “أن لمي قصيدة غنائية جميلة عنوانها الناصرة Nazareth وأخرى بعنوان “قمم حطين” Les Cornes de Hettin ومقطوعات نثرية ضمنتها حبها الكبير لفلسطين وحنينها إلى ربوعها، سهولاً وجبالاً وبلداناً”(53). وبعد أن ترسّخت شهرة مي في العالم العربي كأديبة مجددة، قامت برحلات عدة إلى سورية وأوروبا بصحبة والديها. لكنها زارت فلسطين ثلاث مرات (1923 و1924 و1925) بمفردها للاستجمام وزيارة “الأراضي المقدسة”. وكل مرّة كانت تسجل أحاسيسها على الورق: “لست أدري أأنا أشد حباً للكرمل أم لجبل الطور المستدير هناك على صفحة مرج ابن عامر؟ قد تنتهي أيامي قبل أن أكون على بيّنة من الأمر”(54).
ما كتبته مي عن الناصرة تحديداً، وفلسطين عموماً، يندرج فقط في سياق مشاعر الحنين لذكريات مضت. وهي لا تعدو كونها عبارات وجدانية لا تصل إلى سوية الانتماء للقضية المصيرية كما عايشها الفلسطينيون يوماً بعد آخر. وربما يعترض بعضهم بالقول إن مي لم تكن على دراية بالمشروع الصهيوني وتداعياته الكارثية على سورية برمتها. لكن هذا العذر غير صحيح وغير مقبول. فهي كانت شديدة الاهتمام بمتابعة أحداث العالم، حتى وإن تجنبت الخوض في السياسة. أضف إلى ذلك أن التطورات الفلسطينية إحتلت صدارة التغطية الإعلامية وقتذاك. ففي رسالة شكر وجهتها مي في آذار سنة 1939 إلى كل من وقف إلى جانبها في محنتها “اللبنانية”، قالت: “أشكر فلسطين الدامية التي عرفت في إبائها أن تنسى محنتها أحياناً لتتألم لمحنتي”(55). ومن الأدلة أيضاً أن كتاباً وكاتبات “شاميين” مقيمين في مصر، كما مي وعائلتها، تناولوا المسألة الفلسطينية بشكل موسع على صفحات الصحف والمجلات التي نعتقد بأن مي كانت تطلع عليها! مثال على ذلك نقولا الحداد، الكاتب والصحافي المعروف، الذي عمل سنة 1910 في مجلة “المحروسة” لصاحبها إلياس زياده، والد مي. ونحن نعلم أن العلاقة بين العائلتين إستمرت حتى بعدما أصدر الحداد وزوجته روز أنطون (شقيقة المفكر النهضوي فرح أنطون) مجلة “سيدات ورجال” في القاهرة. فقد نشر حداد في آذار سنة 1929 (العدد الخامس، السنة العاشرة. صفحة 303 ـ 308) مقالاً عن الصهيونية حذّر فيه من مخاطر الآتي. وفي العام نفسه (عدد تشرين الأول) كتب مقالاً عنوانه “مسكينة فلسطين”، أدان فيه بريطانيا بقوة وهاجم الحركة الصهيونية(56).
ومن النساء الناشطات نذكر كلثوم نصر عودة فاسيليا (1892 ـ 1966)، وهي من مدينة الناصرة أيضاً(57). لكن النموذج الأهم، ويصلح للمقارنة مع مي في ما يخص المسألة الفلسطينية، يتمثل بالكاتبة والصحافية لبيبة ماضي هاشم (1882 ـ 1952) التي هاجرت من لبنان إلى مصر سنة 1896. وأصدرت في القاهرة سنة 1906 “فتاة الشرق” مجلة أدبية تاريخية روائية. وكانت تنتقد الذين يفضلون اللغات الأوروبية على العربية. كما هاجمت المدارس الأجنبية، ودعت إلى التوسع في إنشاء المدارس الوطنية. وما يعنينا هنا موقفها من التطورات الفلسطينية. فقد قالت عنها مجلة “الهلال” (عدد أيار 2003): “وكان لصاحبة “فتاة الشرق” يد طولى في التنديد بالحركة الصهيونية في فلسطين، فأخذت المجلة على عاتقها شرح أبعاد المشروع الصهيوني في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. واستفاضت في ذكر جهود اليهود في هذا المجال من جمعيات أسسوها ومؤتمرات عقدوها. وتناولت المجلة منذ عام 1929 مقاومة الفلسطينيين للمشروع الصهيوني، وأبرزت دور المرأة الفلسطينية والمؤتمر الذي شاركت فيه الفلسطينيات وطالبن فيه بإلغاء وعد بلفور ووقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين”.
ويزداد استغرابنا عندما نعلم أن أمين الريحاني، صديق مي وداعمها، أبدى في تلك الفترة اهتماماً خاصاً بالوضع الفلسطيني. فقد نشر هشام شرابي مقالاً(58) كشف فيه عن تحرك الريحاني لدى وزارة الخارجية الأميركية وتقديمه مذكرة بمطالب الشعب الفلسطيني. وكان الريحاني قد زار فلسطين في نيسان سنة 1927، أي قبل حوالي السنتين من أحداث البراق التي اندلعت في آب 1929. وأرسل بتاريخ 21 نيسان 1927 رسالة إلى عيسى العيسى صاحب جريدة “فلسطين” يصف فيها أوضاع الشعب الفلسطيني وقياداته قائلاً: “لا مفر لكم من الزعامات القديمة، ولا يستقيم أمر من أموركم في تفضيل زعامة على أخرى… فالحكمة تدعو لتعزيز كليهما”. ويضيف: “لو كان هناك حزب من الشعب ورجل من الشعب يرأسه لقال للأسرتين (الحسيني والنشاشيبي): قد ولى يومكما وأقبل يوم الأمة، فالاعتزال أو الامتثال”. ويختم رسالته: “الاتحاد، إخواني، الاتحاد وإلا ذهبتم فريسة الصهيونية على ضعفها الذي كشفته الأيام. وإذا نجوتم من الصهيونية تكونون بيد صاحب الأمر الأعلى، آلات للاستعباد”.
إن “اللاموقف” الذي اتخذته مي من المسألة الفلسطينية لفت أنظار عدد من الباحثين بين ناقد ومبرّر ومفسّر. ومن أبرز الذين حاولوا تبرير ذلك التجاهل الباحثة وداد سكاكيني. فمن ناحية أولى، أبدت استغرابها(59) “أن يزعم أحد المؤلفين أن كآبة مي في حياتها ومحنتها أنها عاشت سنيها الأولى في فلسطين. فكأن وراء شعورها في ذلك الزمن البعيد تحسساً بالغيب واندفاعاً عفوياً نحو المأساة الكبرى في نكبة الأرض المقدسة باغتصابها وتشريد أهلها. ولو صح هذا لكتبت في هذا الشأن، وأشارت إلى ما يدبر سراً وعلانية لسلب البلاد التي أحبتها وكان منها أهلها”. لكن سكاكيني نفسها تعود لتقع في الخطأ ذاته تقريباً عندما تقول في مكان آخر من كتابها(60): “… بل لو امتد عمرها إلى زمن النكبة والفجيعة بفلسطين، لثارت من أجل وطنها الأول الذي اغتصبته الصهيونية الباغية”.
لا يستطيع الباحث المتمعن في كتابات مي إلا أن يطرح تساؤلات مشروعة للغاية حول “غياب” الهم الفلسطيني عن أعمالها. فهل كان ذلك نتيجة “أزمة الهوية والانتماء”، أم أن مي كانت خاضعة لاعتبارات ضاغطة أو لنفوذ أشخاص بارزين، لديهم قناعات سياسية ذات تأثير عميق؟
تضافرت عناصر عدة، ذاتية وموضوعية، لصنع شخصية مي زياده السياسية أو اللاسياسية، في ظل حرصها على ترسيخ فكرة أنها لا تحب السياسة. وربما شعرت بأن اللاموقف يمكن أن يبعد عنها الملامة بسبب انحيازها للغرب أو لسكوتها عن جرائمه الاستعمارية. إضافة إلى ذلك، كانت طبيعة إلياس زياده المتحفظة تنعكس على ابنته، فتخلخل مشاعرها وتنأى بها عن الانتماء إلى وطنٍ تموت لأجله أو تحيا به. غير أن هذه العناصر والاعتبارات ما كانت لوحدها قادرة على دفع مي نحو اللاموقف القائم على تجاهل ما يتعرض له أبناء جلدتها في فلسطين. ففي الظل، تواجدت شخصية فاعلة رافقت تطور مي في أبرز محطات حياتها.
إدريس راغب باشا
كان إدريس راغب (1862 ـ 1928)، أحد أهم وأقوى الشخصيات الماسونية في مصر والشرق الأدنى في تلك الفترة. تولت مي إعطاء دروس خصوصية لبناته في منزلهن العائلي. فكان ذلك بداية علاقة قوية ووطيدة، توّجها إدريس سنة 1908 بمنح ملكية جريدته “المحروسة”، التي كانت متوقفة عن الصدور، ومعها مطبعتها إلى إلياس زياده للتعيّش من ريعها، وفي الوقت نفسه تكون صفحاتها منبراً تطل منه مي في محاولاتها الأولى للكتابة والنشر باللغة العربية. وبالفعل عادت “المحروسة” إلى الصدور مطلع سنة 1909 لـ”صاحبها ورئيس تحريرها إلياس زياده”. علماً بأن راغب كان قد اشتراها ومطبعتها سنة 1904، أي قبل انتقال عائلة زياده إلى مصر.
ليس الهدف من هذه الدراسة تقديم سيرة مفصلة عن حياة راغب، وإنما سنكتفي بالجوانب المتعلقة بموضوعنا الإشكالي، الذي يحاول الكشف عن طبيعة المشاعر السياسية التي حملتها مي.
تعود أصول عائلته إلى الأتراك الذين استقروا في المناطق اليونانية، ويُطلق عليهم لقب “الموره”. دخل الجد راغب في حاشية محمد علي باشا والي مصر ومن بعده إبراهيم باشا. وبعد وفاته تقلد ابنه إسماعيل مناصب حكومية رفيعة وصولاً إلى تولي رئاسة الوزراء في عهد الخديوي توفيق سنة 1882. كان لإسماعيل إبن وحيد هو إدريس، لذلك اهتم كثيراً برعايته وتربيته، فأحضر له أفضل الأساتذة. وهكذا إتقن إدريس اللغات الفرنسية والإنكليزية والتركية والعربية. وأبدى اهتماماً خاصاً بالكتابة الصحافية، فكان يراسل جريدة “المقتطف” التي تصدر في بيروت آنذاك ونشر فيها مقالات عدة ذات طابع علمي(61).
أنتمى إدريس إلى الحركة الماسونية سنة 1887 عضواً في محفل “كوكب الشرق” التابع لمحفل إنكلترا. وترقى سريعاً في عضويته ليصل إلى درجة “الأستاذ” سنة 1888. وفي سنة 1891 أنتخب رئيساً أعظم للمحفل الأكبر المصري. وقد أظهر نشاطاً مكثفاً لصالح الحركة الماسونية، بحيث وصل عدد المحافل المصرية في عهده إلى 54 محفلاً. وسخّر حياته كلها وثروته وممتلكاته في خدمة النشاط الماسوني في مصر. وبلغ من تقدير الماسونية العالمية لإخلاصه أن أنشأت محفلين يحملان إسمه، أحدهما “محفل إدريس” والآخر “محفل راغب” وهو ما لم يحدث لشخص غيره من قبل. أنشأ صحيفة تنطق باسم الماسونية، ثم أسس “الحزب الدستوري”(62). وفي عهده ارتفع شأن المحافل الماسونية في مصر حتى أصبحت هي القوة الخفية المهيمنة على نظام الحكم في البلاد.
ظل راغب على علاقة قوية بآل زياده، على الأقل من خلال جريدة “المحروسة” التي يبدو أنها شكلت نقطة لقاء وتفاعل لعدد من الصحافيين والكتاب المنتمين إلى المحافل الماسونية في مصر. ونلاحظ هنا وجود خيط ناظم يمتد من “المحروسة” ليربط عقد محرريها وكتابها، وصولاً إلى إدريس راغب الذي إشتراها ولم يصدرها، لكنه تنازل عنها بكل طيبة خاطر لصالح إلياس زياده… وهذا الخيط هو الإنتماء إلى الحركة الماسونية التي جمعت خلال القسم الثاني من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين نخبة المفكرين والأدباء والكتاب السوريين والمصريين، سواء في الوطن أو في المغتربات، تحت شعارات “الحرية والإخاء والمساواة”.
وعلى رغم أننا لا نملك ما يؤكد إنتماء إلياس زياده وابنته مي إلى أي محفل ماسوني آنذاك، فمن الصعب تجاهل احتمال أن يكون العامل الماسوني ساهم بصورة أساسية في إقدام إدريس راغب على إهداء “المحروسة” إلى والد مي، إذ يبدو لنا أن خطوة بهذه الأهمية، ونظراً إلى تاريخ الجريدة المشبع بالأجواء الماسونية وإرتباطاتها، لا تُفسّر فقط بشعور الشكر والتقدير لماري زياده التي علّمت بنات راغب. وكذلك لا نستطيع أن نتقبل رأياً آخر حاول تفسير “الإهداء” بعلاقة حب نشأت بين ماري وإدريس راغب: “يبدو أنه كان أمراً مفقوداً ومضروباً عليه، بدت به سيرة مي معماة في جانب منها، مع أنه عُرف وذاع وألمّ به الناس في حياة مي. ذلك صلتها الوثيقة العرى بإدريس راغب أستاذ المحفل الماسوني الأعظم يومئذ (…) ومن المعلوم يقيناً أن جريدة “المحروسة” التي ظهرت باسم أبيها إلياس زخور زياده، كان المنفق عليها والمشرف على إدارتها هو إدريس راغب الأستاذ الأعظم في الماسونية الذي أشرب في قلبه حب مي، وراشها هي وأهلها بخير”(63).
ولعل راغب قدّر لمي إهتمامها ببناته المحجبات وعكوفها على تدريسهن اللغة الفرنسية، ولعله أيضاً أعجب بها وبثقافتها العامة وانفتاحها على الحياة وهي في عز شبابها وتألقها، ولربما وقع إستلطاف بينه وبين تلك الشابة السورية القادمة حديثاً إلى القاهرة فصار يلتقيها علناً في “مقهى متاتيا”(64)… ولم تغب هذه الناحية من علاقة آل زياده بالوجيه الماسوني حتى عن معاصري مي، فعباس محمود العقاد الذي ربطته بها علاقة حميمة يقول في معرض حديثه عن ندوتها الأسبوعية: “وبين الزائرين الذين كانت لهم زلفى الرعاية الطويلة إدريس راغب رئيس المحافل الماسونية إلى عهد الملك أحمد فؤاد. ولم تكن مي من أعضاء المحافل الماسونية على ما أعلم، ولكن إدريس راغب كان يملك مطبعة “المحروسة” وينزل لوالد مي، إلياس زياده، عن حق إدارتها وإصدار الصحيفة منها”(65).
بات واضحاً الحضور القوي والمهيمن لشخصية من مستوى إدريس راغب، ويمكننا أن نتصور تأثيره العميق على المحيطين به والمرتبطين معه بعضوية الحركة الماسونية أو بمشاريع تحتاج إلى تمويل منه. وهناك أكثر من مؤشر يدفعنا إلى تحميله مباشرة أو مداورة جانباً من حالة “اللاموقف” التي عاشتها مي زياده تجاه المسائل السياسية، وفي طليعتها فلسطين الدامية كما وصفتها في إحدى رسائلها. فقد أصدر إدريس بياناً موقعاً بصفته رئيس المحفل الوطني الأكبر في مصر بتاريخ 2 نيسان 1922 تحت عنوان “نداء إلى أهالي فلسطين” يناشدهم الهدوء والسلام والعيش المشترك مع اليهود. وجاء في البيان(66):
“يا أهل فلسطين تذكّروا أنّ اليهود قد ركبوا متن الغربة، فأفلحوا ونجحوا، ثمّ هم اليوم يطمحون للرجوع إليكم لفائدة وعظمة الوطن المشترك، بما أحرزوه من مال وما اكتسبوه من خبرة وعرفان.
“أسمعوا وعوا هذا الصوت الذي تناشدكم به مصر شقيقتكم الكبرى، إنّها تدعوكم إلى السلام والوئام لمصلحتكم ولمصلحة الشرق… هذا الصوت المنبعث عن أرض تُفاخر وتُباهي بصلاح الدين…”.
طبعاً إندلعت ضجة وصلت أصداؤها إلى المهاجرين في القارة الأميركية. ولهذا حديث آخر في وقت آخر. أما مي زياده فاعتصمت بالصمت!!!
الهوامش:
1 ـ مراسلات خاصة بالإنكليزية عن طريق البريد الإلكتروني.
2 ـ مجلة “المقتطف”، المجلد 100، العدد الأول ـ كانون الثاني 1942. نقلاً عن كتاب “أحاديث عن مي”، صفحة 129.
3 ـ سلمى الحفار الكزبري، “مي زياده وأعلام عصرها”. صفحة 323.
4 ـ فاروق سعد، “باقات من حدائق مي”. صفحة 121.
5 ـ المرجع السابق، صفحة 123.
6 ـ راجع كتابنا “مي زياده صحافية”، دار الساقي ـ بيروت 2009.
7 ـ من رواد الندوة المداومين: ولي الدين يكن، طه حسين، خليل مطران، شبلي شميل، يعقوب صروف، أنطون الجميل، أحمد لطفي السيد، عباس محمود العقاد، أحمد شوقي، مصطفى صادق الرفاعي…
8 ـ سلامة موسى، “تربية سلامة موسى”، القاهرة – طبعة 1958، صفحة 348.
9 ـ واسيني الأعرج، “هل كانت مي زياده ماسونية ويهودية لاوية؟” جريدة “القدس العربي”، لندن. تاريخ 7 تشرين الثاني 2017.
10 ـ جميل جبر، “رسائل مي: صفحات وعبرات من أدب مي الخالد”. دار الرافدين ـ بيروت 2020، صفحة 10.
11 ـ مجلة “آفاق عربية”، السنة الرابعة ـ آذار 1979.
12 ـ أصدرها سليم نقاش سنة 1880 في الإسكندرية، وكانت قريبة جداً من السياسة الفرنسية. (فارس يواكيم، “الأسراب الشامية في السماء المصرية” ـ صفحة 47).
13 ـ أحمد حسين الطماوي، “ليلة باسمة في حياة مي”. صفحة 48.
14 ـ الكزبري وبشروئي، “الشعلة الزرقاء”. صفحة 81.
15 – “مذكرات طه حسين”، ص 45 – 46.
16 – حافظ محمود، “عمالقة الصحافة”، ص 118.
17 – سلامة موسى، “تربية سلامة موسى”، القاهرة – طبعة 1958، صفحة 230.
18 ـ “الهلال”، الجزء 38، شباط 1930.
* نفضل استخدام مصطلح اليقظة أو التنبه أو التنوير لوصف الحركة الفكرية والاجتماعية التي شهدتها سورية ومصر في مطلع القرن التاسع عشر (الاحتلال الفرنسي لمصر 1798). ذلك أن مصطلح “النهضة” له مفهوم محدد في الفكر القومي الاجتماعي يختلف عمّا يعطيه إياه أتباع المدارس الفكرية الأخرى.
19 ـ أنطون سعاده، “الأعمال الكاملة”، الجزء الثالث ـ صفحة 176.
20 ـ “كلمات وإشارات ـ 2″، صفحة 23.
21 ـ “بين المد والجزر”، صفحة 28.
22 ـ “كلمات وإشارات ـ 2″، صفحة 25.
23 ـ “ظلمات وأشعة”، صفحة 107.
24 ـ “كلمات وإشارات ـ 2″، صفحة 34.
25 ـ جميل جبر، “مي في حياتها المضطربة”، صفحة 173.
26 ـ نقلاً عن مجلة “صباح الخير” اللبنانية، العدد 64. تاريخ 1 تشرين الثاني 1976.
27 ـ فاروق سعد، “باقات من حدائق مي”، صفحة 123.
28 ـ فارس يواكيم، “الأسراب الشامية في السماء المصرية”. صفحة 20.
29 ـ مجلة “المقتطف”، المجلد 100، العدد الأول ـ كانون الثاني 1942. نقلاً عن كتاب “أحاديث عن مي”، صفحة 129.
30ـ أنطون سعاده، “أيام مي الأخيرة” (15 كانون الأول 1941) في “الأعمال الكاملة ـ المجلد الرابع” صفحة 320.
31ـ جميل جبر، “مي في حياتها المضطربة”. صفحة 60.
32 ـ وداد سكاكيني، “مي في حياتها وآثارها”. صفحة 144.
33 ـ المرجع السابق، صفحة 99.
34 ـ سلمى الحفار الكزبري، “مي زياده أو مأساة النبوغ” الجزء الأول ـ صفحة 205.
35 ـ أنطون سعاده، مرجع سابق، الجزء الأول. الصفحات 29 ـ 42.
36 ـ الكزبري، مرجع سابق. صفحة 312.
37 ـ المرجع السابق، صفحة 233.
38 ـ جميل جبر، مرجع سابق. صفحة 176.
39 ـ مجلة “المحروسة”، 20 تشرين الأول سنة 1914.
- ـ جوزيف زيدان، “الأعمال المجهولة لمي زياده”، الصفحات 215 و224.
41 ـ الكزبري، مرجع سابق. صفحة 392.
42 ـ فاروق سعد، “باقات من حدائق مي”. صفحة 364.
43 ـ أنتيا زيغلر، “مي زياده: كتابات منسية”. صفحة 301.
44ـ وداد سكاكيني، مرجع سابق. صفحة 117.
45 ـ مجلة “صباح الخير” اللبنانية، العدد 63. تاريخ 25 تشرين الأول 1976.
46 ـ سكاكيني، مرجع سابق. صفحة 59.
47 ـ مجلة “آخر ساعة”، العدد 924، تاريخ 9 تموز 1952. نقلاً عن كتاب “السر الموزع للآنسة مي”، فاروق سعد. صفحة 345.
48 ـ وداد سكاكيني، مرجع سابق. صفحة 209.
*أسسها في القاهرة سنة 1885 كل من فارس نمر ويقوب صروف. “وكانت جريدة موالية للسياسة البريطانية بصراحة واضحة وبالتزام تام”. (فارس يواكيم، “الأسراب الشامية في السماء المصرية”، صفحة 125).
49 ـ الكزبري، مرجع سابق. صفحة 310.
50 ـ من أبرز تلك الصحف جريدة “الشورى” التي أصدرها الصحافي الفلسطيني محمد علي طاهر في القاهرة سنة 1924. ويقول الطاهر في مقابلة صحافية (مجلة “كل شيء والدنيا” بتاريخ 14 أيلول 1936: “ولعل أفظع ما رأته الإنسانية من الغدر والنكث هو ما أصاب فلسطين. فقد فُصلت عن سورية الكبرى الأم، ثم فرض عليها الانتداب أو الاستعمار فرضاً. وبعد ذلك أخذوا في إنشاء وطن قومي يهودي فيها، وإذا بهم يريدون جعلها كلها وطناً قومياً لليهود”).
51 ـ مجلة “الكاتب الفلسطيني”، العدد 11، كانون الثاني 1980.
52 ـ من ديوان شعر “أزهار حلم” Fleurs de Reve الذي صدر في القاهرة سنة 1911 بتوقيع مستعار “إيزيس كوبيا” Isis Copia صفحة 113، مقطوعات نثرية، ترجمة الدكتور جميل جبر.
53 ـ “مي زياده أو مأساة النبوغ”، المجلد الأول. مؤسسة نوفل ـ بيروت، الطبعة الأولى 1987.
54 ـ مي زياده، “الصحائف”. صفحة 147.
55 ـ جوزيف زيدان، “الأعمال المجهولة لمي زياده”. صفحة 326.
56 ـ سلمى مرشاق سليم، “نقولا الحداد الأديب العالم”. صفحة 196.
57 ـ مجموعة باحثات وباحثين، “النساء العربيات في العشرينات”. صفحة 341.
58 ـ جريدة “النهار” اللبنانية، تاريخ 3 آب 1995.
59 ـ “مي زياده في حياتها وآثارها”، صفحة 18.
60 ـ المرجع السابق، صفحة 67.
61 ـ اعتمدنا في هذه السيرة الموجزة على كتاب “الحقائق الأصلية في تاريخ الماسونية العملية” للماسوني شاهين مكاريوس. طبعة “مؤسسة الهنداوي”، القاهرة 2015.
62 ـ واسيني الأعرج، جريدة “القدس العربي”، لندن. تاريخ 7 تشرين الثاني 2017.
63 ـ حسين عمر حمادة، “أحاديث عن مي زياده وأسرار غير متداولة من حياتها”. دار قتيبة – دمشق الطبعة الأولى 1983. صفحة 10-11 (نقلاً عن أحمد أبو الخضر منسى: “مي زياده”، مجلة الكاتب العربي، العدد 12، تاريخ 10 أيار 1965، صفحة 45).
64 ـ أحمد حسين الطماوي، “ليلة باسمة في حياة مي” – صفحة 49.
65 – عباس محمود العقاد، “رجال عرفتهم” – صفحة 212 – 213.
66 ـ جريدة “الجريدة”، سان باولو، في 22 تموز سنة 1922.