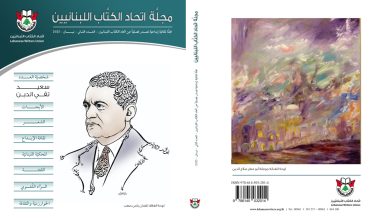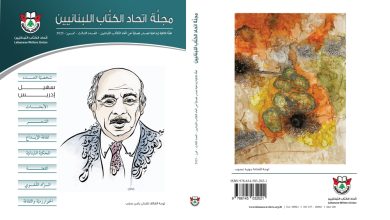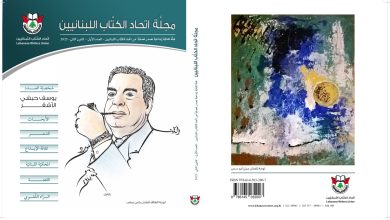الأثر وتمثّل الهوية الشعرية في نصيّ “سخاء الزمن” و”كون متماسك/إنسان أخرق” للكاتبة حكمت حسن

الأثر وتمثّل الهوية الشعرية
في نصيّ “سخاء الزمن” و”كون متماسك/إنسان أخرق” للكاتبة حكمت حسن
أ. خليل عاصي
سخاء الزمن
هزيمة المكان نبوءةٌ
المادّة كثافةٌ موؤودةٌ
وصولنا استقالة الغاية
استحالة الممكن ممكنةٌ
تكسّر الإطار رغبةٌ
وما بعدها
سلاسل متناقضةٌ
ممتلئةٌ هي الحياة
خيارنا حلقاتٍ متراصّةٌ
نملأها
نفرغها
نعدّدها
فالآمر فينا هو الكلّ
حين يستجيب
كون متماسك/ إنسان أخرق
رؤيةٌ لا تتّضح لها رؤيا
رؤيا لا تتزامن مع مثيلاتها
أتكون الأفكار سرّيّةً فيما منابعها مفتوحةٌ؟
كوننا بحجم الفكر
يتوالد منه وفيه
أتكون الحدود أفكاراً متعالية نطالها؟
أنكتب إثماً في الزمن يبقى للزمن؟
لا شكل لفكرنا
لا شكل لكوننا
ولبراءتنا كأطفال نرسم دائرة
أ. حكمت حسن
من ديوان “نصف شمس تعبث بنا” الصادر عن دار نلسن 2024
قبل أن نسبر أغوار هذين النصين في محاولة لتفكيكهما، أو تأويلهما للوقوف على الغاية الجمالية منهما، أكان على مستوى البنية التركيبية أم على مستوى المعنى، علينا أولا أن نعمل على تحديد هويتهما الأدبية. تحت أيٍّ من الأجناس الأدبية يمكن أن نضعهما؟ ثم هل يمكننا تحديد الفن وتأطيره في أنماط وقوالب معينة أم أن شرط الفن هو الحرية والإبداع بغض النظر عن الكيفية والمقاربة؟
لقد حافظ الشعر العربي على شكله الكلاسيكي المتمثل بالقصيدة العمودية إلى في بداية القرن التاسع عشر، إبّان ظهور الإرهاصات الأولى التي فتحت كوّة للتمرد على نظام البيت عبر الانتقال إلى البناء الشعري الحر، مع شعراء المهجر. الأمر الذي أدى إلى نشوء صراع بين مجدد ومحافظ ، قاد فيما بعد، في أواسط القرن نفسه مع نازك الملائكة وبدر شاكر السياب، الى نشوء قصيدة التفعيلة التي توفق بين الاثنين معا. وهذا الخروج الذي جاء طبيعيا لسببين.
الأول: التأثر بالأدب الغربي الذي انتقل إلينا عبر الترجمة والذي كان مكتنزا بالموضوعات الجديدة الناتجة عن مخاضات عصر التنوير والمدارس الفكرية المزدهرة وقتذاك، والتي تناولت موضوعات الانسان والوجود والطبيعة والتأمل في أشكال ادبية مختلفة مثل الرمزية، الدادائية، البرناسية، الوجودية، العدمية، وغيرها… الأمر الذي فتح على مقاربة موضوعات جديدة لم تكن مطروقة كثيرا في الشعر العربي، وبطبيعة الحال انسحب هذا التجديد على الشكل ليتلاءم مع المضمون.
الثاني: التململ من جمود القصيدة العمودية ومكوثها في شكل محدد منذ العصر الجاهلي، وبالتالي كان لا بد من التمرد في محاولة لاكتشاف أنماط وأنساق ومقاربات جديدة، حيث أن البيت الشعري في القصيدة العمودية يفرض عليك حقلا معجميا معينا يتناسب مع الإيقاع والقافية.
إذن، كان لا بد من محاولة الخروج من قيود القصيدة العمودية بغض النظر عما اذا كان هذا الخروج سيكون للأفضل أم لا. على الرغم من الأدلة الواضحة على ان امكانية التجديد داخل القصيدة العمودية كانت وما تزال متاحةً، وهناك أمثلة لا حصر لها تؤكد ذلك، ولكن لا ضرر في المحاولة، فالفن والإبداع يتحققان بما يتركانه من أثر ودهشة في المتلقي، وليس من خلال الهندسة اللغوية والنسقية والشكلية على أهميتها. وهذا يجعلنا أمام سؤال أساسي لا مناص من طرحه. ما الذي يجعل النص الأدبي شعراً إذا ما تخففنا من الشروط الشكلية؟ وما المائز الذي يُسبغ على النص سمة الشعر؟. قولنا في ذلك: إن جوهر الشعر ومناط وجوده شعرا، يشبه جوهر الإنسان كما عرّفه أرسطو، هو اتحاد أقانيم ثلاث (عقل، روح، جسد)، فلا إنسان بلا عقل، ولا إنسان بلا روح ولا إنسان بلا جسد. كذلك الشعر، لو قمنا بإسقاط هذه النظرية عليه، سنجد أن العقل يجانس الفكرة، والروح تجانس الشعرية والجسد يجانس الشكل بمعزل عن أنساقه، إذ إنه لا شعر بلا فكرة ولا شعر بلا شعرية (روح) تجعل النص نابضاً بالحياة، ولا شعر بلا الشكل الذي يعدُّ مسوّغاً وجودياً له. فإذا توافرت هذه الأقانيم الثلاثة في نص أدبي، يمكننا أن نسميه شعرا، بمعزل عن شكله أكان عموديا او تفعيله أو نثيره، ومن نافل القول، أن أصعب الأشكال في المقاربة الشعرية هي النثيرة، كما يحب أن يسميها سعيد عقل، أو ما يعرف بقصيدة النثر، ذلك أنه يجب عليك أن تبذل جهدا مضاعفا كي تقنع المتلقي بأن ما تكتبه هو شعر. فقصيدة النثر تفتقر إلى الروافع والمحسّنات الفنية كالقافية والرويّ والوزن والتصريع وغيرها، وهي مطالبة بجذب انتباه المتلقي بمجّانية صرفة وابتكار أنساق لغوية خاصة ومتغيرة وغير مطروقة، هذا شكلا، أما في المضمون فلا شكّ أن صعوبتها تكمن في معالجة الموضوع، لأن هذا النوع من الشعر يكشف خلفية الشاعر الفكرية والثقافية وما إذا كان الشاعر ممتلئا بالموضوع الذي يعالجه أم لا. كما يكشف عن قدرة واتساع المناورة المخيالية لديه.
إن هذه المقدمة برأيي، كانت ضرورية قبل الولوج إلى نصّي الكاتبة حكمت حسن، لنسهّل على القارئ تلقّفَ ما سيؤول إليه تفكيك هذين النصين، ثم نترك له القرار فيما إذا كان هذان النصّان يندرجان تحت ما تقدم أم يجانبانه.
من الواضح أن النظرة الأولية تحيلنا إلى أن هوية هذين النصين هي النثيرة التي تعالج موضوعها بالاتكاء على الرمز المتحدّر من الوجودية، وهذا ما يشي به عنوانا هذين النصّين “سخاء الزمن” و”كون متماسك/إنسان أخرق“. هذان المدخلان يحيلان منذ البداية إلى الزمن الأصيل، والكينونة أو الوجود هناك في العالم، اللذين يشكلان ركيزة الفلسفة الوجودية عند هيدغر. ربما لم يتسنّى للكاتبة الاطلاع على هذا الفيلسوف الصعب، لكنها حتما تشاركت معه الهاجس نفسه، فالشاعر فيلسوف مشوّش يعبّر عما يجود به مخياله من دون أن يبحث في المنطلقات والمآلات. كل جملة من هذين النصين يمكن أن نجد أثرا لها في الفلسفة الوجودية، فهل قصدت الكاتبة في قولها “هزيمة الزمان نبوءة، المادة كثافة موؤودة“، أن الزمن السَيَلانيّ يُعدمُ المكان لما يضفيه عليه من تغيُّر دائم؟، أم أن هذا الانعدام للمكان يأتي من تكثّف المادة حتى وصولها إلى الوجود الخالص، الذي يعني العدم عند هيغل؟ إن في هذا الطرح تحريض واضح على التأمل والتفكير بعمق. وفي تعبير لافت آخر تقول الكاتبة “وصولنا استقالة الغاية، استحالة الممكن ممكنة“. والوصول هنا، هو في الحقيقة سلب لحركة الكينونة، إذ إنّ الوجود الحرّ والأصيل هو الوجود هناك، الوجود الآتي من المستقبل، والطريق إلى الهدف – بما هو مستقبل – أهم وأجمل من الوصول إليه، لأن التجربة والمغامرة والاكتشاف كلها كمائن مزروعة في الطريق إلى الغاية، وما أن تصل حتى تنسدل الستارة على دينامية الوعي فيصبح أمام سؤال وجودي حقيقي، هل “استحالة الممكن ممكنة“؟ فلو كان الجواب بنعم؛ كان السقوط في العبثية والعدمية واللاجدوى، وإن لم، فذلك يعني العودة إلى نقطة البداية للنظر في اجتراح غايات أخرى تعيد الكينونة إلى حركيّتها.
تقول الكاتبة أيضاً:
“تكسّر الإطار رغبةٌ
وما بعدها
سلاسل متناقضةٌ
ممتلئةٌ هي الحياة
خيارنا حلقات متراصّة
نملأها
نفرغها
نعدّدها
فالآمر فينا هو الكلّ
حين يستجيب”
في هذه المقطوعة يمكننا أن نستشرف القلق الذي تعيشه الكاتبة، والذي يتماوج بين الرغبة في التمرد، والخروج من الإطار، وبين ما ينتظرنا في الحياة من تناقض ومتاهات، لا تفضي إلى رؤية واضحة، وصولا إلى نفي تقرير المصير عن الإنسان في هذا العالم، فالقرار هنا هو بيد العقل الجمعي أو الآخر، “فالآمر فينا هو الكل حين يستجيب” وهذا ما يتصادى مع فكرة “مكر العقل الكلي” عند هيغل، الذي يوهم الإنسان بالقيادة بينما يكون هو المُقاد.
في نصها الثاني تقول حكمت:
“رؤيةٌ لا تتّضح لها رؤيا
رؤيا لا تتزامن مع مثيلاتها
أتكون الأفكار سرّيّةً فيما منابعها مفتوحةٌ؟
كوننا بحجم الفكر
يتوالد منه وفيه
أتكون الحدود أفكاراً متعالية نطالها؟
أنكتب إثماً في الزمن يبقى للزمن؟
لا شكل لفكرنا
لا شكل لكوننا
ولبرائتنا كأطفال نرسم دائرة”
كأنَّ الكاتبة تريد أن تكشف لنا عن الحالة الضبابية الحادة التي تعيشها، لا بل يصل بها الحال إلى أنَّ الرؤى نفسها تحاول عبثا العثور عن معنى لوجودها، “رؤيةٌ لا تتّضح لها رؤيا، رؤيا لا تتزامن مع مثيلاتها“.
تنتقل بعد ذلك من اللاوعي حيث الرؤى، إلى الوعي حيث الأفكار المتعالية بعيدة المنال، ثم تطرح سؤالا وجوديا آخراً: “أتكون الأفكار سريّة ومنابعها مفتوحة ؟”، وهذا يجعلني أتساءل ايضا، هل حقا الأفكار سرية؟ اذا كانت كذلك، فما معنى قول ديكارت أن العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس، إذ إنَّ آليات التفكير عند الإنسان واحدة، تعمل وفق أنساق وأنماط متشابهة، وهذا ما يفسر الكثير من الظواهر الحياتية المعاشة كالتخاطر وفهم الآخر من دون أن يتكلم أحياناً، فنحن نستطيع استنطاق الصمت وتأويله، وما كان لهذا أن يكون لولا أنَّ منابع الأفكار مفتوحة، يمكن أن نغرف منها جميعاً من دون أن تتشابك الأيدي.
أثر فلسفي آخر تضعه الكاتبة في هذا النص وهو : “كوننا بحجم الفكر يتوالد منه وفيه” وهذا يحيلنا أيضاً إلى هيدغر الذي يرى أن الفكر يساوي اللغة، التي بدورها تمثّل بيت الكينونة، حيث أنَّ الإنسان المفكّر هو الذي يُسبغُ المعنى على الوجود من خلال “الدازين”، فقولها كوننا بحجم الفكر، يعني الكون كما نعرفه نحن، أو كما نفكر فيه. في العبارات الأخيرة من النص، انزلاق واضح للكاتبة إلى العبثية بسبب غياب الأجوبة الشافية، وضبابية الرؤى، وصعوبة استشراف الغيب، انطلاقاً من قراءة واقعية متشائمة، حيث تذوب الآمال في وحول ومستنقعات الأحداث الجائرة والخالية من البياض ما يؤدي إلى سيطرة ظلامية مطبقة.
بعد هذا التفكيك للنصوص، والذي كشف عن وعيٍ فلسفيٍّ كامنٍ بقوة عند الكاتبة، وعيٍ يحرّكه الألم، ويصقله القلق، ويؤرّقه البحث عن الذات والمستقبل.
لسنا بصدد مناقشة هذه الافكار التي تعبّر عن شعور الكاتبة وعن البرهة الزمنية التي دفعت بها إلى الحفر والنَّبش في هكذا موضوعات. ما يعنينا هو ما طرحناه في بداية هذه القراءة، وهو سؤال الهوية التي ينتمي إليها هذين النصين، فهل استحوذا فعلاً على أقانيم الشعر الثلاثة؟ يمكننا أن نتحرَّى الفكرة العامة رغم حضورها مبعثرة ومشتتة في أرجاء النص، وهذا مبرّر ربما لانسجامها مع طبيعة المعالجة، لكننا حينما نتتبّع الروافع الفنيَّة الجاذبة للمتلقي لا نجدها، وهذا ما يجعل قراءة النص، قراءة نخبوية خاضعة لنظام فكري وثقافي ومنطقي صارم. في بنائها النسقي للنصوص، نرى أن الكاتبة قد التزمت ببعض شروط قصيدة النثر التي أصلّت لها سوزان برنار، وأضاف إليها أنسي الحاج، مثل: اعتماد الجمل القصيرة، التقليل من أدوات الربط، الإيجاز، المجانية،… لكنها تكاد تخلو من أهم شروطها وهو “التوهّج” الذي يعني الشعرية او الروح التي تجعل العشب ينمو أخضراً في حنايا القصيدة، بل وتجعل رائحة الورد عابقة على قميص اللغة، والبسمة مسمّرة على شفاه المعنى والدَّمعة واقفة على شفير الانهمار. وبالتالي، فلو أردنا أن نمنح هذين النصّين هويَّة فنيَّة، لصحّ أن نسميها شذرات فكريّة محرضة على التفكير والتأمل، وفي ذلك متعة لا تقل شأنا عن الشعر، بل قد ترتقي أحيانا مع بعض النصوص عنه وتتجاوزه، كما يعتقد سارتر. لأن النثر المكثّف الممتلئ بالموضوعات الإشكالية، والمكتظ بالأسئلة، هو الأقدر على استنطاق الوجود استنطاقا محايثا أو متعالياً وعلى التنقيب عن الدُّروب المغمورة التي تفضي إلى مآلات معرفية مُلحّة، وعن الغاية من وجودنا في هذا العالم.