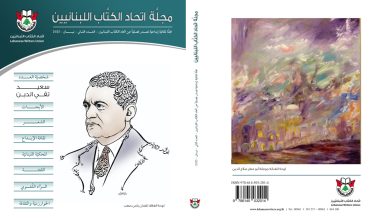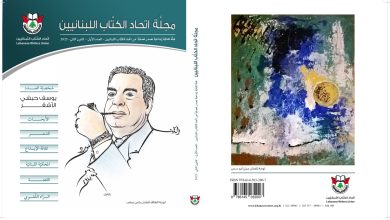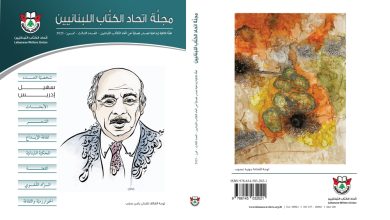اللّعب اللغويّ والوجود الحركيّ لذّة النّص وتجربة القراءة في قصيدة “سخاء الزمن وكون متماسك/ إنسان أخرق”

اللّعب اللغويّ والوجود الحركيّ
لذّة النّص وتجربة القراءة في قصيدة “سخاء الزمن وكون متماسك/ إنسان أخرق”
د. سُميّة عزّام
سخاء الزمن
هزيمة المكان نبوءةٌ
المادّة كثافةٌ موؤودةٌ
وصولنا استقالة الغاية
استحالة الممكن ممكنةٌ
تكسّر الإطار رغبةٌ
وما بعدها
سلاسل متناقضةٌ
ممتلئةٌ هي الحياة
خيارنا حلقاتٍ متراصّةٌ
نملأها
نفرغها
نعدّدها
فالآمر فينا هو الكلّ
حين يستجيب
كون متماسك/ إنسان أخرق
رؤيةٌ لا تتّضح لها رؤيا
رؤيا لا تتزامن مع مثيلاتها
أتكون الأفكار سرّيّةً فيما منابعها مفتوحةٌ؟
كوننا بحجم الفكر
يتوالد منه وفيه
أتكون الحدود أفكاراً متعالية نطالها؟
أنكتب إثماً في الزمن يبقى للزمن؟
لا شكل لفكرنا
لا شكل لكوننا
ولبراءتنا كأطفال نرسم دائرة
أ. حكمت حسن
من ديوان” نصف شمس تعبث بنا” الصادر عن دار نلسن 2024
مكابدة القراءة تعادل مكابدة الكتابة. والعناء فيهما كلتيهما ينحاز إلى الجانب الآخر المغاير من المعنى، الجانب المدهش لما نخاله شقاءً. ففي المغايرة متعة، وفي التجربة دهشة السؤال. وتجربة المحاورة تعلّمنا أنّ القصيدة – أيّ قصيدة- تخلق قواعدها الخاصّة بكسرها أي قاعدة سابقة عليها. وفي الخلق ولادة للعبتها اللغوية. وقبل أن ننتبه إلى عنوان الديوان “نصف شمس تعبث بنا”، نكاد في غفلتنا نشعر بأننا منساقون مع النهر، فعلينا أن نجيد التجذيف. هي قصيدة – في وحدتين مكثّفتين؛ وإذ تتقن فنّ اللعب، تُدخلنا في اللعبة علّنا نفهم قواعدها، ونتعرّف باللاعبين والمواقيت واحتمالات الفوز والانهزام، وممكنات المعنى.
سخاء الزمن ولعبة الأسئلة
أن نجد منفذاً لدخول القصيدة يبدو من أشقّ المهمّات. لعلّ العنوان في الوحدة الأولى يعلن عن موضوعه؛ وموضوعه هو “الزمن”. لكنّ المكان بلفظه ومادّته وكثافته وإطاره هو ما يطالعنا في متن النصّ. ليستمرّ حضوره في الوحدة الثانية، وذلك في وصف الكون ومتعلّقاته اللفظية من شكل وحجم ورسم وحلول ودخول، جنباً إلى جنب مع ألفاظ الزمن والتزامن أو عدمه. إلّا أنّ الحضور لا يُعلَن عنه بالكلمة، بل بما تفعله؛ فالكلمة فعل. ومهمّة الزمن الحدوث والتحقّق؛ ولا حدث بغير مكان يجري فيه. فنحن في هذا اللهو بين الزمان والمكان بخصائصهما المتباينة، أمام تكامل وتلازم وجودي لكليهما؛ حيث لا نتعقّل أيّ منهما إلا بالقياس إلى الآخر. يصحّ -والحال هذه- إطلاق الاصطلاح الفلسفي “تضايف الأضداد”؛ حيث إنّ تصوّر الأوّل يتوقّف على تصوّر الثاني. فما السخاء؟ وكيف يكون الزمن سخيّاً؟
للإجابة عن سؤال سخاء الزمان، نذهب إلى موقع الإنسان في هذا النسيج الكوني، تحدّده عبارة “ممتلئة هي الحياة”. فالسخاء هو الامتلاء، والرغبة نقص في سعي مستديم إليه، ولا وصول: “وصولنا استقالة الغاية”. والوقت في كرمه يتيح الفرص والخيارات والإمكانات والحركة؛ لكي نملأ الحياة ونفرغها ونخصبها ونعدّدها وفق خياراتنا، وبما نرغب. والإجابة عن سؤال: متى يكون الزمن سخيّاً؟ تفيد به الظرفيّة الزمنيّة لاستجابة “الكلّ” فينا، بالقول: “حين يستجيب”. وقبل فحص مدلول “الكلّ”، تستوقفنا جملة “استحالة الممكن ممكنة”؛ فنتبيّن أنّها تختزن اللعب الحركي في تبادل المواقع والتناوب بين الإمكان والاستحالة. بل إن كلمة الاستحالة تحمل المعنيين المقصودين معاً: انعدام الفُرص، والتحوّل. عدم الإمكانية، قد يتحوّل إلى إمكانيّة في ظروف تسعف على تحقّق الحدوث، ووفق تبدّل القوانين. إنّما القوانين التي تحكم هذا التغيّر/ اللعب ليست خارجنا بل “فينا” وتتحدّد في “الكلّ” الآمر؛ وما الكلّ إلا قوة الاقتدار.
سيولة المكان ولعبة الزمن
أيكون منبع الخيار في الرغبة أم الإرادة؟ أو في الاثنين معاً؟ في تحديدها النفسي، تفتقر الرغبة إلى الاتزام بالفعل، بينما تتجاوز الإرادة الرغبة؛ إذ تنطوي على التصميم والمثابرة والقدرة على الفعل. وهكذا تكون الاستجابة في بذل الجهد اللازم لتحقيق ما هو ممكن، ولتغيير موقع المستحيل بنقله إلى ما يقابله. و”الأنا” وسط هذا التكثير من الاحتمالات ، وفي امتنانها لسخاء الزمان، ولما يخلقه من “سلاسل متناقضة”، ما هي إلا تجسيد لاختياراتها في العالم المعيش. فإن كان الزمن هو واضع قوانين اللعبة، فالكون ملعبنا، ونحن اللاعبون، ولنا أن تصوّر ما نجنيه من متعة في هذا اللعب المُضني.
تصوّر التناقضات لا يقف عند حدود عبارة “سلاسل متناقضة” بحلقات الخيارات المتراصّة. فالمفهوم ينفتح على معنى السيولة لا التقابل؛ إذ منذ البدء نجد توليفاً لغويّاً للتضاد بين كلمات تحمل دلالات الإيجاب، مثل: (النبوءة، والوصول، والغاية، والممكن، والامتلاء، والاستجابة)، وأخرى تحمل دلالات السلب والنفي، مثل: (الهزيمة، والوأد، والاستقالة، والتكسّر). وثمة كلمات تختزن النفي والإيجاب معاً، مثل: الاستحالة. لكنّ جمعها في مركّبات اقترانيّة تتيح لنا الدخول في لعبة الحدود المائلة واللا تحديد، فيحلو لنا أن نسبغ على وجودها عبارة “سيلان المتناقضات”. وعليه، الأنا المتجسّد هو نتاج هذا النسيج الزمكاني؛ حيث إنّ انسجام المتناقضات هو الذي يخلق ديمومة الكينونة. فلا ثابت إلا الحركة، ولا مكان إلا صيرورة المادّة، ولا رغبة إلا في تكسير الأُطر ومجاوزة الحدّ. إذاً، هي إرادة البلوغ تنقلنا إلى الوحدة الثانية من القصيدة، وتُدخلنا في قلب العلاقات المثلّثة: الفكر، والكون، والزمن.
الأنا في النسيج الكونيّ: كوجيتو الحالِم
اللافت في شكل عنوان الوحدة الثانية وجود الشَّرطة المائلة بين مركّبين وصفيين: كون متماسك وإنسان أخرق. وفي حين أنّ هذه العلامة تقودنا إلى علاقة التقابل بين الجزء والكلّ، فهي تضعنا في قلب إشكاليّة التساؤل عن القصديّة. فهل أنّ الإنسان إزاء هذا الكمال والتعالي والتناسق والانسجام للكون (العالم) أخرق، بمعنى النقص والحمق والجهل؟ وبالتالي يتبدّى سعيه لفهمه سعياً عبثيّاً يُظهره بمظهر الأخرق في تصوّراته الجزئيّة جميعها، وتحديداته القارّة. أمّ أنّ ظنّه الكمالَ في الكون هو اعتقاد أحمق؟، السؤالان -في طبيعة الأمر- يكمّل بعضهما بعضاً لتحرّي الإجابة عن معنى الوعي بالعالم.
لفظتان تؤكّدان الانفتاح واللا اكتمال، كما تحيلان إلى الحسّي والفكري في التجربة؛ وهما: الرؤية (البصريّة/ الحسّيّة)، والرؤيا (التصوّر الفكري والتخيُّل). والرؤيا بدورها تذكّرنا بالنبوءة في الوحدة الأولى. فما أُنبئ به هو هزيمة المكان ووأد الكثافة في المادة، وهذا يعني بقاءها في صورة الهيولى (المادّة الأوّلية/ الوجود بالقوّة) قبل التشكّل. تستمر فكرة التعدّد والتكثير والانحلال للأفكار والتصوّرات للمعنى الهادي لوجودنا، وتتأكّد مع انفتاح المنبع على كلّ فكرة تتولّد منه وتعود إليه. فاقتران الحسّي بالتأمّلي يفضي بنا إلى مفهوم الوعي بأنّه (أي الوعي) إدراك الأشياء من خلال تجارب حسّيّة وتأمّليّة. فالعالم إذاً، يُدرك كظاهرة تُبنى داخل وعينا، ويتشكّل بحجمه وأبعاده وَفق أفكارنا على اختلافها وتنوّعها. وما نحن إلا في حالة حوار مع الكون/ عالمنا، حوار الحالِم والمحلوم به.
كم نحن سُذّج أمام هذا الكمال، أو أنّ الاكتمال يُخيّل لنا؛ فنقع في إثم الظنّ! ونلجأ حينئذٍ إلى الكتابة بوصفها كَفارة، ونحمّلها رؤى ضبابيّة (رؤية لا تتّضح لها رؤيا) يحفظها الزمن لنا، ولمن سيأتي بعدنا متابعاً في طريق الحمق نفسه (رؤيا لا تتزامن مع مثيلاتها). ولأنّ العالم موجود كما نحلم به، يتراءى لنا مختلفاً باختلاف نظرتنا إليه، ووفقاً لاختيارنا. ولا نلهو بالكتابة وحدها، بل بالرسم. ولا نتخيّل الكون إلا في شكل دائرة، وقد يكون صورة عن أحلامنا. فلِم الدائرة فحسب؟ ببساطة، لأنها رمز الكمال، والوحدة الكونيّة، والقوّة المركزيّة، والتعبير الأكمل عن العقلانيّة والاستقرار. لذا، نتخيّل تماسك الكون ووحدة الزمن في دائرة، هذا الشكل الأبسط والأوضح؛ فنختزل -ببراءة- تعقيدات الفهم في تبسيط متناهٍ.
مع الدائرة نتذكّر تجربة سيزيف، في التكرار والعودويّة، في حمله الصخرة صعوداً لإعادتها إلى قمة الجبل في كل مرّة تتدحرج هابطة إلى أسفل. تصوّره ألبير كامو سعيداً، بالرغم من ارتسام اللا جدوى في عمله. إنما لم نعرف إن كان سيزيف هو من يعي عبثيّة ما يعمل، أم أنّ الوعي بهذه اللا جدوى يعود إلينا؛ ربما حقيقة العمل اشتبهت علينا، فأسأنا التوصيف. على أيّ حال، لنا أن نفهم المعادلة على نحوٍ يخصّنا، متسائلين عن سرّ السعادة في التكرار، مستدركين أنّه ليس تماثلاً في التجربة، في استعادته تجربةً سابقة عليه، بل إنّه انتشار وتحويل، تماماً كرجل هيرقليطس في تجربة نزوله إلى النهر. هل في تكرار المحاولة لرفع الصخرة وإعادتها إلى مكانها -موضعها الأوّل- يبقى سيزيف نفسه، أم أنّ ثمة شيئاً تغيّر في سعيه ورؤاه إلى ما يحاول إنجازه؟
الإجابة طيّ فعل الكتابة، ومثيلتِها في تجربة القراءة، في رسمهما الدوائر إلى ما لا نهاية؛ كي يزهر المعنى في داخلنا. وهذه القصيدة القائمة على التدفّق، والمناطق الضبابيّة، والحدود المائلة، وتآلف الأضداد، واللايقين، والتشظّي، تليق بها القراءة التفكيكيّة، لفكّ رموزها الوجوديّة، وملء الثغرات؛ مع علمنا أنّ كل قراءة هي سوء قراءة، ولا تفصح.