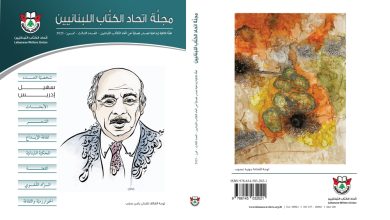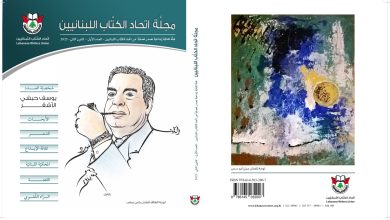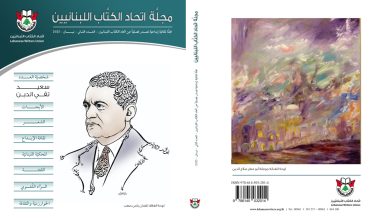زياد الرّحباني و النهايات المفتوحة على جماليّات الإبداع وتعدُّد الهويات الموسيقية
أ. عمار مروة
تتنوّع وتتشابك عناصر الإبداع الفنّيّ ومصادره في شخصيّة الموسيقار الكبير زياد الرّحباني، حيث إنّ أي حديث عن فصلها قد لا يأخذ بالقارئ إلى أيّة فائدةٍ معرفيّةٍ مغريةٍ.
لعلّه من الأفضل التّسليم بأنّ سرَّ الخصب والحيوية اللّذين تطفح بهما إبداعات هذا الفنّان المميّز، يكمن بالذّات في الانصهار المحكَم لشعلة هذه العناصر والمصادر المتعدّدة، واتّساع أفقها على وحدة فنّيّة متماسكة متناغمة بشكلٍ يدعو للدّهشة والاحترام… رغم ما قد يبدو فيها للوهلة الأولى من تباعد في هويّاتها ومصادرها.
أمّا المفتاح لفهم هذه المسألة بما فيها من قيم معرفيّة وجماليّات، فيكمن في انفتاح وتلقائيّة القدرات الّتي يستنبطها زياد الرّحباني بمهارة هندسيّة مبتكرة للدّخول والخروج على ومن وإلى متاهات التّقطع والتّقاطع والالتقاء لسكك نسيجها الدّاخليّ.
لدى زياد الرّحباني إذاً قدرات ومواهب تسمح له بالالتفاف على عناصر هذه المصادر؛ لتطويع مفرداتها الموسيقيّة المختلفة؛ لتنصهر على يديه إلى نسيج مفتوح على رؤيته الخاصّة الّتي يخرج بها عن مألوف التّوقّعات والتّنبّؤات الكلاسيكيّة والتّقليديّة الّتي يؤمن البعض -مخطئاً- أنّ مجراها في عمليّة التّأليف ينحصر ضمن اتّجاه واحد أحد، أو أنّ هويّتها ثابتة لا تحتمل إلّا مفهوماً صنميّاً مغلق الأفق.
أعتقد أنّ المسافة الزّمنيّة الكبيرة الّتي تفصل مفردات لغة التّأليف الخاصّة بزياد الرّحباني وتطوّرها بين أوّل عمل مهمّ (سهرية)، وبين آخر عمل صدر له (إيه في أمل) هي مسافة تحفل بالكثير الكثير من العطاءات الرّاقية الّتي تبعث على الإعجاب والتّفكّر؛ لاستثنائيّتها وأهمّيّتها, خصوصاً إذا تابع المراقب باهتمام ما حصل خلالها على السّاحة الفنّيّة والثّقافيّة والفكريّة والسّياسيّة، لبنانيّاً وعربيّاً، لناحية الانحلال والتّردّي الفاضح في المستوى العام لتلك الحقول، إذا عطفنا عليها جميعاً غياب أكبر رمز موسيقيّ لبنانيّ (عاصي الرّحباني)، وغياب بقيّة الرّموز العربيّة الكبرى كأمّ كلثوم، ومحمد عبد الوهّاب، ورياض السّنباطي، ومحمد القصبجي، وزكريا أحمد، والعديد غيرهم، بدون أن تظهر بدائل عربيّة تعادلهم، إذا أضفناها على اشتعال نيران الحرب الأهليّة، وما تبعها من تردٍّ وتفريغ لمنجزات تلك النّهضة، خصوصاً على مستوى المؤسّسات الفنيّة العامّة والخاصّة، ما أدَّى إلى تهميش آخر بقايا الحصانة والمناعة الانفعاليّة لأُذُنِ وقيم جمهور الأجيال الجديدة الّتي ولدت في أثناء تلك المسافة الزّمنيّة الكبيرة الممتدّة منذ بدايات الحرب اللّبنانيّة، وما بعدها.
يبدو – لحسن الحظّ- أنّ زياد الرّحباني ظهر في تلك الفترة الصّعبة، ليؤدّي دوراً مهمّاً جدّاً بسعة إنتاجه، وامتلائها بما يتناسب من إبداعات خلّاقة، لتردم تلك الهوّة السّحيقة الّتي أسهمت ملابسات الحرب الأهليّة وتواطؤ المؤسّسات الرّسميّة والخاصّة، خصوصاً العربيّة منها، والمرتبطة بالمال السّياسيّ الفنّيّ، بتسطيح الجمهور بكلّ ما هو هابط وفارغ المضمون.
وسط تلك الفوضى العارمة ابتدأ زياد بالضّبط من حيث انتهى منصور وعاصي… كان لا بدّ له أن يستنفر كلّ ما لديه من مواهب كبيرة، وقدرات مميّزة، وإمكانيّات مادّيّة وإعلاميّة قليلة جدّاً. ورغم كونه كان أمام تركةٍ وتراثٍ كبيرين، وذي ثقلٍ نوعيٍّ تركته له المؤسّسة الرّحبانيّة، لكنّه كان أيضاً تراثاً معرّضاً للتّفريغ بفعل الزّمان، إذا لم يُحسن تطويره بمقتضيات إعادة تقديمه للأجيال الجديدة بأشكال مبتكرة ومفتوحة على حساسيّات عصر جديد، لجمهور شديد الخصوصيّة في تعرّضه للتّهميش والفجوات في وعيه ووجدانه، لكنّه متعطّش لكلِّ جديدٍ نوعيٍّ ومتقدِّمٍ… جمهور أثبت أنّه مخلص لكلّ من يحمل همومه، ويجسّد أحلامه بصدقٍ وثباتٍ وحِرَفيّةٍ تتناسب وتطلّعاته.
كان على زياد، وهو يباشر تلك المهمة أن يبدأ بالتّوازي معها في بناء لُبنات مشروعه الخاصّ، هو بالذّات، “مشروعه المختلف عن مشروع المؤسّسة الرّحبانيّة السّابقة” الّذي كسرته الحرب السّياسة… ابتدأ زياد إذاً بأهل البيت، “وأوّلهم السّيّدة فيروز، شريكة عاصي، وظلّه على الأرض… أمّا امتداده الثّاني، فكان في جدوى حضورهما معاً بالتّوازي مع مشروعه الجديد. لم ينس زياد امتداده على “البُزُق”؛ بُزُق عاصي الّذي ورثه مفتوحاً على الجملة اللّحنيّة المميّزة، والممتلئة بالحضور الرّحباني على المقامات المحلّيّة الّتي أثبت من خلالها “زياد” لعاصي (على حياة عينه كما يقولون) إتقانه لأسرار صُنعتها في أوّل عملٍ مسرحيٍّ “سهريّة”، حيث أبحر بحرفيّة عالية على تقنيّتها، واطمأنّت السّيّدة أنّ هذا الشّبل “ابنها زياد” هو حقاً من ذلك الأسد (زوجها أوّلاً، وأبيه ثانياً، وأستاذه ثالثاً).
أبحر زياد في خضمّ تلك الجملة اللّحنيّة على أعمال أخرى متعدّدة، بعد “سهريّة”، وتوزّعت أعماله على ريبرتوار “الأخوين رحباني” وغيرها، وكانت تبشّر بمستقبل واعد. كان لعاصي المتابع لها بضع ملاحظات، لكن زياد كان يزداد تفرّداً وتوقاً إلى عوالم صوتيّة أُخرى باتت تطرق أبواب وعيه… تابع علومه (ولو بتقطّع أحياناً بسبب ظروف الحرب) على أيادٍ مؤتمنة: أيادٍ بيضاء لأستاذ المحترفين “بوغوص جلالیان”، المؤلّف الموسيقيّ الّذي احترف التّأليف الموسيقيّ الغربيّ عبر أكثر آلات التّأليف الكلاسيكيّ تقنيّةً، وهي البيانو” الّتي كانت أوّل آلة موسيقيّة أجاد زياد العزف عليها قبل البزق، والّتي فتحت في وعيه وتفكيره الموسيقيّ آفاق التّجريب على أساليب التّأليف المتنوّعة الهويّات، أهمّها كان اتّساع أفقه على “أسلوب التّفكير السّيمفونيّ”، وتجارب على تركيب أنسجة لتعدّد الأصوات (البوليفونيا)، فتح لها صلات مبتكرة (كان فيها لعاصي محاولات وتجارب جميلة، معروفة، وغير معروفة)، تابع زياد العمل عليها، خصوصاً على النّماذج الشّرقيّة في الهارموني على الثلاثة أرباع الصّوتيّة، وبقيّة المقامات العربيّة الّتي لا تقع فيها تلك الأرباع، كما زاد زياد وعمّق أفق تلك المحاولات المبتكرة، بأن فتح في أنسجتها البوليفونيّة التّركيب نوافذ يطلّ منها التّأليف على هويّات متعدّدة لموسيقى “الجاز”، سواء منها النّماذج الأميركيّة الأصل أو النّماذج الأميركيّة اللّاتينيّة: البرازيل خصوصاً “البوسانوفا”، والنّماذج الأخرى كالأرجنتينيّة، والبرتغاليّة، والبلقانيّة وصولاً حتى البامبا (راجع أغنية “لا والله” لفيروز)… وإذا كان يحلو للبعض أن يدّعي نظريّاً أنّ نظامين مختلفين للموسيقى سيتعارضان في وعي الرّحباني الابن، فإنّ زياد كان في ذلك خلّاقاً؛ لأنّه في وعيه لتلك الاختلافات لم يقع لا في المحظور الأوّل، أي السّلفيّة الموسيقيّة الّتي لا تمارس عمليّاً إلّا اجترار الموروث، من دون أن تفضي إلى الابتكار، ولا في المحظور الثّاني الّذي يذهب بالتّأليف إلى الحياكة الصّنميّة على منوال المادّة الكلاسيكيّة الغربيّة، ليصبح التّأليف ضاحية موسيقيّة لا تدور إلّا في فلكها.
لقد فتح زياد أشرعته ليبحر في عوالم صوتيّة مختلفة ومتعدّدة، لم يقطع مع أيّ مصدر، ولم يُغلق أيضاً أيّ باب، ولم يسبح عكس أيّ تيار…
بدا دائماً -وما زال- منفتحاً بتحفّظ، ولكن بإيجابيّة تعرف ماذا تريد، وماذا يناسب خامة التّأليف المتطوّر المفتوح على الشّرق. شرق زياد جديدٌ ومتحرِّرٌ من عُقد التّخلّف والتّبعيّة، ومتحرّرٌ أيضاً من الخوف على الانفتاح بحجّة التّغريب، وضياع الهويّة… فماذا حصل؟ انفتحت أمامه تقنيّة الجدوى القابلة للتّفاعل بالأخذ والعطاء على حساسيّة الشّرقيّ الّذي استنبط جملاً تسري على مفاتيح للدّخول والخروج والتّفاعل على التّقنيّات كلّها، والغربيّ -أساساً- لم يكن في يوم من الأيّام واحداً… تماهى زياد مع فنّ السّماع، ليحاكيه بانفتاح، وبدا كأنّه يزداد صلابةً وتماسكاً على جذوره، كما شعر، وما زال يشعر بها. لم يضع زياد شروطاً في عمليّة فنّ السّماع، وهو يستكشف عوالم الأصوات المختلفة في مساراتها، ولكن هذا لا يعني أنّ بعض تلك المسارات استطاعت أن تأسره بصنميّة، إذا ما تقاطعت معه في بناء تركيب صوتيّ فتحته رؤياه عليها. فهو لذلك متحفّظ في انفتاحه، بدليل انفتاح موسيقاه من دون تناقض على تعدّد هويّاتها. مؤلّفات زياد تثبت للمستمع المحترف والمثقّف أنّه يعرف كيف يرى مسارات الصّوت، وكيف تتوازى ملامحها أحياناً وتتقاطع. لذلك أتقن عمليّة الإمساك بهذه المسارات عبر فنّ السّماع الّذي يؤدّي إلى فنٍّ آخر يتمتّع به، وهو فنّ الرّؤية، فهو -حسب تقديري- يأخذ الصّوت الّذي يلفته من الأذن مباشرةً إلى التّحليل؛ لذلك يمكن القول إنّ عبقريّة زياد نابعة من الجذور، ومشرّعة على الانفتاح…
يعاني زياد في تلك العمليّة الصّعبة من أن لا تأسره هويّة هذا الصّوت في مطبخ التّأليف. فهذا المطبخ يشترك عادةً في صياغة معادلاته: العقل والقلب… حيث الصّراع مفتوح على الذّاكرة، وهناك تحديداً يسكن الأخوان عاصي ومنصور، ولا يبارحان المنطقة المفتوحة على الحلم، حلمهما القديم المتجدّد والمفتوح على الجمال المطلق، وصفاء الألوان الموسيقيّة الّتي ترفض التّعصّب لدكتاتورية اللّون الواحد، هناك -إذاً- تترك الأصوات ملامحها الواحدة المفترضة، وتذوب في أبواب الرّؤية عند زياد. لا أبيض ولا أسود، بل ألوان الطّيف، لتخلع الموسيقى هويّتها، وتخضع لمرجعيّة التّوحّد في أصل الأشياء والأصوات، فتنفتح على معادلة ثنائيّة الجمال والبساطة الّتي لم يتخلَّ عنها عاصي، وإن كان زياد لا يتعب من توسّلها عبر أكثر مفاصلها مدعاةً للصّمت والتّأمّل. أمّا عندما تتحرّك بعض الأوهام الّتي تفرّق وتحيا في الماضي؛ لأنّ العالم قد تدخّل في غمرة تسارع أحداثه، وقسوة محرَّماته البالية، على بعض هويّات ومسارات الأصوات، فصنّفها بتخلّف، وهو ينظر لمقاييس صناعة البراءة، وتعليب القبح والضّجيج، عندها قد لا تصل تلك الأصوات إلى تقاطع مفترَض بين الجمال والبساطة. لكنّ زياد “المؤلّف المحترف” الّذي يعرف تقنيّة اسرارها الّتي تزدحم بتنظيرات تلك المرجعيّات، سواء أكانت أكاديميّة أم تجاريّة، نراه يفكّ تلك الادّعاءات، ويستدركها بمكوّنات معادلة الانفتاح والتّجريب على السّهل الممتنع؛ ليبني عليها سككاً بوليفونيّة ترتفع فوقها تأليفاته القائمة على التقاء روافد تحتفل فيها بنتائجها الجديدة، وبأهمّيّة حالاتها الجماليّة الّتي تهديها الموسيقى اللّبنانيّة إلى أمّها -الموسيقى العربيّة- بفرح الولادة الجديدة لتلك الحالات.
فتح زياد أشرعة عوالمه الموسيقيّة على مسارات وتآلفات صوتيّة أكثر أهمّيّةً من المفهوم الجامد للشّرقيّ والغربيّ… ذهب إلى أبعد من تقليديّة المشترك بينهما، رغم أهمّيّته، فأحلامه لم تكن هناك، ولم تكن تسعى أساساً إلى تسوية، ذهب إلى أبعد، وغاص في أعمق… كيف تجلّى ذلك يا ترى؟ وأين ابتدأ؟ كانت البداية في مكانين: الأول موسيقي عالمي يطوي مفهوم المحلية بعبقريةٍ غير مسبوقة، والثاني تلحيني مع السيدة فيروز يستند على الجملة اللحنية ذات التوجُّه الموسيقي، إذا أخذنا نموذجاً سريعاً عن المكان الأول، وليكن عمله الموسيقي الرائع الذي بناه على “موتيف” افتتاحية Franz Liszt للرابسودية الهنغارية الثانية، والتي كتبها على سلَّم DO DIEZالصغير. أخذ منها زياد خمساً وعشرين ثانيةً وأهمل كل شيء آخر ليبني عالماً فنيَّاً ساحراً ومبتكراً، وصل فيه بروح الشرق إلى قمة البلاغة في التأليف على الطرب المعقلن بالتوق إلى التحرُّر من التبعيَّة للكلاسيكيَّة الغربية. التقط زياد روح التحرُّر في موسيقى الغجر التي بنى على أساسها Liszt نسيجه الغربي، التقطه زياد بآلات القانون والأوكارديون والكرنيطة والترومبيت.
المكان الثاني كان في أوّل عمل خصّصه للسّيّدة فيروز، ليقول عبره أشياءه الأولى الجديدة والمبتكرة، كما ذكرناها أعلاه، وإن كان في أطوارها الأولى. كان العمل تحت عنوان “وحدن”، كمكان موسيقيّ مختلف ومتطوّر، لا ينظر إلى الوراء، أمّا الزّمان، فكان بالضّبط، حين غادره عاصي مطمئنّاً، ليترك فيروز في أيدٍ أمينةٍ. كان الجميع يعتقد أنّ العقد انفرط، وأنّ على فيروز أن تتعلّم العيش على أمجاد الماضي، كانت تلك الخطوة موفّقة لناحية الزّمان، وضربة معلّم لناحية المكان الموسيقيّ، امتلأت بالسّعة الموسيقيّة في مداميك عمارتها، كتأليف حافظ على أصالة متجدّدة لناحية لغة المقام المفتوحة على الجملة اللّحنيّة الّتي أحبّها عاصي… ومع ذلك، كانت ممتلئة في بعض تفاصيلها باستخدام تقنيّة غربيّة متناغمة مع لغة المقام اللّحنيّ لتلك الجملة. وهذا التّناغم أتى بالضّبط في أبهى مفاتنها الشّرقيّة، امتلاءً بالطّرب المفتوح على التّأليف الموسيقيّ، وليس فقط على سيولة الميلودي. هناك بالضبط كتب زياد امتدادات لحنيّة أفقيّة الطّابع لناحية أسلوب الكتابة المتوازية بين البيانو والوتريّات، عرفت آلة السّاكسوفون كيف تساهم في إغناء هذا النّسيج من دون أن تخدش حساسيّته الشّرقيّة (خصوصاً في أغنية وحدن)، حيث سارت الجُمَل مع جملة السّيّدة فيروز، وجملة الباص، وآلات النّفخ، خاصّةً السّاكسوفون: سارت بتوازن بوليفوني مدهشٍ ومتقنٍ… كما انتقل تنوّع الائتلافات الهارمونيّة إلى حالة أخرى في أغنية “البوسطة” في مقطعها الأخير، حين يغنّي الكورس جملة “من ضيعة حملايا على ضيعة تنّورين”، باشتقاقات النّهوند، لتدخل فوقه فيروز بجملة موازية هرمونيّاً من مقام البيات، وتغنّي جملتها “الهوا يا معلّم، لو بتسكّر هالشّباك… رح يسفقنا الهوا… يا معلّم”، كما فتح بعضاً من آفاق أخرى لهذا التّناغم على أجواء الطّرب في أغنية “عندي حنين”، حيث ساهمت آلة الأكورديون بجُمَلِها اللّحنيّة الطّربيّة المميّزة بتوازيات لحنيّة مع الوتريّات، وآلات النّفخ، ومعها بقيّة الآلات المستعملة على الجملة المقابلة لها.. بصوت فيروز المفتوح على القصيدة بنوستالجيا تعبيريّة راقية، كما حلّقت السّيّدة في ذلك العمل على أجواء الطّرب بقماشة لحنيّة عربيّة بأغنيتين؛ هما: “حبّيتك تنسيت النّوم”، وأغنية “بعتلك روحي” الّتي أبدعها زياد هنا في التّأليف على الجملة الأساس، بحيث لا معنى للكلمة بقدر اللّف بالتّنويع على المقام عند كلمة “بعتلك” وكأنّني بزياد يلَبْنِن الطّريقة المصريّة في التّطريب على الكلام بأسلوبٍ جديد، بلغة تلك الأيّام… وقد تمّ لاحقاً بتطويرها في أغنية “ليلي ليلي ليلي” إلى آفاق أغنى من تلك الصّيغة، إلى صيغة جديدة تجمع بين الأصالة اللّحنيّة، وبعض النّماذج المعاصرة في التّأليف على صيغ الجاز، فنجحت في القبض على ملامح الاثنين بجرأة وإحكام، فلا الشّرقيّ تضرّر، ولا الجاز كان غريباً، بل تآلفا في نسيج التّوزيع المتعدّد الأصوات بطريقة أثرَت (من ثراء) ملامح بعضها بعضاً بطاقة إيجابيّة من التّلاقح، وغدا صوت فيروز بمنزلة آلة لها دور جديد، أسهمت بإغناء نسيج التّأليف، بحيث يحقّ لزياد إعادة تسمية تلك القطعة الموسيقيّة باسم جديد، وهو “تقاسيم للصّوت والأوركسترا تسلطن بوليفونيّاً على الجاز” ولِمَ لا؟ أَلَمْ يَتَحَوَّلُ صَوْتُهَا إِلى آلةٍ عربيّة المنشأ تعزف ضمن نسيج تأليف متطوّر، يستقبِل المصادر الثَّلاثة بتوازنٍ متين واقتصاد محكم بعيدين من الثَّرثرة؟ بالتّأكيد هذا ما حصل، والقطعة ممتلئة باتّساع أفق، تدعو زياد لاستنباط تأليفات متجدّدة لها، تزدهر بخصب آفاق البوليفونيا في نسيج الأوركسترايون المفتوح آلياً على تقنيّات الجاز، إحداها كانت أكثر ثراءً في آفاق الجاز، موجودة على اليوتيوب، ومؤرّخة عام 1986، وبدت بكورس من أربعة أشخاص يحلّ محلّ صوت فيروز مع 3 ترومبيت، و2 ترومبون، وساكسوفون آلتو، وكونترباص، وآلات إيقاع، وبقيادة زياد على البيانو، وكان هناك حتّى آلة هارب (harp)، وبعض الآلات الأخرى في الخلفيّة… وبعد هذه اللّمحة عن عمل “وحدن” الّذي يمكن أن يكون قد شكّل بداية تاريخ مميّز لتعاون خلّاق بين فيروز وزياد، أسّس أعمال أخرى زادته عمقاً وغنى، وأهمّيّةً، مثل الأغنية المذكورة أعلاه، على سبيل المثال لا الحصر، نعود بعد هذه اللّمحة إلى بحثنا عن الجملة اللّحنيّة والجملة الموسيقيّة للفنّان زياد الرّحباني، وعن بقية العناصر الإبداعيّة الّتي تربطهما بعملية التّأليف من توزيع وأركسة ونسيج تعدّد الأصوات… ولكن قبل هذا الدّخول يجب التّأكيد على الفرق الكبير بين الجملة الموسيقيّة، والجملة اللّحنيّة عند الفنانين الكبار الّذين يبدعون في مجالي التّأليف والتّلحين المختلفين، وعلى أعلى مستوياتهما، وسيظهر الفرق بينهما من خلال البحث. فماذا إذاً عن الجملة اللّحنيّة؟!
الجملة اللّحنيّة عند زياد بليغة بالفطرة، ممتلئة بإمكانيّات العمل عليها بالتّأليف الموسيقيّ بعدّة اتّجاهات (وهذا نادر)، وهي قصيرة نسبياً بالمعنى الإيجابي للكلمة، كونها غالباً ما تكون موقعة على التّنبيض (من نبض pulsation)، وهذا ما يجعلها في أحيان كثيرة تنحو باتّجاه أسلوب السّينكوب (tendency towards syncopation)، ولأنّها قصيرة وتنحو نحو تلك الاتّجاهات، فهي بعيدة جداً من الثّرثرة الّتي تُكْثِرُ من الزّخرفات والحليات الخارجة من زمانها ومكانها في النّصّ الموسيقيّ، والفارغة المضمون؛ كالأربيجات والكريشندات، والعديد غيرها الّتي لا تتعمّد إلّا الإطالة (المدرسيّة الطّابع)، بهدف الفذلكة، وعرض العضلات، بلا مبرّر جمالي أو لمآرب أخرى.
ورغم كونها مشدودة ميلودياً باتّجاه دراميّ، أو غالباً ما تكون باتّجاه الكوميديا السّوداء (أساساً لا يمكنها إلّا أن تكون كذلك)، لذلك فإنّ سرّ قوّتها وقدرتها على التّفاعل باتّجاه تطوير نسيج عامّ عليها للتّأليف، يكمن في كونها موسيقيّة الأساس، وتختزن داخلها قابليّة واسعة للتّحليق في نسيج الأركسة… لذلك نرى زياد يُثبت، من عمل إلى آخر – وتحديداً منذ صدور أسطوانة “كيرياليسون” عام 1977 حتّى صدور آخر عمل “إيه في أمل” عام 2010، وبشكل تصاعدي -أنّ جُمَلَه هي موسيقيّة الأساس، والسّعة، والتّطلّعات أكثر بكثير من كونها تلحينيّة الطّابع، كيف؟
إذا كان لا بدَّ من عرض ذلك، والتّدليل عليه للقارئ ببساطة تبتعد من التّنظير والتّعقيد العلميّ، فلا بدّ من اللّجوء إلى الأمثلة الحيّة السّهلة.. ولتكن أمثلتنا هذه من آخر عمل له وأقربه إلينا، وهو عمله الأخير “إيه في أمل”… وليستمع القارئ أوّلاً إلى الأغنية رقم 7 بعنوان “ما شاورت حالي”، والممتلئة بِجُمَلِها اللّحنيّة الكرديّة الأصل الّتي كان أهمّها ثقلاً واتّساعاً: جملة “الريفران” الّتي تغنّيها السّيّدة فيروز كالتّالي “ياضيعانو .. شو كان منيح بزمانو”. ثم ليستمع مباشرةً بعدها إلى القطعة الموسيقيّة رقم 8 بعنوان “ديار بكر”، والممتلئة بكثرة الجمل الموسيقيّة المتنوّعة والمفتوحة على حرفيّة عالية من التّأليف الموسيقيّ المرتكز على ثراء بوليفونيّ مفتوح على نماذج مختلفة المصادر من الموسيقى العربيّة والملامح الكرديّة الواضحة، والمفتوحتين أيضاً على دوز (dose) متوازن من الجاز، بطبيعة تحاكي فنّ التّقاسيم… إذاً، إذا استمع القارئ إلى القطعتين 7 و8 بتتابع كرونولوجي، فسيجد أنّ زياد كان في الأغنية مقيّداً بضرورات الشِّعر، من حيث الإيقاع الشِّعريّ على عدد الكلمات ووزنها، مع أنّ إيقاع الأغنية كان ينبض على إيقاع رباعي 4/4، وهو من الإيقاعات البسيطة، ومع ذلك لم يكن الإيقاع الشِّعريّ يسمح لزياد بالتّحليق خارج التّقطيع النّبضيّ للماسورة، وبالتّالي فإنّ أجواء التّأليف كانت ضيّقة على المقام اللّحنيّ. لا بدّ أنّه كان يشعر في الوقت نفسه بالسّعة الموسيقيّة الّتي يختزنها الرّيفران، رغم كونه لا يستطيع أن يفعل له شيئاً ليحرّره من ورطة التّلحين. فكيف تصرّف؟ أخذ الأغنية إلى نهايتها السّعيدة بعد أن أعطاها استحقاقاتها الشِّعريّة فوق فرشة التّلحين الرّاقي، وخرج منها حاملاً الرّيفران إلى مكان آخر مختلف، وهو “ديار بكر”، وهناك حرّرها من الوزن، والكلام، ونبض التّقطيع اللّحنيّ، وحوّلها إلى موتيف (motif) موسيقيّ عمل عليه بحرّيّة كاملة على أساس جُمَل موسيقيّة جديدة، موزّعة على عمارة تأليف مموسقة بثراء يشعر المستمع في ثناياها بانفتاح آفاق الموتيف الجديد (بدون كلام طبعاً) على التّحليق عالياً بِجُمَلٍ اتّسعت آفاقها على عدّة نماذج من أساليب التّأليف المختلفة. نراه أوّلاً يستخدم التّلوين المقاميّ، ثمّ التّنويع على ذلك المقام بطريقة لحنيّة جميلة؛ ليعرّج على ثنايا تقنية الموديليسيون، وليسمح لكلّ آلة من الآلات أن تأخذ اللّحن إلى خصوصيّتها الموسيقيّة، فتقسِّم عبره بأجمل ما يمكّنها أن تروي روايتها بالطّريقة الّتي ترتئيها، وتطلق عبرها مكنونات صدرها، وذلك من خلال تقنيّة الارتجال على أسلوب الجاز الممسوك بهويّة شرقيّة التّقطيع لملامحها الموسيقيّة، من حيث تقارب الأنترفالات (intervals) بما يتناسب مع خامة وطبيعة الموسيقى العربيّة، حتّى ولو كان الجاز أحياناً واضح المعالم. لقد وصل تلاحم الملامح في ثنايا التّأليف إلى حدود الطّرب، الطّرب المفتوح على تأثيرات كرديّة خلّابة.
لعلّ لزياد الحقّ بأن يفتخر بهذه المهارة الّتي يمتاز بها في آفاق العمل على مزج الهويّات المتعدّدة في بوتقة واحدة، لا تناقض سلبياً فيها لغلبة هويّة على أخرى (تقاسيم -آفاق لحنيّة شرقيّة- جاز- طرب- أسلوب تفكير أوركسترالي مبني على بوليفونيا تجمع ملامح متعدّدة من التّراث الشّرقيّ العربيّ؛ كالكرديّ في هذه الحالة…) ومن دون أن يتدنّى مستوى أيّ منها، إنّما بأسلوب قادر على جمعها بما يُغني من شأنها جميعاً نحو حالة أكثر جماليّة، وهذا -برأيي- قمّة الإبداع، وقد يفسّر تصميم زياد على التّتابع الكرونولوجى للقطعتين 7 و8 في العمل، ولا شأن للمصادفة في ذلك، بل لغاية في نفس يعقوب (بمعنى أنّ ذكاءه ليس بريئاً من رؤية هادفة على مكرٍ محبّب لمن يجيد قراءته وفهمه).
بالمناسبة، في هاتين القطعتين، تفاعل لنوع آخر يجب التّأكيد والتّدليل عليه لأهمّيّته، وهو حفاظه على أجواء البوليفونيا مفتوحةً على خلايا الثّلاثة أرباع الصّوتية في مكان ورودها، حيث يتابعها باستمرار كلّما فتحت تأليفاته مجال خوضها بطرق خلّاقة، مبتكرة، ومقنعة.
إذاً، من خلال هذه الأمثلة (وهناك أمثلة أخرى كثيرة)، نجد فيها دليلاً على كون الجملة الموسيقيّة عند زياد أهمّ بكثير من أختها اللّحنيّة، وهي بالتّالي تمثّل الأجواء المثاليّة الّتي يمكن لمواهبه أن تحلّق عبرها إلى آفاق التّأليف العالية الثّراء في تناسق وتكامل هويّاتها، وتعني أيضاً -عطفاً عليها- أنّ زياد مؤلّف موسيقي بالفطرة، وقد أخذته دراساته وانفتاحه على فنّ السّماع إلى موهبة إعادة توجيه المسارات الموسيقيّة نحو تحديث وتطوير هويّاتها، بطريقة ديالكتيكية تليق وتغتني بها، ولا داعي للخوف من فقدان هويّتها- كما ترى النّظرة الاستشراقيّة الّتي ينظر بها الغرب الى أيّ مؤلّفٍ عربيٍّ ذي شأن، وله قدرات زياد في ابتكار المسارات المختلفة بفكر خلّاق غير مألوف عندهم، (أي عند الغربيّين)، ولا يراعي نمط تفكيرهم وتصنيفاتهم، وبالتّالي غرورهم في عمليّة الإبداع. بهذا المعنى فإنّ زياد، بتعدّد قدراته، وانفتاح طاقاته على مستوى فهم آفاق التّأليف المتطوّر في جرأته، يشكّل مرجعيّة أساسيّة أولى واستثنائيّة لا غنى عنها في إغناء وتطوير مشروع العقل الموسيقيّ العربيّ، لما يرفده فيه من إجابات عن أسئلة مهمّة يطرحها هذا المشروع، ولما يفتحه فيه من نوافذ تطلّ على الآفاق المتعدّدة المسارات؛ لاحتمال تطوّر هذا المشروع بلا عُقَد وتابوهات. زياد إذاً مؤلّف موسيقيّ من طراز نادر أوّلاً قبل أن يكون ملحّناً ومسرحيّاً أو شاعراً أو إذاعيّاً أو إعلاميّاً. ومع ذلك لا بدّ من القول إنّه ملحّن من طراز رفيع بدون تناقض، خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار بناء أغنياته الّتي سنأتي على ذكر بعض أجمل خصائصها، لناحية روعة توزيعاتها، وغنى نسيجها البوليفوني، وهو أيضاً مسرحي متميّز، بل طليعيّ، بدليل أنّه أوّل من أرسى أساسات المسرح السّياسيّ اللّبنانيّ (وربما المسرح السّياسيّ العربيّ) بقوّة لا مثيل لمحاكاتها، ويصعب أن نجد لغيرها أصداء مثلها جيّدة ما زالت هزّاتها الارتداديّة تنبض فى وجدان الأجيال المتعاقبة، لتؤثّر في شرائح المجتمع المتباعدة الانتماءات الاجتماعيّة، والطّبقيّة، والسّياسيّة (حتّى لجهة خصومه المفترضين)، وبشكل يصعب تفسيره سوسيولوجيّاً. كما إنّه شاعر وإعلاميّ وناقد اجتماعيّ فذّ وسياسيّ جريء ومتفرّد في تعدّد مواهبه الّتي فتحت إنجازات ما زالت تأثيراتها مستمرّة في أكثر من مجال…
فمَنْ منّا نجا من تأثيرات برامجه “العقل زينة” أو “بعدنا طيبين.. قولوا الله” أو “نص الألف خمسميّة”؟ ومن منّا لم تداعب متاهات مخيلته وعلى فترات مختلفة من حياته تأثيرات الشّخصيات الّتي ابتكرها؛ مثل: فهد، وعباس، ونخلة التّنين، أو زكريّا الكلكلي، أو أبو الزّلف أو أستاذ نور؟ وأهمّها -برأيي- رشيد. تلك الشّخصيّات الّتي تقف شاهدةً على عمق وفهم زياد لحركة القوّة والضّعف في تركيب الشّخصيّة اللّبنانيّة المتذبذبة في فهمها لحدود دورها في الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة من جهة، وفي ممارستها لذلك الفهم والدّور، على أساس طائفي وعشائري مشوّه، يصل في تشوهّه إلى درجة اللّامعقول من جهة أخرى، ما يستحضرني قول الجنرال ديغول: “أن تكون لبنانيَّاً فهذا ليس هوية، بل مهنة”.
أمّا بعد أن استنتجنا من الأمثلة السّابقة أهمّيّة الجملة الموسيقيّة، وقوّتها، واختلافها الكبير عن الجملة اللّحنيّة، يبقى -عطفاً عليها- أن ننتقل إلى اجتماعها كلّها مع نسيج أوركسترالي (سواء سيمفوني أو أصغر)، يؤدّي غالباً إلى حالة جماليّة مركّبة بوليفونياً بشكلٍ مبتكرٍ في نتيجتِهِ النّهائيّة.
لنبتعد عن التّنظير، ولنلجأ بالقارئ إلى الأمثلة الّتي تسلّط الضّوء على تنوّع قدرات زياد في هذه المجالات أيضاً… مثلُنا الأوّل سيكون بعودتنا إلى الوراء، إلى عصر سيّد درويش، بأغنيته الوطنيّة المميّزة: “أهو دا اللّي صار”، ثمّ إلى بدايات عصر الأخوين رحباني عند أغنية “بكتب إسمك ياحبيبي”: نجد أسلوبين مختلفين استعملهما زياد لتحقيق هدف واحدٍ، هو التّأليف على قديم دخل الريبيرتوار العربيّ واللّبنانيّ الكلاسيكيّين.. ورغم هذا التّصنيف، شعر زياد -لأسباب تتعلّق برؤيته الفنّيّة وتقنيّة تفكيره- أنّه بالإمكان العمل على العمق اللّحنيّ لهما، لاتّساعهما على آفاق موسيقيّة مختلفة، قادر على فتحها بطريقتين مختلفتين:
الأولى: أغنية “أهودا إلي صار”، حيث سعى زياد إلى الحفاظ على حساسيّتها اللّحنيّة مقاميّاً، وبعد أن عرض الجملة الأساسيّة للموضوع الموسيقيّ مفتوحةً على الوتريّات فقط، بطريقةٍ مونوفونيّة بطيئة، ليفتح عليها مباشرةً نسيج تأليف بوليفوني متطوّر في آفاق الأوركستراسيون الّتي تتناسب مع القماشة اللّحنيّة، فَعَمَدَ إلى التّلوين المقاميّ، والتّنويع عليه بطريقة الكتابة الأفقيّة بشكلٍ ميلودي، وابتعد من الأكورات العموديّة ذات الطّبيعة الغربيّة (التونال)، والّتي تتفاعل بهويّة طنينيّة لا تتناسب مع أسلوب المقام اللّحني… وبذلك بقيت هويّة البوليفونيا محافظةً لروح الشّرق بتوازي الألحان فوق بعضها، على طول نسيج الأوركستراسيون، لتتفاعل مع طبيعة موسيقيّة ذي اتّجاه progressive فوق خطّ التّأليف العام، كانت بتوازيات لحنيّة واضحة على جملة صوت فيروز، وخرجت الأغنية بنظام تأليف جديد متطوّر حافظ على هويّتها بإخلاص وأمانة، وكما يُفترض أن يتمّ التّعامل مع نسيج مونوفوني تراثي لأغنية وطنيّة عريقة.
أمّا الأغنية الثّانية للأخوين رحباني “بكتب إسمك”، فاختلف أسلوب تعامله معها بقوّة لافتة تجنح للمعاصرة والتّحليق في تعدّد هويّات أساليب التّأليف عليها، فهي أغنية عاطفيّة مفتوحة على نوستالجيا معاناة المحبّ الّذي يشتكي من تجاهل حبيبه… وهي موزّعة بأسلوب تقليديّ (بلغة تلك الأيّام الرّاقية)، يغلب عليها طابع المونوفون، جملتها اللّحنيّة -ظاهرياً- خفيفة؛ لأنّها سعت بكلّ ثقلها لخدمة تلحين الحالة الإيقاعيّة للقصيدة الشِّعريّة.
أعتقد أنّ زياد شعر أنّه إذا كسر رتابة الحركة الدّائريّة لاتّجاه جملتها اللّحنيّة المتكرّرة باتّجاه الكلام، فإنّه يستطيع تحرير طاقة اللّحن الأساسيّ فيها إلى طبيعة حرّة متجدّدة للتّحليق إلى آفاق موسيقيّة ذات حساسيّة مختلفة، ومن أجدر بالتّصرّف بها بهذه الحرّيّة المطلقة من ابن عاصي ومنصور؟ بدأ زياد ب “تيما” (theme) مقدّمة الأغنية القديمة المفتوحة على ثماني نوتات، كثّفها إلى أساسها الثّلاثيّ، نقرها على البيانو أوّلاً كموتيف للمقدّمة، وأعاد بناء بداية التّأليف بالضّبط من نهاية الأغنية. ثمّ تخلّص من تكرار “theme” الغناء القديمة عبر استنباط تكثيف موسيقيّ لها مفتوح على نسيج عالي التّقنيّة في اتّجاهه البوليفونيّ، عمل من خلاله على فتح علاقات لحنيّة متوازية تفاعلت بطريقة progressive في التّركيب المتعدّد الهويّات، فمزج أكثر ملامح الأركسة بأسلوب تفكير أوركسترالي مطعّم بملامح جميلة وجريئة في انفتاحها على تقنيّات الجاز الّتي تتماهى مع الأسلوب البرازيلي للبوسانوفا (كتقنيّة عزف إيقاعيّة الشّكل وأفقيّة التّفاعل الميلودي لآكورات الغيتار على سبيل المثال لا الحصر)… كتب بعدها صيغة تأليف للكورس مزدوجة الوظيفة على أساس ال (theme) الجديدة الّتي تعيد تتابعها بتجدّد من دون تكرار، وبأساسٍ متوازٍ فوق جُمَل الوتريات والنّحاسيات، ليتبادلا الأدوار بالتّناوب على الدّور الأساسيّ، والأدوار الأخرى المتوازية لها على أساس نسيج التّوزيع.
باختصار أعاد زياد تأليف الأغنية بتقنيّة متفوّقة وغير مألوفة، تأخذنا بالضّرورة إلى مجموعة أغانٍ أخرى من أجمل ما كتبه وهو يتعمّد فتحه بقوّة لافتة على أسلوب البوسانوفا، وإيقاعاتها .. وأعتقد أنّ سبب انفتاحه عليها بإيجابيّة واستعمالها كأسلوب معتمد هو كونها تؤدّي -بطبيعتها المتسامحة والصّعبة في آنٍ معاً- إلى الانفتاح على أنسجة تأليف أخرى، خصوصاً الموسيقى الشّرقيّة الهويّة.. أمّا سرّ أسباب هذه الخاصّيّة فيها (إذاً قلّما ينتبه المستمع لها أو يلتفت إليها، رغم شعوره بصلة القربى بينه وبين موسيقانا اللّبنانيّة العربيّة)، سرّها إذاً في هذا هو سهل جداً، ويكمن في أنّ الأكورات (يلعبها عادةً الغيتار)، وإن كان أساسها من ناحية الشّكل إذا أخذناها بالمفرق (أي إذا عزلنا كلّ كورد على حدة، فسنجد أنّه يكتب بنوتات عموديّة على بعضها، ما يذهب بتأثيرها الفرديّ باتّجاه تفاعل طنيني (تونال). ولكن هذا لا يعطيه أيّ معنى بالمفرد؛ لأنّه يكتب ضمن خطّ سير لمجموعة أكورات لها طابع ميلوديٌّ مستمرّ يسرد لحناً توناليَّاً له أساس أفقيّ، يتوازى فوق جُمَل لحنيّة لآلات ثانية في نسيج التّوزيع البوليفوني، فإنّ حركة سيرها تفرض عليها تغيير وظيفة ذلك التّفاعل المنفرد للطّنين، إلى تفاعل لحني ذي طبيعة Modal Progressive تذهب نحو سيولة أفقيّة تتابعيّة فوق اتّجاه سير الجملة اللّحنيّة الأساسيّة، سواء كانت كونتربنطية فوقها (counter pointail)، أو ترجيعيّة خلفها (fugue)، أو شكل الكانون عليها (canon)، لذا نجد لها طبيعة خصبة في ازدهارها لحنيّاً ومقاميّاً بالاتّجاه الشّرقيّ الميلودي ذي الهويّة الغنائيّة، وهذا بالضّبط ما يجتهد زياد فيه لناحية تجديد نسيج التّأليف. ولكي نثبت هذا الكلام أدعو القارئ إلى العودة إلى عمله الرّائع “ولا كيف”، وتحديداً عند ترتيلة “يا مريم البكر”، وفي عمل الآخر “إلى عاصي”، وتحديداً عند أغنية “بعدو الحبايب بيعدو”؛ لنرى بوضوح كبير كيف تمكّن من إعادة صياغتهما بتأليف شديد الذّكاء، وصل إلى ذروة البلاغة في ابتكاره لنسيج أوركاستراسيون يزدهر بخصب العلاقات البوليفونيّة الكثيفة في تشابك تآلفاتهما الّتي تسير من أسلوب التّفكير السّيمفونيّ إلى آفاق الجاز المفتوح على أجمل ملامح البوسانوفا المفتوحة فوق فنّ التّقاسيم على المقام اللّحني. إذاً في الأولى، ترتيلة شرقيّة من تراث كَنَسي سرياني إلى تفكير ذي ملامح أوركسترالية معقّدة، ومفتوحة على أسلوب التفكير السّيمفونيّ، ومؤسّسة على إيقاعات البوسا البرازيليّة، والموزّعة على فنّ التّقاسيم، والثّانية تختلف عنها قليلاً “كونها كانت أغنية بلديّة”، اجتمعت كلّها مجدّداً بتآلف شديد الخصوبة، يزدهر بأرقى فنون التّأليف دون أيّ تناقض، بل بمرونة وتلقائيّة ذات توازن دقيق ومفتوح على احتفال جماليّ رفيع السّمو.
وإذا خرجنا من المؤلّفات الّتي ابتكرها زياد، على أساس مؤلّفات قديمة أو تراثيّة، أو للأخوين الرّحباني، وأخذنا مثالاً آخر لتأليف له هو (أي لزياد)، فليكن حديثنا عن مقطوعة “ميس الرّيم” الّتي تشكّل علامة فارقة في تراثه، عدا عن دلالتها على عمق نسيج الأركسة المفتوحة على غنى التّآلفات البوليفونيّة لديه. أعتقد أنّه بتصرُّف الجمهور اللّبنانيّ ثلاث نسخات عنها بالحدّ الأدنى:
– الأولى: هي نسخة المسرحيّة بتأليف كلاسيكي لبنانيّ الطّابع.
– الثّانية: نسخة تحت عنوان “أبو علي”، وهي تحاكي مؤثّرات مشتقّة من بعض أجواء الجاز.
– الثّالثة: نسخة “بيت الدّين”، وتحاكي عدّة آفاق بأسلوب التّفكير السّيمفونيّ.
وكلّ نسخة لها صلة القربى لحنيّاً بالاثنتين، لكنّها تبتعد منهما كثيراً، بكلّ تفاصيل التّأليف المستقلّة، ما يعني أنّ العمل على صيغة التّأليف عند زياد لا ينتهي عند نهاية التّسجيل في الاستديو، ولا بعد الحفل، بل تبقى المادّة المعمول عليها صيغة لمادّة خام قابلة للتّجديد والعمل، وإعادة الإبداع عليها. وهذه ميزة المؤلفين الكبار المنفتحي الرّؤية والموهبة والذّكاء الّذين يرون اختلاف أبعاد الجملة، وتعدّد احتمالات صياغاتها على أشكال أخرى متعدّدة.
أمّا الظّاهرة المميّزة في العلامات الائتلافيّة والبوليفونيّة للهارموني عند زياد، فواسعة ضمن تناسبها للمادّة الشّرقيّة. فنراه ينهل من الحقب والمدارس المختلفة، لكنّها لا تشطح أبداً إلى اتّجاهات النّيوكلاسيكيّة أو الأتونال… فهو لا يتردّد بالتّحليق في أجواء العمل الواحد من انتقال مفاجئ، خصوصاً عند مفترقات الجُمَل أو المراحل الانتقاليّة، ليفاجئ المستمع دائماً بأفكار لا يتوقّعها، ودائماً تكون مبتكرة، فنراه ينهل من مركّبات ومعادلات المراحل المختلفة، لحقبة الباروك، وحقبة الكلاسيكيّة، وحقبة الرّومنطيقيّة، وحقبة النّيورومنطيقيّة، وقلّما يبتعد إلى ما بعدها، أمّا إذا ابتعد فنراه يتراجع بسرعة، ولا يغامر بدخول عالم ائتلافات الضّجيج، ونلاحظ أيضاً عند دخوله على أنسجة البوليفونيا ليحاكي أجواء الجاز في امتزاجه مع الهويّات الأخرى، نلاحظ -إذاً- أنّه يبتعد في تلك الأجزاء(المفتوحة على الجاز)، من المركّبات المشتقّة عن الكورد الكامل أو ما يسمّى ب (the perfect chord).. أمّا المجال المثالي، إذا أراد المستمع المتخصّص دراسة هذه الائتلافات عند زياد، فهو في مؤلّفاته التّالية:
هناك مؤلّفان على قصيدتين لمحمود درويش هما: “أحمد الزّعتر”، والثّانية مديح الظّلّ العالي” للفنّان خالد الهبر، عمل زياد على إعادة صياغتهما، وإعدادهما للتّوزيع والأوركسترا السّيمفونيّة، تحفلان بصيغ هارمونيّة مناسبة، تحمل طابع تفكيره في تلك الأيّام. كما يمكن للمستمع أن يجد مناخاً مميّزاً لتلك الصّيغ في عمله المهمّ؛ لإعادة العمل على التّأليف والتّوزيع لأجمل المحطّات في ريبيرتوار الأخوين رحباني وفيروز في عمله “إلى “عاصي” والّذي يتحمّل أكثر من بحث في التّجديدات الجميلة الّتي فتحها فيه… وكذلك في أنسجة أغنيات “شو بخاف” و”أنا فزعانة”، و”خليك بالبيت”، كذلك في بعض ضواحي عمل مونودوز، حيث حلّق في تراكيب تلك المعادلات. أخيراً ينبغي التّشديد على حقيقة مهمّة، وهي أنّ الدّخول إلى عالم زياد الرّحباني بما فيه من آفاق وغنى وتجديدات، وإدخال عناصر هويّات إلى أخرى مختلفة بحرفيّة وذكاء – قد يكون أمراً صعباً ومشوّقاً، ولكن الخروج منه، بما يقتضيه ويتوجبّه من استحقاقات، هو أمر أصعب بكثير وغاية في التّعقيد، خصوصاً تحت ضغط مقال أو بحث يفرض حدوداً بعدد صفحاته، ويضغط بقوّة من ناحية تعدّد أجزاء وعناوين بحثه المختلفة؛ لأنّها ظاهرة تقاوم التّجزئة والعنونة؛ لذلك وقبل الخروج من تلك الورطة سالمين، أحبّ -عطفاً عليها- أن أعلّق على بعض ما يدور أحياناً من نقاشات جانبيّة، أكانت في أوساط أكاديميّة أم عند آراء بعض الموسيقيّين، بأنّ ضرورة ربط عناصر مشروع العقل الموسيقيّ العربيّ لتحديثه قد لا تكتمل إلّا بأخذه إلى مسار التّفاعل الدّراميّ المبثوث في خلايا التّفكير الآلي السّيمفونيّ كحلّ وحيد للتّطوّر، وبأنّ الجاز وبقيّة الأنواع العربيّة المتداولة ليس لها القدرة على الخوض في هذه الآفاق، أعتقد أنّ هذا التّفكير استنسابي ويشطح، بتطرّف نظريّ، من أفق مثالي طوباوي إلى نزعة غرور وتعالٍ، لا علاقة لها بالواقع المفتوح على جملة مغالطات، منها عدم فهم إحدى طبائع الموسيقى العربيّة- اللّبنانيّة ذات الطّبيعة اللّحنيّة المنفتحة الأفق غنائياً، ويمكن -إلى حدود معيّنة- أن تفتح تشابهاً لها مع الموسيقى الإيطاليّة الّتي ذهبت بعيداً في تطوّرها باتّجاه الآفاق السّيمفونيّة وبالذّات، من باب طابعها الغنائيّ (الأوبرا أحد وجوهه)، بعكس الألمانيّة الّتي بقيت مغلقة بصيغتها الآليّة. وهذا ما قد يفسّر ابتعاد بتهوفن عن التّأليف لفنّ الأوبرا، (كتب أوبرا واحدة فقط)، ولكنه أبدع في التأليف للفن السيمفوني. وأعتقد أنّ كثيراً من الإجابات والحلول والمقترحات لهذه المسائل والإشكالات النّظريّة موجودٌ ببساطة متناهية لمن يريد رؤيتها في مؤلّفات ومبتكرات الموسيقار زياد الرّحباني، سواء الموسيقيّة منها أو الغنائيّة. أمّا مختصرها المفيد والمكثّف ببساطة للقارئ، فيكمن في سر الانفتاح الواسع والشّجاع دون عُقَدٍ أو خوف أو تابوهات، بشرط وحيد هو تناسب تماشيها في التحام عناصرها بعناصر الموسيقات الأخرى المختلفة الهويّة، من دون أن تنفي إحداها الثّانية، خصوصاً لناحية تقارب الأنترفالات (المسافات الصّغرى)، وتماشي صيغها اللّحنيّة بطريقة فنّيّة متناغمة.
إنّ الثّقافة في جوهرها تجلّياتها ووحدتها، لا يمكن لها -مهما تطوّرت وصفت- أن تكون وحيدة المنشأ والمسار والاتّجاه، مهما علا شأنها، ولا يمكن لها أيضاً أن تحيا بوجهها الواحد الأحد، أو بالعكس: أن تبقى حيّة وهي تنهل من مصدر وحيد، أعني به تراثها وماضيها مهما كان مشرقاً. لا بدّ للثّقافة بكلّ فروعها (والموسيقى بالضّرورة إحداها) من التّفاعل مع الجوار والمحيط والمستقبل، وإلّا سارت إلى زوال…
والموسيقى العربيّة، كالموسيقى الغربيّة لا يمكن اختزالها بأحد وجوه جوانبها المتعدّدة والمتنوّعة.. فكما الغربيّ لا يُختَزَل بالكلاسيك أو الجاز أو السّيمفونيّ – الآليّ، كذلك فالموسيقى الشّرقيّة العربيّة لن يختزلها أحد بمقامات معيّنة أو سكك إيقاعيّة وتقليديّة، أو طرق تأليف وعزف مونوفنيّ مغلق الأفق والتّوجّه تجاه البوليفونيا، هذا إذاً ظلم، وينطوي على نظرة انعزال ودونيّة. لعلّي لا أتطرّف هنا أنا الآخر إذا قلت إنّ بذور الإجابات موجودة في انفتاح الخلايا الجميلة المتعدّدة والمبتكرة الّتي يفتحها زياد في أنسجة موسيقاه على كثير من انسجام الآفاق القابلة للتّفاعل بحبٍّ وإيجابيّة تفتح على تلاقح يُؤتي ثماره الّتي نقطفها موشّحةً بألوان الفرح والمتعة والجمال في نسيج إبداعاته. إنّ بعض اللّبنانيّين الّذين يتغنّون -عن جهل أو تجاهل أو منفعة- بجبال لبنان الّتي غدت جرداء، أو سهوله الّتي يضربها الجدب والإهمال، أو تاريخه المفتوح على الحروب الطّائفيّة والفتن، أو معالمه الأخرى المفتوحة على قطاعات غير منتجة لا صناعيّاً ولا زراعيّاً ولا علميّاً، أجدى بهؤلاء أن يبحثوا في غمرة قسوة هذا الواقع المزمن عن المقامات الّتي لا تعرف، وفي غمرة عطاءاتها إلّا قمّة الإبداع الصّادق والحقيقيّ للقيم الجماليّة الباقية في تاريخ لبنان وثقافته المتعدّدة الجوانب. تلك الثّقافة والقيم الّتي تشكّل سرّ وجوده، وجوهر رسالته. فهل من يُعيد بناء معالم الأوطان ويسهم في تشكيل ملامحها الرّاقية إلّا أمثال الفنّان الحقيقيّ الّذي لا يعرف إلّا العطاء من دون تنازل عن الجودة، أو انحناء للقبح، والمال، وإغراءات السّهولة، والتّبسيط، أو الاختزال، ومن دون تكبّرٍ أو تعالٍ بل بتواضعٍ وحبٍّ. إذا كان لهذه القامات – في لبنان – من عنوان أو نموذج ، فأوّلهم من دون منازع هو هذا الرّحباني الأصيل… زياد.