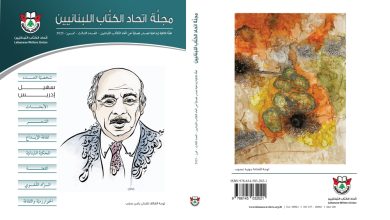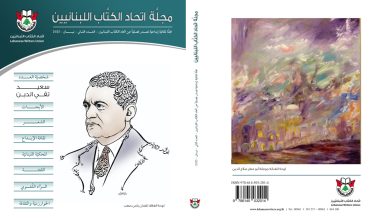مفردات الأغاني الحائرة: شكوى الشعراء المتجدِّدة – أ. د. علي نسر
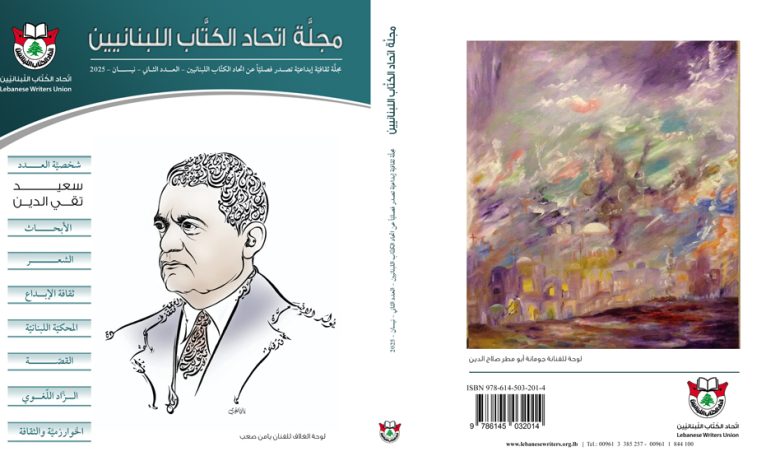
– القراءة الثانية –
مفردات الأغاني الحائرة: شكوى الشعراء المتجدِّدة
أ. د. علي نسر
وأنت تقرأ قصيدة مفردات الأغاني الحائرة، من ديوان “صهيل الأغاني الحائرة” للشّاعر أمين ألبرت الريحاني، تسحبك الكلمات الموحية بالتشتت، إلى قرون غابرة رفع فيها جهابذة الشعر العربيّ أصواتهم، شاكين انزلاق الموضوعات والمعاني والكلمات من فروج أصابع القصيدة، والحجّة، وقتذاك، عدم بقاء ما يمكن التعبير عنه بعد نفاده على أيادي السابقين، من “هل غادر الشعراء من متردّم” عند العبسيّ، إلى “ما أرانا نقول إلا رجيعاً/ أو معاداً من قولنا مكرورا” عند زهير، مروراً بمالئ الدنيا وشاغل الناس في قوله: “أتى الزّمان بنوه في شبيبته/ فسرّهم وأتيناه على هرمِ”، وكذلك المعرّي وغيرهم.
لكنّ شكوى الريحاني تختلف نظراً إلى اختلاف طبيعة الحياة، وما شهدته من تحوّلات بعد تلك التراكمات الحياتيّة. وذلك من خلال ما وفّرته القصيدة الحرّة الإشكالية، من فرصة لأصحابها، كي يحشدوا في القصيدة الواحدة، كمّاً من الثنائيات والمتعارضات من حيث الشكل والثيمات والموضوعات، بحجّة انفتاح النصّ وقدرته على استيعاب ما لم تستطع القصيدة بقالبها القديم من استيعابه. فالشاعر يبحث عن بقايا، أو فلول من جيوش الكلمات، ويحاول التقاطها كما يلتقط جامع المواد البلاستيكية والنحاسية النتف والمبعثر منها، ليقدّمها بحللٍ جديدةٍ بعد إعادة تدويرها. لكنّ أبرز ما يسلّط الشاعر الضوء عليه، ثنائية الجسد والروح، أو الخارج والباطن، أو المبنى والمحتوى، عبر كلمتين شكّلتا عمود القصيدة الفقري، وكل منهما امتداد للآخرى، وهما: قشرة الذات، وأديم الأرض. فالشاعر محاصر ويتعرّض للصفعات، ولكنّ المحاصِر والضارب هما سطحيّة الوجود لا الجوهر، فالسطحي إلغائيّ نظراً إلى عدم قدرته على مواجهة الفكر والعقل، فيواجه ذاك عبر سلوك حركيّ فيه من الإقصاء الكثير، وهذا مغاير لما يقوم به الجوهر حين يحتدم الصراع الجدليّ المنطقي، وهذا يردّنا إلى قناة المتنبّي حيث الفكرة الجوهرية الوجودية، يركّب فيها الضعيف سناناً (كلّما أنبت الزمان قناةً/ ركّب المرء في القناة سنانا).
ليست الكلمات والمفردات ما يرمي الشاعر إلى العثور عليه، بل شكّلت هذه الثيمات مطيّة ليعبر الشاعر عبرها إلى ما هو أبعد. إنّه منطق المدينة المشوّه، المدينة التي تشكّل هي الأخرى طرفاً في ثنائيّة السطح أو القشرة أو الأديم من جهة، وما يقابلها من جوهر وباطن ومحتوى ومواد من جهة أخرى. فتكمن الخطورة في سلب المدينة ما يحتاج إليه قاصدها أو قاطنها، من سمات العمق والجوهر والتعدّدية، وإن توافر هذا يصعّب تطويقها وتقويضها وخرقها، في حين أنّ الطرف الثاني، والذي تمثّله القرى من دون أن يسمّيها الشاعر- لأنّها ليست والمدينة مقصودتين بالمعنى بل بما يرمز إليهما- يحمل -أي الطرف الثاني- صفة الأحادية القشرية المتوقّع اختراقها في أي لحظة نظراً إلى الطينة ذات الرائحة الاجترارية التي لا تعرف التحوّلات مهما طالتها رياح التغيير والتبدّل، وهذا ما جعل المتنورين عبر التاريخ، ومنهم الأنبياء يبحثون عن المدن الكبيرة لترويج أفكارهم لأنّ التعددية في المدن تستوعب الطرح الجديد بعكس القرية ذات الفكر الأوحد.
ولم يكتف الشاعر بالإشارة إلى هذه الثنائية الصراعية عبر التنظير إليها فحسب، بل استطاع أن يلفت النظر إليها، عبر أسلوبه الشعري، إذ انعكس الحصار والتنميط اللذان يحاول الشاعر أن يهرب منهما، على القصيدة شكلاً وطريق تعبير وإيقاعاً، فالخوف دفع الشاعر إلى ما يشبه عدم تحديد الهويّة الإعرابية للكلمات، وبهذا استطاع تشويش أفق انتظار المتلقي من خلال جعله واقفاً وسط الحيرة التي ربّما يكون الشاعر قد وقف فيها هو الآخر، إذ شكّل غياب تشكيل بعض النعوت إلى الضياع الذي أراد الشاعر أن يشاركه القارئ فيه، فلم نعرف الانكسار إن كان عائداً إلى الذات أم إلى القشرة، (قشرة الذات المنكسرة)، فـ “المنكسرة” خلت من الحركة التي تجعلها تنتمي إلى قشرة (بالرفع) أو (المنكسرة بالكسر)، وكذلك (الغاربة) بالنسبة إلى المدينة أو الكلمات، والأمر نفسه يتجلّى في جملة (مفردات الأغاني الحائرة)، وكذلك في (صقيع الرماد الشريد).
هذا الخوف والتأرجح بين الكلمات المتوافرة والهاربة، جعلا الشاعر يستخدم مفردات من دون هويّة الحركات الإعرابيّة ليبقى المعنى عصيّاً عليه كي لا يسقط في بحيرة التنميط المستنقعية، ويجعل المخاطب سلبيّ التلقّي. لكنّ هذه المحاولة على مستوى التركيب النحويّ، أبطلها سقوطه المشير إلى خوفه من الخروج على المألوف كي لا يفتقد ما لديه بعد إعلانه الواضح عن محاولة جمع شمل المشتت الضائع. هذا الخوف أكثر ما تجلّى في الجانب الإيقاعي المتعلّق بمحاولة يتيمة لإيجاد موسيقى تحدّد هويّة النص، فكان ذلك عبر تكرار بعض الأحرف في نهاية السطر، تلك الأحرف التي يظّنها القارئ رويّاً في قصيدة موزونة لكنّها لم تكن سوى حركة من حركات السجع كما هي الحال في (شريدة وطريدة وعتيدة… ومجامر ومغاور). كما أظهر الشاعر نضوب الكلمات الوجودية عبر استخدامه كلمات إن دقّقنا في محتواها فقد تكون كلمات تواصليّة أكثر مما هي كلمات شعريّة تصلح في قصيدة. لكنّ هذا خدم فكرة القصيدة، وهي فكرة البحث والفقد ومحاولة تجميع المتناثر، وبهذا وفّق الشاعر في التوفيق بين الطرح المضموني والشكل التعبيريّ بنسبة ما.