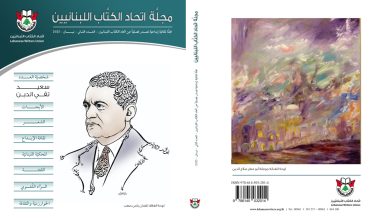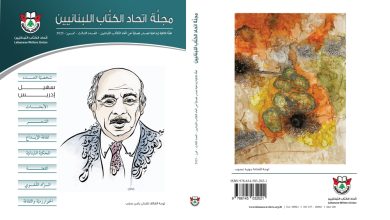الرَّسمُ العُثمانيُّ للقُرآنِ الكَرِيْم – أ. د. فايز ترحيني
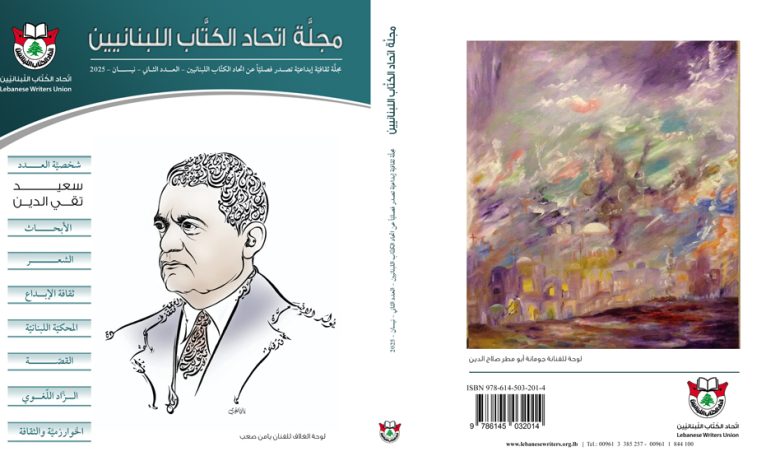
الرَّسمُ العُثمانيُّ للقُرآنِ الكَرِيْم
أ. د. فايز ترحيني
تمهيد: هو اللهُ سبحانَه الَّذي ورد اسمُه في القرآن الكريم بهذا اللَّفظ 2699 مرة، وهو عددٌ لا ينقسمُ إلَّا على نفسه، والنَّتيجة “أحَدٌ فردٌ صمد”. فاللهُ عنده أُمِّ الكتاب وعِلمِه، كِتابٌ مَكْنُـونٌ في لوحٍ محفوظ. فيه علمُ كلِّ الأكوان، وكلِّ مخلوقٍ في كلِّ الأمكنةِ والأزمان. الكتابُ المَكنونُ أُنزِلَ علمُه على الرَّسولِ الأكرم في ليلةِ القدر جُملةً واحدةً، قال تعالى: ﴿إنَّآ أَنزَلنَٰهُ فِي لَيلَةِ ٱلقَدرِ﴾ وجعلها مباركة، قال: ﴿إِنَّآ أَنزَلنَٰهُ فِي لَيلَة مُّبَٰرَكَةٍ﴾، كما أنزله بالتَّدرُّجِ حسب الحاجة ليسهُــلَ حِفظُه واستيعابُه.
الكتابُ المَكنونُ فيه القرآنُ الَّذي أنزلَه اللهُ على النَّبيِّ الكريم مُنَجَّماً وقرَّأه إيَّاه، فحفِظه وتدبَّره وكتَّـبَه وأدَّاهُ وبلَّغهُ وكان عليه شهيدا. فالقرآنُ الكريمُ أعجزَ الخلقَ بآيةٍ فما استطاعوا، وما عَـلِـمَ كُنْهَه إلَّا الله، أمَّا الرَّاسخونَ في العلم فدونَهم عقولٌ لما تنضجْ لاستيعابه.
القرآنُ المُنجَّمُ جُمِعَ في عهد الرَّسولِ في الصُّدور وفي السُّطور المُتاحَةِ آنذاك، ثمَّ جمعَهُ ابنُ أبي طالب مُرتِّباً سورَه حسب النُّزول، لكنَّه أخفاه بعد أن جمعه عُـثمانُ بين دفَّتي كتاب وأذاعه في الأمصار، وذلك توخِّياً للإجماع وحِرصاً على وَحدةِ المسلمين. بيد أنَّ الجمعين لا يختلفان في شيءٍ من حيثُ المضمونُ والجوهر، وإنَّما الاختلافُ محصورٌ باللِّسان والقراءة والرَّسم، والبحثُ يطول.
فالاختلافُ وقع حول الرَّسمِ القُرآنيِّ بين قائلٍ بالتَّوقيفِ وقائلٍ بالتَّوافقِ أو الاصطلاح أو الاجتهاد ولكلٍّ حُجَّتُه وبيانُه.
أمَّا نحن فنُغلِّبُ مذهبَ التَّوقيف لأنَّ التَّوافقَ يُفقِدُ القرآنَ شيئاً من قُدسيَّتِه، ويفتحُ بابَ الخروج عند كلِّ حُجَّةٍ إملائيَّة أو حاجة. فإذا عمَّ الرَّسمُ الإملائيُّ وتطوَّر قد تختفي أسرارٌ دينيَّةٌ ووجوهٌ بلاغيَّةٌ نَاتجةٌ عن الاختلاف في الرَّسمِ القرآنيِّ للكلمة الواحدة. عندئذٍ يُخشى أن يُصبحَ للمسلمين قُرآنان أو أكثر.
لذا نرى وجوبَ المحافظةِ على الرَّسمِ العُثمانيِّ سواءٌ أكان توقيفيَّاً أم توافُـقِـيَّاً. ونرى أنَّ الاختلافَ في رسم بعض الكلمات لم يأتِ عبثاً أو خطأً من الكَتَبَة، وإنَّما جاء لحكمةٍ أرادها الله، وكنوعٍ من أنواع إعجازه الَّتي لا تُحصى، وليُظهرَ لنا أبعاداً دينيَّةً ولُغويَّةً وبلاغيَّةً وغيرَ ذلك.
هو قرآنٌ واحدٌ برسمين: عُثمانيٌّ وإملائي، وسيبقى واحداً بالرُّغم من محاولاتِ “تهذيبِه” والتَّلاعُـبِ بجوهره لأسبابٍ سياسيَّةٍ بما يتلاءمُ مع مُتطلِّباتِ التَّطبيعِ مع العدوِّ الإسرائيليّ، وذلك بحذفِ كلّ ما يمسُّ طبيعةَ اليهود، كقوله تعالى: ﴿لتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱليَهُودَ…﴾، لكنَّ اللهَ سبحانَه وعد بردِّ كيدِهم ومكرِهم حين قال: ﴿إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا ٱلذِّكرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُون﴾.
ونحن سنأخذُ في هذا البحث بالرَّسمَ العثمانيّ لنُشيرَ إلى ثلاثة محاور، هي: الحذفُ وفتحُ التَّاءِ وقلبُ الواو. هذه الوَمضاتُ وغيرُها لا تُشكِّلُ قواعدَ عامَّةً يُبنى عليها، أو منهجيَّةً تُتَّبع في كتاباتنا، وإنَّما هي تعابيرُ قرآنيَّةٌ خالصةٌ تدلُّ على معانٍ استدعتها الضَّروراتُ الدِّينيَّةِ والنَّفسيَّةِ واللُّغويَّةِ وغيرها.
أوَّلاً: حذفُ الألف والياء: قد تُستبدلُ الألفُ أحياناً في الرَّسمِ العثمانيِّ بألفٍ خِنجريَّة، أو قد تحذف من كلمةٍ معيَّنةٍ وموقعٍ معيَّنٍ وتثبتُ في موقعٍ آخر.
1- الألف الخِنْجَـريَّة: تُسمَّى أيضاً المحذوفةَ والصَّغيرة، وهي تُشبه الخِنْجَر، تكتبُ فوق بعض الحروف للدَّلالة على وجود ألفٍ محذوفةٍ في النُّطق ثابتةٍ في الكتابة. وهي تفيدُ الاستمرارَ والتَّجانُسَ والإثباتَ وغير ذلك، وتستعملُ بشكلٍ خاصٍ في علم التَّجويد.
هي ليست حرفاً وإنَّما حركةٌ من حركات الضَّبط، وأنواعِ الشَّكلِ والإعجامِ الَّتي لحقَـت بالعربيَّةِ في مرحلةٍ لاحقة. فالقرآنُ الكريمُ جُمِعَ ثمَّ لحِقَـهُ الإعجامُ والشَّكلُ بما فيها الألفُ الخِنْجَريَّة.
2- حذفُ الألف: حُذفت الألفُ الفارقةُ في الرَّسم العُثمانيِّ من كلمةٍ معيَّنةٍ وأُبقيت في مثيلتها، وذلك لهدفٍ بلاغيٍّ أو دينيٍّ أو فُقهي أو لزيادةٍ في المعنى أو خِلافه.
أ- جَاءو وأخواتُها: حُذِفت الألفُ الفارقةُ في ستِّ كلماتٍ، هي: “جَاءو” وقد أتت في الرَّسمِ العُثماني في تسع آيات، منها قولُه تعالى: ﴿وَجَاءو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُون﴾، وقولُه: ﴿وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَم كَذِب﴾. فأُخوةُ يوسفَ كانوا يريدون التَّخلُّصَ منه حسداً، لكنَّهم اتَّفقوا على رميه في ﴿غَيَٰبَتِ ٱلجُبّ﴾، فحُذفت الألفُ الفارقةُ لأنَّ غايتهم في القتل لم تتحقَّق، وللبحث صلة.
وحُذِفت من “باءو” ثلاثَ مرَّات، منها قوله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وباءو بِغَضَبٍ مِنَ الله﴾. كما حُذفت مرَّةً واحدة من: ” فاءُو” في قوله: ﴿فَإِنْ فاءُو فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، ومن “عَتَو”، كقوله: ﴿وعَـتَو عُـتٌوّاً كَبِيْرا﴾، و”سَعَـو”، قال: ﴿والَّذيْنَ سَعَـو فِي آياتِنا مُعَاجِزيِن﴾، و” تَبَوَّءُو”، قال: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالإِيمَانَ﴾.
هذه المواضعُ حُذفت فيها الألفُ الفارقةُ بعد واو الجماعة تعبيراً عن الارتباكِ والقلقِ والخوف، وعدم تحقيق الغاية وشيوعِ الكذبِ والتَّزويرِ. ونتيجةً لذلك اختلَّت الأبعادُ النَّفسيَّةُ والقيمُ الدِّينيَّةُ والأخلاقية ممَّا أحدث نقصاً في المعنى وتالياً نقصاً في الرَّسم، وهذا دليلُ بلاغةٍ.
أمَّا رسمُ الهمزة في هذه الكلمات على الواو “جاؤو” فإنَّه جاز لاعتبارها متوسِّطةً مضمومة، ورسمُها منفردةً ” فاءُو” لاعتبارها مُتطرِّفةً لا تـتَّصل.
ويتَّصل بذلك كلماتٌ أُخرى كُتبت بالألف والواو لتدلَّ على معانٍ مُختلفة، كما في كلمة “نبأ ونبؤا”، فالأُولى تدلُّ على أنباء الدُّنيا والنَّاس بعامة، وبالواو تعني أنباء الآخرة والملائكة. ومنها كلمة “الملأ، الملؤا”. الأولى تعني صفوة النَّاس من حيثُ الغنى والشُّهرة، والثَّانية تعني خاصَّة الخاصَّة من مستشاري الحاكم وحاشيته.
ومنها كلمة ضُعفاء وضعفؤا. الأولى تدلُّ على ضعفاء الدُّنيا، والثَّانية تعني ضعفاء الآخرة الَّذين كانوا تابعين للمستكبرين في الدُّنيا.
وكلمة “دعاء، دعؤا”. الأولى تعني النِّداء ومناجاة الله تعالى في الدُّنيا، والثَّانية تعني دعاء الكافرين وهم في النَّار.
وكلمة “شُرَكَآءُ، شُرَكَٰٓؤُاْ”. قال تعالى: ﴿أَم لَهُم شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّين﴾، وقال: ﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُم شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمتُم أَنَّهُم فِيكُم شُرَكَٰٓؤُاْ لَقَد تَّقَطَّعَ بَينَكُم وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم تَزعُمُون﴾، تعني الأولى أشخاصاً لكلٍّ منهم نصيبٌ في ملكية شيءٍ ما، وتعني أيضاً جميع ما أشركه النَّاس بالله تعالى من أصنام وأوثان وغير ذلك، أما الثَّانية فهي أخصُّ لأنَّها تعني الَّذين وضعوا شرائع مغايرة لشريعة الله تعالى.
وكلمة “جزاء، جزؤا”، تعني الأُولى الثوابَ على عملٍ صالح، والعقابَ على عملٍ سيء، أما الثَّانية لا تعني الثواب أبداً بل تعني العقاب على عدد محدَّدٍ من الأعمال السَّيِّئة. وهذا يعني أنَّ الَّتي تَـرِدُ بالواو تكون أكثرَ خصوصيَّةٍ في المعنى من تلك الَّتي ترد بالألف.
ب- فَسْئل: جاء فعلُ الأمر “فسْئل” في الرَّسمِ العثماني محذوفاً ألفُه ابتداءً، وهذا الحذفُ مرتبطُ بالمفاجأة النَّاتجة عن سُرعةِ السُّؤال، وبالحضِّ على سُرعةِ الجواب، قال تعالى للمفرد: ﴿فَسْئلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِك﴾، وقال: ﴿وَسْئلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾، وقال للجماعة: ﴿وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِه﴾. فالنَّقصُ في الرَّسم ناتجٌ عن ارتباكٍ نفسيٍّ فرضته سُرعةُ الجواب. أمَّا كِتابةُ الهمزة في الوسط على كُرسيِّ الياء بدلَ الألف ففيها كلامٌ آخر.
ج- صَٰحِبِه: ليس المقصودُ بالصَّاحبِ دائماً الخليلَ والصَّديقَ المُقرَّب، بل قد يعني رفيقَ دربٍ طارئ مُختلِف. فيوسفُ قال: ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْن﴾، وهما ليسا من أتباعه أو أصدقائه.
والصُّحبةُ قد تكونُ بين مُؤمنٍ وكافر، كقوله تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾، فالمخاطَبُون كُفَّارٌ وصاحبُهم هو الرَّسول، وإيمانُ الرَّسول الكريم تامٌّ، لذا جاء ﴿صَاحِبُكُمْ﴾ تامَّاً تِبعاً لحالة الرَّسول “المُخَبَّر عنه”، وتمامُ المعنى استلزمَ تمامَ الرَّسم.
وقال قومٌ في “صَٰحِبِه” بحذف الألف إنَّها اختُصَّت بأبي بكرٍ بنِ أبي قُحافة، وإنَّه هو المقصودُ بقوله تعالى: ﴿إِذ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ﴾ (1) وإنَّ حذفَ الألف هنا دليلٌ على الحميميَّةِ القلبيَّة والالتصاقِ الرُّوحي بالرَّسول الكريم.
لكنَّ المشهدَ ليلةَ الهِجرة (2) يؤكِّدُ أنَّ “صَٰحِبَ” الرَّسول في “غارِ ثَـوْر” كان رجلاً كافراً اتَّخذه الرَّسولُ الكريمُ دليلاً بإجماع الرِّوايات، وخلط النَّاسُ بين الاسمين للتَّشابه.
فالالتصاقُ هنا جسديٌ وليس قلبيَّا، لأنَّ المُشتَركَ بينهما هو الخوف، فالرَّسولُ بحاجةٍ إلى سكينةٍ أنزلها اللهُ عليه فازداد إيماناً وتسليما، وذاك بقي قلبُه فارغاً ناقصاً إيماناً بالرُّغم من الطُّمأنينة الَّـتي تولاَّها الرَّسولُ. فجاءت كلمةُ ﴿لِصَٰحِبِهِ﴾ ناقصةً تِبعاً لحالة “أوَّلِ الاثنين” من المُخاطَبَين. والفراغُ أو النَّقصُ في المعنى استلزمَ النَّقصَ في المبنى فحُذفت الألف.
ومثلُ ذلك قوله: ﴿فقَالَ لِصَٰحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَـكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا﴾، فصاحبُ المُؤمنِ هنا كافرٌ مُـرتَد ينقصه الإيمان، لهذا حُذفت الألفُ لأنَّ النَّقصَ في المعنى استلزمَ النَّقصَ في المبنى.
3- حذفُ الواو والياء: قد تُحذفُ الواو أو الياءُ من كلمة في موقعٍ معيَّنٍ وتبقى في مثيلاتها:
أ- الواو: تُحذفُ “الواو” لعلَّةٍ نحْويةٍ كالتقاء السَّاكنين، كما في قوله تعالى: ﴿يَمحُ ٱللَّهُ ٱلبَٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ﴾. أو قوله: ﴿يَومَ يَدعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيءٍ نُّكُر﴾، أو قوله: ﴿سَنَدعُ ٱلزَّبَانِيَة﴾. لكنَّ هذا الحذفُ من حيثُ المعنى له دلائل منها سُرعةُ ذهاب الباطل واضمحلاله في الأولى. وسُرعةُ الدُّعاء وسُرعة الإجابة في الثاَّنية، وسُرعة الفعل وسهولته على الفاعل في الثَّالثة.
ب- الياء:
– ياءُ إبراهيم: وردت كلمةُ “إِبرَٰهِم” في سورة البقرة خمسَ عشْرةَ مرَّة رُسمت جميعُها بلا ياء بخلاف باقي السُّور، قال تعالى: ﴿إِذ جَعَلنَا ٱلبَيتَ مَثَابَة لِّلنَّاسِ وَأَمنا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبرَٰهِمَ مُصَلّى وَعَهِدنَآ إِلَىٰٓ إِبرَٰهِمَ … وَإِذ قَالَ إِبرَٰهُِم رَبِّ ٱجعَل هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنا…وَإِذ يَرفَعُ إِبرَٰهِمُ ٱلقَوَاعِدَ مِنَ ٱلبَيتِ … وَمَن يَرغبُ عَن مِّلَّةِ إِبرَٰهِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفسَهُۥۚ …. وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبرَٰهِمُ بَنِيهِ وَيَعقُوبُ ….. قَالُواْ نَعبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبرَٰهِمَ وَإِسمَٰعِيلَ وَإِسحَٰقَ إِلَٰها وَٰحِداً وَنَحنُ لَهُۥ مُسلِمُون﴾.
فكلمةُ ابراهيمَ قُرئت “إِبْرَاهَام”، وهي لغةٌ عِبْرانِية تُرِكت في الرَّسم العُثمانيِّ ولم تُعَرَّب، لأنَّ سورةَ البقرة تحدَّثت إجمالاً عن بني إسرائيل الَّذين كانوا ينطقونها كذلك، ولأن إبراهيم وإبراهام كجبريل وجبرائيل، وهي لغةٌ من ستِّ لغاتٍ تأثَّر فيها القرآنُ الكريم. كما أنَّها تُشبه لغةَ أهل الشَّام. ومُراعاةً لذلك أبقاها النُّسَّاخُ على لفظها ورسموها بدون ألف. وكُتبت في غير سورة البقرة بياء مُراعاة لِـلُغة قريش، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحسَنُ دِينا مِّمَّن أَسلَمَ وَجهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحسِن وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبرَٰهِيمَ حَنِيفا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبرَٰهِيمَ خَلِيلا﴾.
– ياءُ أيْـدٍ وأييد: وردت كلمةُ أَيْــدٍ بمعنى القوَّة مرَّتين، واحدةٌ بياء واحدة، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّاب﴾، حيث دلَّت على قوَّة داوُد كإنسان، وأُخرى بياءين دلَّت على قوَّة الله اللَّامحدودة، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُون﴾. والزِّيادة في المعنى تطلَّبَت زيادةً في المبنى.
ثانياً: التَّاءُ بين الفتح والرَّبط: كلُّ تاءٍ اختلفوا في قراءتها بين المُفردِ والجمع كُتِبَت مفتوحة. والتَّاءُ كالصُّرَّةِ أو الكيس، فإذا كان ما بداخله مجهولاً أو لم يستطع المرءُ الخروجَ مِنه أو الدُّخولَ إليه رُسمت تاؤه مقبوضةً مربوطة. وإذا كان ما بداخله معلوماً أو استطاع المرءُ الدُّخولَ أو الخروجَ رُسمت تاؤه مبسوطة. فالمجهولُ والمُقيَّدُ يناسبُه الإغلاق، والمعلومُ والمُطلقُ يُناسبه الفتح.
في المصاحفِ العُثمانيَّةِ رُسمَت التَّاءُ مربوطةً في كلمةٍ معيَّنةٍ وموقعٍ مُعيَّن، ثمَّ رُسمَت مفتوحةً في موقعٍ آخر، وهذه بعضُها:
1- ابْنَت: وردت التَّاءُ مبسوطةً في قوله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا﴾، بإثباتِ الألف وفتحِ التَّاءِ خلافاً للقاعدة الَّتي توجبُ حذفَ الألفِ والإبقاءَ على التَّاء مفتوحةً إذا كانت مُرتبطةً بمعرفة، أمَّا إذا كانت مُرتبطةً بنكرةٍ أو مجهولٍ فتأتي مربوطة.
أمَّا إجازة القول “ابْنَت” بألف وتاءٍ مفتوحة فلخصوصيَّتها كونها المرأةَ الوحيدةَ في العالم الَّتي حملت بلا دَنَس، ولأنَّها إحدى أفضلِ أربع نساءٍ (2) في العالمين. فالتَّمامُ استلزم التَّمام.
2- امْرَأت: يُطلقُ لفظُ امرأة على من لم تكن مع زوجها على وفاقٍ تام، سواءٌ أكانت التَّاءُ مفتوحةً أم مربوطة، وبعكس ذلك كلمة “زوج”. فكلمة “امْرَأت” وردت بتاءٍ مفتوحةٍ في القرآن الكريم سبعَ مرَّات، منها قوله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ﴾، و﴿امْرَأَتَ نُوحٍ﴾، و﴿وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾، و﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾، وذلك لأنَّها عُرِّفَـت بالعَـلَميَّة، ولإضافتها صراحةً إلى اسم بعلها. كما أنَّ الاختلافَ بالمعتقد أوجب القولَ: امرأة أو امرأت وليس زوجا.
أمَّا مجيئ ﴿ٱمرَأَتُ عِمرَٰنَ﴾ بدل “زوج” بالرُّغم من انتفاء الاختلاف بين الزَّوجين لأنَّها نذرت ما في بطنِها للرَّحمن قبل الولادة، وحين وضعَـت حَمْلَها كان زوجُها قد تُوفي. وكُتبت ﴿ٱمرَأَتُ﴾ أيضاً بتاء مفتوحةً كما في قوله تعالى: ﴿رَبِّ أَنَّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِر﴾ لإضافتها إلى ضميرٍ يعود على اسم علم.
وكُتبت مربوطةً إذا جاءت نكرةً أو اقترنت بنكرةٍ مجهولة، كقوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزا﴾. فكلُّ كلمةِ “امرأة” إن كانت معرفةً رُسمت مفتوحة، وإلَّا جاءت مربوطة.
3- آيت: يُبحثُ فتحُ تاء “آيت” من حيثُ صلاحُ الرَّسمِ للإفراد والجمع، ولقد وردت مفتوحةً في موضعين، قال تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَـتٌ لِّلسَّائِلِين﴾، وقال: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَــــتٌ مِّن رَّبِّهِ﴾. فقرأ ابنُ كَثِـيرٍ وغيرُه “آيَـتٌ” بالإفراد، وقرأها حَفْصُ وآخرون “آيات” بالجمع. وكلُّ ما اختُلِف في قراءته بين الإفرادِ والجمع فبالتَّاء المفتوحة رُسم.
4- بَقِـيَّتْ: فُتحت تاء “بَقِـيَّتْ” في القرآن الكريم مرَّة واحدة وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ … بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِين﴾. فــالقصدُ إن فعلتم ما أُمرتم فـ “بقيَّتُ الله” الَّتي هي دوامُ بسطِ الرِّزقِ الحلال خيرٌ لكم، والبسطُ في المعنى يلزمُه بسطٌ في المبنى.
وجاءت مربوطة كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى﴾. قُـبضت تاءُ “بقية” لأنَّ ما تُركَ أُقفل عليه وحُفظ، والربَّطُ يستلزم الرَّبط.
وفي قوله أيضاً: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُم﴾، جاءت تاءُ “بقيَّة” مربوطةً لقِلَّةِ وجودِ أُناسٍ ينهون عن الفساد، والقِلَّةُ في المعنى استلزمت الرَّبطُ في الرَّسم الإملائي.
5- بَيِّنَت: وردت تاءُ “بيِّنة” مفتوحةً مرَّةً واحدة في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ﴾. قُرئت بالجمع ووُقِـفَ عليها بالتَّاءِ تِبعاً للرَّسم العثماني، وصلاحُ قراءتها بالجمع على تفصيل الحُجج المكوَّنَة منها، وأنَّ كلَّ واحدةٍ منها تُعطي للأُخرياتِ قوَّةً ووضوحاً وجلاء.
وقُرئت بالإفراد على معنى البصيرة، وَوُقِفَ عليها بالهاء تِبعاً لمثيلاتها الَّتي وردت مربوطة، كقوله: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِه﴾. وما اختُلفَ في قراءته بين الإفرادِ والجمع فبالتَّاء المبسوطة كُتب.
6- ثَمَرَٰت : قرأ قومٌ قولَه تعالى: ﴿إلَيهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَٰت مِّن أَكمَامِهَا﴾ بالإفرادِ ووقف عليها بالهاء، والمقصودُ فيها ثمراتُ الدُّنيا.
وقرأها قومٌ على الجمع لأنَّها اسمُ جنسٍ أتى قبلَها حرفُ “مِن” الدَّالَّةِ على التَّبعيض بمعنى العمومية، وللاختلاف رُسمت مبسوطة، وجاءت كذلك في خمسةَ عشَرَ موضعا.
وقُرئت مُفردةً عند الجميع، كما في قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْل﴾، رُبطت التَّاءُ بالرُّغم من أنَّها اسمُ جنس يفيدُ الجمعَ لأنَّ المقصودَ ثمرةُ الآخرة، وقد اقتصرت على أصحاب الجنَّة.
7- جِمَٰلَت: قال تعالى في وصفه لشرر نار جهنَّم: ﴿تَرمِي بِشَرَرٍ كَٱلقَصْرِ كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٌ صُفر﴾، قُرئت بالإفراد، وبالجمع بكسر الجيم أو ضمِّها. فالنَّارُ شررُها عظيمٌ مرتفعٌ كالقَصْر لا يمكنُ لناظرٍ حصرُه. وجِمالاتٌ جمع جَمَل، وصفَها بالصَّفراء لأنَّ ألوانَها سوداءُ تضربُ إلى الصُّفرة. وبسطُ التَّاءِ أنسبُ لأنَّ الشَّررَ جمعٌ، والجمع تناسبه التَّاءُ المبسوطة.
8- جَنَّت: وردت كلمةُ “جَنَّت” في الرَّسم العُثماني مبسوطةً مرَّةً واحدة، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلمُقَرَّبِينَ فَرَوح وَرَيحَان وَجَنَّتُ نَعِيم﴾، والمقصودُ الدَّرجةُ العُليا من درجات الجنَّة حيث تُفتحُ أمام المقرَّبين مخازنُ المعرفة والنَّعيم، والفتح في المعنى استلزم البسطَ في المبنى.
9- رَحْمَت: وردت مبسوطةً في القرآن الكريم في سبعةِ مواضع، منها ما دلَّ على الفرجِ بعد اليأس، كقوله تعالى: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْت﴾ حيثُ وَلَدَت زوجُ إبراهيمَ بعد انقطاع.
أو دلَّ على بسط الرَّحمة، كما في قوله: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا … ورَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون﴾. فرحمة ُالله تعالى بُسِطَت للنَّاس عندما اختار اللهُ محمَّداً نبيَّاً والإسلام ديناً بعد فترة انقطاع.
أو دلَّ على استمرار الحياة بعد موتها، كقوله: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّه كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾، حيث أرسل الغيثَ فبعث الحياة من جديد.
ومنها ما دلَّ على أنَّ الدُّعاءَ والاستغفارَ يَبسُط الرَّحمة، كما في قوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِين﴾.
فإذا كان الإفسادُ في الأرض مَدعاةً لعقاب الله وقطع رحمته، فإنَّ الاستغفار يَبسُطها. وكذلك فإنَّ العملَ على نشر الدِّين وبسطه يَبسُط ُ الرَّحمة، كما في قوله: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّه﴾. والبسطُ في المعنى استلزم البسط في المبنى.
10- سُنَّتُ: بُسِطت تاءُ “سُنَّة” في خمسةِ مواضع، منها قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِين﴾. فمن كفرَ ثمَّ تابَ غفرَ اللهُ له، ومن عاد إلى الكُفر بعد توبة فُتحت عليه أبوابُ الهلاك الآنيِّ والأبدي، وتلك سُنَّةٌ في عذاب الأَوَّلين. فالسُّنَّةُ بتاءٍ مفتوحةٍ بَسطَت لهم الهلاكَ في الدُّنيا والآخرة.
وأما السُّنَّةُ بتاءٍ مقبوضةٍ فقد جاءت في ثمانِ آيات، منها: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾.
فسُنَّةُ الأوَّلين هنا مفادُها الاستهزاءُ بالأنبياء، والكفرُ الَّذي ملأ قُلوبَهم ومكث فيها ولم يبرحْها، والمُكوثُ الدَّائمُ استوجب القبضَ والرَّبط.
11- شَجَرَتُ: التَّاءُ المفتوحةُ تدلُّ على معلومٍ معروفٍ كما سبق القولُ، ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ … خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ﴾ يتحدَّثُ عن شجرة تنبتُ في جهنَّم، تلك الشَّجرةُ عرف أهلُ النَّار صفاتِها بالمشاهدة والممارسة، والمعرفةُ تستوجب بسط التَّاء وفتحها.
أمَّا في قوله: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ …﴾ فإنَّه يصفها لأُناسٍ يجهلونها لأنَّهم ما زالوا في عالم الدُّنيا. والجهل يستوجبُ قبضَ التَّاء وربطَها.
12- غُرُفَٰت: وردت “غُرُفَٰت” في الرَّسم العثماني بتاء مفتوحة مرَّةً واحدة، قال تعالى: ﴿ومَآ أَموَٰلُكُم وَلَآ أَولَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُم عِندَنَا زُلفَىٰٓ إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُم جَزَآءُ ٱلضِّعفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُم فِي ٱلغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ﴾. فالآية قُرئت بالإفراد والجمع لذلك وجب بسطُ التَّاء.
13- غَيَٰبَتِ: وردت “غَيَٰبَتِ” في الرَّسم العثمانيِّ بتاءٍ مفتوحة مرَّتين، وغلب على قرأتِها الإفراد. قال تعالى: ﴿قَالَ قَآئِلٌ مِّنهُم لَا تَقتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلقُوهُ فِي غَيَٰبَتِ ٱلجُبِّ يَلتَقِطهُ بَعضُ ٱلسَّيَّارَةِ﴾، وقال: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَٰبَتِ ٱلجُبّ﴾.
فأُخوةُ يوسف كانوا يريدون التَّخلُّصَ منه حسداً لكنَّهم اتَّفقوا على رميه في ﴿غَيَٰبَتِ ٱلجُبّ﴾. والجُبُّ واسعٌ رَحْبٌ ممَّا أتاح له النَّجاة، فجاءت التَّاءُ مفتوحةً لتناسبَ رحابةَ الجُبّ من ناحية، وإبقاءَ باب الحياة أمامه مفتوحاً.
14- فِطْرَتَ: وردت بتاءٍ مفتوحةٍ مرَّةً واحدة، وهي في قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾. مادَّةُ فَـطَـرَ تُفيدُ الانفتاحَ بعد طول انقباض، ولذا سُمِّي طعامُ الصَّباح فُطورا، وفِطْرَةُ الله هي تقبُّـلُ النَّفس البشريَّة للدِّين، والانفتاحُ على قيمه، لذلك جاءت التَّاءُ مفتوحة.
15- قُـرَّت: وردت مبسوطةً مرَّةً واحدة في قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُون﴾. فامرأةُ فرعون عقيمٌ، لذا ﴿قُــرَّت﴾ عينُها بعد أن تحقَّقَ حلمُها “بالولادة” وفُتحت أمامها أبوابُ الأمل، وتبعاً لذلك فُـتِحت التَّاء.
ووردت بتاء مقبوضةٍ في موضعين، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاما﴾، وقال: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. في الموضعين كان الأملُ مُنتظراً لكنَّه لم يتحقَّق بعد، وبقي حالُ القُـرَّةِ مقفلاً وقت دعوةِ الدَّاعي، لذا جاءت التَّاءُ مقفلةً ومربوطة.
16- كَلِمَت: وردت مفتوحةً في خمسةِ مواضع، واحدةٌ منها قُرئت بالإفراد، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ … وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾، أي إنَّ اللهَ سبحانه تمَّت كلمتُه وحقَّـق لموسى ما وعد قومَه به. والتَّمام في المعني استوجب التَّمامَ في المبنى فجاءت التَّاءُ مبسوطة.
وأربعٌ قُرئت بالإفراد والجمع، منها قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا … وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا﴾، فاللهُ سبحانه وعد أهلَ الكتاب بإرسال محمَّدٍ نبيَّا، وصدقَ اللهُ وعدَه وتمَّت كلمتُه ببعثة النَّبي الكريم. رُسمت مفتوحةً لاختلاف قراءتها بين الإفراد والجمع، ولأنَّ الوعدَ تمَّ وتحقَّق.
17- لَعْنَتْ: بُسطت التَّاءُ في آية المباهلة، قال تعالى: ﴿… ثُمَّ نَبتَهِل فَنَجعَل لَّعنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلكَٰذِبِين﴾ وفي آية اللِّعان، قال: ﴿وَٱلخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعنَتَ ٱللَّهِ عَلَيهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلكَٰذِبِينَ﴾، وفي الموضعين جاءت اللَّعنةُ مُوجِبةً لأنَّ الكاذبين دخلوا فيها طوعاً واختياراً، وإذا وجَبَت فُتِحَـت، وفُتحت لأجلها التَّاء.
18- مَعْصيت: بُسطت التَّاءُ في موضعين، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنْ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ …. حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِير﴾. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُون﴾.
رُسمت مفتوحةً لأنَّها جاءت تحذيراً لمن دخل طوعاً في الإثمِ والعُدوان، وفي معصية الله والرَّسول، والمعصيةُ المفتوحةُ من حيثُ المعنى يلزمها تاءٌ مفتوحةٌ من حيثُ المبنى.
19- نِعْمَتَ: بُسطت التَّاءُ في مواضعَ عديدةٍ، منها قوله تعالى: ﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾. فنِعَمُ اللهِ سبحانه مفتوحةٌ لا تُحصى، والفتحُ استوجب الفتح.
وفتحت في حال الخروج منها بعد التَّمتُّع بها، كقوله: ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُون﴾. وفي حال عُرفت ثم أُنكرت، كقوله: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ﴾، وفي حال بُدِّلت، كقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار﴾.
وبُسطت أيضاً إذا كانت النِّعمةُ معروفة، كقوله: ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُون﴾، أو قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾، أو كقوله: ﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُون﴾.
وبُسطت في تلك الَّتي أراد اللهُ أن يُذكِّر بها المؤمنين، قال: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِه﴾، فالقرآن الَّذي أخرجه لهم بسط أمامهم أبوابَ النِّعمة مما استوجب بسط التَّاء وفتحها. ومثل ذلك نعمةُ الإسلام الَّذي أخرجهم من العداوة والشِّرك إلى المودَّة والنَّعيم، قال: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾.
ثالثاً: قلبُ الواو
كلماتٌ خمسٌ كُتبت بالواو تعلوها ألفٌ خِنْجَريَّةٌ في الرَّسم العُثمانيِّ لكنَّها قُرئت بألفٍ صحيحةٍ، وهي: ٱلرِّبَوٰٓاْ وٱلغَدَوٰةِ ومِشكَوٰة ومَنَوٰةَ وٱلنَّجَوٰةِ. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ … بِأَنَّهُم قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلبَيْعُ مِثلُ ٱلرِّبَوٰاْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلبَيعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾.
وقال: ﴿وَٱصْبِر نَفسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدعُونَ رَبَّهُم بِٱلغَدَوٰةِ وَٱلعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجهَهُۥۖ﴾، وقال: ﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضِ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشكَوٰة فِيهَا مِصبَاحٌ ﴾، وقال: ﴿أَفَرَءَيتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلعُزَّىٰ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلأُخرَىٰٓ﴾، وقال: ﴿ويَٰقَومِ مَا لِيٓ أَدعُوكُم إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّار﴾.
وثلاثٌ مثلُها، وهي: ٱلحَيَوٰةِ وٱلزَّكَوٰةَ وٱلصَّلَوٰةَ. كُتبت بالواو فوقها ألفٌ خِنجريَّة، وتاءٍ مربوطةٍ سواءٌ أكانت نكرة، كقوله تعالى: ﴿وَلَكُم فِي ٱلقِصَاصِ حَيَوٰة يَٰٓأُوْلِي ٱلأَلبَٰبِ لَعَلَّكُم تَتَّقُون﴾ أم مُعرَّفةً بأل، كقوله: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱركَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِين﴾، أم معرَّفة بالإضافة كقوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشتَرَوُاْ ٱلحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا بِٱلأٓخِرَةِ﴾.
أمَّا إذا أُضيفت إلى ضمير رفعٍ مُتحرِّكٍ فإنَّها تُكتبُ بألفٍ طويلة وتاءٍ مفتوحة، كقوله تعالى: ﴿يَقُولُ يَٰلَيتَنِي قَدَّمتُ لِحَيَاتِي﴾. أو قوله: ﴿وَيَومَ يُعرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذهَبتُم طَيِّبَٰتِكُم فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنيَا﴾، أو قوله: ﴿وَقَالُوٓاْ إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنيَا وَمَا نَحنُ بِمَبعُوثِينَ﴾.
هذه الكلماتُ اختلفوا في سبب كتابتها بالواو فوقها ألفٌ خنجريَّة. بعضهم ذهب إلى أنَّ الألف لا تُفخَّم لذاتها لذا رُسمت بصورة الواو لتؤدي مُؤدَّاه، وهذا أمرٌ دخل إلى العربيَّة من السِّريانيَّة. وذهب غيرهم إلى أنَّه بقايا أثريَّة من الخطِّ النِّبْطي.
وذهب آخرون إلى أنَّ “”ٱلحَيَوٰةَ وٱلزَّكَوٰةَ وٱلصَّلَوٰة” أصلُ ألفِها “واوٌ”، وجمعُها حيوات وزكوات وصلوات. أو أنَّها رُسمت كذلك مراعاة لبعضِ لُغات الأَعراب الَّذين كانوا يميلون في اللَّفظ إلى الواو، وقُلبت ألفاً لمَّا انفتحت وانفتح ما قبلها.
وذهب البعضُ إلى أنَّ هذه الكلمات كُتبت “بالواو” دلالةً على الاستمرارِّيَّة، في حين تدلُّ الألفُ الوسطى على الانفصالِ والانقطاع.
قطوف الكلام: هو قرآنٌ واحدٌ برسمٍ عُثمانيٍّ وآخرَ إملائي. فكلُّ كلمةٍ في الرَّسمِ الأوَّل جاءت غيرَ مُتوافقةٍ مع الثَّاني من حيثُ الكتابةُ أو القراءة فإنَّها لم تأتِ عبثاً أو خطأً من الكَتَبَةِ والنُّسَّاخ، وإنَّما ارتبط ذلك بالفهم الدِّينيِّ وباللُّغة والبلاغة والمعنى.
فتاءُ “امرأةٍ” مثلاً جاءت في الرَّسم العثمانيِّ أحياناً مفتوحة، وذلك لتدلَّ على معنىً جديد، ومثلها كلمة “شجرت”. كما أنَّ كلماتٍ كـ” ٱلصَّلَوٰة” رُسمَت بالواو وفوقها ألفٌ خِنجريَّة لتدُلَّ على التَّفخيمِ أو الوعيد، أو لارتباطها بالجذر، أو هي بقايا أثريَّة من الخطِّ النِّبْطي، أو لتأثُّرها بالعبرانيَّة، لكنَّها قُرئت في كلِّ الأحوال بالألف.
أمَّا من حيث القراءةُ فكلُّ تاءٍ اختلفوا في قراءتها بين المُفردِ والجمع كُتِبَت مفتوحة. وهي كالصُّـرَّة، فإن كان ما بداخلها مجهولاً رُسِمَت مقبوضةً مربوطة. وإن كان معلوماً رُسِمت مبسوطةً أو مفتوحة. فالمجهولُ يناسبُه الإغلاق، والمعلومُ يُناسبه الفتح.
1- جاء في الذِّكر الحكيم: ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذ أَخرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثنَينِ إِذ هُمَا فِي ٱلغَارِ إِذ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحزَن إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّم تَرَوهَا﴾،
2- اتَّـفقَ المسلمون على الاثنينيَّة الجسديَّة أي إنَّ الرَّسولَ كان في الغار ومعه شخصٌ واحدٌ فقط، وعلى أنَّ خطرَ كُـفَّارِ مَكَّةَ كان مُحدِقاً بهما. واتفقوا أنَّ الرَّسولَ كان: ﴿ثَانِيَ اثنَينِ﴾، لكنَّهم اختلفوا حول شخصيَّةِ “الأوَّل” الذي كان في صُحبة الرَّسول الكريم.
في المشهد كان الرَّسولُ الكريمُ و”صَٰحِبُه” بحاجة إلى طمأنة، ﴿فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيه﴾ أي على الرَّسول وحده. هذه السَّكينةُ الإلٓــهيَّة لم تمسَسْ قلبَ “الصَّاحبِ” بالتَّــأكيد، لأنَّ الضَّميرَ مُفردٌ يعود على الرَّسول وحده. أمَّا الصَّاحبُ فقد جاءت طمأنتُه على لسان الرَّسول، فقال: ﴿لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا﴾. هذا التَّطمينُ أمرُ طارئ يتطلَّبُه الموقفُ المُحرج، أمَّا السَّكينةُ فهي طُمأنينةٌ ثابتةٌ دائمة.
وفي صحيح البُخاري في حديث مرفوع: كان سالمٌ مولى أبي حُـذَيفة يَـؤُمُّ المهاجرين الأولين وأصحابَ النَّـبيِّ في مسجد قُـبَـاء في يثرب قبل هجرة الرَّسولِ إليها، وكان فيهم أبو بكرٍ وعمرُ وأبو سَلَمَة وزيدٌ وعامرُ بنُ ربيعة. وهذا يعني أنّ أبا بكرٍ لم يكن في الغار إلى جانب الرَّسول لتعذُّرِ وجوده في مكانين مُتباعدين في وقت واحد.
ذهب قومٌ أنَّ الصَّحب في الغار إنَّما هو أبو بكرٍ بنُ أبي قُحافة، وجعلوا ذلك دليلاً على مكانتِه في الإسلام، إذ وضعه اللهُ أوَّلا، وجعل النَّبيَّ ثانياً، وأنَّ السَّكينةَ إنَّما أرسلها اللهُ إلى نفس أبي بكر، لأنَّه كان خائفاً مرعوباً، والرَّسولُ حاشا أن يدخلَ قلبَه الرُّعب.
وذهب آخرون إنَّما هو عبدُالله بنُ أُريقط بن بكر وكان كافراً، لكنَّ طبيعةَ العرب في الوفاء بالعهود وإجَارة الملهوفِ غلبته. وجعله اللهُ أوَّلَ الاثنين لأنَّه الدَّليلُ وأوَّلُ من وطأت نِعالُه الغار. وخلط النَّاس بين الاثنين لتشابه الأسماء. انظر كتابنا: عُصارة عمر، تحت عنوان: ثاني اثنين إذ هما في الغار، دار المحجَّة البيضاء، 2025، ص: 27.
3- هنَّ: آسية ابنت مُزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنت عمران، وخديجة ابنت خويلد زوج الرَّسول، وفاطمة ابنت محمَّد زوج الإمام علي. والمعروف أنَّ كلمة ابن وابنة تحُذف ألفه وتُّفتح تاؤه إذا كان بين اسمي علم.