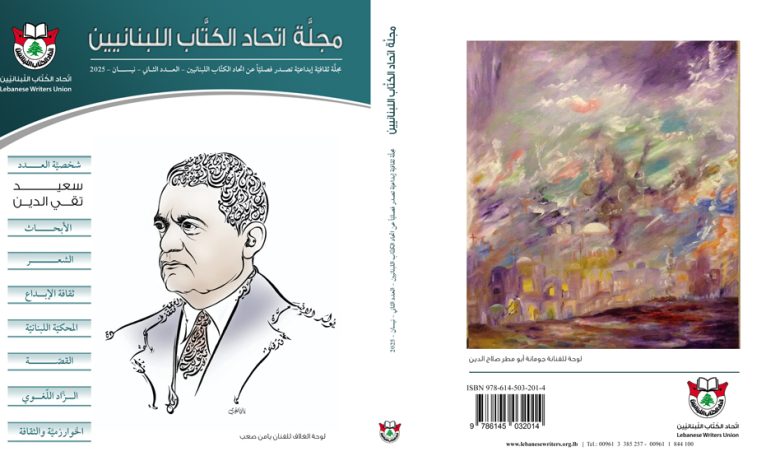
نُظُم الحُكم والإدارة في بلاد الأندلس
أ. د. مريم قاسم
الأندلس هي تلك البلاد التي وطِئَتْها أقدام العرب الفاتحين، وقد سُمِّيت بذلك نسبةً إلى رجل نزَلَها قديماً اسمه الأندلس بن طوبال بن يافث بن نوح(1). وقيل: نسبة إلى قوم سكنوها بعد الطُّوفان، عُرِفوا بالأندلش، ثم عُرِّب الاسم بالسين غبر المُعجَّمة، فصار: الأندلس(2). وقيل: إنَّ العجم الذين كانوا يتملَّكون تلك البلاد قبل دخول العرب، كانوا يُسَمُّونها الأندلوش(3). وروى ابن خلدون أنَّ العرب الذين فتحوا تلك البلاد هم الذين أسْمَوْها الأندلوش(4). وقيل: إنَّ قوماً عُرفوا ب “فاندلوس” Los Vandalos، دخلوا إسبانيا نحو سنة 409م، واستقرّوا في سهولها الجنوبيَّة، فنُسِبَتْ تلك السهول إليهم، فصارت تُعرف باسمهم، ثم خُفِّف هذا الاسم من قبل العرب وأصبح “أندلس”(5).
وكانت كلمة “أندلس” تنطبق على الأراضي الإسبانيَّة والبرتغاليَّة، التي تَمَّ فتحها من قبل العرب والمسلمين، ثم أخذ مدلولها يقِلّ شيئاً فشيئاً تَبَعاً للوضع السياسي، وبعد زوال الحكم العربي من الأندلس، صارت كلمة “الأندلس” تنطبق على الإقليم الجنوبي من إسبانيا الحاليَّة، الذي يعرف باسم “أندلوسيا” Andalucia(6).
والأندلس شبه جزيرة، يحيط البحر بجميع جهاتها إلّا من جهة الشِّمال(7). وتشتمل على مَوْسطة وشرق وغرب (8). وكان مؤرِّخو الأندلس يُشيدون بحسن هوائها وكثرة محاسنها، فقال ابن غالب نقلاً عن أبي عبيد البَكْري: “الأندلس شاميَّة في طِييها وهوائها، يمانيَّة في اعتدالها واستوائها، هنديّة في عطرها وذكائها، أهوازيّة في عِظَم جنّاتها…”(9)
وقبل فتح الأندلس عام 92ه/711م، كان الخليفة عثمان بن عفّان قد أمر بالسَّيْر إلى الأندلس عام 27ه/647م، فغزوها في هذا التاريخ ثمّ عادوا إلى أفريقية(10). وقد تَمَّ فتح الأندلس سنة 92ه/711م في عهد الخليفة الأُمَوِيّ الوليد بن عبد الملك على يد العربي موسى بن نصير ومولاه البربري طارق بن زياد(11).
وفي عام 95/714م اتَّخذ الوليد قراراً بعودة موسى وطارق إلى دمشق، وسَحْب جيوشهما من جنوب فرنسا، فعادا في السنة التالية إلى المشرق بما كان معهما من غنائمَ وذخائرَ وأموالٍ، بعد أن عَيَّنَ موسى ابنه عبد العزيز والياً على الأندلس في أواخر العام المذكور(12).
ولم يكن هذا الفتح سوى نتيجةٍ حتميَّةٍ لِما اقتضته طبيعة الحركة العربيَّة الإسلاميَّة التي آلت على نفسها تصفية الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة المُعادية لها، والتوسُّع في بلاد العالم شرقاً وغرباً. وهكذا لم يكن هذا الفتح مجرَّد احتلال عسكري، بل كان حدثاً حضاريّاً بدأ العرب والمسلمون بترجمته على الأرض منذ دخولهم تلك البلاد، إلى أن تحقَّقَتْ حضارةٌ أندلسيَّةٌ عريقةٌ ظلّت معالمها ساطعة على مَرِّ السنين، ولا تزال.
أولاً- نُظم الحُكْم في الأندلس:
عَرَفَتِ الأندلس مِن لَدُنِ الفتح حتّى السقوط خمسة أشكال من نُظُم الحُكْم هي: نظام الولاية، نظام الإمارة، نظام الخلافة، نظام المملكة ونظام السلطنة.
1- نظام الولاية: عرفت الأندلس هذا النظام بُعَيْدَ الفتح بثلاث سنين، وبالتحديد عام 95ه/714م، وظلّ قائماً حتّى عام 138هـ/755م، لذا عرف عصر هؤلاء الحُكّام بعصر الوُلاة. وقد حكم بلاد الأندلس في خلال تلك المُدَّة التي لا تتجاوز ثلاثاً وأربعين سنة، عشرون والياً، أوّلُهُم عبد العزيز بن موسى بن نُصَيْر (95-97ه/714-716م) وآخرهم يوسف بن عبد الرحمن الفِهْري (129-138ه/746-755م) الذي تغلَّب عليه عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، المعروف بالداخل(13).
وكانت الأندلس في ظِلِّ هذا النّظام تابعة للمشرق، وقد شهدتِ فِتَنَاً داخليَّة كانت تقوم بين العرب والبربر وتغذِّيها العصبيَّة العنصريَّة، أو بين العرب أنفسهم وتغذِّيها العصبيَّة القبليِّة.
كذلك عرفت الأندلس نظام الولاية في عَصْرَي المُرابِطِين (المُلَثَّمين) والمُوَحِّدين البربر، ولكنّها لم تكن آنذاك ولاية تابعة للمشرق، بل ولاية تابعة للمغرب، خاضعة بصورة مباشرة لسلطان البربر بمرّاكش. وكون هؤلاء البربر طارئين على الأندلس، فقد ظلُّوا نسيجاً غريباً عن المجتمع الأندلسي، ما وفَّرَ جوّاً مؤاتياً لقيام ثورات ونزعات قوميَّة أندلسيَّة بوجه دولتيهما المُرابطيِّة والمُوَحِّديَّة.
وقد امتدّ عصر المُرابِطِين بالأندلس من عام 483ه/1090م حتّى عام 542ه/1147م، وأوّل أمرائهم يوسف بن تاشُفِينَ، وآخرهم إبراهيم بن تاشُفِينَ بن علي بن يوسف بن تاشُفِين.
وكان هؤلاء المُرابطون يُعيِّنون على مدن الأندلس وُلاةً تابعين لهم بمرّاكش(14). وبعدهم جاء المُوحِّدون، فحكموا الأندلس من عام 542ه/1147م حتّى 635ه/1237م، وأوّل خلفائهم عبد المؤمن بن علي، وآخرهم الواثق بالله إدريس بن محمَّد بن عمر بن عبد المؤمن، الذي انقرضت على يده دولتهم بالمغرب على أيدي بين مَرِين عام 667ه/1268م؛ لتقوم على أنقاضها ثلاثُ دُوَلِ تقاسمت السيطرة على بلاد المغرب. وهي: الدولة المرينيَّة بفاس، والدولة الزّيّانيَّة بِتِلِمْسان، والدولة الحَفْصِيَّة بتونس(15). وفي أواخر عهد المُوحِّدين تساقط معظم مدن الأندلس في أيدي الإسبان؛ فسقطت جزيرة مَيّورقة ومدينة بَطَلْيَوْس سنة 627ه/1229م، وسقطت قرطبة سنة 633ه/1235م، وَبَلَنْسِية سنة 636ه/1238م، وجزيرة شُقْر سنة 639ه/1241م، ومدينة شِلْب سنة 640ه/1242م، وشاطِبة وغيرها من شرق الأندلس سنة 645ه/1247م، وإشبيلية سنة 646ه/1248م(16).
2- نظام الإمارة: بعد عصر الوُلاة انتقلت الأندلس إلى عصر آخَرَ هو عصر الإمارة (138-316ه/ 755-928م)، فعرفت نظاماً جديداً هو نظام الإمارة، وقد تَوَلّى مقاليد الحُكم فيها آنذاك ثمانية أمراء، أوّلهم عبد الرحمن الداخل، المعروف بصقر قريش (138-172ه/755-788م) وآخِرُهم عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله، المعروف بالناصر لدين الله (300-350ه/912-961م)(17).
وفي سنة 139ه/929م قَطَعَ عبد الرحمن الداخل الدُّعاء لأبي جعفر المنصور العبّاسي من على منابر الأندلس، وسَلَكَ الأمراء من بعده سُنَّته في ذلك إلى عهد عبد الرحمن الناصر، الذي تسمّى بالخلافة بعد سنين من سلطانه(18).
وفي عهود الأمراء الثلاثة محمَّد بن عبد الرحمن الأوسط وولديه المنذر بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد، عانتِ الحكومة المركزيَّة بقرطبة الضعف والفوضى، فاستغلَّت العناصرُ المعادية هذا الوضع وأقدمت على الاستقلال عن الإمارة، ما أدّى إلى ظهور دويلات مستقلَّة عن الحكومة المركزيَّة، عُرِفت باسم دويلات الطوائف الأولى، وفي بدايات حكم عبد الرحمن الناصر توحّدتِ الأندلس وانقضى عهد الفوضى والاضطراب السياسي(19).
3- نظام الخلافة: عرفت الأندلس هذا الأنموذج من نُظُم الحُكم عام 316ه/928م، بعد مرور سِتَّةَ عَشَرَ عاماً على تولّي عبد الرحمن الناصر مقاليد السلطة بقرطبة؛ إذ استكمل الناصرُ مرتبة الخلافة وسمّى نفسه أمير المؤمنين، واستمرَّتْ هذه السِّمةُ عليه وعلى عَقِبِه من بعده إلى أن انقرضت دولتهم عام 422ه/1031م، حيث انتقلت الأندلس إلى نظام ملوك الطوائف أو دول الطوائف(20).
وروى ابن خلدون أنَّه عندما تلاشى أمرُ الخلافة بالمشرق، واستبدَّ موالي التُّرك على بني العبّاس، وأنَّ المقتدر العبّاسي قتله مولاه سنة 327ه/938م، تَلَقَّبَ الناصر بألقاب الخلافة(21). ونقل المقَّري هذه الرواية وأخذ بها، ولكنَّه ذكر أنَّ الناصر تلقّب بألقاب الخلافة بعد مقتل المقتدر العبّاسي سنة 317ه/756م(22). ولم يُشِرِ ابن الأبّار إلى تسمية الناصر بالخليفة، فاكتفى بالقول بأنَّه لمّا ضَعُفَ سلطان العباسيِّين بالمشرق وغَلَبت عليهم الأتراك وظهرت الدعوة الفاطميَّة الشيعيَّة بالمغرب، تَسمّى الناصرُ بأمير المؤمنين، وذلك بعد سنين من تسلُّمه الحُكْمَ بقرطبة(23).
وبلغ عدد خلفاء الأندلس اثْنَيْ عشر خليفةً، ومنذ اندلاع الفتنة البربريَّة عام 399ه/1008م، وحتّى سقوط الخلافة عام 422ه/1031م، تقاسم الخلافةَ عَشْرَةُ خلفاءَ ضعفاءَ، أوّلهم المهدي محمَّد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن بن الناصر (399-400ه/1008-1010م) وآخِرُهم المُعتدّ بالله هشام بن محمَّد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر (418-422ه/1027-1031م).
وقد وُسِمَت هذه الفتنة بالبربريَّة نسبةً إلى البربر الذين دخلوا قرطبة مع المستعين سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر، عام 399ه/1009م، حين استولى عليها في دولته التي افتتحها بالقهر وسفك الدماء، وعاثوا بها(24). وقد أثَّرَتْ هذه الفتنة في نفسيَّة ابن شهيد أيَّما تأثير، فوصفها في إحدى رسائله فقال: “إنَّ الفتنة نَسْخٌ للأشياء، من العلوم والأهواء، ترى الفَهْمَ فيها بائر(25) السِّلعة، خاسِرَ الصَّفْقَة(26)…”. ووصفها ابن سعيد فقال في ترجمة أبي بكر محمَّد بن قاسم، المعروف بأشْكَهْباط: “تلك الفتنة التي قَلَبْتْ أسافِلُها أعاليها”(27). وكان من نتائج هذه الفتنة خرابُ مدينتي الزهراء والزاهرة بقرطبة، وتحويل قرطبة إلى فَيافِيَ مُوحِشَةً بعد الأنس، وذهابُ دولة بني أميَّة بالأندلس(28).
4- نظام المملكة: عندما سقطت الخلافة عام 422ه/1031م صارت قرطبة واحدة من اثنتين وعشرين مملكة من ممالك الطوائف بالأندلس(29). وكان لعرب قرطبة وبربرها وصقالبتها ومواليها مشاركةٌ غير مباشرة في تجزُّؤ الأندلس إلى هذا العدد من الممالك. وظلَّ هذا النظام سائداً في بلاد الأندلس حتّى عام 484ه/1091م. وكانت تلك الممالك متفكِّكة من الناحية السياسيَّة، يستعين ملوكها بملوك الإسبان؛ لمحاربة بعضهم بعضاً، حسبما يقول عبد الله بن بُلُقِّين، آخِرُ ملوك بني زيري بغرناطة في مُذَكَّراته: “فتنافسوا على الدنيا وطَمِعَ كلُّ واحد في الآخرَ. وكذلك لا يَصِحُّ أمرٌ بين نَفْسَيْن، فكيف سلاطينُ كثيرةٌ وأهواءُ مختلفة؟”(30)
وإذا كان الأدب قد وصل إلى أوْجه الكامل في عصر الخلافة، وخصوصاً في عَهْدَي الخليفة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر (350-366ه/961-976م)، حيث سادَ البلادَ رخاءٌ ورُقيٌّ وانتقلت حياة التَّرَف والنعيم من المشرق إلى الأندلس، فإنّ عصر ملوك الطوائف يُعَدُّ أيضاً عصر سطوع الأدب، إذ لم يَعُدِ الشعر والنثر منحصرين في قرطبةَ المركزِ الأدبي المرموق في العصر السابق، بل تعدّاها إلى مدن أخرى ضاهت قرطبة ونافستها، كغرناطة، وألمريَّة، وسرقسطة، وبَطَلْيوس، وإشبيلية، إلّا أنَّ هذه الأخيرة تحوَّلت أكثر من غيرها، في ظِلِّ بني عَبّاد، إلى مدينة الفنّ والرقص والموسيقى، وطغى الشعرُ على غيره من الفنون(31).
وإذا كان همُّ ملوك الطوائف في الاستكثار من أسباب التَّرف والبَذْخ، فإنَّ علماء الأندلس قد أَفْتَوْا أميرَ المُرابِطِين يوسف بن تاشُفِينَ في خلع هؤلاء الملوك، فخلعهم واحداً تلوَ الآخَر، مؤخِّراً سقوط الأندلس في أيدي الإسبان مدّةً تَنُوفِ على أربعة قرون، ومغيِّراً الوضع السياسيَّ في الأندلس، بحيث حوَّله إلى عصر جديد عُرِفَ بعصر السيطرة المغربيَّة (482-635ه/1090-1237م)؛ دولة المُرابِطِين البربر ودولة المُوَحِّدين البربر(32).
5- نظام السَّلْطَنَة: عرفت الأندلس نظامَ السلطنة في عصر سلاطين بني نصر، المعروفين ببني الأحمر، على يد سلطانهم الأوَّل الغالب بالله محمَّد بن يوسف بن محمَّد ابن نصر الخزرجي الأنصاري (635-671ه/1237-1272م)(33). وقد أسّس الغالب بالله لقومه بغرناطة سلطنة قويَّةً امتدّت حتّى عام 897ه/1492م، ترَبَّع على عرشها بعده سلاطينُ أقوياءُ، وآخرون ضُعَفاءُ، وعددهم واحد وعشرون سلطاناً، وأشهرهم قُوّةً أبو الحجّاج يوسف بن إسماعيل ابن فرج بن إسماعيل النّصري (734-755ه/1333-1354م) وابنه الغنيُّ بالله محمَّد بن يوسف بن إسماعيل ابن فرج بن إسماعيل النّصْري (755-793ه/1354-1390م)، اللذان وصلت الحركة الأدبيَّة في عهديهما إلى عِزَّها، حيث عرفت الأندلس طائفةً من أئمّة الشعر من أمثال ابن الجيّاب وابن خميس وابن خاتمة الأنصاري وابن الخطيب وابن زَمْرَك.
وهذان الأخيران يُعدّان من شعراء الأندلس الفَطاحل، إذ استطاعا أن يردِّدا أصْداء الماضي في موسيقى جميلة وإيقاع تَطْرَبُ له الآذان أيَّما طرب(34).
وكان أضْعَفَهُمْ آخرُهم أبو عبد الله محمَّد بن علي بن سعد النّصْري، الذي سقطت الأندلس في عهده؛ فحين سقطت غرناطةُ حاضرة الأندلس في أيدي الإسبان عام 897ه/1492م خرج أبو عبد الله من قصر الحمراء منتكس الرأس وعيناه تذرفان فَيْضاً من الدُّمُوع، فقالت له أمُّه عائشة(35) (الخفيف):
اِبْكِ مِثْلَ النِّساء مُلْكاً مُضاعاً
لم تُحافِظْ عليه مِثْلَ الرِّجالِ
وقد أورد محمَّد عبد الله عنان هذا البيت الشعري، نقلاً عن رواية قشتاليَّة، نثراً بهذه الصورة: “أَجَلْ، فَلْتَبْكِ كالنِّساء مُلْكاً لم تستطعْ أنْ تُدافِعَ عنه كالرِّجال”(36).
وهكذا انقرضت بدولةِ أبي عبد الله مملكة الإسلام في الأندلس، ومُحيَت رُسُومها.
ثانياً- نُظم الإدارة في الأندلس:
كان المجتمع الأندلسي على امتداد أَكْثَرَ من ثمانية قرون قَدْ سادتْهُ نُظُمٌ إداريَّةٌ أشرفت عليها عناصرُ مسلمةٌ انحصرت في العرب والبربر والمولِّدين، وأخرى غير مسلمة انحصرت في اليهود والنصارى والإسبان سُكّان البلاد الأصليّين الذين عرفوا بعجم الأندلس وبالمُسْتَعْرَبِينَ Los Mozarabes. وقد عُرف هذا المجتمع بعيش مشترك كانت فيه التأثيراتُ بين العرب والمسلمين وبين النصارى متبادَلَةً، وإن كانت كَفَّةُ ميزان العرب والمسلمين هي الراجحة في التأثير.
ونحن إذا أردنا أنْ نبحث في جانب التأثير العربي والإسلامي في الإسبان واليهود، فإنَّنا نحتاج إلى دراسة مستقلّة؛ لأنَّ هذا التأثير كان قد عَمَّ مختلف جوانب المجتمع الأندلسي، ويكفي أن نذكر دليلاً واحداً على ذلك وهو أنَّ المُسْتَعْرَبِينَ واليهود أَتْقَنوا اللغة العربيَّة الفصيحة والعاميَّة، وتمكنوا من كتابتها؛ لأنّ العربيَّة الفصيحة كانت اللغة الرسميَّة في الأندلس ولغة الأدب والتفاهم بين الناس، والعربيَّة العاميَّة كانت مجالاً للتفاهم بين عناصر المجتمع الأندلسي ومجالاً للانتشار في كثير من خَرَجاتِ المُوَشَّحات(37).
وفيما يتعلّق بتأثُّر العرب والمسلمين بالنّصارى في الجانبين الاجتماعي والثقافي، فهناك غير دليل على ذلك؛ ففي الجانب الاجتماعي التزم العرب والمسلمون يوم الأحد من كلِّ أسبوع عطلةً رسميَّة(38). وشاركوا المُسْتَعْرَبِينَ في أعيادهم وفي مقدّمتها عيدُ ميلاد السَّيِّد المسيح وعيد رأس السنة الميلاديَّة(39). واتَّخذوا زيِّ النصارى الإسبان المجاورين لهم، حتّى في عهود بني نَصْر بغرناطة(40). وتزوَّجوا من إسبانيّات، وأوَّلُ من تزوّج إسبانيَّة هو والي الأندلس عبد العزيز ابن موسى بن نُصَيْر؛ تزوّج أيلة Egilona أرملة رُذريق Rodrigo آخِرِ ملوك القوط في إسبانيا، وكانت تُكَنّى في المصادر العربيَّة أمَّ عاصم(41).
وفي الجانب الثقافي نقول: تأثّر العرب والمسلمون بثقافة الإسبان، فأخذوا عنهم لغتهم الرومنثيَّة (الإسبانيَّة القديمة أو العجمِيَّة أو اللطينيَّة) التي انتشرت أيضاً في الشعر والنثر، ولا سيّما في خَرَجات المُوَشَّحات(42).
وعُرِفَ عن أهل الأندلس كَثْرَةُ التديُّن والنظافةُ، وإقامةُ الحدود ورجمُ القُضاة بالحجر إذا لم يَعْدِلوا، والبُعْدُ عن الإسراف والتَّبذْير، وحُبُّ الموسيقى والغناء، وعِزَّةُ النَّسَب، وفَصاحة الأَلْسُن، والعناية المُفْرِطَةُ بالعلوم، واستنباط المياه، وإحكْامُ المِهن ومُعاناةُ الحروب(43).
واعتنق أهل الأندلس أربعة مذاهبَ، أوّلها مذهب إمام الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، المُتوفّى سنة 157ه/774م(44)، وثانيها مذهب إمام المدينة المنوّرة مالك بن أنس، المتوفّى سنة 179ه/795م، الذي حلَّ محلَّ مذهب الأَوْزاعي(45). وثالثها مذهب أبي حنيفة النّعمان بن ثابت العراقي، المتوفّى سنة 150ه/767م، ولم يلق تجاوباً كبيراً(46). ورابعها مذهب داود بن علي بن خلف الأصفهاني، الملقَّب بالظاهري، المتوفّى ببغداد سنة 270ه/883م، وقد أخذ به فقيه الأندلس ابن حزم الأندلسي، إلّا أنَّه لم يَصْمُدْ أمامَ مذهب مالك، الذي ظلَّ سائداً في بلاد الأندلس حتّى السقوط، حسبما يقول المقَّري: “ولا مذهب لهم (لأهل الأندلس) إلّا مذهب مالك”(47).
وكان لحكّام الأندلس خِطَطٌ يتولّاها أهل الاختصاص ويقومون في قيام الدولة وتنظيم أعمال الحكومة، وهي التي تسمّى اليوم بالتنظيم الإداري، وقد تحدّث عنها النّباهيُّ وحصرها بستٍّ: أوّلها القضاء، ثم الشُّرطة، وصاحب المظالم، وصاحب الرَّدِّ (أي ما يُرَدُّ عليه من الأحكام) وصاحب المدينة وصاحب السوق(48). وحصرها المقَّري بسبعٍ هي: الوِزارة، والكِتابة، والخَراج، والقضاء، والشُّرطة، والحِسْبة والطّواف بالليل(49).
1- خِطَّة الوِزارة: خِطَّة الوِزراة من الخِطط الكبرى في الأندلس، وقاعدتها في مُدَّة بني أُميَّة أنَّ صاحب الدولة، الوالي أو الأمير أو الخليفة، هو الذي كان يُعَيِّنُ الوزراء؛ وذلك للإعانة والمُشاورة، وأنَّه كان يَخُصُّهم بالمُجالسة، وأنَّ مراتبهم كانت كالمُتَوارثة في البيوت المعلومة لذلك، وأنَّه كان يختار منهم شخصاً ينوب عنه، يُعرفُ بالوزير ويُسمّى الحاجب، وأنَّ اسم الحاجب كان مُعَظَّماً(50).
وقاعدتها في عصر ملوك الطوائف أنّ المَلِكَ من ملوك الطوائف كان يُسمّى بالحاجب؛ لِعِظَم اسم الحاجِب في مُدَّة بني أُمَيَّةَ، وكان يرى أنّ هذه السِّمة أعظم ما تُنُوفِسَ فيه وظُفِرَ به وأنّها موجودة في مدائح الشعراء، وأنّ من جالس هؤلاء الملوك واختصّ بهم صار وزيراً، وأصبح الحاجِبُ، أي الوزير الذي ينوب عن الملك، يُعرف بذي الوزارتين، وأكثر ما يكون عالماً بأمور المُلك، وقد يكون فاضلاً في علم الأدب(51).
نبدأ بعصر الوُلاة فنقول: لم يكن للوالي وزراءُ، بدليل أنَّ عبد الرحمن الداخل، أوَّلَ أمراء بني أميّة الذي أنهى نظام الولاية، لم يكن له من يطلق عليه سِمَةُ وزير، بل كان له أشياخٌ عيَّنهم للمُشاورة والمُؤازرة، أوّلهم أبو عثمان وعبد الله بن خالد(52). ويروي الخُشَنيُّ أنَّ هشام بن عبد الرحمن الداخل (172-180ه/788-796م) كان له وزراءُ، وأنَّ هؤلاء الوزراءَ كانوا قد عرضوا على زياد بن عبد الرحمن القضاء عن الأمير هشام، فأبى(53).
وكان للوزارة بَيْتٌ يجتمعون فيه(54). وهو بيت رفيع أقامه الأمير عبد الرحمن ابن الحكم، المعروف بعبد الرحمن الأوسط (206-238ه/821-852م) داخل قصره، وخصّه للوُزراء، فإذا قعدوا فيه أخرج رسائله إليهم بأمره ونَهْيه، فينظرون فيما يصدر إليهم من عزائمه، وقد جرى على ذلك من تلاه حتى أيّام ابن حيّان، المتوفّى سنة 469ه/1076م(55). وهو أوَّل من ألزم الوزراءَ الاختلاف إلى القصر كلّ يومٍ، والمَشُورَةَ لهم في النَّوازل، يستدعيهم إذا شاء إلى مجلسه جماعةً وأشتاتاً، يَفْحَصُ معهم الرأي فيما يُبْرِمُه من أحكامه ويخوض معهم فيما يطالع به من أمور دولته(56).
وأوَّل من سمِّيَ بالأندلس بذي الوزارتين الوزير أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن عمر ابن شهيد بن الوضّاح الأشجعي، وكان من أهل الأدب البارع(57). يروي المقَّري أنَّ ابن شهيد هذا كان أهدى لعبد الرحمن الناصر هديَّته المشهورة سنة 327ه/938م وكتب معها رسالة حسنة اعترف بها للناصر بالنعمة والشُّكر عليها، فزاد الناصر وزيره حَظْوةً، وأسمى منزلته على سائر الوزراء، وتبنّى له العظمة فسمّاه ذا الوزارتين، وكان أوَّل من تسمّى بذلك بالأندلس امتثالاً لاسم صاعد بن مَخْلَد البغدادي، المتوفّى سنة 276ه/889م، وزير بني العبّاس ببغداد، الذي لُقِّب بذي الوزارتين(58).
وهناك من وُلّي الوزارة والكتابة معاً؛ يروي ابن حيّان أنّ محمَّد بن موسى الغافقي وُلِّي الوزارة والكتابة في عهد عبد الرحمن الأوسط سنة 213ه/828م(59). وهناك من وُلِّي الوزارة والمدينة معاً، كالوليد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم، الذي تولّاهما للأمير محمَّد بن عبد الرحمن الأوسط(60).
ويُقابِلُ الحاجبَ اليوم رئيسُ الوزراء، ونظرًا إلى أهمِّية منصب الحجابة، أخذ الوزراءُ، بعد وفاة الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مُغِيث في صدر إمارة عبد الرحمن الأوسط، يتنافسون فيها(61). وكان ابن مغيث هذا حاجب الحكم بن هشام، المعروف بالحكم الرَّبَضيّ (180-206ه/796-821م)(62)، ولم يكن منصب الحجابة معروفا في عصر الولاة، بل عرفه عصر الإمارة؛ فتمام بن علقمة كان أوَّل حُجّاب عبد الرحمن الداخل، ومِنْ بَعْدِهِ جاء يوسف بن بَخْت الفارسي، ثُمَّ تلاهما عبد الكريم بن مغيث (63).
وكان حَبُّوس بن ماكْسَنْ بن زِيري ( 410-429ه/1019-1037م) مَلِك غرناطة في عصر ملوك الطوائف، قد اتَّخَذَ إسماعيل بن يوسف بن نَغْرالَّة اليهودي كاتبه وناصحه ومستشاره ووزيرا أوَّلَ لِمَمْلَكَتِهِ(64). وبعد وفاة حَبُّوس تَوَلّى ولدُه باديس مقاليد الحكم (429-467ه/1037-1074م)، فأمضى وزير أبيه وكاتبه، إسماعيل ابن نَغْرالَّة، على وزارته وكتابته وسائر أعماله، ورفعه فوق كل منزلة(65). وبعد وفاة إسماعيل ابن نَغْرالَّة عام448ه/1056م، وَلّى باديسُ يوسف بن إسماعيل ابن نغرالَّة على خِطَّة الوزارة التي تَبَوَّأَها أبوه، فَخَلَفَهُ على منصب الوزير الأوَّل(66).
2- خِطَّة الكِتابة: هي أيضاً من الخِطَط الكبرى بالأندلس، وهي والحِجابة والوزارة من الخِطَط السَّنِيَّة، حسبما يقول ابن الأبّار في ترجمة الوزير أحمد بن عبد الملك ابن عيسى ابن شهيد: “وتَصَرَّفَ بنوه للخلفاء في الخِطَط السَّنِيَّة من الإمارة والحجابة والوزارة، إلى انقراض الدولة الأمويّة بالأندلس(67). وهي على ضَرْبينِ: أعلاهما كاتب الرسائل، ويليه كاتب الزِّمام(68). وكاتب الرسائل أديب يتولّى كتابة الرسائل الرسميَّة وغير الرسميَّة(69). وكان له حظّ في القلوب والعيون عند أهل الأندلس، وأشرف أسمائه: الكاتب، وبهذه السِّمة يَخُصُّه من يعظِّمه في رسالة، وأهل الأندلس لا يكادون يَغْفُلُون عن عثراته لحظة؛ فإن كان ناقصاً عن درجات الكمال لم ينفعها جاهُه ولا مكانه من سلطانه من تَسَلُّط الألسن في المحافل والطّعْن عليه(70).
أمّا كاتب الزّمام، فيعرف أيضاً بكاتب الجهبذة، أي المعرفة بتمييز الجّيِّد من الرّديء(71). ووسَمه أحمد أمين بالكاتب الحسابيّ(72). ولا يكون هذا الكاتب يهوديّاً ولا نصرانيّاً ألبتّةَ؛ لأنَّ عمله نبيهٌ يحتاج إلى صاحبه عظماءُ الناس ووجوهم، ولأنَّ عظماء الناس كانوا يأنفون أن يحتاج المسلم إلى من ليس من دينه(73).
ويروي ابن حيّان أنَّ الأمير عبد الرحمن الأوسط كان قد اتَّخذ للوزراء كاتباً مفرداً لكتابتهم، وجرى الأمر على ذلك من بعده إلى آخر دولة بني أميّة(74).
وكان أميّة بن زيد يكتب ليوسف بن عبد الرحمن الفِهري، آخر وُلاة الأندلس(75). وأوّل من كتب للأمير عبد الرحمن الداخل أبو عثمان وعبد الله بن خالد ثمّ أميَّة بن يزيد، كاتب الفِهْري من قبل(76).
وروى الخشنيُّ أنَّ قومس ابن أنْتنيان النَّصراني تولّى الكتابة للأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط (238-273ه/852-886م) ومات على النَّصرانيَّة(77). وروى ابن حيّان أنَّ قومس المذكور كان نصرانيّاً وأسلم، فولّاه الأمير محمَّد بن عبد الرحمن الأوسط كاتب الرسائل، وكان بليغاً بصيراً بصناعة الكتابة الحِسبانيَّة، مُدَقِّقاً لحساباتها الصعبة، وهو الذي سَنَّ لِكُتّاب الأمير وأهل الخدمة تعطيل الخدمة في يوم الأحد من الأسبوع(78).
وكان أبو القاسم ابن العريف، وزيرُ حبُّوس بن ماكْسَن بن زيري قد عيّن إسماعيل بن يوسف بن نغرالَّة اليهودي كاتباً له ومستشاراً، فدخل اليهودي بذلك في خدمة البَلاط الغرناطي(79).
3- خِطّة القضاء: هذه الخِطَّةُ من أَسْنى الخِطط وأجَلِّها وأعظمها قَدْراً بالأندلس، ولا سيّما إذا اجتمعت إليها الصلاة(80). وعدَّها المَقَّري من أعظم الخِطَط عند الخاصَّة والعامَّة من الأندلسيّين؛ لتعلّقها بأمور الدين(81). وكان على رأسها قاضٍ كبيرٌ سمّيَ قاضي الجُنْد ثمّ قاضي الجماعة فيما بعد(82). وكان يسمّى ببغداد قاضي القضاة(83). وقال المقّري: “وقاضي القضاة يقال له: قاضي القضاة وقاضي الجماعة”(84). وكانوا يُسَمُّونه في عصر الولاة قاضي الجُنْد(85). وفي عصر الإمارة سُمِّيَ قاضي الجماعة؛ يروي المقّري أنّ عبد الرحمن الداخل، لمّا تسلَّم مقاليد الحكم بالحاضرة قرطبة، ألفى على قضاء الجماعة يحي بن يزيد اليَحْصُبيّ، فأقرّه حيناً، ثُمَّ ولّى بعده معاوية بن صالح الحِمْصي(86). وهكذا قال الخشني، ولكنّه لم يُسَمِّ يحي قاضي الجماعة، بل سمّاه قاضي قرطبة(87). ورُوِيَ أنَّ عبد الرحمن الداخل تَغَلَّبَ على يوسف بن عبد الرحمن الفِهريّ، آخِرِ وُلاة الأندلس، فهَرَبَ الفهري إلى غرناطة، فلحِقَ به الداخل في السنة التالية وحاصره بغرناطة فطلب الفِهريّ الأمانَ بحضور قاضي قرطبة يحي بن يزيد التُّجيبي، فحضر القاضي وكتب في كتاب المقاضاة هذه العبارة: “بمحضر يحي بن يزيد، قاضي الجماعة”(88). ويروي ابن القوطيّة أنّ الأمير محمَّد بن عبد الرحمن الأوسط استقضى عمرو بن عبد الله بن مُغيث، المعروف بالقُبَّعة، على القضاء بقرطبة، ثم عزله(89). ويضيف أنّ هذا الأمير أعاد القُبَّعة إلى قضاء الجماعة بقرطبة، وهو أوَّل من تسمّى قاضي الجماعة، إذ لم يكن من الجند فينسب إليهم ويقال له: قاضي الجند، وأنّ القضاة قبله كانوا من أجناد العرب(90). ويذكر الخُشني أن القبّعة المذكور كان أوّل من ولِّي قضاء الجماعة من الموالي، فَشَقَّ ذلك على العرب(91).
وظلَّ اسم قاضي الجماعة سائراً في العصور اللاحقة، حتّى عصر سلاطين بني نصر، وقد ظهر هذا الاسم في الظَّهيرِ الذي أنشأه ابن الخطيب على لسان سلطان غرناطة الغنيِّ بالله، حين أضاف الغنيُّ إلى علي بن عبد الله ابن الحسن النُّباهي المالقي خطابة الجامع الأعظم بغرناطة إلى قضاء الجماعة بها: “قاضي الجماعة وخطيب الحضرة العليّة”(92).
ونَظَراً إلى عَظَمَة شأن قضاة الجماعة، فقد كان الوزراء يُسْتشارون في اختيارهم؛ يروي الخشني أنَّ الأمير المنذر بن محمَّد (273-275ه/886-888م) استشار الوزراء في اختيار قاضي الجماعة بالحاضرة قرطبة(93). ويضيف أنَّ الأمير عبد الله بن محمَّد (375-300ه/888-912م) جَمَعَ الوزراء يوماً وجعل يشاورهم في قاض(94).
وكان العلماء يشترطون في متولّي خِطَّة قضاء الجماعة العقل، والعلم، والورع، والصِّحّة، والكمال، والذكاء والفطنة(95).
وهناك من جمع بين خُطَّتي القضاء والصلاة بالجامع الأعظم، كمحمَّد بن بشير ابن شراحيل المعافري، الذي ولّاه الحكم بن هشام، المعروف بالرَّبَضيّ (180-206ه/796-821م) قضاء الجماعة والصلاة(96). ومحمد بن سلمة الذي ولّاه الأمير عبد الله بن محمَّد تيْنِكَ الخُطَّتَيْن(97). وخِطَّة الصلاة تتضمَّن خطابة الجامع الأعظم، وبذلك تكون خِطَّتا الجماعة وخطابة الجامع الأعظم منصبين دينين لم يكن في الأندلس في أيّام ابن الخطيب المتوفّى سنة 776ه/1374م، أجلُّ منهما(98).
وكان لقاضي الجماعة سلطة كبيرة، فكان يَحُدُّ على الزِّنا وشرب الخمور، وكان له الحقُّ في أن يأمر بقتل من يستحقُّ القتل دون الرجوع إلى الحاكم الأول، وكان يُحضر الحاكم الأوّل ليسمع كلامه(99). يروي المقَّري أنَّ الحاكم في مدّة بني أميّة، كان لو توجَّه عليه حُكْمٌ، لحضر بين يدي القاضي حتّى لو كان هذا القاضي والياً للحكم الشرعي في مدينة جليلة؛ لأنَّه إذا كان في مدينة صغيرة فلا يطلق عليه إلّا مُسّدِّد(100). وبعد أن حَدَّدَ النُّباهي حكم القاضي في الدماء والأموال والحلال والحرام(101)، عدّد أحكامه وحصرها بعشرة أهمُّها: قطع التشاجر من المتنازعين، واستيفاء الحقّ لمن طلبه، والنَّظَرُ في الأحباس (الإشراف على السجون والمساجين)، وإقامة الحدود، والنظر في المصالح العامَّة وتوخّي العدل(102). وأضاف أنّه إذا تظلَّمَ أهل المدن من قضاتهم، تعهَّدَ الأميرُ إلى قاضي الجماعة بالحاضرة قرطبة أن ينظر في الأمر؛ ليرى ما إذا كان القاضي ظالماً أو بريئاً من تهمة الأهالي(103).
وأضاف أن الأمير الحكم الرّبضي أمر قاضي الجماعة أن يتخيّر من يراهُ مناسباً من القضاة على المدن والنواحي(104).
وقد يصاحب القاضي أميره في غزواته؛ فالقاضي معاوية بن صالح رافق الأمير عبد الرحمن الداخل في إحدى غزواته،ن فلبس سلاحه ومضى إلى الصفِّ حيث القتال(105). وهناك قضاة كانوا يتغافلون عن قرع السُّكارى بالسِّياط؛ لرقَّة قلوبهم(106). وكان لقاضي الجماعة كاتب خاصّ(107).
وكان مكان عمل قاضي القضاة في الحاضرة في المسجد الجامع أو في داره؛ يروي الخشني أن محمَّد بن بشير، قاضي الجماعة في عهد الحكم بن هشام، كان يقضي في سَقِيفَةٍ معلّقَةٍ بقبليّ مسجد أبي عثمان بقرطبة، وكانت داره قِبلْيَّ ذلك المسجد، وكان يقعد للقضاء وحده ولا يجلس معه أحد، فيفصل بين الخصمين، وكان يقعد لسماع الخصومة من غدوِّه إلى ما قبل الظهر بساعة، ثم يقعد بعد صلاة الظهر إلى العصر(108). ويضيف أنّ سعيد ابن سليمان الغافقي، قاضي القضاة فب عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط، كان يحكم في المسجد الجامع بقرطبة، وكان يأتي إلى المسجد ماشياً(109). وكان إذا وَلّاه الخليفة قَدَّمَ له المَواعظ والوَصايا وحدّ له الحدود ورسم له الرسوم(110).
وكان للقضاء ديوانٌ تدوّن فيه أسماء قضاة الجماعة بالحاضرة قرطبة(111). وقاضي الجماعة مسؤول عن هذا الديوان (112).
4- خِطَّة المظالم: أغلب الظَّنِّ أنَّ هذه الخِطَّة تابعة لخطة القضاء، وقد انفرد بذكرها ابن حيّان، فروى أنَّ الخليفة عبد الرحمن الناصر قدَّمَ في عام 328ه/939م الوزير أبا العبّاس أحمد بن عبد الملك بن عمر ابن شُهَيْد على خِطَّتي المظالم والشرطة العليا، فَجُمِعَ له ذلك إلى الوزارة(113).
5- خِطَّة الشرطة: هذه الخِطَّة أدنى من خِطَّة الوزارة: يروي ابن حيّان أنَّ عبد الرحمن الأوسط بعد تسلُّمه الإمارة، أمضى محمَّد بن كليب بن ثعلبة على الشرطة، إذ كان يتولّاها من قَبْلُ، ثُمَّ رَقّاه إلى الوزارة(114).
وكانت هذه الخِطَّة تسمّى أيضاً “أحكام الشرطة”؛ ذكر ذلك ابن بَشْكُوال، فقال في ترجمة عبد الرحمن بن محمَّد الرُّعَيْني، المعروف بابن المَشّاط: “وولّاه ابن أبي عامر (المنصور محمَّد بن أبي عامر) أحكام الشرطة”(115).
وكان صاحبها يسمّى والي الشرطة(116). وقال المقّري: “ويعرف صاحبها في ألسن العامّة بصاحب المدينة وصاحب الليل”(117). ومن صلاحيّاته أخذ السّكران والأمر بجلده(118).
وحدّد المقّري صلاحيّاته في قوله: وهو الذي يَحُدُّ على الزِّنا وشرب الخمر، وكثيرٌ من الأمور الشرعيَّة راجعٌ إليه”(119). وهنا تتداخل صلاحيّاته وصلاحيّات قاضي الجماعة. وإذا كان عظيم القدر عند الأمير كان له القتل لِمَنْ وَجَبَ عليه دون استئذان الأمير، وذلك قليل، ولا يكون إلّا في حضرة الأمير(120).
وكان في الأندلس نوعان من الشرطة: الشرطة الصغرى (السُّفلى) والشرطة الكبرى (العليا)(121). وفي سنة 317ه/929م اخترع الخليفة عبد الرحمن الناصر خِطَّة الشرطة الوسطى، فكان أوّل من ثلَّثها، فصار في أيّامه ثلاث خططٍ للشرطة: خطة الشرطة الصغرى، وخِطَّة الشرطة الوسطى، وخِطَّة الشرطة الكبرى، وتعرّفت هذه الخِطَطُ الثلاث في دولته واستمرّت بعده(122). ويروي ابن حيّان أنّ حارث بن أبي سعد ولِّي الشرطة الصغرى في عهد عبد الرحمن الأوسط، وبالتحديد عام 221ه/835م(123). ويروي الخشني أنّ الأمير عبد الله ابن محمَّد وُلِّيَ موسى بن محمد بن زياد ابن حبيب الجذامي خِطَّة الشرطة الصغرى، ثُمَّ نقله إلى الشرطة العليا(124). ويضيف الخشني أنَّ ابن حبيب هذا كان قد تصرَّف في خِططٍ جَمَّة، منها الوزارة والكتابة(125).
وهناك من وُلِّيَ الشرطة والصلاة معاً، كمحمَّد بن خالد بن مرتنيل، المعروف بالأشج، إذ كان صاحب الصلاة بالحاضرة قرطبة، ثم أضيفت إليه ولاية الشرطة عام 224ه/838م(126).
6- خِطَّة المدينة: هي من الخِطَط ذوات الشأن الأعظم، وقد يتولّاها وزير؛ فالأمير محمَّد ابن عبد الرحمن الأوسط كان يُداوِلُ مدّة ولاية المدينة في الحاضرة قرطبة بين وزيرين هما: أميَّة ابن عيسى ابن شهيد ووليد بن عبد الرحمن بن غانم؛ لمعرفته بفضلهما وبأنّهما لا ينفذانِ في أحكام المدينة والأمور العِظام فيها إلّا بما يوافق الحقّ والصواب(127).
وصاحبها يسمّى والي المدينة أو صاحب المدينة(128). وهو المسؤول عن أمن المدينة(129)، وقد تكون رُتْبَتُهُ أعلى من رتبة قاضي الجماعة؛ يروي الخشني أن عبد الرحمن الأوسط أراد عزل قاضي الجماعة محمَّد بن زياد، فأمر والي المدينة محمَّد بن السليم أن يحضر محمد ابن زياد، فتمّ عزله(130). ويضيف الخشني أن الأمير محمَّد بن عبد الرحمن الأوسط كتب في عام 260ه/874م إلى أميَّة بن عيسى ابن شهيد، صاحب المدينة يومئذ، يأمره بعزل سليمان ابن أسود عن قضاء الجماعة بالحاضرة قرطبة(131). ويروي الخشني أيضاً أنَّ الأمير المذكور عَزَلَ أميَّة بن عيسى ابن شهيد عن المدينة، إذ كان صاحبها (132).
7- خِطَّة الطّواف بالليل: يُعْرَفُ صاحبُ هذه الخِطَّة بالدَّرّاب؛ لأنَّ مدن الأندلس كان لها دروب بأغلاق (أقفال) تُغلق بعد العتمة(133). وكان للدرّاب مساعدون يبيتون الليل؛ لحماية الناس من اللصوص وشرّ العامَّة الحاذقين في أمور التلصُّص؛ ففي كل زُقاق من أزقة المدينة خفيرٌ يخفره ويبيت الليل ومعه سراج معلّق وكلب يسهر، وسلاح مُعَدٌّ؛ لأنَّ اللصوص كانوا يفتحون الأغلاق الصعبة ويقتلون صاحب الدار خوف أن يطالبهم بعد ذلك، إذ لا تكاد في الأندلس تخلو من سماع: “دار فلان دُخِلَت البارحة” و “فلان ذبحه اللصوص على فراشه”(134). وبرغم إفراط والي المدينة في الشدَّة، حيث إنّ سيفه كان يقطر دماً، وإنّ الحال آلت إلى أن قتلوا شخصاً سرق عنقوداً من كرم عنب، وما أشبه ذلك، فإنّ اللصوص لم ينتهوا(135).
8- خِطَّة الخيل: يعرف صاحب هذه الخِطَّة ب “صاحب الخيل”؛ يذكر الخشني أنّ موسى بن سماعة كان صاحب الخيل في عهد الأمير الحكم بن هشام، المعروف بالحكم الرَّبَضي(136). وكانت هذه الخِطَّة أدنى من خِطَّة الوزارة؛ يروي ابن حيّان أنّ عيسى بن شهيد بن عيسى ابن شهيد ولّاه الأمير عبد الرحمن بن الحكم الرّبضي خطّة الخيل، ثم استوزره(137). ويقول ابن حيّان في ترجمة هشام بن عبد العزيز بن هاشم، أشهر وزراء الأمير محمَّد بن عبد الرحمن الأوسط: “وكانت أوَّلَ ولاية أَحْظَتْه بالأمير محمَّد فبانَ فيها، استقلالُه خِطّة الخيل، التي قلده إيّاها… ثمّ رَقّاه إلى خِطّة الوزارة”(138).
9- خطّة القيادة: هي خِطّة قيادة الجيوش، ومن يتولّاها يحظى بثقة الأمير؛ يروي ابن عِذاري أن شهيد بن عيسى ابن شهيد حَظِيَ بثقة الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل، فكان قائداً لجيوشه(139).
10- خِطَّة الإشراف على الدولة: يتولّاها من يحظى بثقة الخليفة ثقة كبيرة؛ يروي ابن حيّان أنّ الخليفة عبد الرحمن الناصر أقصى في عام 330ه/941م أحمد بن شُهيد عن خطة الإشراف على المملكة وعَيَّنَ مكانه عليها ابنه وليّ عهده الحكم المستنصر(140).
11- خطة الوثائق السلطانية: تُعنى الوثيقة السلطانيَّة بموضوعات مختلفة كالمال والميراث وغيرهما، ومن يتولّاها يُعرف بصاحب الوثائق، ويكون حسن الفطنة فيها. فلا يُوقِّعُ شهادته فيها حتى يقرأها من فاتحتها إلى خاتمتها(141). وقد تولّاها عبد الرحمن ابن محمَّد الرُّعيني المعروف بابن المَشَّاط، من قبل الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر، حسبما يقول ابن بشكوال في ترجمة ابن المَشَّاط المذكور: “وولّاه ابن أبي عامر أحكام الشرطة وخطة الوثائق السلطانية”(142)
12- خِطَّة العَرضْ: أغلب الظَّنِّ أنَّ هذه الخِطَّةَ تقوم بوظيفة عَرْضَ الجُنْدِ؛ لِيُعْرَفَ مَنْ غاب منهم ومن حضر. وقد ذكرها ابن عِذاري، فروى أنَّ عبد الرؤوف بن أحمد بن عبد الوهّاب تولاها في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر عام 317ه/929م: “وفيها… ووُلِّيَ عبد الرؤوف ابن أحمد بن عبد الوَهّاب خِطَّة العَرْض”(143).
13- خِطَّة الطِّراز: تُعنى هذه الخِطَّة بنسج ثياب الوالي أو الأمير أو الخليفة أو الملك أو السلطان. وقد تولّاها سعيد بن عبد الملك بن سعيد بن عاصم في عهد الأمير محمَّد بن عبد الرحمن الأوسط(144).
14- خِطَّة الخِراج: تُعنى هذه الخِطَّة بجمع ضريبة ما يُخْرَجَ مِن غَلَّة الأرض، وما يقع على الجِزْية ومال الفَيْء. وصاحب الأشغال الخراجيّة في الأندلس أعظم من الوزير؛ فإليه تميل الأعناق، ونحوه تُمَدُّ الأكفّ(145).
15- خِطَّة الخزانة (المال): تُسَمّى أيضًا خِطَّة المال، ويُسَمّى صاحبها خازن المال، وكان خازنو المال يَقْعُدُون مع القوّاد عند حضور العطاء(146). يروي الخشني أنَّ عبد الرحمن الأوسط عرض على موسى بن حُدَير ولاية الخزانة، فأبى قبولها، ثم تولّاها، فكان خازناً نحو الشهر(147). ويروي ابن حيّان أن عبد الله بن حسين بن عاصم تصرف في ولاية الخزانة للأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط(148). ويروي ابن عِذاري أن عبد الرحمن الناصر وَلّى خالد بن أميَّة بن شُهَيد خزانة المال، وفي سنة 316ه/928م عزله عنها، ثم أعاده إليها ثانية بعد سنة(149).
16- خِطَّة ولاية السوق: تتولّى هذه الخِطَّةُ النظر في السوق والإشراف على الشؤون العامة. وقد أسماها ابن حيّان ولاية السوق: “… الحسبة المعروفة عندنا بولاية السوق(150). وكرر ابن بشكوال ما قاله ابن حيّان، فقال في ترجمة عبد الرحمن بن محمد الرّعيني، المعروف بابن المشّاط: “واتَّصل بالمنصور محمَّد بن أبي عامر… وولاه أحكام الحسبة المدعوَّة عندنا بولاية السُّوق(151). وأسماها ابن حيان أيضاً: خطة السُّوق فقال في ترجمة سليمان بن وانسوس: وتولّى سليمان بن وانسوس خِطَّة السوق للأمير محمد، ثم عزله عنها(152). وسمّاها النُّباهي: الحسبة، فقال: “وصاحب السوق كان يعرف بصاحب الحسبة”(153). وتابعه أحمد أمين في قوله: “وكان للأندلسيِّين خِطَطٌ لتنظيم أعمال الحكومة وهي… وكان بجانب وظيفة القضاء وظيفة الحسبة”(154). وأسْماها المَقَري: خِطَّة الاحتساب، فقال: “وأمّا خِطَّة الاحتساب، فإنَّها عندهم (عند الأندلسيِّين) موضوعة في أهل العلم…”(155).
ومَنْ تولاها كان يُعْرف بوالي السوق، وظلَّ هذا المصطلح سائدا في الأندلس، حتّى إنَّه ظهر في عصر المُرابِطِين إلى جانبه مصطلحان هما: ناظر السوق والمحتسب(156). كذلك عُرف بصاحب السوق وصاحب الحسبة: “وصاحب السوق كان يعرف بصاحب الحسبة؛ لأنَّ أكثر نظره إِنَّما كان يجري في الأسواق، من غِشٍّ، وخديعة، وتفقُّد مكيال وميزان، وشِبْه ذلك”(157). وعرف أيضاً بالمحتسب(158). وقد انتقل مصطلحاً “صاحب السوق” و “المحتسب” إلى الإسبان مُحَرَّفَينْ في صورتي Zabazoque: وalmotacén، وهما المستعملان اليوم(159).
وكان صاحب هذه الخِطَّة من أهل العلم والفِطَن، وكأنَّه قاض(160). وكي يمتحن الأسعار ويراقب البطاقات التي كانت توضع على الخبز واللحم والسلع، كان يَجُول في الأسواق وهو راكب، وأعوانه معه، وميزانه الذي يزن به الخبز في يد أحد هؤلاء الأعوان؛ لأنّ الخبز عند الأندلسيين كان معلوم الأوزان(161). وكان يرى أحيانا أنه من المصلحة أن يختبر الخَبّازُ سِرّاً فيرسل إليه صبيّاً صغيراً أو جارية(162). نشير هنا إلى أن أفران الأندلس كانت مصنوعة على شاكلة أفران المشرق(163).
وإذا لم يُحَدِّد المقَّري عقوبة الفرّان الغَشَّاش، فإنَّه حَدَّد عقوبة الجزّار؛ يروي أنّ اللحم تكون عليه ورقةٌ بسعره، بحيث لا يجرؤ الجَزّار أن يبيع بأكثر ما حدّ له المحتسب في الورقة، وقد يدسّ له المحتسب صبيّاً أو جارية، يبتاع أحدهما منه، ثم يختبر المحتسب الوزن، فإن وجدََ نقصاً قاس على ذلك حاله مع الناس، فلا تسأل عما يلقى، وإن كرَّرَ الجَزّار الغش وكثر ذلك منه ضربه المحتسب وجَرَّسه في الأسواق وأشْهَرَ عيوبه فيها، وإذا لم يتُب نُفي من البلد(164).
وكان لأهل الأندلس في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها كما تتدارس أحكام الفقه؛ لأنَّها عندهم تدخل في مختلف المُبْتَيَعات وتتفرَّع(165).
17- خِطَّة الديوان: يتولّاها قاض يشرف على دواوين الدولة كلِّها، فهناك ديوان الحاكم، وديوان الجُنْد، وديوان الرسائل، وديوان القضاء، وديوان بيت المال، وديوان النفقات، وديوان الخِراج، وديوان البريد… يروي الخشني أنّه لمّا توفّي القاضي محمَّد ابن سلمة عام 291ه/903م، أمرَ الأمير عبد الله بن محمَّد وزيره محمَّد بن أميَّة بن شُهَيد، صاحبَ المدينة يومئذ، أن يتولّى الديوان ويجعله بمكان الحِفْظ والصِّيانة حتّى يولي القضاءَ مَنْ يرضى(166).
حواشي البحث:
1 المَقَّري: نَفْح الطِّيب، تحقيق الدكتورة مريم قاسم والدكتور يوسف علي طويل، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1995 (ج1 ص127).
2 الحِمْيَري: الرَّوض المِعْطار، تحقيق الدكتور إحسان عبّاس، الطبعة الثانية، مؤسَّسة ناصر للثقافة، بيروت، 1980، ص33 والمقّري: نفح الطيب (ج1 ص135). وقد حدث الطُّوفان على أيّام نوح، عليه السلام.
3 المقّري: نفح الطيب (ج1 ص146).
4 ابن خلدون: كتاب العبر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1981(م4 ص252).
5 هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف بمصر، 1979 (ص13-14) والعبّادي: في التاريخ العبّاسي والأندلسي، دار النهضة العربيَّة، بيروت، 1971 (ص227).
6 طويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي، طبعة جديدة، بيروت، 2003، ص9.
7 الحُمَيْدي: جَذْوَةُ المُقْتَبَس الدار المصريَّة للتأليف والترجمة القاهرة، 1966، ص٦، والضبّيّ: بغية الملتمس، دار الكاتب العربي، القاهرة، 1967، ص 11.
8 المقَّري: نفح الطيب (ج1، ص163).
9 ابن غالب: قطعة من كتاب فرحة الأنفس، تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع، مجلَّة معهد المخطوطات العربيَّة، المجلَّد الأوَّل، الجزء الثاني، مطبعة مصر، 1955، ص281. وانظر أيضًا: الحِمَيري: الروض المعطار (ص33) والمقَّري: نفح الطيب (ج 1 ص 128-129).
10 الطبري: تاريخ الامم والملوك، دار القاموس الحديث، بيروت، دون تاريخ (ج 5، حوادث سنة 27هـ) وابن الأثير: الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، 1982، (ج 3 ص 93) وابن عِذاري البيان المغرب، تحقيق الأساتذة ج. س. كولان وإ. ليفي بروفنسال وإحسان عبّاس، دار الثقافة، بيروت، دون تاريخ (ج 2 ص4) وابن كثير: البداية والنهاية، الطبعة الثالثة، مكتبة المعارف، بيروت، 1979 (ج 7 ص 152) وابن تَغْري بِرْدي: النجوم الزاهرة، طبعة دار الكتب المصرية، دون تاريخ (ج 1 ص 84- 85).
11 عن فتح الأندلس انظر: الحُمَيْدي: جذوة المقتبس (ص 3-4) والضبّيّ: بغية الملتمس (ص 2-9) وابن خلدون: كتاب العبر (م4، ص253- 261) والمقري: نفح الطيب (ج1 ص 219- 264).
12 ابن خلدون: كتاب العبر (م 4 ص 255-256) والمقَّري: نفح الطيب (ج1 ص223-224).
13 عن هؤلاء الولاة انظر: ابن قتيبة: تاريخ الخلفاء المسمّى الإمامة والسياسة، الطبعة الثالثة، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1981 (ج2 ص103) والحميدي: جذوة المقتبس (ص5-8) والضبّيّ: بغية الملتمس (ص9-11) وابن خلدون: كتاب العبر (م4 ص255-261) والمقّري: نفح الطيب (ج1 ص224-228).
14 عن المُرابِطِين انظر: ابن خلِّكان: وَفَيات الأعيان، تحقيق الدكتورة مريم قاسم والدكتور يوسف علي طويل، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1998، (ج5 ص469-486) والذهبي: سِيَر أعلام النبلاء، تحقيق الأستاذين شعيب الأرناؤوط ومحمَّد نعيم العرقسوسي، الطبعة التاسعة، مؤسَّسة الرسالة، بيروت، 1413ه (ج18 ص426) وابن الخطيب: الحُلل المَوشِيَّة، مطبعة التقدّم الإسلامية بتونس، 1329ه (ص12-106) وابن خلدون: كتاب العبر (م6 ص373- 389) والمقّري: نفح الطيب (ج1، ص422- 425) وطرييه: التعصّب العنصري والديني في الأندلس، الطبعة الأولى، مطبعة بيبان، بيروت، 1986 (ص45) والهرفي: دولة المُرابِطِين، دار الندوة الجديدة، بيروت، 1405ه/1985م.
15 عن الموحِّدين انظر: ابن صاحب الصلاة: تاريخ المَنّ بالإمامة، تحقيق الدكتور عبد الهادي التازي، دار الحِّريَّة للطباعة، بغداد، 1979، (ص120-567) وعبد الواحد المرّاكشي: المُعْجِب، تحقيق الأستاذ محمَّد سعيد العريان، القاهرة، 1963 (245-282، 308-417) وابن خلِّكان: وَفَيات الأعيان (ج4 ص297-305) و(ج5 ص486- 494) وابن الخطيب: الحلل المُوشِيَّة (ص107-144) والمقّري: نفح الطيب (ج1 ص425- 426) والسعيد: الشعر في عهد المُرابِطِين والمُوحِّدين بالأندلس، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1979.
16 عن سقوط هذه المدن وغيرها من مدن الأندلس انظر: الحميري: الروض المعطار ص60، والمقري: نفح الطيب (ج6 ص219، 225- 226، 228- 229) وجاء فيه ص228، أنّ قرطبة سقطت سنة 636ه/1338م، وعنان: نهاية الأندلس، الطبعة الثالثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، 1966، ص20، وجاء فيه أنّ شاطبة سقطت عام 644ه/1246م، وطويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي ص12.
17 عن هؤلاء الأمراء انظر: الحميدي: جذوة المقتبس ص8-13، والضبّيّ: بغية الملتمس ص12-17، وابن حيّان: المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تحقيق الدكتور محمود علي مكي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1973، ص1-399، والمقتبس في تاريخ الأندلس، تحقيق الدكتور إسماعيل العربي، الطبعة الأولى، دار الآفاق الجديدة، المغرب، 1990، ص15-169، وابن الأبّار: الحُلَّة السِّيَراء، تحقيق الدكتور حسين مؤنس، الطبعة الأولى، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 1963، (ج1 ص35-50، 113-124) والمقّري: نفح الطيب (ج1 ص 360-419).
18 ابن الأبّار: الحُلَّة السِّيَراء (ج1 ص35-36) والمقّري: نفح الطيب (ج1 ص318) وابن عذاري: البيان المغرب (ج2 ص48).
19 طويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص11.
20 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق ب. شالميتا وف. كورينطي ومحمود صبح، المعهد الإسباني العربي للثقافة، مدريد 1979، (ج5 ص241-242). وعن خلفاء الأندلس انظر: الحُمَيْدي: جذوة المقتبس ص12-20، والضبّيّ: بغية الملتمس ص18-36، وابن حيان: المقتبس (ج5 ص7-490) وابن الأبّار: الحُلَّة السِّيَراء (ج1 ص36) وابن خلدون: كتاب العبر (م4 ص298-336) والمقَّري: نفح الطيب (ج1 ص319-364).
21 ابن خلدون: كتاب العبر (م4 ص298).
22 المقَّري: نفح الطيب (ج1 ص340).
23 ابن الأبّار: الحُلَّة السِّيَراء (ج1 ص198).
24 المقري: نفح الطيب (ج2 ص26).
25 بارَتِ السِّلْعَةُ: كَسُدَتْ ولم تَنْفُقْ.
26 ابن بسام: الذخيرة، في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1978-1979، (ق1 ص212).
27 ابن سعيد: المُغْرِبِ في حلى المَغْرِب، تحقيق الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، 1964، (ج2 ص31).
28 ابن حزم: رسائل ابن حزم، تحقيق الدكتور إحسان عباس، الطبعة الأولى، المؤسَّسة العربيَّة للدراسات والنشر، بيروت، 1980-1983 (ج1 ص 227، 260-261) وطوق الحمامة في الألفة والألاف، تحقيق الأستاذ فاروق سعد، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1972 (ص220،252).
29 عن ملوك الطوائف انظر: ابن خلدون: كتاب العبر (م4 ص336-356) والمقري: نفح الطيب (ج1 ص 426-432) وقاسم: مملكة ألمريَّة في عهد المعتصم بن صمادح، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية ببيروت، مكتبة الوحدة العربية بالدار البيضاء، 1994 (ص27-29)، ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية ببيروت، مكتبة الوحدة العربية بالدار البيضاء، 1994(ص84-86).
30 ابن بُلُقِّين: مذكرات الأمير عبد الله، تحقيق الأستاذ إ. ليفي بروفنسال، دار المعارف بمصر، 1955 (ص18).
31 راجع: طويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص25-26.
32 راجع: طويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص12.
33 عن دولة بني نصر وسلطنتهم بغرناطة انظر: ابن الخطيب، اللمحة البدريّة في الدولة النصرية، الطبعة الثالثة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1980، ص42-131، وابن خلدون: كتاب العبر (م4 ص366-384) والمقري: نفح الطيب (ج1 ص426-431) والأجزاء الأخرى.
34 راجع: طويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص28-29.
35 انظر: طويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص12-13. وعن تسليم أبي عبد الله مفاتيح الحمراء بغرناطة لصاحب قشتالة، والشروط التي فرضها المسلمون على الإسبان مقابل تسليم غرناطة انظر، المقّري: نفح الطيب (ج6 ص280-283) وعنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصِّرين، الطبعة الثالثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، 1966(ص229-270).
36 عنان: نهاية الأندلس ص267. وانظر أيضاً: مدخل إلى الأدب الأندلسي ص13.
37 راجع: ابن الحدّاد الأندلسي: ديوان ابن الحداد الأندلسي، تحقيق وتقديم الدكتور يوسف علي طويل، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990، ص69 من مقدّمة المحقِّق، وقاسم: مملكة ألمرية (ص66-67) ومملكة غرناطة ص249-250، وطويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي ص14-15، 217.
38 راجع: ابن حيّان: المقتبس، من أنباء أهل الأندلس، تحقيق د. مكي ص138، والمقّري: نفح الطيب (ج1 ص400) وابن الحداد الأندلسي: ديوان ابن الحدّاد الأندلسي (ص68، من مقدمة المحقق) وقاسم: مملكة ألمرية ص65، ومملكة غرناطة ص248-249، وطويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص13.
39 عن هذه الأعياد وغيرها انظر: ابن خلِّكان، وَفَيات الأعيان (ج5 ص576-577) وابن الحدّاد الأندلسي: ديوان ابن الحدّاد الأندلسي (ص68، من مقدّمة المحقّق)، وقاسم: مملكة ألمريَّة ص65، ومملكة غرناطة ص249، وطويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص14.
40 عبد الواحد المراكشي: المعجب ص278، وابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق الدكتور يوسف علي طويل، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003، (ج1 ص37-38) وأعمال الأعلام، تحقيق الأستاذ إ. ليفي بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، 1956 (القسم الثاني ص261) واللمحة البدريَّة ص39، والمقَّري: نفح الطيب، ج1، ص212-213، وطويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي ص14.
41 الحجّي: أندلسيّات: دار الإرشاد، بيروت 1969، ص75-86، وطويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي ص14.
42 راجع: ابن الحداد الأندلسي: ديوان ابن الحدّاد الأندلسي ص69، من مقدمة المحقق، وقاسم: مملكة ألمريّة ص66-67، ووملكة غرناطة، ص249-250، وطويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي ص15.
43 المقَّري: نفح الطيب (ج1 ص210، 214) و(ج4 ص 133-134) وطويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي ص16.
44 الحُمَيْدي: جذوة المقتبس ص244، والضبّيّ: بغية الملتمس ص324، والعبّادي: في التاريخ العباسي والأندلسي، دار النهضة، بيروت، 1971، ص319، وطويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي ص16.
45 الحُمَيْدي: جذوة المقتبس ص218، والضبّيّ: بغية الملتمس، ص294، والعبادي: في التاريخ العبّاسي والأندلسي، دار النهضة، بيروت، ص325، 1971، وطويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص17.
46 ابن حزم الأندلسي: رسائل ابن حزم الأندلسي (ج2 ص229) والعبّادي: في التاريخ العبّاسي والأندلسي، ص 327-328، وطويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص17.
47 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص211.
48 النّباهي: تاريخ قضاة الأندلس، تحقيق الدكتورة مريم قاسم، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995، ص20.
49 المقَّري: نفح الطيب ج1، ص208-209، وامظر أيضاً: طويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي ص19.
50 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص208.
51 المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
52 المصدر نفسه ج4، ص38.
53 الخشني: قضاة قرطبة، تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري، الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982، ص28.
54 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق مكّي، ص171.
55 المصدر نفسه، ص29.
56 ابن القُوطيَّة: تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري، الطبعى الأولى، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1402ه/1982م، ص77، وابن حيان: المقتبس، تحقيق مكّي، ص29.
57 ابن الأبّار: الحلَّة السيراء (ج1، ص337-338).
58 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص 342-343.
59 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق مكّي، ص79.
60 المصدر نفسه، ص174.
61 ابن القُوطيَّة: تاريخ افتتاح الأندلس، ص78.
62 المصدر نفسه ص64.
63 الخشني: قضاة قرطبة ص27، والمقَّري: نفح الطيب، ج4، ص38.
64 قاسم: مملكة غرناطة، ص109، 111، 112.
65 المرجع نفسه، ص148.
66 المرجع نفسه، ص151.
67 ابن الأبّار: الحُلَّة السِّيَراء، ج1، ص238.
68 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص208.
69 أمين: ظُهْر الإسلام، الطبعة الخامسة، دار الكتاب العربي، بيروت، 1969، ج3، ص19.
70 المقَّري: نفح الطيب، ج1 ص208.
71 المصدر نفسه والصفحة نفسها.
72 أمين: ظهر الإسلام، ج3، ص19.
73 المقَّري: نفح الطيب، ج1 ص208، وأمين: ظهر الإسلام، ج3، ص19.
74 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق مكّي، ص35.
75 المقَّري: نفح الطيب، ج4، ص38.
76 المصدر نفسه والصفحة نفسها.
77 الخشني: قضاة قرطبة، ص159- 160.
78 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق مكّي، ص138-142.
79 قاسم: مملكة غرناطة، ص111.
80 النباهي: تاريخ قضاة الأندلس، ص17، 22.
81 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص209. وانظر أيضاً: أمين: ظهر الإسلام، ج3، ص18.
82 الخشني: قضاة قرطبة، ص47، وأمين: ظهر الإسلام، ج3، ص18.
83 الخشني: قضاة قرطبة، ص18.
84 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص209.
85 الخشني: قضاة قرطبة، ص47.
86 المقَّري: نفح الطيب، ج4، ص39.
87 الخشني: قضاة قرطبة ص47.
88 المصدر نفسه، والصفحة نفسها، وابن عذاري: البيان المغرب، ج2، ص48.
89 ابن القوطيّة: تاريخ افتتاح الأندلس ص86.
90 المصدر نفسه ص 88.
91 الخشني: قضاة قرطبة، ص146.
92 المقَّري: نفح الطيب، ج7، ص129.
93 الخشني: قضاة قرطبة ص 182.
94 المصدر نفسه ص204.
95 النُّباهي: تاريخ قضاة الأندلس، ص17-18.
96 الخشني: قضاة قرطبة، ص75.
97 المصدر نفسه، ص200.
98 المقَّري: نفح الطيب، ج7، ص130.
99 أمين: ظهر الإسلام، ج3، ص18.
100 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص209.
101 النباهي: تاريخ قضاة الأندلس، ص17.
102 المصدر نفسه، ص21.
103 المصدر نفسه، ص29.
104 المصدر نفسه، ص89.
105 الخشني: قضاة قرطبة، ص54.
106 المصدر نفسه، ص226.
107 المصدر نفسه، ص226.
108 المصدر نفسه، ص76-77.
109 المصدر نفسه، ص140.
110 المصدر نفسه، ص223.
111 الخشني: قضاة قرطبة، ص141.
112 المصدر نفسه ص169.
113 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق الأستاذ ب. شالميتا و د.ف. كورينطي ود. محمود صبح، ج5، ص461.
114 المصدر نفسه، تحقيق مكّي، ص38.
115 ابن بَشْكُوال: الصِّلَة، تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري، الطبعة الأولى، دار الكتاب المصري بالقاهرة، دار الكتب اللبناني ببيروت، 1980، ص464.
116 الخشني: قضاة قرطبة ص129.
117 المقَّري: نفح الطيب (ج1 ص209).
118 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق مكي ص187.
119 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص209.
120 المصدر نفسه والصفحة نفسها.
121 الخشني: قضاة قرطبة، ص20، وابن حيّان: المقتبس، تحقيق شالميتا ج5، ص252.
122 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق شالميتا، ج5، ص252، وابن عٍِذاري: البيان المغرب ج2، ص201-202.
123 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق مكّي، ص80.
124 الخشني: قضاة قرطبة، ص 190.
125 المصدر نفسه ص191.
126 ابن حيّان: المقتبس تحقيق مكي، ص81.
127 ابن القوطيَّة: تاريخ افتتاح الأندلس، ص98، وابن حيان: المقتبس، تحقيق مكي ص171.
128 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق مكّي، ص172.
129 المصدر نفسه، ص 540، رقم الحاشية 341، من تعليق المحقِّق.
130 الخشني: قضاة قرطبة، ص132.
131 المصدر نفسه، ص169.
132 المصدر نفسه، ص158.
133 المقَّري: نفح الطيب، ج1 ص210، وأمين: ظهر الإسلام: ج3، ص18.
134 المقَّري: نفح الطيب، ج1 ص210، وأمين: ظهر الإسلام: ج3، ص18.
135 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص210.
136 الخشني: قضاة قرطبة، ص87.
137 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق مكي ص26.
138 المصدر نفسه، ص 160.
139 ابن عِذاري: البيان المغرب، ج2، ص63.
140 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق شالميتا، ج5، ص487.
141 الخشني: قضاة قرطبة، ص 227-228.
142 ابن بَشْكُوال: الصلة، ص464.
143 ابن عذاري: البيان المُغْرِب، ج2، ص202.
144 ابن حيان: المقتبس، تحقيق مكي، ص185.
145 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص209.
146 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق مكي، ص137.
147 الخشني: قضاة قرطبة، ص119.
148 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق مكي، ص186.
149 ابن عِذاري: البيان المغرب، ج2، ص 197- 202.
150 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق مكي، ص 186.
151 ابن بَشْكُوال: الصلة، ص464.
152 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق مكي ص189.
153 النُّباهي: تاريخ قضاة الأندلس، ص20.
154 أمين: ظُهْر الإسلام، ج3، ص18.
155 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص209.
156 راجع: عبّاس: السوق “الحسبة” في الأندلس، أطروحة دكتوراه بالجامعة اللبنانية، بإشراف الدكتور يوسف علي طويل، بيروت، 1420ه/2000م، ص17.
157 النُّباهي: تاريخ قضاة الأندلس، ص20.
158 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص209، وأمين: ظهر الإسلام، ج3، ص18.
159 F. Coriente Diccionario espanol- arabe, Instituto Hispano arabe de cultura Madrid, 1970 (zabazoque almotacen)
160 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص209، وأمين: ظهر الإسلام، ج3، ص18.
161 المقَّري: نفح الطيب، ج1 ص209.
162 المصدر نفسه والصفحة نفسها.
163 الخشني: قضاة قرطبة، ص166.
164 المقَّري: نفح الطيب، ج1، ص209-210.
165 المصدر نفسه، ج1، ص210.
166 الخشني: قضاة قرطبة، ص204.

